«قل لي ماذا قرأت، أقل لك من أنت».. لست أعرف ما إذا كانت هذه العبارة من أقوال أحدهم رسخت في ذاكرتي أم أنها من بنات أفكاري لكن ما أعرفه جيداً أنها تعبر بصدق عن تجربتي الشخصية. فقد كان من نعم الله عليًّ أني أدمنت القراءة منذ بدأتُ أفك الخط وأركب الحرف فوق الحرف ليصير كلمة.
بدأت بقراءة لافتات المحلات، وتباريت مع من هم أكبر مني في تلك اللعبة، «بقالة الاشتراكية، كنفاني عباد الرحمن، صيدلية الوحدة العربية»، عمري وقتها لم يكن يتجاوز أربع سنوات، ثم مع دخولي المدرسة وجدت كنزي في مجلات مثل «سمير» و«ميكي» و«سوبرمان»، ومعها سلسلة قصص «المكتبة الخضراء للأطفال»، وكذلك «مكتبة الكيلاني»، ثم انطلقت مبكراً في القراءة الأعمق، ونحيت كل ما فات جانباً.
وكان من حظي أن ابن عم لي يكبرني بنحو خمس عشرة عاماً يدرس العلوم الأزهرية وكان يستخدمني في أن يقرأ عليًّ ما حفظه سواء من القرآن الكريم، أم الأحاديث النبوية، أم من متون كتب النحو، وعلى رأسها شرح «ألفية بن مالك»، وما تزال تلك السور والأحاديث في تلافيف الذاكرة ما أن استرجعها حتى تعود ندية كأنها حفظتها بالأمس، وما زلت أذكر أول بيت حفظته في شرح الألفية من كثرة تكراره يتعلق باقتران جواب الشرط بالفاء إذا كانت جملة الجواب: (اسميَّةٌ طلبيَّةٌ وبجامدٍ … وبما، ولن، وبقد، وبالتنفيس).
مقولة أخرى أعرف أنها من بنات أفكاري فقد كنت دائماً أردد: « علمتني الكتبُ، وأدبتني الحياة»، فقد كان لأثر القراءة في حياتي فضل كبير على توجهاتي منذ البدايات الأولى، وكما في كل زمان ومكان كان الأهل والأقارب والمختلطون معنا يسألون السؤال الدائم للأطفال: «تحب تطلع إيه لما تكبر؟»، ولست أذكر أني تمنيت ولو لحظة واحدة أن أكون لاعب كرة شهيراً، رغم أنني أحببت صغيراً الكثير من لاعبي الكرة المميزين جداً في وقتها، ولا خطر ببالي في يوم من الأيام أن أكون ممثلاً أو فناناً من أي نوع من الفن، رغم حبي الشديد لعبدالحليم حافظ، وعمر الشريف و عبد المنعم إبراهيم وغيرهم كثيرين.
ما أذكره أن إجابتي حين يُطل عليَّ السؤال من أحد من أفراد أسرتي أو معارفنا أو حتى جيراننا، تراوحت بين أكثر من إجابة، مرات كنت أقول: نفسي أطلع مهندس في السد العالي، وكانت كليات الهندسة في ذلك الوقت على رأس كليات القمة، وسبقت حتى كليات الطب في بعض السنين، وكانت الكلية الفنية العسكرية تشد الراغبين في الالتحاق بالقوات المسلحة أكثر مما كانت تشدهم كليات الحربية والطيران، كان خريج الفنية العسكرية يعتز أيامها بكونه ضابطاً كما يفخر بكونه مهندساً تمت عملية تأهيله علمياً ومعملياً على أعلى مستوى، وربما أفضل من كليات الهندسة المدنية. وكان السد العالي وقتها هو مشروع مصر القومي الذي تحالفت ضده القوى الكبرى في العالم لكي توقف بناءه، وفشلوا وفشلت كل مؤامراتهم ضد مصر والسد وحركة التنمية المستقلة التي تسارعت خطاها في الستينيات من القرن الماضي.
وكان قريب لي قد سافر للعمل في السد العالي، فكان السد حاضراً في بيتنا، كما كان حاضراً في دراستنا، وكنا ندرس في كتب المطالعة موضوعاً عن السد، وما زلت أذكر الشيخ كشك رحمه الله، وقد كان في زيارة إلى منزلنا، وهو يسألني إن كنت أستطيع أن أتحدث عن أي موضوع أريده، فتحدثت عن السد العالي بما حفظته من كتاب المطالعة، وكان فيما قلته أن السد سيحمي مياه مصر من أن تضيع سُدى، وسألني الشيخ رحمه الله، عن معنى كلمة «سُدى» فأجبته بسرعة: يعني بلا فائدة، وربت الشيخ على رأسي داعياً لي، وبشَّر الحاضرين بما سيكون لي من شأن.
كان يغريني في تلك الآونة مسكة المسطرة «حرف تي» بيد طلاب هندسة القاهرة خاصة حين التحقت بالمدرسة السعيدية التي تجاور جامعة القاهرة، أقرب إلى كليتي الهندسة والحقوق التي شاء حظي أن أتخرج منها بعد ذلك بسنوات.
وفي مرات أخرى كنت أقدم إجابة أخرى على السؤال فأقول:
ـ عايز أطلع عباس محمود العقاد. وكنت قد اقتحمت القراءة في مجالات أكبر من سني بتشجيع من ابن عمي، وكانت مكتبته عامرة بالكتب في كل مناحي الثقافة والفكر والدين، وكان اسم العقاد يذكر مع صعوبة عباراته وتعقيد أفكاره، خاصة وأني بدأت أولاً بقراءة أشعاره فلم أفهمها ولم أستسغ منها بيتاً واحداً، ونشأ داخلي نوع من التحدي الصبياني فتركت شعره الذي تصورته أسهل من كتبه، وبدأت بقراءة أحد عبقرياته، أظنها «عبقرية عمر»، وللحق فقد شدتني إليها جداً، وقربتني بشدة من شخصية وعبقرية الفاروق، كنت أتجاوز الصفحات التي يصعب عليَّ فهمها إلى غيرها مما أفهمه حتى انتهيت منها، وقد صرت “عقادياً” مولعاً به وبكتابته، ومن يومها عزمت على قراءة كل ما كتبه.. ولا زلت أذكر أنني كنت أكتب اسمي الثلاثي أسفل اسم العقاد الثلاثي هكذا: عباس محمود العقاد ثم محمد محمود حماد وأحس بطربٍ وفخر شديدين للوزن الواحد والقافية المشتركة بين الاسمين.

عباس محمود العقاد
وكان سهلاً عليَّ دراسته في السنة الأولى من المرحلة الثانوية حين قرروا علينا واحدة من تلك العبقريات، وكان مدرس الفصل يستدعيني إلى القراءة بصوت جهوري لكل من العبقرية و«الميثاق» وقد كان مقرراً بدوره علينا في نفس السنة.
ومن ذكرياتي المحببة في تلك الفترة أن بعض زملائي في الفصل كان يغار من استئثاري بالقراءة من دون زملائي جميعاً، وكنت أتقن القراءة بالإعراب الصحيح لكل كلمة، وكنت أتجنب التسكين ثقة في قدرتي على القراءة الصحيحة، وفي مرة قرأت فقرة في «الميثاق» تتحدث عن مصر التي كانت تتطلع عبر سيْناء إلى ما يجري على الحدود مع فلسطين، وقرأتُ لفظة سيْناء بتسكين الياء، ولم يكن كثيرون من زملاء الفصل قد سمعوها من قبل بالتسكين، فضجوا بالضحك والاستهجان. وقفت ثابتاً حتى انتهوا من ضجتهم المفتعلة، ونظرت إلى أستاذي الذي بادرهم بمقولته الشهيرة، حين يبدأ في شرح ما غمض علينا فقال:
ـ «احنا خدامين البُلغ»، احنا ها نشرح لكم، جاءت اللفظة في القرآن بهذه القراءة، الخ الخ الخ..
كان ذلك في مرحلة متقدمة من تعليمي، وكنت ساعتئذ في بداية المرحلة الثانوية، وصادف أنني قرأت لطه حسين في فترة الريبة العقادية فأحسست أنه أسلس وربما أكثر تأثيراً في قارئه، ولم يُعدني إلى حبي الكبير لقلم العقاد إلا مطالعات متعددة لأعماله وكتاباته الصحفية، ثم ساقني القدر إلى مطالعة كتاب “معارك فكرية” لأنور الجندي، وفيه وجدت نقداً شديداً وساخناً وربما لاذعاً لأفكار طه حسين بأقلام الكتاب الكبار الذين تعرفت عليهم دفعة واحدة من خلال هذا الكتاب الكبير، فشملهم حبي الذي لم يعد يقتصر على العقاد وحده، وللحق فقد وجدت قلم طه حسين أسلس ولغته أقرب إلى العقل، ووجدت جدة في أطروحاته فقرأت «الأيام» واقتربت من كتبه بعد ذلك.

طه حسين
مع كل مرحلة كانت اجابتي على السؤال: «تحب تطلع ايه لما تكبر» تتغير مع التغير الذي طرأ عليَّ وعلى المرحلة التي أسأل فيها مثل هذا السؤال، وفي مرات كنت أحتفظ لنفسي بإجابة خاصة بي لا أطلع عليها أحداً. كنت أشعر بتوق إلى أن أكون مثل محمد فؤاد عبد الباقي الذي عرفته صغيراً في مكتبة بيتنا وأنا أقرأ عناوين الكتب المجلدة التي تتزين بالكتابة بماء الذهب على كعوبها الخلفية حيث يكتب اسم الكتاب، ثم اسم مؤلفه، ثم صاحب الكتاب الذي هو في الغالب الأعم ابن عمي الذي تربيت على يده ثقافياً منذ نعومة أظفاري.
كان اسم محمد فؤاد عبد الباقي يبعث فيًّ مشاعر كثيرة حين أنظر إلى العبارة التي تسبق اسمه : «جمعها وحققها محمد فؤاد عبد الباقي»، وأكثر ما شدني وأنا ما زلت صبياً يافعاً كتاب« المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم»، وهو معجم جديد من نوعه آل الأستاذ فؤاد عبد الباقي على نفسه أن يخرجه لقراء القرآن الكريم، وبذل فيه جهداً هائلاً لكي يتمكن القارئ من خلال أي كلمة من الآية القرآنية أن يصل إلى نص الآية، ورقمها، وموضعها في القرآن، (وهو الأمر الذي صار متاحاً من دون أي مشقة مع التقدم التكنولوجي الهائل)، وكانت لعبتي في تلك السن الصغيرة أن أجرب البحث عن آية، وبهرني الكتاب كما ظل يبهرني اسم المحقق الكبير محمد فؤاد عبد الباقي حتى تمنيت أن أطلع “محمد فؤاد عبد الباقي” ..

محمد فؤاد عبد الباقي
العقاد وطه حسين ومحمد فؤاد عبد الباقي والسد العالي.. كانت تلك هي الاسماء والأفعال التي كانت تملأ سماء وأرض بلدنا ونحن صغاراً، وكانت تلك بعض أمانينا، ونحن لا نزال على عتبة الدنيا نتطلع الى أفضل مستقبل. كنا محظوظين بلا شك حين كانت قدوتنا نوعية مثل العقاد وطه حسين ، ومشايخ مثل محمد الغزالي ومحمد أبو زهرة والشيخ شلتوت، وكنا محظوظين أكثر أنا نشأنا في مجتمع يضع في صفوفه الأولى علماء الأمة ومفكريها وكتابها ومهندسيها وبناة نهضتها الحقيقية، وكان إقبال الآباء والأمهات على إلحاق أبنائهم وبناتهم كليات مثل الهندسة والطب والزراعة فقد كان نجوم المجتمع وقادته من هذه الكليات، باختصار كنا محظوظين لأن المجتمع الذي نشأنا فيه كان جاداً أكثر، ويعرف هدفه بشكل أوضح، ويمضي في طريقه بثقة أكبر.
أكثر ما آسف عليه أن نجيب محفوظ دخل حياتي متأخراً حين دخلت الجامعة ووجدت أعماله على لسان زملائي وأصدقائي، ولم أستطع أن أعترف بتخلفي عن قراءة أعمال العملاق الكبير، ووجدتني اذهب وحيداً إلى سور الأزبكية وقد كان ساعتئذ في ميدان الأوبرا وما حوله، واقتنيت مرة واحدة الثلاثية وعدداً آخر من روايات الكاتب الكبير، ودخلت عالماً من السحر والعذوبة وانفتحت أمامي أبواب للقراءة لم تكن تخطر لي ببال، فعرفت بعده أسماء كبيرة في عالم الرواية العالمية، وكان أكثر ما شدني في تلك الفترة من الانكباب على قراءة الأدب العالمي رواية توماس مان «آل بودنبروك- Buddenbrooks» وروايتا الكاتب الإنجليزي ألدوس هكسلي، أولاً رواية «الجزيرة» ، ثم رواية «نقطة مقابل نقطة”، ثم كانت رواية «1984» للكاتب جورج أورويل الذي كان له الفضل فيما جرى لي من نقلة نوعية في قراءاتي، وجعلتني أكثر اهتمامًا بالكتب التي تتحدث عن الوعي بالمستقبل، وعن تأثير السياسة في تشكيل حياة الشعوب.

نجيب محفوظ
كان جل انشغالي في مرحلة ما قبل الجامعة ينصب على قراءة كتب التراث وأعلام العرب والمسلمين، ومع دخول الجامعة مع بداية السبعينيات انفتحت أمامي طاقة القدر الثقافية، واتجهت بوصلة قراءاتي إلى مطالعة وقائع التاريخ القريب، وقد كنا نراه يزيف أمام أعيننا كل يوم، في تلك الأثناء وجدت كنزي المفقود في كتابات محمد حسنين هيكل، وكامل زهيري، وطارق البشري وعبد العظيم رمضان وصلاح عيسى، ومحمد عودة.
التهمنا في تلك الآونة كتاب عبد العظيم رمضان «تطور الحركة الوطنية في مصر: 1918-1945»، ومعه كتاب المستشار طارق البشري: « الحركة السياسية في مصر 1945 -1952ـ» والكتابان من منظورين مختلفين يؤرخان كل بطريقته ومنهجه لفترة تبدأ بنهاية الحرب العالمية الأولى 1918، وتنتهي بقيام ثورة 23 يوليو 1952، ثم كان كتاب «ميلاد ثورة »كأنه يعزف على أوتار وعينا بلحن تمنت قلوبنا وعقولنا أن تسمعه، وكان حظي أن أتعرف على الأستاذ محمد عودة صاحب «ميلاد ثورة» مبكراً ونحن ما نزال طلاباً بالجامعة، وكان هو نفسه جامعة متحركة، فضلاً عن ثقافته الموسوعية، وقراءاته المتعددة في شتى مناحي الثقافة وبلغتها الأصلية فقد كان يتقن الفرنسية والانجليزية كما لو كانتا لغته الأصلية، وكان يطوف بنا على المسارح ودور السينما ومعارض الفن التشكيلي فعوضنا عن عشرات الكتب التي لم نستطع قراءتها.
«ميلاد ثورة»
ولع جيلنا بكتاب «ميلاد ثورة ” له في الحقيقة عدة أسباب: أولها أنه الكتاب الذي حرَّض هذا الجيل على الاهتمام بقراءة التاريخ من جديد، ثم هو الكتاب الذي فتح أعيننا على ضرورة إعادة اكتشاف تاريخنا بطريقة مختلفة، ثم هو الكتاب الذي رسخ في وعينا مبكراً أن كل جيل له الحق، بل عليه واجب، أن يحقق ويدقق ليعرف، وليجد نفسه، ويحدد موقعه، ويتلمس طريقه، ويصوع من بعد ذلك دوره.
وبعيداً عن ولع جيلي بكتاب «ميلاد ثورة» فهو واحد من أهم وأمتع كتب محمد عودة، وتاريخ صدور الكتاب مهم في التعرف على الخلفية التي دفعت الأستاذ إلى تأليفه، صدر الكتاب في أول أكتوبر 1971 ضمن سلسلة «كتاب الجمهورية» وحمل رقم 31 في السلسلة.
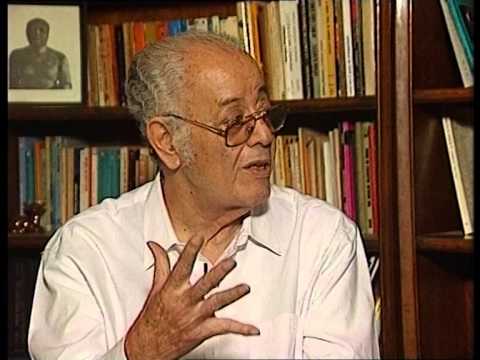
محمد عودة
كان قد مر على رحيل جمال عبد الناصر سنة والواضح أن الكتاب صدر بهذه المناسبة، وكانت قد جرت مياه كثيرة في نهر السياسة المصرية، قبل صدوره بأقل من خمسة أشهر كان أنور السادات تمكن من أن ينفرد بالحكم بعد الإطاحة بمن كانوا يسمون “رجال جمال عبد الناصر” في مايو 1971. كان الكتاب ومن خلفه الكاتب يحاول أن يضع الأساس لفهم كل ما جرى خلال الثمانية عشر عاماً من عمر الثورة المصرية والتي ذكر عودة في أول فقرة في الكتاب أنها “أهم السنين التي مرت في تاريخ مصر كله”، ومن ثمَّ راح عودة ــ في تلخيص معجز ــ يروي “قصة الثورة” متناولاً ما جرى بين الثورتين (ثورة 1919، وثورة 1952)، مركزاً على ما جرى مع نهاية الحرب العالمية الثانية (1945)، مسترجعاً ما جرى طوال قرن ونصف القرن من ثورات للمصريين، منوهاً بدروسها المستفادة، مقارناً بين أبطالها وقادتها، لينتهي هذا الجزء من الكتاب عند نهاية حرب السويس (1956).
وأظن أن هذا الكتاب تحديداً هو أول الكتب التي حببت إليًّ فكرة إعادة قراءة تاريخنا ووجهني وجهة جديدة في قراءاتي ما تزال تعيش معي حتى يومنا هذا وبعد مرور ما يربو على أربعين عاماً.
أعجب من البعض الذين تدخل بيوتهم فتجد كل شيء، ولا تجد مكتبة، وتدخل بيوتاً أخرى فلا تجد فيها كتاباً واحداً، وبعض هؤلاء إذا زارك في بيتك فيفاجئ بالمكتبة فيسألك: هل قرأت كل هذه الكتب؟، وبعضهم يسأل: لماذا كل هذه الكتب؟، وماذا تفعل بها؟، وتحار جوابا.
ما لا أنساه أني تعلمت القراءة صغيراً، والفضل الأول يرجع لوجود المكتبة والكتاب في البيت، وتعلمت كبيراً أن الذي يتصدى للكتابة، لابد له أن يشحن عقله دائماً عبر القراءة، وإلا كان كمن يريد أن يركب سيارته ليقود بها على الطريق السريع وهي تكاد تكون خاوية من البنزين.
أصقلتنا قراءات الطفولة بالكثير من المعرفة ربما لم تتح لنا بعد ذلك، وأثرت حياتنا الكتب حين كبرنا، وهي ما تزال قادرة على منحنا متعة يمكن أن يقاتلنا عليها السلاطين لو أنهم شعروا يوماً بلذتها.
بالمناسبة: ماذا تقرأ هذه الأيام؟







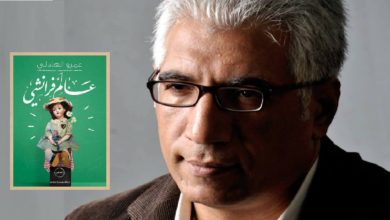

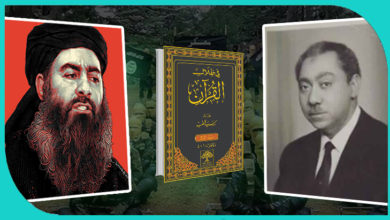




مقال أكثر من رائع، رصد بأسلوب سلس وممتع جانب من وقائع حياة الكاتب، وهو في الوقت ذاته تأريخ لفترة بالغة الحيوية من حياة مصرنا الحبيبة.
خالص المودة والتقدير والاحترام للأستاذ محمد حماد كاتب المقال