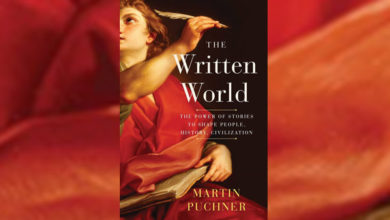تتفق حنا آرندت مع أرسطو في أن الإنسان حيوان سياسي بطبعه، لتقف على هذه المسلمة مقرة بأن السياسة هي “مسكن الوجود الإنساني”، هي الحرية التي تحمل نزوعا عميقا نحو الفعل وتوجها قويا تجاه الآخر، هي المحيط الأبرز لممارسة الفاعلية الإنسانية.
تبغض السياسة لدى آرندت كل مظاهر العنف والهيمنة التي تروج لها الأنظمة التوتاليتارية في الفضاء العام لتفرغه من أي طابع إنساني. التوتاليتارية أو الأنظمة الشمولية وفق رؤية آرندت هي الجحيم في الأرض، وهذا الجحيم الأرضي يعيش الإنسان فيه فاقدا حريته، مستلبا إرادته، لتقوم في ظله قطيعة مع كافة التقاليد التي تنظم حرفيا “كل مقولاتنا السياسية ومعاييرنا للحكم الأخلاقي”، لذا فقد صورت آرندت هذه الأنظمة باعتبارها شر محض، هدفه التحكم في الغير وإخضاعه وتدميره إن لزم الأمر.
على سبيل التعريف يمكن أن نصف التوتاليتارية بأنها النظام السياسي الذي يجري الجمع فيه بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، وبهذا تكون سيطرة الحكام على المحكومين تامة، لا يستثني منها حتى أدق تفاصيل حياتهم.

هذا الطغيان، تبعا للفكر السياسي التقليدي يمكن أن نصفه كذلك بنظام لا يجبر القائمون عليه على تقديم أي حساب لأي أحد، وتعتبر آرندت أن هذا اللا أحد يمثل الحكم الأكثر طغيانا، ما دام ليس هناك شخصا مسؤولا يمكن أن يخضع للمحاسبة. بالتأكيد فإن هذا النوع من الحكم هو الأكثر استخداما للعنف طلبا لطاعة غير مشروطة، وهي “الطاعة التي يعتمد عليها النشال تحت تهديد السلاح ليسرق محفظة، أو السارق حين يسطو على مصرف وهو يحمل مسدسا لتهديد من فيه”.
ورغم التلازم بين السلطة والعنف في الأدبيات السياسية فإن آرندت تمايز بينهما، حيث تعرف السلطة أنها قدرة الإنسان ليس فقط على الفعل، بل على الفعل المتناسق نتيجة التفاعل القائم بين مجموعة من الناس، يعني هذا أن السلطة لا تكون أبدا خاصة فردية، وتظل قائمة طالما ظلت المجموعة تتعاون فيما بينها. وحين نقول عن شخص ما إنه في السلطة، فإننا في الحقيقة نشير إلى كونه قد سُلط من قبل عدد من الناس لكي يفعل باسمهم، أما العنف فيتميز بطابعه الأداتي، إذ يُستخدم لمضاعفة القدرة حتى تستطيع أن تحل محلها في آخر مراحل تطورها، أي أنه الملجأ الأخير للسلطة لكي تواجه المتمردين عليها.
تتقدم آرندت في عرض رؤيتها فتضع حدا فاصلا بين السلطة والعنف، ترى أن السلطة تكمن في جوهر كل حكومة، بينما ليس بالضرورة كمون العنف في هذا الجوهر، هو وسيلة بحاجة على الدوام إلى مبرر لاستعمالها. بالتالي فإذا كان العنف في حاجة إلى تبرير من طرف آخر، فلا يمكن أن يكون جوهرا في أي شيء، بعكس السلطة، التي هي غاية في ذاتها، لا تحتاج إلى تبرير، بل هي في حاجة إلى شيء آخر، وهو المشروعية.

ولا تجد آرندت أن التمييز بين السلطة والعنف كافيا لإجلاء طبيعتهما بشكل كامل، لذا فهي تؤكد على تعارض المفهومين، فحين يحكم أحدهما حكما مطلقا يغيب الآخر، وإذا استدعت السلطة العنف في الحالات التي تخضع فيها إلى تهديد، فإنه إن تُرك له الحبل على الغارب سينتهي الأمر بتلاشي السلطة. لكن في ذات الوقت لا مجال للحديث عن سلطة لا عنفية، وهذا لا يمنع من الاستدراك بملاحظة أن العنف لا يستطيع أن يُوجد السلطة.
لا يكتمل الحديث عن السلطة بغير أن نفرق بين مبدأ السلطة ومبدأ التسلط التوتاليتاري، فالسلطة تنحو بطبيعتها إلى تحديد الحرية، بينما التسلط التوتاليتاري يهدف دوما إلى القضاء عليها، ولن يكون من التطرف في القول إذا أثبتنا للتوتاليتارية العداء لكل ظاهرة عفوية بشرية بصفة عامة، ما يكون له أبلغ الأثر على الخاضع لهذه السلطة، حيث تنسحق شخصيته بالكلية في مواجهتها، لتسلبه إرادته وتقتنص حريته، فيقف عاريا أمام السلطة “إنسانا مائعا” منزوع الإنسانية، بحيث لا يبقى أمام مواطني السلطة التوتاليتارية، بحسب سارتر، كي يكونوا بشرا من جديد إلا “الجنون القاتل”. يساهم في هذا المسعى من السلطة لإخضاع محكوميها حملات توجيه تقودها أجهزة إعلام، تسعى لعزل الجماهير عن العالم الواقعي، وإقامة ستار حديدي يحول دون أن تنفذ نتفة من الواقع إلى المحكومين، كل هذا كي يحظى النظام التوتاليتاري بمواطنه المثالي، ذلك “الإنسان المائع”.
Mohamed.altanawy1@gmail.com