أمضى محمد عودة في الريف ثلاث سنوات طويلة اشتغل خلالها بالمحاماة، واجه واقعاً أشد قسوة مما تخيل، وذاق مرارة الفشل، ثلاث سنوات كأنها لم تكن، تمنى ـ فيما بعد ـ لو أنه يستطيع حذفها من سجل حياته. لكن ما الذي دفع به إلى أتون تجربة بكل هذه القسوة وبكل هذه المرارة، وهو ما يزال في بداية حياته العملية بعد تخرجه مباشرة من كلية الحقوق؟ ما الأسباب، وما الدوافع، وكيف كانت الطموحات، وكيف خطفت الأحلام الفتى الثائر إلى قعر الريف المصري في أواسط الأربعينيات؟
نحاول الإجابة..
قضيتان تفتح وعي الشاب محمد عودة عليهما مبكراً جداً وهو بعد طالب في المرحلة الثانوية، قضية الاستقلال الوطني، وقضية التفاوت الطبقي الشاسع بين فئات المجتمع المصري. كانت البداية في مدرسة «السعيدية» الثانوية حيث لفت انباهه وامتعاضه أيضاً أن بعض التلاميذ يأتون إلى المدرسة يومياً تحملهم عربات فاخرة على أحدث موديل، وبعضهم الآخر تكاد ملابسه تفضح أوضاعه الطبقية المتدنية، حتى في الأكل كانت هناك تلك الطبقية المقيتة، حيث يقبل الفقراء على ما يوفره مطعم المدرسة من طعام، «أما الأغنياء، فقد كانت تأتيهم السندويتشات الجاهزة من بيوتهم وبعضها غير مألوف لمن هم دونهم طبقياً، بينما نحن نهب مسرعين إلى اليمكخانة (قاعة الطعام) لنيل طعامنا كالقطعان».. يقول محمد عودة.

بدأ وعيه الطبقي يتفتح لأول مرة على هذا الواقع المرير، وزاد من حدة إحساسه بهذه المرارة أن أوضاع والده المالية تدهورت إلى درجة الصفر، حتى قال له: (يا محمد أنت أملنا الوحيد في هذه الدنيا، لم يعد لنا بعد الله غيرك يا بني)، ومن ناحية أخرى هذا الاستفزاز الطبقي الذي يواجهه في الفصل، يقول: «كرهت هؤلاء الاقطاعيين والموسرين»، وصار حاد المزاج يطالب بنقله إلى فصل آخر بعيداً عن فصل أولاد الذوات بحجة أنه غير متوافق مع زملاء في الفصل.
تبلور الوعي الطبقي لدى محمد عودة على يد مدرس التاريخ الذي سأله عن سبب طلب نقله إلى فصل آخر، وعندما عرف السبب انفجر فيه وهو يقول بحماس واضح: (هؤلاء أولاد خونة، ولصوص، وسفاكي دماء، ولا بد لأمثالك أن يتعلموا، وأن يتفوقوا، حتى يخلصوا البلاد منهم)، يقول عودة: ثم ألقى على رأسي محاضرة عن تاريخ رئيس الوزراء الأسود وهو والد أحد الطلاب الذوات في الفصل، ووصفه بالخيانة والديكتاتورية، ونصحني بأن أدخر من مصروفي قرشاً لأشتري جريدة (الوفد) وأقرأها بعناية.
كان هذا هو أول درس في الحياة، وفي التاريخ، وفي الوطنية، على يد مدرس التاريخ الذي أحبه الفتى محمد عودة وظل يكن له كل احترام طول حياته، وربما كان هو السبب وراء اهتمام محمد عودة بدراسة التاريخ المصري وإعادة تقديمه للأجيال الجديدة بطريقة تفرد بها وحده، وصارت له مدرسته الخاصة في كتابة تاريخ مصر الحديث.
تخرج الفتى من «السعيدية» والتحق بكلية الحقوق وعرف أن ما يدرس داخل هذه الكلية العليا من مفاهيم العدل والقانون والحرية السياسية لا علاقة له بأوضاع المجتمع المصري البائسة، كان البحث عن الذات وعن خلاص مصر وتحررها أمراً يستبد بأبناء جيله، فراح يجرب مع الأحزاب العلنية ومع التنظيمات السرية، فدخل الوفد وانتمى إليه فترة من الزمن ثم فارقه، وجرب مع تنظيمات يسارية كانت تنشط في تلك الآونة وابتعد، وأثبتت له كل هذه التجارب أن الطريق التي يتوق إليها لا تمر من هنا.

نحن الآن في مصر سنة 1944 تقريباً، نتايع حركة الشاب محمد عودة الحاصل على ليسانس الحقوق من جامعة «فؤاد الأول» (القاهرة حالياً)، وقد خاض عبر السنوات الخمس الأخيرة من عمره في الكثير من التجارب، واطلع على الكثير من الكتابات والكتب باللغتين الفرنسية والانجليزية، وتقاطعت حركته مع الكثير من الشخصيات والتنظيمات والأحزاب، وانخرط على طريقته في فاعليات الحركة السياسية التي كانت تموج بها البلاد في ذلك الوقت.
رغم وعيه البكر والمبكر بقضيتي الاستقلال والعدل الاجتماعي، لكن كان السؤال الكبير وقتها هو: كيف الخلاص من هذا الواقع الذي تستشري فيه الطبقية، وتتحكم في البلاد قوة أجنبية محتلة، وقصر خائن في قبضة ملك فاسد، وبقيت الطريق إلى هذا الخلاص غائمة ملامحها، لا تكاد تبين له في تلك السن.
فكر مع آخرين ـ منهم وعلى رأسهم أستاذه الأول الدكتور مصطفى مشرفة أستاذ الأدب الإنجليزي ـ في طرق الخلاص من هذا الواقع المرير الذي تعيشه مصر أواسط الأربعينيات من القرن العشرين، وكان أستاذه واحداً من شباب ثورة 1919، وانضم إلى تنظيمها المسلح، وكان طريق العنف الثوري يلوح أمام ناظريه كحل سحري للقضاء على الملكية الفاسدة، والاحتلال الغاشم، ولكن نفسه لم تألف متطلبات هذا الطريق، وطبيعة شخصيته المسالمة جعلته لا يمتلك شجاعة أن يذبح دجاجة كما كان يقول.
كانت استراتيجية الثورة القادمة محور مناقشات طويلة من دون التوصل إلى قناعة مستقرة، وكان من الأسئلة المطروحة عليهم حول طبيعة الثورة القادمة، حسب طريقة تفكيرهم،ـ هل تتم بضربة قاصمة وبالاستيلاء على القاهرة، واقتحام قصر عابدين واعتقال الملك والأسرة الحاكمة ونفيها من مصر كما حدث في «سان بطرس بورج» على الطريقة الروسية، أم تتم بالزحف الطويل المضني، وحرب الشعب من جبال «تيان شان» حتى «بيجين»، و«شنغهاي» على الطريقة الصينية؟
يؤكد محمد عودة أن الرأي الذي كان يميل إليه مع أستاذه أن ثورة مصر القادمة سوف تكون تطويرًا وتنويعًا جديدًا لثورة 1919، وأنها سوف تأخذ «الطريق المصري» إلى الحرية، الذي ابتدعه المصريون عام 1919، وسوف تشتعل بنفس الطريق المصري في يوم واحد غير منتظر، وتعم كل المدن والقرى، وتفرز زعامتها وقيادتها بل ومفكريها ومثقفيها بأعمق وأفضل مما حدث سنة 1919، وفي هذه المرة لن يستطيع البريطانيون أن يجهضوها وسوف يكون هناك العمال والفلاحون، والكوادر الثورية العلمية، وسوف يبدأ التاريخ.
وحين صار «الليسانس» في يد محمد عودة كان أمامه طريقان: إما أن يسافر إلى فرنسا تبعاً لوعد الدكتور طه حسين بتدبير منحة دراسية له في باريس، وإما أن ينغمس في البحث عن طريق الخلاص الجماعي، ويكيف حياته ليكون مؤهلاً للقيام بدور ما ظل يبحث عنه طويلاً.
شدته أكثر فكرة العودة إلى الريف، حيث مسقط رأسه في «فاقوس»، كان يعتقد مع أستاذه مصطفى مشرفة أن الثورة القادمة سوف تندلع من الريف، وأن الفلاحين هم قادة تلك الثورة وأن الآخرين سوف يتبعونهم، «كنا قد اتفقنا أنا والأستاذ أن رياح الثورة الاجتماعية نفذت إلى الريف وأن الثورة القادمة لن يتبع الفلاحون فيها الباشوات والبكوات، ولكن قد يتبعهم هؤلاء، وأنه لا بد أن تنتشر الكوادر في الريف».
كان محمد عودة يحاول أن يضع لنفسه ملامح الدور الذي جاء من أجله في «فاقوس»، وكان محملاً بطاقة «رومانسية ثورية» هائلة، وتقوده أحلام كبيرة، يقول: «كنت واثقًا أني سوف أقدم نموذجًا جديدًا يُبطل كل الصور والدعاوي التقليدية لمحامي الأرياف الذي يقبل كل قضية رابحة أو خاسرة، والذي لا يعنيه سوى الأتعاب، ويستبسل في إقامة العلاقات، وكسب ثقة أصحاب الأملاك، وذوي النفوذ، والحصول على قضاياهم «الدسمة»، سوف أكون «محامي من لا محامي له»، وسوف أدافع عمن اغتصبت حقوقه الخاصة أو العامة».
وفي طريقه إلى «فاقوس» كانت صورة الزعيم الفيتنامي «هوشي منه» تملأ عليه كيانه، كزعيم ثوري أعلن الثورة ضد الاحتلال الفرنسي -الياباني لبلده فيتنام، وخاض حرباً شرسة بتكتيك حرب العصابات مكبداً الفرنسيين واليابانيين خسائر فادحة رغم ضعف التسلح، وكان يؤمن مثل الثوار الآسيويين «أن الفلاحين هم عماد الثورة»، ووضع استراتيجية شعارها: «كل قرية قلعة»، وأن يتحول الريف إلى سلسلة من قواعد المقاومة يغرق فيها الفرنسيون.
كان عودة قد آل على نفسه ألا يفعل كما فعل أحد الكوادر الذي أرسله «هوشي منه» إلى قرية بعيدة ذات أهمية استراتيجية، لتجنيد أهلها، وما لبث أن عاد ليخبر الزعيم أنها قرية ملعونة لا يرجى منها خير وأن أهلها مدمنو أفيون، ولا انتماء لهم، أو جدوى من العمل بينهم، واستمع إليه الزعيم وأعفاه من المهمة، وكلف بها رفيقًا آخر، ولما احتج قال له: «نحن نقوم بالثورة لنرد لهؤلاء الناس إنسانيتهم، وإذا يئسنا من قرية، فلا مناص من أن نيأس من الجميع»، وخجل الكادر الثوري وطلب أن يُمنح فرصة أخرى، وأصبحت القرية من أشهر قلاع المقاومة.

هوشي منه
تضمنت قائمة الأحلام التي حملها محمد عودة معه، في طريقه إلى الريف، أن يكتب رواية عن الفلاح، وهي الرواية الغائبة كما رأى محمد عودة حيث لم يكتب عن الفلاح المصري حتى ذلك الوقت سوى رواية واحدة كتبها الأديب الفرنسي «إدمون أبو»[1] في القرن التاسع عشر في عصر إسماعيل بعنوان «أحمد ـ الفلاح»، ولم تحدث أي صدى، وظل مكان الفلاح شاغرًا تمامًا في الأدب المصري.
كانت هناك روايتان شدتا انتباه ووجدان محمد عودة الفتى الثائر، الرواية الأولى رواية «فونتا مارا» للكاتب الإيطالي الشهير «إجنازيو سيلوني»[2]، ومثل كثيرين من أبناء جيله فقد فتن برواية «الأم» التي كتبها مكسيم جوركي[3]، وصارت تعويذة لحركة «العمال» وأيقونة النضال من أجل توحيد صفوفهم.

الغريب أن الشاب محمد عودة (الذي سيدخل بعد ذلك بحوالي ثلاثين سنة في معركة فكرية شهيرة مع توفيق الحكيم) كان قد قرر ألا يفعل مثلما فعل الحكيم في «يوميات نائب في الأرياف» التي صدرت سنة 1937، وقد رأى محمد عودة أن الحكيم أطل على الريف (بكل مشاكله وتعقيداته) من مقعد وكيل النيابة الآمن، ومن ناحية أخرى لم يكن في إمكانه أن ينظر إلى الريف من شرفة الاقطاعي النبيل، كما فعل محمود تيمور، وكان قراره أن ينزل إلى «الميدان» كواحدٍ من أهله، «حيث لم تعد مهمة المثقف أن يشخص أو يفسر أو يندب، ولكن مهمته على الحقيقة أن يغير».
كان هذا هو كل ما في جعبة الفتى الثائر وهو في طريقة إلى قريته «فاقوس» في قلب ريف مصر أواسط الأربعينيات، ولكن التجربة على أرض الواقع جاءت مختلفة و«مريرة» حسب وصفه، وكان الريف من شرفة فيلا الدكتور مصطفى مشرفة، وفي الكتب عبر التجارب في بلاد بعيدة مختلفُا تماماً عما يجري على أرض مصر.
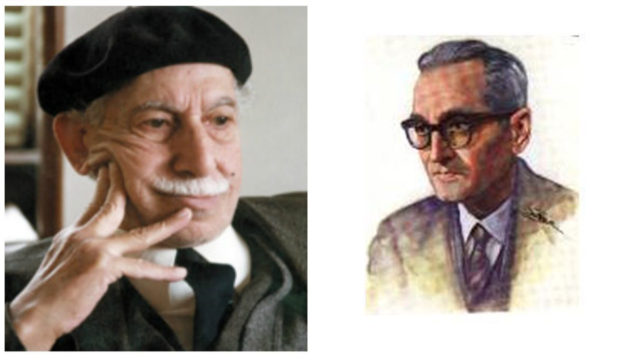
محمود تيمور توفيق الحكيم
بهذه الأفكار، وتلك المشاعر، ومع كل هذه الأحلام قرر محمد عودة العودة إلى «الجذور»، إلى مسقط رأسه، حيث يكون إلى جوار أمه التي سعدت بوجوده أيما سعادة، وتناست فكرة أن يصبح ابنها سفيراً في الخارجية كما كانت تأمل وترجو، وحيث يبقى إلى جوار أبيه الذي أصبح مزهوًا لأن في البيت «أستاذ» يقرع الناس الباب في الصباح أو المساء لاستشارة قانونية أو الحضور تحقيق أو توكيل في قضية غالباً بلا أتعاب وقبل كل شيء دراسة قضايا، ومشاكل أبيه شيخ البلد.
:هوامش
[1] رواية «إدمون أبو» عن «أحمد ـ الفلاح» تبدو أقرب إلى دراسة بعيون رحالة غربي عن عادات المصريين، وقد ألقى فيها الضوء على أحوال الفلاحين على لسان بطل الرواية أحمد، وتبدو رؤية المؤلف نظرة من الخارج إلى الريف المصري، ويكفي أن تقرأ لبطل الرواية وهو يقول: «والدي ليس سيداً وإنما يعمل في الحقول، منزله على الأرض، لا توجد به نوافذ، والقش يكسوه وثروته الحقيقية تتكون من نخلتين وجملين».
[2] «إجنازيو سيلوني»: اسم مستعار أصبح اسماً قانونياً من الستينيات للكاتب الصحفي والسياسي «سيكوندو ترانكويلّي” (١٩٠٠-١٩٧٨)، كان من أشهر المثقفين الإيطاليين في عصره، وأصبحت روايته الشهيرة «فونتا مارا» رمزاً لإدانة القمع والظلم الاجتماعي وحالة الفقر التي يقبع فيها الفلاحون. وقد تٌرجمت إلى العديد من اللغات ورٌشحت لجائزة نوبل للأدب لعشر مرات بين عامي 19٤٦-19٦٣. قضى سيلوني سنوات طويلة في المنفى يناهض الحكم الفاشي ويتعرض لنقد النقاد الإيطاليين بينما يحصل على تقدير النقاد بالخارج. «فونتا مارا» هو اسم وهمي لبلدة ريفية ايطالية، مركب من كلمتين Fonte بمعنى مصدر، Amara بمعنى المرّ، والرواية تحكى على لسان أسرة من أسر الفلاحين التي تمكنت من الهرب إلى المنفى بعد القضاء على سكان القرية ويحكي أفرادها تجربتهم بتقنية الفلاش باك، حيث توقفت الكهرباء عن قريتهم تلك من أول شهر يونيو ١٩٢٩ لعدم دفع الفلاحون الفواتير. ولحل هذه الأزمة تم اقناع الفلاحين الأميين بالتوقيع على ورقة بيضاء من قبل أحد جنود النظام ثم اكتشفوا فيما بعد أنها للتنازل عن حقهم في مجرى المياه الذي يروي أراضيهم لتحويله لري أراضي التاجر الكبير المرتبط بالنظام والذي حصل أيضا على منصب رئيس البلدة، وتستمر اعمال تضليل وقهر الفلاحين وسلب حقوقهم في عدة وقائع فظيعة. الرواية نشرت لأول مرة في زيورخ سنة 19٣٦، وانتشرت في ٢٠ دولة، وطبعت منها 34 طبعة بلغات مختلفة، ولم تنشر في ايطاليا إلا في سنة 1945. يذكر أن الرواية تم تمصيرها فيما بعد (سنة 1970) في الفيلم الشهير «الأرض» اخراج يوسف شاهين وتأليف عبد الرحمن الشرقاوي. وسيناريو وحوار حسن فؤاد ويطوله كوكبة من الممثلين والممثلات على رأسهم محمود المليجي وعزت العلايلي ويحيى شاهين وحمدي أحمد واخرون كثيرون.
[3] مكسيم جوركي (28 مارس 1868 – 18 يونيو 1936): أديب وناشط سياسي ماركسي روسي، كان صديقاً لـ لينين الذي التقاه عام 1905، ويعتبر جوركي مؤسس مدرسة «الواقعية الاشتراكية» التي تجسد النظرة الماركسية للأدب حيث يرى أن الأدب مبني على النشاط الاقتصادي في نشأته ونموه وتطوره، وأنه يؤثر في المجتمع بقوته الخاصة، لذلك ينبغي توظيفه في خدمة المجتمع. تم ترشيحه 5 مرات للحصول على جائزة نوبل في الآداب. جوركي باللغة الروسية تعني «المر»، وقد اختارها الكاتب لقباً مستعاراً له، تعبيراً عن واقع المرارة التي كان يعاني منها الشعب الروسي تحت الحكم القيصري، انعكس هذا الواقع المرير يشكل واضح على كتاباته وبشكل خاص في رائعته الشعيرة رواية «الأم».
صورة الغلاف بريشة الفنان: سعد الدين شحاتة














مقال أكثر من مهم لأنه يضىء مرحلة فاصلة من تاريخ النضال الوطنى موضحا ارتباطه الوثيق بالنضال الاجتماعى ..