لم يكن محمد عودة يتوقع وهو يحمل حقيبة أحلامه في طريقه إلى مسقط رأسه أنها لا تحوي غير أوهام عن الثورة القادمة من الريف، كانت أغنية «محلاها عيشة الفلاح» التي لحنها محمد عبد الوهاب (1939)، لكي تغنيها أسمهان في فيلمه الأول «يوم سعيد» (1940)، قد واجهت رفضاً في منتصف الأربعينيات من الحركة الوطنية المصرية التي بلغت ذروة فورانها بعد الحرب العالمية الثانية، بعدما ظهرت عشرات الجمعيات والتنظيمات اليسـارية والتقدمية، وصار الرأي السائد في الأوساط الثقافية رافضاً لفكرة التغني بحيـاة الفلاح في الريف المصري، وتصويرها على غير الحقيقة كما جاء في كلمات الأغنية الشهيرة بينما الريف يعج بالجهل والمرض والفـقر، ويعــاني أهله من ظلــم اجتماعي صارخ.
محمد عودة مثل كل المثقفين اليساريين في ذلك الوقت هاله أن تكون كلمات الأغنية الحالمة من نظم الشاعر الشعبي بيرم التونسي، الذي عرف بنقده الشديد للواقع المصري في تلك الفترة، وكان أول وأشهر من كتب الزجل السياسي الهجائي، وقد نفاه الملك فؤاد لسنوات خارج مصر عقابا له على أشعاره الساخرة وأزجاله اللاذعة، ثم يأتي في «محلاها عيشة الفلاح» ليتغنى بحلاوة حياة الفلاح ويكاد يحسده عليها
محلاها عيشة الفلاح مطمن قلبه مرتاح
يتمرغ على أرض مراح والخيمة الزرقا ساتراه
لا يطلب شرط ومشروط غير لبده وغره وزعبوط
واللقمة ياكلها ومبسوط اكمنه واكلها بشقاه
القعدة ويا الخلان والقلب مزقطط فرحان
تناقلها بجنة رضوان يا هناه اللي الخل معاه
الشكوى عمره ما قالهاش إن لاقى والا ما لاقاش
والدنيا بقرشين ما تسواش طول ما اللي حبه حداه
أوهام الأغنية التي رفضها محمد عودة مع جيله من الشباب الوطني، لم تكشف له عن أوهام أخرى كان قد حملها معه وهو يدخل أول معاركه مع الحياة بعد التخرج من كلية الحقوق أواسط الأربعينيات من القرن الماضي، كانت الاغنية تصور الواقع على غير حقيقته، وكانت أفكار محمد عودة تصور له الريف المصري وقتها على غير واقعه، ومن هنا كانت صدمته الكبرى حين قرر الرجوع إلى الجذور وأن يبدأ حياته العملية من حيث نشأ، فوقع في أول التجارب الفاشلة في حياته.

بيرم التونسي أسمهان محمد عبد الوهاب
بغير حاجة إلى رواية التفاصيل كانت التجربة من الواقع مختلفة ومريرة، وكان الريف من شرفة فيلا أستاذه الدكتور مصطفى مشرفة، أو في الكتب التي قرأها عن تجارب ثورات الريف في بلاد بعيدة مختلفُا عما يحدث على أرض الريف في مصر.
لا يمكن لنا أن نسجل وقائع ثلاث سنوات قضاها محمد عودة في الريف، باحثا عن دور وطني، آملاً في تحقيق بعض النجاح في كسب العيش، وقد بدت له البلدة مثل أخواتها في ريف مصر يحكمها طاقمان، أحدهما يتكون من العمدة ومشايخ البلد حتى المأمور وسعادة وكيل النيابة وحكيمباشي المستشفى الأميري، وباشمهندس الري، ومفتش الزراعة، ومدير بنك التسليف، ومشاهير المحامين إلخ، ويليه طاقم سفلي لا يقل أهمية يتكون من كاتب الجلسة والباشمحضر، ووكيل المحامي وحضرة الصول النوبتجي.
كانت المشاكل والمصائر تحسم وتقرر في الليل على موائد أصحاب النفوذ، وكان على المحامي الشاب أن يقضي وقته كله بين المحكمة والمركز والمستشفى الأميري وتفتيش الزراعة، وهندسة الري، وبنك التسليف، وقلم المحضرين، وإدارة الخبراء ومكاتب الخبراء الاستشاريين، فلم يكن له أن يحقق أي نجاح يذكر من دون توثيق العلاقات مع الأعيان ثم مع الحكام، وبدت له المهمة ثقيلة، تعثر ت أمامها خطواته إلى جانب أنه كان يستنكف ـ نفسياً ـ المضي فيها.
وربما كان الاكتشاف الأخطر والأشد وطأة هو مواجهة المسخ الذي يفعله القهر بشخصية الفلاح، ورؤية نماذج من الفلاحين أحبطت تفاؤله، فهذا الفلاح المنافق الذي يجيد استرضاء الملاك والحكام، ثم هذا الفلاح المشاغب «المرازي» الذي يتقن التلاعب باللوائح والقوانين بأبرع مما يستطيع المحامي، وهناك الفلاح «المأجور» والذي يسخره المالك لفرض سيطرته وإرهابه على فلاحيه، وكان لكل واحد من الأعيان «عصابة» أو «منصر» يشيع الرعب والخوف في قلوب الأغلبية التي بقيت بلا حول ولا قوة.
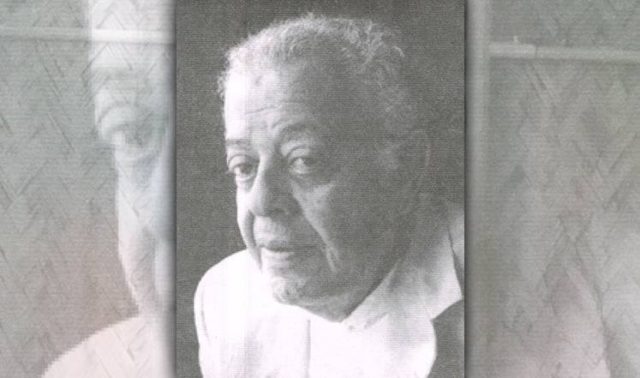
محمد عودة
تتالت المفاجآت غير السعيدة في تجربة محمد عودة الفريدة، وكانت كل مفاجأة منها كفيلة بأن تدفع به إلى أن يحمل حقيبته ويعود أدراجه إلى القاهرة، ولكن أفكاره الثورية ـ الساذجة وقتها ـ كانت تقوده وتحكم تصرفاته، ولم تقتصر المفاجآت على بؤس الواقع الذي فاجأه قبحُه، من بين هذه المفاجآت انتشار وباء الكوليرا في مديرية الشرقية، ورأى المحامي الشاب محمد عودة أنها مؤامرة بريطانية، يقول: «كنت قرأت تحقيقًا صحفيًا عن مجاعة البنغال في الهند خلال الحرب العالمية الثانية والتي راح ضحيتها ثلاثة ملايين هندي، في أكثر ولايات الهند مقاومة للبريطانيين، وكيف أنها كانت من تدبير حاكم الولاية البريطاني ردًا على الشعار الذي رفعته الحركة الوطنية الهندية بالجلاء فورًا عن الهند ليدافع الهنود عن وطنهم وليس عن الإمبراطورية».
كان محمد عودة واقعاً تحت تأثير وقائع رواية أرسلها له أستاذه الدكتور مصطفى مشرفة بعث بها إليه المؤلف، وكان روائيًا بريطانيًا اسمه «جيرالد هنلي»، كانت الرواية بعنوان «القنصل عند غروب الشمس»، وتقدم رؤية لسنوات الاحتضار في حياة الإمبراطورية، وفي فصل من فصولها يقدم الحاكم العام خبرته للشباب الجديد الذي يتسلم منصبه في ولاية إفريقية قائلًا: «حينما تعوزك كل الوسائل ولا يبقى أمامك مخرج؛ أشعل حريقًا كبيرًا أو انتشر وباء أو افتعل مذبحة، أي حدث مروع يذهلهم ويشل إرادتهم».
حاول المحامي الشاب أن يقوم بدور ما في هذه المأساة، وأبدى رغبته لطبيب شاب يعمل في الميدان، ولكنه أخبره بمرارة بأنه لا يمكنه أن يفعل أي شيء، سوى أن يصيبه المرض، وقال: «كل شيء هناك فوضى، لا تصدق شيئاً في بلاغات الحكومة أو بياناتها، أول أمس ماتت أنشط الممرضات ولم نستطع إنقاذها».
ولأن المصائب لا يأتين فرادي، فلم يكد ينحسر وباء الكوليرا حتى انفجر وباء الملاريا، وهذه المرة وصل الوباء إلى مسقط رأسه في قرية «جهينة»، فراح محمد عودة يعود المرضى في بيوتهم، وكانت المرة الأولى التي يدخل إلى تلك البيوت، وقد راعته مظاهر البؤس والفقر التي تغلق عليها بيوت الفلاحين «رأيت صورًا مرعبة، لم أتصورها أنا الذي أعيش بينهم».
ثم زاره المرض في عائلته أولاً، ثم مرض هو نفسه ثانياً، بدأت الملاريا بابن خالته، وكان شاباً تعهده محمد عودة بتكوينه وتعليمه، وتثقيفه، ثم قضى مع من راحوا في الوباء، ثم لم يلبث أن يسقط هو نفسه صريع الملاريا، وعاين التجربة ورأى كيف أنه مرض لا يعجز المريض فحسب، بل ويسخر به أشد السخرية، يقول: «كلما هُيئ لي أنني شفيت وأستعد للخروج تعاودني النوبة بأشد مما كانت، وأتصور النهاية وسط الوباء، ولم أحقق شيئًا بعد».

لكن القدر كان يحمل له على جانب آخر مفاجآت سارة، وحسب قوله: «عثرت وسط هذا الشقاء والظلام المتفاقم على واحة وارفة اكتشفتها صدفة كما حدث لي مرات كثيرة»، كان ذلك حين التقى في إحدى السهرات في بيت أحد الأعيان، بضيف من غير الطاقم المحلي، لم يكن رآه من قبل، أول ما شد نظره الى هذا الضيف أنه يدخن «البايب»، ويبدو عليه أنه من أهل القاهرة أو الإسكندرية، وبدا أن الضيف الغريب يناقش التغيرات المتوقعة في أسعار القطن بدراية واسعة، وعرف محمد عودة أنه يشغل منصبًا مهمًا في تفتيش الزراعة في المديرية، وحين انتهت السهرة أو كادت استأذن الضيف ليرحل إلى الزقازيق، وقبل أن يرحل أعطى محمد عودة ( الذي يبدو أنه هو الآخر لفت نظره) الكارت الخاص به، ثم قال له إنه يرحب باستقباله إذا ما جاء إلى الزقازيق.
يحكي عودة أنه كان يستثقل ظل هذه المدينة، ولا يذهب إليها إلا مضطراً، وأنها كانت تختص بقبحٍ خاص تفوق به قبح كل مدن المديرية، إن لم تكن مدن المملكة، ولكنه وجد نفسه مضطراً للذهاب إليها لاستيفاء سندات وأوراق قضية مهمة كانت أول مرة يتقاضى فيها أتعابًا مجزية، وكان كسبها ضروريًا، يقول: «ذهبت إلى دار المديرية، وصعدت كل الأدوار، وتنقلت بين كل المكاتب والغرف وحولني رؤساء الأقلام كل منهم للآخر، ورفضت عروض الوسطاء في الردهات ممن «يشهلون» المشكلات، وحينما وصلت إلى حافة اليأس تذكرت مدخن البايب، وسألت عنه، ودخلت عليه مكتبه بلا استئذان، وكان يجمع أوراقه للانصراف ولكنه رحب بي بحرارة، وشرحت له المشكلة، وسلمته ما معي من مستندات، وراجعها، وقال: بسيطة أتركها لي ثلاث أيام، وتنفست الصعداء وشكرته شكرًا عميقًا».

حين تأهب محمد عودة للانصراف، فوجئ بصاحب «البايب» يدعوه إلى منزله لتناول الغذاء وانتظار قطار الرابعة عصراً حتى يأتي، يقول: هيأت نفسي لمقابلة إنجليزية أو إيرلندية تعيش في هذه البلدة القبيحة، وتعاطفت معها مقدمًا، وكنت قد اكتسبت خبرة في معاملة الزوجات البريطانيات. وقطعنا مسافة طويلة بالسيارة حتى وصلنا إلى قرية بعيدة عن المدينة وتتابعت المفاجآت.
البيت بُني بالطوب الذي يبني به الفلاحون بيوتهم، ولكن على طراز أقرب إلى أفكار المعماري الشهير حسن فتحي (الذي تعرف عليه عودة مبكراً، وصار ثالث ثلاثة مع الدكتور مشرفة)، أما الزوجة ففلاحة جذابة ممشوقة القوام ترتدي زيًا ريفيًا أنيقًا، وتبدو خارجة على التو من متحف مختار، رحبت بلهجة الشراقوة «تعطيش الجيم»، وهي قريبة «صاحب البايب»، تزوجها وتولى تكوينها من جديد، وعلمها الإنجليزية وصحبها إلى أيرلندا، وهي لا ترتدي الزي الأوروبي إلا حينما تسافر إلى القاهرة، لترى ابنها الذي يدرس في الجامعة، ويرفض أن يرى أمه فلاحة.
ثالث المفاجآت أن يكون «الويسكي الأيرلندي» مشروباً مقدماً للضيف في مثل هذه الأجواء، وعرف محمد عودة أن مضيفه خريج ايرلندا، ودرس الزراعة هناك، وتخصص في التعاون الزراعي، وعاد متشبعًا بالتجربة الايرلندية. يقول عودة: تناولنا غداء ريفيًا صميمًا «فتة باللحمة المسلوقة» وطواجن، وبلح الشرقية المشهور، ثم قال: ننتقل لتناول القهوة في غرفة المكتب، ولأول مرة أرى مكتبة تحوي هذا الكم من الكتب المتنوعة، وجاءت زوجته بالقهوة وقال لي:
– أول مرة سوف تشرب «القهوة الأيرلندية»، التي يعتز بها الأيرلنديون، وهي تصنع من البن والويسكي والقشدة.
وجد محمد عودة نفسه في واحة عبر تلك الصحراء القاحلة، وأحس لأول مرة أنه يستطيع أن يتحدث بصراحة مع أحد، وتجددت أحلامه وآرائه في الريف، بعد أن كان الصدأ قد نفد إليها، وباح له بالسر الذي لم يستطع أن يحدث فيه أحداً من قبل، وأخبره أنه وضع خريطة ودراسة طبقية للقرية وتوزيع الأرض والثروة عامة في المديرية، وشكي له أنه لم يستطع أن يستكمل البحث.
الاكتشاف الأهم والمفاجئ أنه وجد صديقه الجديد «صاحب البايب» لديه نفس الاهتمام، وأخبره أنه حاول انجاز هذا المشروع نفسه منذ عامين، وقام وأخرج ملفًا من المكتبة وبسط عدة خرائط قائلًا:
– هذه المنطقة وهي من أخصب أراضي المديرية منحها البريطانيون بعد الاحتلال للذين سهلوا احتلالهم ولا بد أنك تعرف «القصة» ولاتزال ملكًا مطلقًا لهم، ولا أحد يجرؤ على التدخل أو الاقتراب، وما زالوا تحت الحماية البريطانية، يفاخرون بذلك، وفي كل سنة وفي موسم الصيد يزورهم السفير البريطاني، ومن قبله المندوب السامي، وتقام الحفلات والمهرجانات، ويُعد العيد السنوي.
ـ وهذه المنطقة تفاتيش الخاصة الملكية، وتفاتيش الأميرات، وهي مناطق مغلقة، وشبه مقدسة، ويستباح فيها كل شيء.
ـ وهذه مساحة كبيرة كانت الحكومة قد أصلحتها لكي تباع لصغار الفلاحين، ولكن استولى عليها صدقي باشا ووزعها على النقابات الاجتماعية، والصعاليك الذين حولهم إلى بكوات وأعيان، ليقيم عليهم حكمه ويضرب بهم الوفد، وبالمناسبة التقينا عند أحدهم ولعلك تذكر كيف كان يتحدث بحماس عن الوطنية والديمقراطية ثم عن الدين.
ـ وهذه ملكيات صغيرة وأحيانًا ضئيلة، ولا يملك الفلاحون الصغار والمتوسطون أكثر من خُمس أراضي المديرية، والباقي مجرد فائض سكان وعمال تراحيل، وليس هناك إحصاءات دقيقة، وربما يتجاوز عددهم ثلث سكان المديرية.
وأعاد الملف إلى مكانه بالمكتبة، وطلبت أن أقترضه ووعدني أن يوافيني بنسخة منه. ثم سكت بعض الوقت وقال: «لا يمكن تحقيق شيء في الريف قبل قطع رأس الأفعى في القاهرة وهدم الهرم من قمته»
استرعت العبارة انتباه محمد عودة واهتمامه، ورسبت في أعماق وعيه ووجدانه.
إلى جانب ما جرى في لقاء «صاحب البايب» كان هناك لقاء لمحمد عودة مع شخص آخر، وقصة أخرى كانت السبب المباشر لأن يقطع تجربته الفاشلة في الريف، ويقرر العودة من جديد إلى القاهرة، كان اسمه الشبراوي عبد العال، وهو عامل من عمال التراحيل، تلاعبت به ظروف وواقع الفلاحين في تلك الفترة أواسط الأربعينيات من القرن العشرين، وجعلته يدفع فمناً باهظاً من أجل حفنة «فول حراتي».
في إشارة عابرة خلال روايته لما جرى للشبراوي، ذكر محمد عودة أن هستيريا العداء للشيوعية كانت تتصاعد كل يوم، وقيل أن جلالة الملك يرى الشيوعيين تحت سريره، وأنه أقال رئيس الوزراء لأن الشيوعيين استولوا على الجامعة ويتسربون إلى الجيش، وأنه نفض التراب عن «عدو الشعب» إسماعيل صدفي باشا، واستخرجه من سلة مهملات التاريخ ليقضي على «الوباء» ويستأصله قبل أن يستفحل، وكان الباشا عند حسن ظن الملك، فقد اعتقل في يوم وليلة مائتين من صفوة المثقفين والكتاب والأدباء والصحفيين بتهمة الشيوعية، واستصدر قانونًا نقله عن القانون الإيطالي «الفاشي» لتجريم الشيوعية، وكان الباشا يتخذ إيطاليا الفاشية وزعيمها موسوليني نموذجه، وظل على إعجابه حتى بعد انهيار النظام وإعدام «الدوتشي».

بينيتو موسوليني إسماعيل صدفي باشا
حين نراجع قائمة رؤساء وزارات مصر نجد أن إسماعيل صدقي باشا تولى وزارته الثالثة خلال الفترة من 16 فبراير إلى 9 ديسمبر سنة 1946. في تلك السنة جرت وقائع تلك القصة التي غيرت مجرى حياة محمد عودة، كان عمره وقتها 26 سنة، تخرج حديثاً من كلية الحقوق، وتعلقت به وعلقت عليه آمال أسرته في استرداد ما تبقى لهم من قطعة أرض عليها عراك قانوني تنظره المحاكم، ولكنه كان قد قرر أن يبدأ معركة أخرى في ريف مصر حين توجه إلى قريته ليكون «محامي من لا محامي له».
التجربة لم تكن مشجعة، وصادفته عوائق كثيرة، ولكنه لم يستطع أن يحكم عليها بالفشل الكامل حتى جاءته هذه القضية تسعى إليه، وكانت هي آخر قضية للمحامي الشاب محمد عودة، قضية الفلاح الشبراوي عبد العال المتهم بسرقة حفنة فول حراثي من حقل تابع للخاصة الملكية (ضمن الأراضي المملوكة لجلالة الملك فاروق المعظم)، وتطوع عودة للدفاع عن الفلاح، وقرر في البداية أن يكون دفاعه هو دفاع المثقف الثائر علي النظام الاجتماعي الظالم، وأن ينتصر لقيمة إنصاف الملايين بصورة كريمة خالية من المذلة والهوان.
وجاء في مسودة مشروع الدفاع الأول الذي أعده محمد عودة:
سيدي القاضي: إن الشبراوي عبدالعال مواطن مصري يملك بنص الدستور كل الحقوق التي لك وللنيابة وللزملاء ولكل من في قاعة المحكمة أو خارجها، وأول هذه الحقوق وأقدسها هو حق الحياة، أي حقه في أن يأكل ويشرب وينام تحت سقف، وحقه في أن يتعلم ويعمل وفي أن يستوفي نصيبه من الثروة والسلطة والمعرفة ومن كل خيرات بلاده، وإذا ما حرم مواطن من هذه الحقوق فإن التبعة لا تقع عليه، ولكنها تقع بالطبع علي الذين اغتصبوا هذه الحقوق، وإذا ما تضور مواطن من الجوع ولم يجد ما ينقذ به حياته سوي أن يستولي علي حفنة فول أخضر من حقل مواطن آخر لا تزيد في كميتها عما يملأ منديلا صغيراً، فإنه لن يكون معتديا أو مجرما. إن الفلاح الشبراوي عبدالعال يا سيادة القاضي ضحية وليس متهما، إنه ضحيتنا جميعاً، ضحية النظام الذي يخلق ملايين من أمثاله ممن ليس لهم من ينصفهم سوي القضاء العادل. إن عقاب هذا المتهم ـ يا سيدي القاضي ـ لن يحقق أمناً، وربما يخلق مواطناً غاضباً ساخطاً، وإذا ما تضاعف عدد هؤلاء المحرومين المظلومين، فقد يأتي يوم يقتحمون فيه الأرض، ويعلنون أن من حقهم أن يبقوا فيها، لأن الناس شركاء في الماء، والنار، والكلأ ، كما يقضي الدين الحنيف.
مثل هذا الدفاع في ذلك الوقت (1946)، وفي عهد حكومة اسماعيل صدقي الباطشة، كان كفيلاً بأن يضع المحامي محمد عودة في السجن إلى جانب المتهم الفلاح، ولا شك في أن تهمة عودة ستكون أشد وأقسى، وهي التآمر على جلالة الملك فاروق ومحاولة قلب نظام الحكم في البلاد. رجع المحامي الشاب لنفسه وقال إن مهمة المحامي الأولي والأخيرة هي تبرئة المتهم، وليس التنديد بالنظام، وتحرير المجتمع، والتزاماً بذلك بدأ البحث عن دفاع آخر، وقاده البحث والتفكير إلى دفاع عملي واقعي مختلف عن الدفاع السابق.
وقف محمد عودة أمام المحكمة يقول:
سيدي القاضي: هذا المتهم لقي أكثر بكثير من جزائه، حيث تم ضربه بقسوة علي يد ناظر الزراعة وأعوانه، وقد جاء ذلك عقابا له علي استيلائه علي حفنة فول يسد بها رمقه حتي لا يموت جوعا، ومن حسن حظه أن كانت الأرض هي أرض جلالة الملك، ولو قدر لجلالته حفظه الله أن يعرف أن مواطنا جائعا مد يده إلي حفنة فول من مزارعه لما تردد في العفو عنه، بل إنه سوف….
لم يتركه القاضي يكمل مرافعته، وقاطعه بجفاء شديد، وقال بسخرية واضحة: هذه جنحة سرقة يا أستاذ، والمتهم متلبس، ونحن محكمة، نطبق القانون، ويمكن لحضرتك أن تقدم التماساً بالعفو من جلالة الملك بعد الحكم. وحكم القاضي علي الفلاح بالسجن لمدة ستة أشهر. بعدها قرر عودة أن يترك مهنة المحاماة إلى الأبد، يقول: «خرجت من المحكمة أشعر بالهزيمة، وأشد منها بالخزي والمهانة، لوكنت اخترت الدفاع الأول لكانت النتيجة أفضل، على الأقل كنت احتفظت بالكرامة واحترام النفس. لن أدخل محكمة بعد اليوم، لن احترف هذه المهنة التي لم أخلق لها».
وحمل محمد عوده حقائبه وفيها أحلامه المحبطة، وفي قلبه ووعيه رسبت فكرة أنه «لا يمكن تحقيق شيء في الريف قبل قطع رأس الأفعى في القاهرة وهدم الهرم من قمته».
صورة الغلاف بريشة الفنان سعد الدين شحاتة













