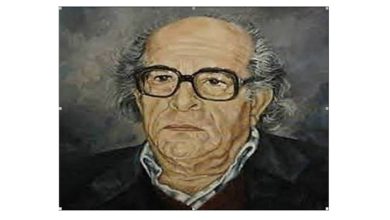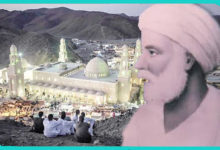في العصر العباسي هبت جماعة من المتدينين المحافظين لإرهاب موجات جارفة نزعت إلى استخدام العقل في قراءة النص الديني، لجأ هؤلاء المحافظون إلى الاحتماء بظاهر النص والتقوقع في الماضي حين اهتز الواقع تحت فهمهم التقليدي والسطحي للعقائد الدينية. بدأ الأمر مع نهاية القرن الثاني الهجري ومطلع القرن الثالث بظهور عدد من الفرق تعتمد التأويل اعتمادا شبه كلي، أولها فرقة المعتزلة التي ترجع نشأتها إلى تلك القصة الدرامية في مجلس الحسن البصري، عندما اعتزل مجلسه واصل بن عطاء وانضم إليه عمرو بن عبيد لتنشأ فرقة المعتزلة التي دعت إلى الاعتماد على العقل في إثبات وجود الله وفي تقرير القضايا الإيمانية، وكذلك في تأويل الآيات القرآنية التي تفيد التشبيه والتجسيم وغيرها من الصفات التي لم يرونها تليق بذات الله.
معركة العقل والتأويل
في ذلك الوقت كان التصوف الإسلامي قد بدأ يتحول من طوره الأخلاقي الذي يقوم على الزهد والتقشف، إلى طور عملي وفلسفي استفاد في بعض جوانبه من التيارات الروحية التي عرفت في ديانات وفلسفات الشرق القديم، لاسيما عند الحارث المحاسبي وذي النون المصري وأبي يزيد البسطامي، وسعى هؤلاء إلى استنطاق الجانب الروحي والباطني في الأحكام الشرعية، فلم يكن يرضيهم –حسب قولهم- أن يتحول الإسلام إلى مجموعة من القواعد والرسوم والحركات، وأطلقوا على معارضيهم من الفقهاء تلك التسمية الشهيرة “أهل الرسوم”، فيما اعتبروا أنفسهم “أهل الحقيقة والمكاشفة”.

هذا النزوع للتعويل على العقل لم يشذ عنه حتى أهل الفقه، فلقد كان الإمام أبو حنيفة (150 ه) قد خطى خطوات واسعة في تأسيس الحياة العقلية في الإسلام، ولذا عرف مذهبه بمذهب “أهل الرأي”. كما كان الاعتماد على التأويل ركيزة أساسية للعديد من فرق الشيعة والفرق الباطنية والخوارج والغلاة التي اختارت بعض المذاهب القديمة وأرادت صبغتها بالصبغة الإسلامية، فلجأت إلى التأويل لكي تجد لعقائدها في القرآن موضعا تبرر به هذه العقائد وتستند إليها في محاولة الانتشار.

تواكب ذلك مع بدايات السعي لنقل الفلسفة اليونانية إلى الثقافة الإسلامية، ولم يجد الفلاسفة الذي أخذوا على عاتقهم النهوض بهذه المهمة من سبيل لإنجازها سوى الاعتماد على المنهج العقلي، ثم انشغلوا بمحاولات التوفيق بين الأفكار المنقولة عن الفكر والتراث اليوناني وبين العقيدة الإسلامية، كسعيهم لاستخدام مناهج الاستدلال العقلي في إثبات وجود الله أو التوفيق بين بعض نظريات الثقافة اليونانية والعقائد الإسلامية كما شهدنا عند الفارابي (260ه- 339ه) ومن بعده ابن سينا المتوفي 427 هـ في فلسفته الإشراقية، وأصبحت الثقافة الإسلامية تعج بمصطلحات الفلسفة اليونانية مثل الجوهر والعرض والطفرة والتولد، التي أخذ يستخدمها الفلاسفة أنفسهم أو مقلديهم من ذوي الميول الكلامية كالمعتزلة.
احتشاد سلفي
في المقابل احتشد جماعة من الفقهاء، لاسيما الحنابلة، للتصدي لمثل هذه التوجهات في قراءة النصوص الدينية، واعتبروا أن أصحابها على اختلاف تياراتهم وتوجهاتهم سيحاولون قراءة العقائد الدينية اعتمادا على منهج التأويل للوصول إلى نتائج توافقهم أو تدعم توجهاتهم، ومن ثم يتعين رفض هذه المنهجية في قراءة النصوص القرآنية واعتماد القرن الأول الهجري معيارا تقاس عليه القضايا التي يثيرها المتكلمون وغيرهم من الطوائف الإسلامية، ومن ثم النظر بعدها في إقرارها أو رفضها باعتبارها بدعة. واحتج هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وتابعيهم لم يخوضوا في تلك القضايا، وبالتالي فهي مرفوضة لأنها بدعة لا أصل لها ولا قيمة، ولو كانت من جوهر العقيدة لحدثنا عنها النبي وصحابته وإلا لكانت عقائدهم ناقصة، ومحال عليه صلى الله عليه وسلم وصحابته ذلك، ولو كان النبي يعلمها وسكت عنها فأولى بنا السكوت عنها، وإن كان (صلعم) يجهلها فمن أين لنا بها؟
كانت هذه هي المنهجية التي اعتمدها جماعة من الفقهاء الحنابلة، سيتسمون فيما بعد بالسلف، في مواجهة ما رأوه تشعبات واجتراءات فكرية انتابت المجتمع الإسلامي تهدد بالانحراف بالعقيدة عن بساطتها ووضوحها وفتح السبيل أمام تسربات عقائد أخرى، لاسيما أن الحركات الشعوبية والقوميات القديمة التي انصهرت في الثقافة الإسلامية كانت لا تزال في نفوسها من الإسلام والعروبة الكثير، لذلك يحلو للبعض القول بأن “السلفية ظاهرة عباسية”. وهو ما ذهب إليه أيضا الشيخ أبو زهرة في كتابه “تاريخ المذاهب ” حين يعرف السلفيين بأنهم “أولئك الذين نحلوا أنفسهم ذلك الوصف، وأولئك ظهروا في القرن الرابع الهجري، وكانوا من الحنابلة، وزعموا أن جملة أرائهم تنتهي إلى الإمام أحمد بن حنبل الذي أحيا عقيدة السلف وحارب دونها، ثم تجدد ظهورهم في القرن السابع الهجري ، أحياه شيخ الإسلام ابن تيمية، وشدد في الدعوة إليه، وأضاف إليه أمورا أخرى قد بعثت إلى التفكير فيها أحوال عصره”.
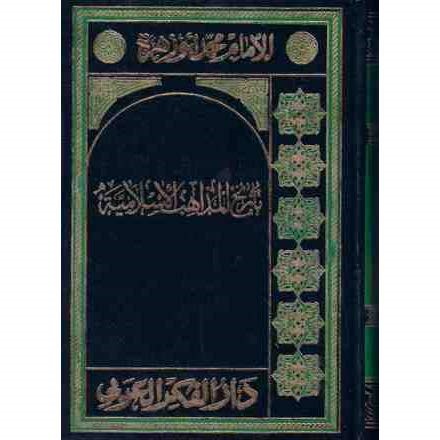
كان رفض السلفيين للتأويل رفضا قاطعا، ما أغلق الباب أمام أي مساحة مشتركة للتلاقي مع المتصوفة، وإذا سلمنا جدلا مع ابن كثير الذي أورد في ترجمته للإمام أحمد بن حنبل في كتابه “البداية والنهاية” فيما يذكر محمد حلمي عبدالوهاب في كتابه “ولاة وأولياء” بأن الإمام أحمد بن حنبل (الجد الأكبر للسلفية) قد مارس التأويل عندما لجأ إلى تأويل قوله تعالى “وجاء ربك والملك صفا صفا” أنه جاء ثوابه، فإن تلاميذه ومدرسته المتمثلة في بعض الائمة ومنهم أبو الوفاء بن عقيل (431- 513) وأبو الفرج بن الجوزي (510ه- 597ه) وابن تيمية (621-728)، وابن قيم الجوزية (691-751) اتخذوا موقفا قاطعا من التأويل على النحو الذي مارسه المتصوفة، ومن ثم أخذوا يناصبونهم العداء ويهاجمون ممارساتهم وطقوسهم وحتى عقائدهم، بل ويعتبرها بعضهم من تلابيس إبليس.
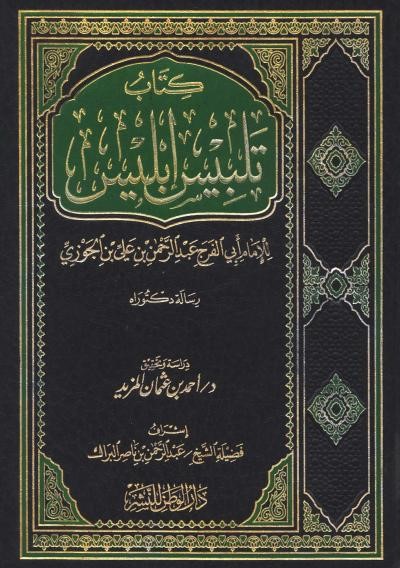
معضلة التشبيه والتجسيم
تكمن أهمية اعتماد التأويل من عدمه بين الصوفية والسلفية، في أن إنكار السلف للتأويل سينعكس على تفسيرهم لبعض الآيات القرآنية المتعلقة بقضايا الذات والصفات التي اعتمدوا فيها الأخذ بظاهر النصوص، وبالتالي يوقعهم في التشبيه والتجسيم، حسب ما يذهب المتصوفة، بل وبعض متقدمي الحنابلة أنفسهم الذين أنكروا تفسيرات بعضهم لقضية الاستواء، حتى قيل: “لقد شان أبو يعلى الحنابلة شينا لا يغسله ماء الدهر”، وذلك بعد ظهور كتابه “إبطال التأويلات لأخبار الصفات” على ما أورد العز بن عبدالسلام في كتابه “مفتاح الكنوز”، وكما سجله أيضا ابن الأثير في كتابه الشهير “الكامل في التاريخ” في أحداث سنة 429هـ، فقال: “وفيها أنكر العلماء على أبي يعلى بن الفراء الحنبلي ما ضمنه كتابه من صفات الله سبحانه وتعالى المشعرة بأنه يعتقد التجسيم، وحضر أبو الحسن القزويني الزاهد بجامع المنصور وتكلم في ذلك، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا”.
وإذا كان فقهاء الحنابلة قد نجحوا في إخماد لظى هذه الفتنة في القرن الخامس الهجري، فإنه سيعاد بعثها مع سطوع نجم إمام السلفية الأكبر وصاحب الإحياء الثاني للمدرسة الإمام ابن تيمية.