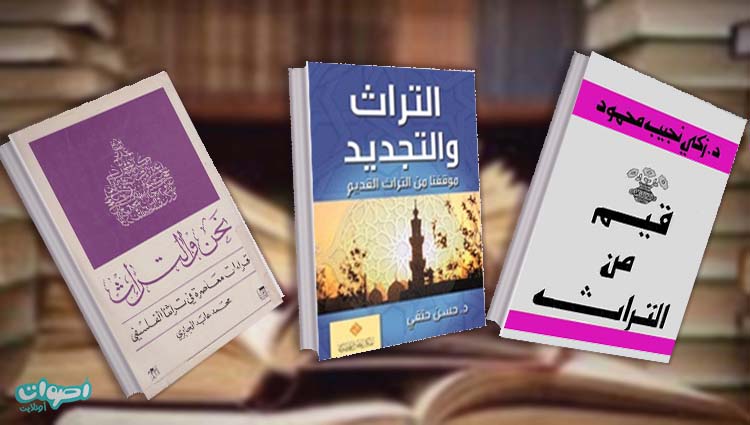لا تكاد تسمع أى حديث عن تجديد الخطاب الدينى إلا وتسمع عن التراث، وأنه ليس مقدسًا، فما هو هذا “التراث”؟ وهل هو شيء مقدس؟ وما هو المقدس بالأساس؟ أسئلة نحاول أن نجيب عليها بشكل ميسر ومبسط.
كلمة التراث لغة مشتقة من الورث أو الميراث، وهو أن يكون الشيء لقوم ثم يصير لآخرين، هذا بصفة عامة. أما معنى التراث الخاص الذى نحن بصدده، فهو ذلك النتاج والمجهودات والتراكمات الإنسانية الواعية، سواء أكانت مادية، أو فكرية التى قام بها السابقون، وتركوها لمن أتوا بعدهم.
أما المقدس، فهو من القُدس، وهو الطهر، والقدوس من اسماء الله تعالى ويعنى: المنزه عن الأضداد والأنداد، ومن ثم يقال عن النص القرآني إنه مقدس لأنه صادر من القدوس والشيئ المقدس هو الشيئ الطاهر المنزه الذى لا يُمس ولا تطوله يد التحريف ويعلو على الزمان والمكان.

المقدس والتراث
وبناء على ذلك فلا يمكن أن يكون التراث مقدساً. إذ هو من صنع البشر وهو مجهود إنسانى بالأساس، وبالتالى يخضع ويؤثر فيه الزمان والمكان، ويتغير بتغيرات الأحوال والأشخاص، كما لا يمكن للمقدس أن يسمى أو يكون تراثاً لأنه لا يخضع للزمان ولا للمكان، ولذلك يظل القرآن صالحا لكل زمان ومكان لأنه مقدس يعلو على الزمان والمكان.
في المقابل يبقى تفسير القرآن وتأويله وفقهه تراثا بشريا، أي غير مقدس. وأى محاولة لجعل المقدس تراثًا مثل القول بتاريخية النص القرآنى أى خضوعه وارتباطه بالمكان والزمان بحيث يفقد النص قدسيته، هي جريمة لا تقل بحال من الأحوال عن جريمة تحويل التراث لشيئ مقدس مطلق عن الزمان والمكان لا يمكن تغييره، أو تبديله، كلاهما تحريف للدين، وتضييع له وافتراء على الله.
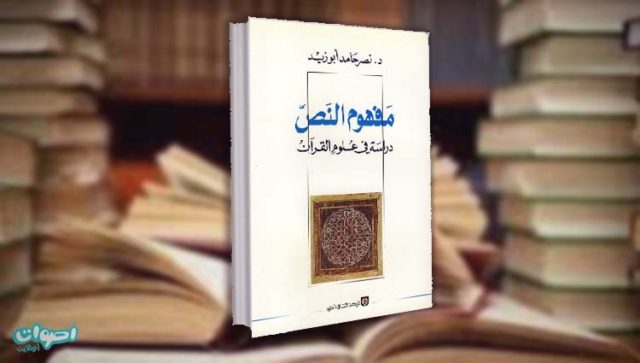
إيقاف الزمن
ومشكلة هذه الأمة تأتى من محاولات إيقاف الزمن، وإبطائه، ومقاومة جريانه بغرض التجميد والتمجيد وعدم التجديد وجعل ذلك كله بيد فئة أو مجموعة أو شخص بعينه من خلال الإستبداد السياسي أو الدينى بدعوى الحفاظ على الاستقرار. كلا النوعين من الإستبداد يعتمد ذات الآليات من ألوان التخويف والترهيب والقهر النفسى وبث الإحتقار والتقزيم لكل من يحاول أن يتكلم، في مقابل التعظيم، بحق أو بباطل، لصاحب السلطة الدينية أو السياسية.
أما الآلية الأخيرة فتتمثل في تكرار مفاهيم معينة بشكل متعمد بحيث تتحول لمسلمات لا مجال لإعادة التفكير فيها، فينغلق العقل المسلم مع مرور الوقت، ويتوقف عن النقد البناء وعن التجديد الإبداع.

ومن الأمثلة على هذه المفاهيم التي تمثل اثراً خطيراً على العقل المسلم من خلال تكرارها ، اقتران البخاري بكتاب الله فيقال “البخارى أصح كتاب بعد كتاب الله” فتتم عملية إحالة وانتقال لقداسة القرآن إلى البخارى، فيكتسب قدرا من القداسة.
عادة ما يبادر أغلب المتخصصين فى العلوم الدينية بنفى القداسة عن البخاري قاصرين إياها على القرآن الكريم عندما يُواجهون بمثل هذا الكلام، وهو موقف يناقض سلوكهم الرافض لأى محاولة علمية لتقييم البخارى قائلين: لا حسبك، إنه أصح كتاب بعد كتاب الله، البخارى لا يمكن أن يخطئ. أجمعت الأمة على ذلك نعم أى بشر يخطئ والبخارى كبشر يجوز فى حقه الخطأ ،ولكن ثبت أنه لم يخطئ وأجمعت الأمة على ذلك، فى حركة دائرية لا تصل فيها سوى لنتيجة واحدة، هي أننا أهل السنة عمليا قدسنا البخارى قولاً واحداً وليس أدل على ذلك من أن هذه الأمة شهدت عصورا كانت تختم البخاري قراءةً كما يُختم القرآن بالضبط، تقربًا إلى الله، وصار المثل المشهور حينما تواجه أحدًا بخطئه يقول لك بالعامية: “هو إحنا غلطنا فى البخارى” بدلًا من القول الصحيح: “هو احنا غلطنا فى القرآن”، وهكذا تقبع وتتجذر فكرة التقديس الخفية فى باطن العقل المسلم.
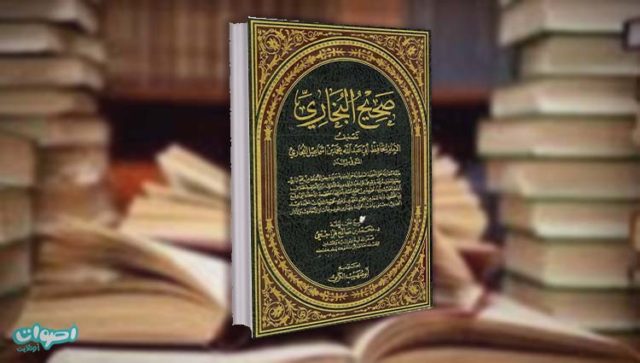
البخاري المظلوم
المسألة ليست مسألة خطأ البخاري، وليس هذا محل النقاش إنما جئنا به كمثال صارخ لمحنة الأمة، ورحلتها؛ فالبخارى رحمه الله كان شخصية علمية فذة وقدوة وإماما ووليا من أولياء الله نفعنا الله ببركاته، ولكن الله يقول:”اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون” مهما كان هذا الولى .
كان البخاري فذا حينما فكر فى وضع قواعد لضبط صحة الحديث، أو بمعنى أدق كان أول من صاغها فى منهج مترابط وطبقها. إذ سبقه من يقول ببعض شروطه التى اشترطها لصحة الحديث، لكنه تفرد فى قدرته على صوغ منهج جديد نافع للأمة أنقذها من مئات الأحاديث غير الصالحة.
مكث الرجل ستة عشر عاماً من الجهد، والتعب استطاع بعدها أن يستخرج من بين ستمائة الف حديث، ما يقارب ثلاثة الآف حديث فقط اطمئن إليها ودوّنها فى جامعه المشهور بالصحيح، وهذا هو درس البخارى القديم المتجدد لهذه الأمة، إنه رجل لم يركن لما هو سائد، وهو عكس ما يطالبنا به بعض علماء الدين اليوم..
مشكلة الأمة أنها وقعت بين عقليتين؛ عقلية طفولية مسطحة ومستسهلة، ليست لديها القدرة على البحث والدرس المعمق، وعقلية جامدة وقفت عند مسائل البخاري رحمه الله ولم تلتقط الإشارة فى منهجه الجديد.
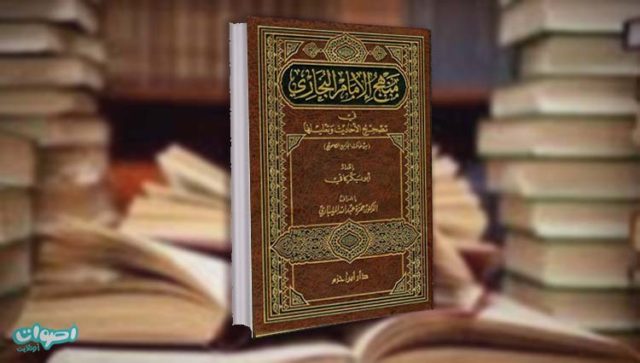
يكمن جوهر منهج البخاري – مقارنة بسابقيه – فى أنه صعب من شروط قبول الحديث وبالغ فى صيانة أقوال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من التحريف والإدعاء، وبدلا من أن يبذل من جاء بعده مزيدا من الجهد بالنظر النقدى لمعرفة مدى التزام البخارى نفسه بتطبيقه علي مصنفه هو قبل غيره تطبيقا علميا متجردًا، وبدلًا من البناء على منهجه، ورفع سقف شروط قبول الحديث، والزيادة عليه، وتحرى الدقة أكثر فأكثر فعلوا العكس تمامًا؛ فنزلوا بسقف القبول، والنقد؛ فكثرت الروايات التى تحتاج لبخارى جديد. لكن هذا المنهج النقدي تلقى الضربة تلو الأخرى فى ظل سيطرة الجمود الذى راح يعمل على تكسير الملكات النقدية على مر عصور متتالية عبر صك عبارات من نوعية البخارى أصح كتاب بعد كتاب الله فكل نقد له طائش، وغير سديد ومبدد وكل تعديل عليه غير مقبول.
فهل هذا هو ما أراده البخارى رحمه الله؟ وهل هذا ذنب البخارى أم ذنب هذه العقلية التى راحت تُحقّر كل جديد، وتقف ضد كل تجديد، بل أصبحت دعوى التجديد الآن دعوة تسبب حساسية تستنفر الكثير من حاملى هذا العلم تحت دعاوى ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب لهذه الأمة. لقد تواتر النقل عن كبار هذه الأمة حول مغبة التقليد والنزوع للجمود، فقال الطحاوي رحمه الله:” لا يقلد إلا عصبي أو غبي”، ونُقل عن أحمد بن حنبل رحمه الله: “لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا”.
أدرك القدامى والسلف تلك المعانى فجدّدوا لزمانهم وتركوا ثروة علمية هائلة فتكلموا فى كل شيئ وأسسوا علوماً ووضعوا متونًا وشروحًا، فإن كان السلف نجحوا، فما نجاحهم إلا لأنهم اجتهدوا، بدءاً من المناهج وانتهاءً بالمسائل ولا سبيل لتقدمنا غير ذلك.