الصدفة وحدها قادتني إلى مشاهدة ذلك الفيلم القصير، حين كنت أجري بحثاً عبر شبكة الانترنت عن قصة «البَلْهاء» لأديب روسيا الراحل وقصاصها الأشهر أنطوان تشيخوف الذي رحل عن عالمنا في مثل هذه الأيام من عام 1904.
قادني البحث إلى فيلم روائي قصير للغاية لا يتجاوز بضع دقائق أبدعه شبان من الأردن الشقيق، كان الفيلم وفياً للقصة الأصلية إلا أنه غيّر مكان أحداثها من روسيا القيصرية إلى الأردن اليوم وجعل صناع الفيلم الحوار باللهجة الأردنية المحلية أيضا.

حين أرسلت رابط الفيلم إلى زميلة روسية جمعتني بها مقاعد الدراسة في الولايات المتحدة جاءني ردها الطريف: «رغم أني لا أجيد اللغة العربية إلا أنني أستطيع أن أميز قصة لتشيخوف أياً كانت اللغة التي تقدم بها».
أعادتني هذه الجملة إلى سبب افتتاني منذ سنوات بقصص تشيخوف، وهو تلك القدرة المدهشة على صياغة أعمال تتجاوز الحدود، لا ترتبط بجنسية بعينها ولا ببلد بعينه ولكنها تتمحور حول قيم إنسانية بحتة مشتركة بين كافة الثقافات.
فتشيخوف المولود عام 1860 والذي إمتهن الطب ولم يترك القصة، و عاش أجواء القهر والجور التي عانى منها كثيرون في ظل حكم القياصرة لروسيا قبل ثورة عام 1917، كان مهموماً في المقام الأول بالإنسان: بآلامه وأحلامه، شأنه في ذلك شأن مواطنه الروائي الكبير ليف تولستوي أو مواطنه فيودور دستوفسكي.
ومن الطريف حقاً أن مؤلفاً بهذا العمق بدأ مسيرته الأدبية بكتابة القصص الفكاهية الهادفة للتسلية فقط كما برع في تقديم القصص البوليسية التي تتميز بالإثارة والتشويق والرعب أيضا وتنتهي عادة بشكل طريف من شأنه أن يثير ضحك القاريء.
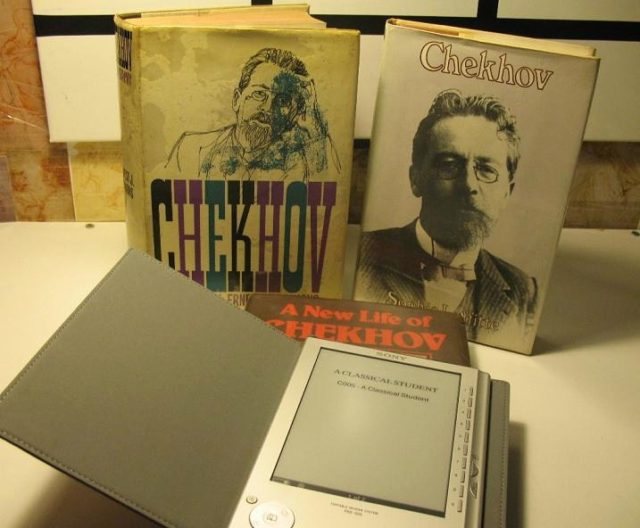
نقطة تحول
لكن نقطة تحول حدثت لتشيخوف غيّرت كتاباته وربما حياته كلها حين زار جزيرة سخالين شمال اليابان التي كانت بمثابة منفى للمحكوم عليهم، وقضى فيها نحو ثلاثة أشهر يحاور هولاء الذين يتلقون عقابهم فى المنفى.
عاد الطبيب الشاب من هذه التجربة بخبرة حياتية استغلها في رواياته وقصصه وأعماله المسرحية التي طرح من خلالها تساؤلات حول قدر الانسان ومصيره وعن قيمة العمل والعدل والحرية.

ورغم تنوع مجالات إبداعاته الأدبية ما بين الرواية والمسرح والقصة، إلا أن القصة القصيرة كانت بمثابة ميدانه الذي تألق فيه وبرزت فيه موهبته وفلسفته على حد سواء.
بدا أسلوب تشيخوف جديداً وفريداً من نوعه بالنسبة لقرائه الذين اطلعوا على قصصه التي كانت تُنشر في الصحف، من حيث استخدامه للجملة الرشيقة والمعبرة في آن وقدرته على طرح أسئلة فلسفية عميقة من ناحية والسخرية المريرة من ناحية أخرى كما في قصصه «موت موظف حكومي» و«عنبر رقم 6» وغيرهما الكثير.

قصة ملهمة
ولعل قصة «البلهاء» المشار إليها سابقاً تصح مثالاً على ذلك، فهذه القصة التي لا تتجاوز عدد صفحاتها أصابع اليد الواحدة تحمل في طياتها العديد من المعاني.
تدور القصة حول كاتب –غالباً تشيخوف نفسه- يلوم على البسطاء من أمثال مربية أولاده كونهم سلبيين وراضين بحالهم وبالظلم الواقع عليهم، لذا يقرر أن يعلمها درساً على حد تعبيره.
فيستدعيها إلى مكتبه ويلاحظ أن حياءها يمنعها من طلب راتبها، فيوفر عليها الحرج ويبدأ بحسابها إلا أنه لا يمنحها الراتب المتفق عليه بل يبدأ بالخصم منه شيئاً فشيئاً لأسباب أبسط ما يقال عنها أنها واهية للغاية.
https://youtu.be/4obelwJaBDA
وفي نهاية الأمر يسلم المربية أقل من نصف الراتب المتفق عليه ولكن الفتاة الخجولة لا تعترض وإنما تأخذ ما أعطاها إياه وتشكره، مما يثير غضب الكاتب فينفجر صائحاً ومتسائلا: لم تشكره وهو قد نهبها وسلبها حقها؟
ويمضي قائلا كيف يمكن لها أن تكون «بلهاء» وسلبية إلى هذا الحد؟ فيأتيه الرد الصادم: «على الأقل..أنت دفعت لي راتبي، أما العائلة التي كنت لديها قبلكم فلم يدفعوا لي شيئاً».
يدرك الكاتب أن واقع الفتاة ومن شابهها من البسطاء أكثر تعقيدا مما كان يتصور لذا يشعر بالخجل ويمنحها راتبها كاملاً، ويتابعها وهي تنصرف من مكتبه، ثم يختم تشيخوف قصته بجملة ذات دلالة على لسان الكاتب: «ما أسهل أن تكون قوياً في هذا العالم».
ولا يملك القاريء العربي حين يطالع هذه القصة وتلك الجملة الختامية إلا أن يقارن بين «بطل» تشيخوف في هذه القصة وبين المثقفين في عالمنا العربي الذين يرتكبون ذات الخطيئة فيتعالون على البسطاء من أبناء شعبهم ويلومونهم على ما يعتبرونه سلبية وخنوعا ناسين أو متناسين أن مجرد بقاء هؤلاء أحياء هو عملية نضالية يخوضونها بشكل يومي.













