لاأظن أن صفة الفيلسوف تصدق على مفكر عربى أكثر من صدقها على هذين العلمين: د. عبدالرحمن بدوى ود. زكى نجيب محمود، ويرجع ذلك إلى التزام كل منهما بمذهب فلسفى واحد ظل يزداد وضوحا ونضجا مع الوقت. حيث التزم بدوى بالمذهب الوجودي بينما التزم. زكي نجيب محمود بالوضعية المنطقية التي بشر بها تبشيرا واسعا في مصر والعالم العربي بمجرد العودة من بعثته العلمية إلى انجلترا ووضع في التأصيل لها مجموعة كتبه الأولى: «خرافة الميتافيزيقا» – «المنطق الوضعى» – «الجبر الذاتى» – «نحو فلسفة علمية»– «شروق من الغرب».
هذه المرحلة الأولى من حياة زكي نجيب محمود، والتى قد يكون كتابه «شروق من الغرب» بعنوانه الدال خير تمثيل لها، تعد الأساس القوى الذى بنى عليه رؤيته النافذة لقضايا التراث وأعلامه من خلال مؤلفاته التى تمثل المرحلة الثانية من رحلته الفكرية على نحو مايظهر فى «الشرق الفنان» و«تجديد الفكر العربى» و«المعقول واللامعقول فى تراثنا الفكرى» و«ثقافتنا فى مواجهة العصر». وبهذا الاعتبار يمكن القول إن د. زكى يعد امتدادا لتيار عريض بدأ منذ عصر النهضة العربية سعيا إلى التوفيق بين الأصالة والمعاصرة.

المعاصر هو الأصيل مجددا
يفرّق د. زكي – وهي تفرقة مهمة للغاية – بين التراث عموما والأصيل منه على وجه التحديد، حين يقول إن «التراث هو الماضي الثقافي كله والأصيل هو الجانب الناضج من هذا التراث القادر على التأثير فى مجرى الحياة الحاضرة. أما المعاصر فهو الأصيل مجددا وقابلا للجديد فى ظروف أكثر ملاءمة لروح العصر» (نقلا عن «زكي نجيب محمود وثورة العقل المعاصر» جلال العشرى ص 29 المكتبة الأكاديمية ).
هذا التحديد يفض وهم التعارض بين الأصيل والمعاصر، حين يرى شرط الأصيل أن يكون فاعلا وقادرا على التأثير فى الراهن. وربما جاز لنا أن نقول – بتعبيرات أخرى – إن د. زكي يفرق – داخل التراث نفسه – بين عناصر التنوير وعناصر الجمود، ويجعل من قضايا العصر الحديث وخصائصه مقياسا للحكم على هذه العناصر كما يبدو في قوله فى «تجديد الفكر العربي»: «إذا كان السؤال المطروح هو: كيف السبيل إلى دمج التراث القديم في حياتنا المعاصرة لتكون لنا حياة عربية ومعاصرة في آن: كانت طريقة الإجابة السديدة هي أن أبحث عن طرائق السلوك التى استلزمها العلم المعاصر».
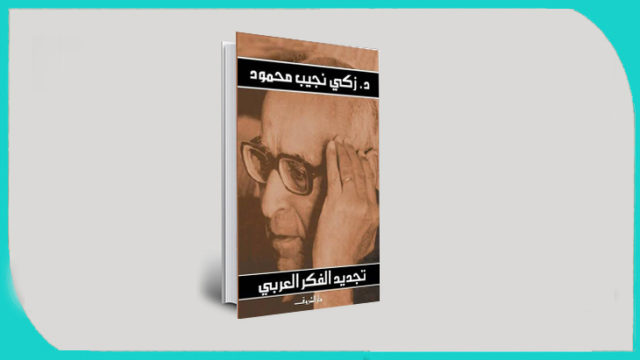
عصر العلم والمنطق
يرجع إيمان د. زكي بالوضعية المنطقية إلى إيمانه بالعلم بوصفه أهم مايميز العصر الحديث، وهو يرى فى ذلك نقلة نوعية في طبيعة الفلسفة ذاتها وانتقالا لها إلى مرحلة جديدة بعد مرحلتي الأخلاق والدين حين يقول فى «حياة الفكر فى العالم الجديد»: «لئن كانت الفلسفة قد لبثت خلال عصور طويلة خادمة للدين.. فقد آن لها أن تخدم سيدا آخر هو العلم الذى كتبت له السيادة فى عصرنا الحديث» نقلا عن «زكي نجيب محمود» د. مصطفى عبد الغنى ص 46 الهيئة المصرية العامة للكتاب 1992) لم يعد الفيلسوف – عند د.زكي – ذلك المفكر الذى لايبرح عزلته مبتعدا عن العالم ثم يطلق تأملاته حول الحياة وما بعدها بل أصبح المفكر الذي يهبط إلى الواقع ليتعامل مع قضاياه بشكل علمي لتغييره واستبدال مثل عليا جديدة بمثل عليا فى أوانها ولم تعد كذلك كما يقول فى كتابه الهام «تجديد الفكر العربى». هذا الإيمان الجازم بالعلم جعله لا يفكر بكل ما لا يخضع للتجربة العلمية والإدراك الحسى أو العقلى على نحو ما يبدو فى قوله «أنا مؤمن بالعلم كافر بهذا اللغو الذى لايجدى على أصحابه ولا على الناس شيئا وعندى أن الأمة تأخذ بنصيب من المدنية يكثر أو يقل بمقدار ما تأخذ بنصيب من العلم ومنهجه» («المنطق الوضعى»).
اقرأ أيضا:
زكي نجيب محمود.. فارس العقل وتحدي الخرافة via @aswatonline https://t.co/l3Dix58hNi
— أصوات Aswat (@aswatonline) August 29, 2019
التفسير والتغيير
إذا كان د. زكى نجيب قد رفض الصورة النمطية للفيلسوف الذى يكتفي بالتأمل البعيد عن مجرى الحياة فهذا يعني أن الفلسفة – عنده – قد انتقلت من مرحلة التفسير إلى التغيير ففي كتابه «ثقافتنا فى مواجهة العصر» يقول: «إن الفكر ليس له في عصرنا معنى إلا أن يكون أداة لتغيير ما نود تغييره مما يحيط بنا من مواقف فى السياسة إلى شئون فى الاقتصاد أو في التعليم أو في نقد الفنون أو فيما شئت أن تغيره»، ومن البديهى أن تقول إن التغيير لن يحقق هدفه المنشود إلا بعد التفسير العقلى المنطقى القائم على خلاصات العلم. من هنا تأتى أهمية العقل وضرورة الاحتكام إليه والذى يراه د. زكى «العامل المشترك بين كل الحضارات» فالفرق كبير «بين من يركن إلى عقله ومن يركن إلى وجدانه : فأولهما يعلم أن أحكامه معرضة للخطأ ولذلك تراه لايكف عن مراجعتها ثم هو لايغضبه أن يظهر له فى الناس من ينبهه إلى مواضع الخطأ فى تلك الأحكام، وأما ثانيهما فلأنه واهم فى ظنه بأن إدراكه الوجدانى منزه من الخطأ تراه يقدم إقدام الواثق ويصم أذنيه عن نقد الناقدين» («ثقافتنا فى مواجهة العصر» ص83). إن ماسبق يهدف إلى حتمية الانتقال من الأحكام المطلقة إلى النسبية ومن اليقيني إلى الاحتمالى وهو تفكير يمكن وصفه بالتفكير العلماني بناء على تعريف د. مراد وهبة لها بأنها «التفكير فى النسبى بما هو نسبي».

الشريعة والحكمة
لا يعارض زكي نجيب محمود الوجدان، لكنه يرى ضرورة ترشيده بإخضاعه لسيطرة العقل مثله مثل الشهوات والغرائز المختلفة، على أنه يسعى إلى ماهو أعمق حين يحدد -على عادة فلاسفة الوضعية المنطقية- دلالات إحدى الثنائيات التى توضع غالبا فى سياق التعارض وهي ثنائية: الدين والعقل أو الشريعة والحكمة، فيرى أن أسلافنا لم يترددوا فى ترجمة الفلسفة اليونانية التى كانت تمثل «علم» هذا العصر، وفى تأكيد هذا ينقل فى كتابه «المعقول واللامعقول..» من رسائل إخوان الصفا قولهم: «إن الشريعة قد دنستها الجهالات واختلطت بالضلالات ولاسبيل إلى غسلها وتطهيرها إلا بالفلسفة، لأن هذه الفلسفة قوامها الحكمة فإذا رأينا حكمة الفلاسفة اليونان قد انتظمت مع شريعة الدين كان لنا بذلك كمال ليس بعده أكمل» (ص 178) ويتوقف بإسهاب أمام «المعتزلة» بوصفهم فرسان العقل فى التراث الإسلامى بدءا من شيخهم أبى الهزيل العلاف وتلميذه الذى فاقه علما إبراهيم النظام وصولا إلى الجاحظ الموسوعى المعتزلى.
لاتعارض إذن بين الشريعة والحكمة أو بين الوحى والعقل، فالثانى يحاول إثبات ما آمن به القلب. وفي سياق هذا الفهم رفض د. زكي مقولة «الغزو الثقافى» الشهيرة، فالغرب لايستطيع إجبارك على قبول شىء ترفضه ثقافتك بل أنت الذى تذهب إليه مختارا وتستعير منه مايناسبك وتقوم بتعديله وتكييفه، لهذا فإن «النظم السياسية» – عندنا – على اختلاف صورها فى مختلف الأقطار العربية مأخوذة كلها من أوروبا وأمريكا، وإلا ماسمعنا بشىء اسمه دستور أو برلمان أو جمهورية، وهى استعارات لاتخل بالهوية العربية ولا تناهضها على نحو ما يدعى دعاة السلفية بل هى فى حقيقتها وسائل لتحقيق أهداف المواطنة والعدل والحرية.
الدين والعلمانية
لم يكن من الممكن أن يمر مصطلح العلمانية والخلاف حوله واتهام دعاته بمعاداة الدين والهوية بوصفه مصطلحا غربيا، دون تدقيق من زكى نجيب محمود الذى ظل طوال عمره مهتما بوضع «نقط الحروف»، لهذا فإنه يرجع إلى «القاموس المحيط» فيرى «العلمانى نسبة إلى العلم (بفتح العين وسكون اللام) بمعنى العالم وهو خلاف الدينى أو الكهنوتى» وفى كتابه «عن الحرية أتحدث» يرى – فى مقاله الشهير «عين فتحة – عا» – أن «المتحدث عن العلمانية – سواء كان مهاجما لها أو مدافعا عنها – ينطقها» مكسورة العين وكأنها منسوبة إلى العلم مع أن حقيقتها هى العين المفتوحة نسبة إلى هذا العالم الذى نقضى فيه حياتنا الدنيا». والحقيقة أن العلمانية كانت دعوة ملحة فى الغرب للخروج من العصور الوسطى التى امتدت عشرة قرون من القرن الخامس إلى القرن الخامس عشر الميلاديين وانتشرت خلالها حركة الرهبنة وأصبح العالم الدنيوى مهملا باعتباره شيئا فانيا وأصبح الأمر «إما الدنيا وإما الآخرة ولا اجتماع بينهما»، فجاءت العلمانية لكى تجعل هذا العالم الفانى مدار اهتمامها، فتقدم الفكر والعلم دون وصاية كهنوتية ،وبدأ عصر الكشوف العلمية الهائلة التى أحكمت سيطرة الإنسان على الأرض واكتشاف خيراتها وكنوزها.
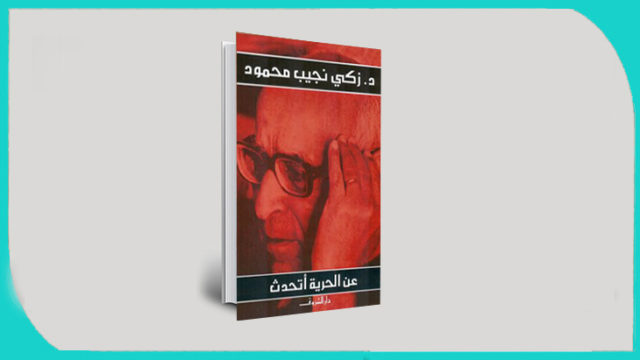
بهذا المعنى فإن العلمانية ليست نقيضا لقيمنا، فنحن نعمل للدنيا كأننا نعيش أبدا ونعمل للآخرة كأننا نموت غدا. الدنيا والآخرة معا على أن تظل الآخرة هدفا أسمى فهى «الحيوان لو كانوا يعلمون» وهى دار البقاء دون أن يمنع ذلك – بداهة – عمارة الأرض التى استخلفنا الله فيها، فلارهبانية فى الإسلام ولا كهنوت لرجال الدين ،فكل إنسان ألزمه الله «طائره فى عنقه» و«كل نفس بما كسبت رهينة» والإنسان مسئول عن عمله لا أحد سواه، و«الإثم» لاينتظر كاهنا لكى يحدده فاستفتاء القلب هو الأساس لأنه كل «ماحاك فى الصدر وخشيت أن يطلع عليه الناس».
لفت زكي نجيب محمود الأنظار إلى حقيقة أن تجاور وتفاعل الدين والعلم هو مما يميز حضارة «الشرق الأوسط» الذى جمع فى تآلف خلاّق بين روحانية الشرق الأقصى ومادية الغرب، كما يؤكد فى كتابه «الشرق الفنان»، وهو مايجعل كتاباته من أهم الكتابات التى حرثت التربة ومهدتها بل ونقلت فكر النهضة في عالمتا العربي والإسلامي نقلة كيفية بما أشاعته من قيم العقلانية والعلم وحرية التفكير والانفتاح على العالم.
صورة الغلاف بريشة الفنان: سعد الدين شحاتة
الفيديو جرافيكس













