جمال عبد الناصر المولود قبل ثورة 1919 بسنة، والمتوفى منذ نصف قرن إلا سنة، لا يزال قضية مطروحة في الحاضر، وهو في نظر أنصاره سيبقى قضية على جدول أعمال المستقبل. لذلك لم تفتر حملات الهجوم عليه وعلى مشروعه الوطني، تلك الحملات التي يتولى إطلاقها وتضخيمها العديد من القوى التي خاصمت عبد الناصر حياً وفاعلاً خلال مسيرته ولا تزال ترفع لواء الخصومة التاريخية معه حتى يومنا هذا.
وقد تلقفت تلك القوى الكتيب الذي كتبه الأديب الكبير توفيق الحكيم تحت عنوان «عودة الوعي» في أوائل السبعينيات من القرن الماضي، وتحمست لإصداره والترويج له وجعله «مانيفستو» لحملات الهجوم على الرجل بعد رحيله.
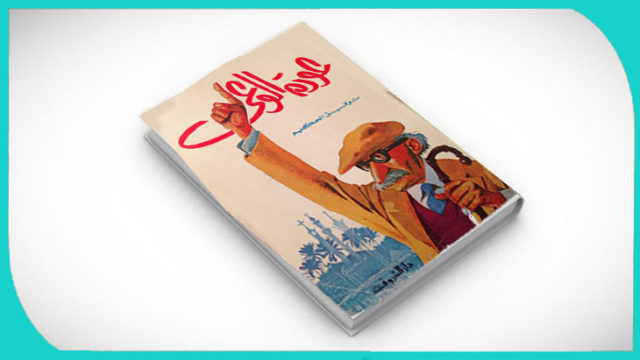
في نهايات القرن الماضي، أصدر الكاتب والمؤرخ البريطاني «بول جونسون»[i] كتاباً حمل عنوان «المثقفون» استعرض فيه ما أسماه «أمراض المشاهير» من الأدباء والشعراء والكتاب والمفكرين، تناول في فصوله عدداً منهم بداية من جان جاك روسو، ومروراً بكل من ماركس، وسارتر، وإبسن، وتولستوي، وهيمنجواي، وبريخت، ونهاية بكل من جورج أوريل، ونعوم تشومسكي.
الكتاب فيه متعة فكرية والكثير من الجدة والطرافة، ويحتوي على بعض الفضائح والمساوئ وحب الذات، وكثير من الحماقات التي ارتكبها هؤلاء المشاهير من المثقفين. وقد ابتدأه جونسون بالتأكيد على أنه خلال القرنين الماضيين حل المثقفون العلمانيون محل «الإكليروس» القديم لهداية البشرية وإصلاح أحوالها، الأمر الذي جعل الكاتب يقدم على فحص عدد من الحالات الفردية لأولئك الذين حاولوا تقديم النصح والإرشاد، يقول: «فحصنا مؤهلاتهم الأخلاقية، وقدرتهم على الحكم من أجل تحقيق ذلك الهدف، وعلى نحو خاص تحرينا مواقفهم من الحقيقة، ووسائلهم للبحث عن الدليل وتقويمه، ومواقفهم، لا من الإنسانية بشكل عام، وإنما من البشر على نحو خاص، كيف يعاملون أصدقاءهم، زملاءهم، خدمهم، وقبل ذلك كله أسرهم، كما تعرضنا للنتائج الاجتماعية والسياسية للعمل بنصائحهم وإتباع مشورتهم».
ثم يسأل جونسون: بعد ذلك الجهد المضني والفحص المتأني: ما هي النتائج التي يمكن أن نستخلصها؟، ولكنه يترك للقراء الفرصة بعد أن يقرأوا فصول كتابه ليحكموا بأنفسهم على هؤلاء «المثقفين».
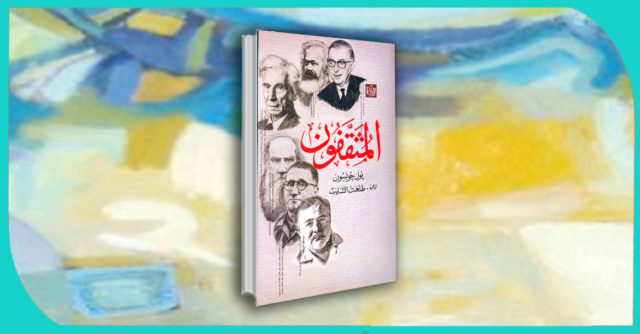
كيسنجر وبداية الحملات على عبد الناصر
عاصرت أنا وجيلي (يسمونه جيل السبعينيات)، بداية الحملات المسعورة على ثورة يوليو وعلى قائدها جمال عبد الناصر، والتي بدأت بشائرها عقب توقف قعقعة السلاح على الجبهة، وبدء جولات «هنري كيسنجر»[ii] المكوكية بين القاهرة وتل أبيب ليضع وزير الخارجية الأمريكي الشهير الأسس الجديدة لترتيبات المنطقة تلك الأسس التي ما تزال قائمة حتى وقتنا الحاضر.
في تلك الأثناء كان على الرئيس أنور السادات أن يشرع في إعادة ترتيب البيت من الداخل تبعاً لما جرى الاتفاق عليه مع «كيسنجر» من سياسات واستراتيجيات وأفكار، وقبل أن ينتهي شهر يناير 1974، وفي ظل حمأة الاتصالات بين واشنطن والقاهرة فوجئت الأوساط السياسية والصحفية بعودة علي أمين من الخارج، والإفراج عن مصطفى أمين من السجن، ومن دون مقدمات معروفة وقتها تمت الإطاحة بالكاتب الصحفي الشهير محمد حسنين هيكل.
ومن دون مقدمات أيضا تقلد علي أمين رئاسة تحرير «الأهرام» خلفاً لهيكل، وتسلم مصطفى أمين جريدة «الأخبار»، وكان ظهورهما مجدداً على الساحة علامة فارقة بين تاريخين، وبداية تاريخ جديد سارت فيه السلطة المصرية في الركاب الأميركي، ثم كانت لحظة رجوعهما معاً إلى الصحافة المصرية وكأنها إشارة انطلاق حملات التشهير بجمال عبد الناصر وعهده، حيث تحولت كل انجازاته إلى مصائب وكل قراراته إلى نكبات، حتى طالت السد العالي، الذي طالب البعض في حمأة تلك الحملات بهدمه.

اقرأ أيضا:
هيكل بين السادات والأَخَوَيْن مصطفى وعلي أمين.. صراع الحيتان via @aswatonline https://t.co/8F3sKZltqM
— أصوات Aswat (@aswatonline) September 26, 2019
توفيق الحكيم يهاجم الثورة
في بدايات تلك الحملات صدر كتيب يحمل اسم توفيق الحكيم بعنوان «عودة الوعي»، بدا وكأنه تدشين لتلك الحملات على الثورة وقائدها بإضافة اسهام بحجم وقيمة وقلم ذلك المفكر والأديب الكبير، وسرعان ما صار هذا الكتيب الصغير «مانيفستو» تلك الحملات يتكئون خلالها على اسم وقيمة كاتبه.
جاء الكتيب مفاجئاً لكثيرين كانوا ينظرون إلى توفيق الحكيم باعتباره الأب الروحي لثورة يوليو، الذي تأثر عبد الناصر بكتاباته قبل الثورة، والذي حظي في ظل حكم عبد الناصر بتكريم لم يحظ به كثيرون غيره من الكتاب والأدباء والمفكرين، إلى جانب أن الناس لم تكن قد نسيت بعد مرثيته الحزينة في عبد الناصر «اغفر لي يا سيدي الرئيس فيداي ترتعشان وأنا أكتب عنك»، ولا دعوته الملحة إلى جمع التبرعات لإقامة أكبر تمثال لعبد الناصر في قلب ميدان التحرير، ثم يقرأون على لسان هذا الكاتب نفسه: «هل كانت ثورة يوليو ذات فائدة حقيقية لمصر والبلاد العربية، أو أنها فترة معترضة لسيرها معرقلة لنهضتها؟، هل كانت نظاما طبيعيا أو نظاما مصنوعا نتج عن حركة آزرتها وخططت لها أمريكا لتزرع في المنطقة أنظمة عسكرية على غرار ما فعلته في أمريكا الجنوبية اللاتينية لتوقعها».

اقرأ أيضا:
توفيق الحكيم وعبد الناصر و«عودة الوعي المفقود» via @aswatonline https://t.co/VLdRPprOJa
— أصوات Aswat (@aswatonline) September 26, 2019
من يقرأ «عودة الوعي» يتصور أن كاتباً بحجم وقيمة توفيق الحكيم لم يكن ليجرؤ على أن يكتب في ذلك العصر الذي قاله عنه حين عاد وعيه: «كانت مرحلة عاش فيها الشعب المصري فاقداً الوعي، مرحلة لم تسمح بظهور رأي في العلن مخالف لرأي الزعيم المعبود»، ويبرر الحكيم غياب وعيه في تلك المرحلة بقوله: «سحرونا ببريق آمال كنا نتطلع إليها من زمن بعيد، وأسكرونا بخمرة مكاسب وأمجاد، فسكرنا حتى غاب عنا الوعي. اعتدنا هذا النوع من الحياة الذي جعلتنا فيه الثورة مجرد أجهزة استقبال».
لكن الحقيقة ـ التي تشهد بها الوقائع وتؤكدها الأوراق ـ على غير ما يقول توفيق الحكيم، فقد كتب في هذه المرحلة التي غاب فيها وعيه أفضل ما أنتجه من إبداع، وأبقى ما طرحه من أفكار. ففي الفترة من سنة 1952 منذ قيام ثورة يوليو وحتى ذكراها في سنة 1972 السنة التي يقول إنه بدأ فيها كتابة «عودة الوعي»، كتب توفيق الحكيم: «السلطان الحائر»، و«الصفقة»، و«الأيدي الناعمة»، و«ايزيس»، و«ياطالع الشجرة»، «والورطة»، و«بنك القلق»، و«رحلة الغد»، و«الصرصار ملكاً»، و«الطعام لكل فم»، و«رحلة الربيع والخريف»، وغيرها. ولو تصورنا إمكانية حذف هذا الإنتاج الأدبي والفكري والإبداعي لتوفيق الحكيم في فترة العشرين سنة التي غاب فيها وعيه سنجد أنفسنا أمام سؤال كبير: فماذا يتبقى له؟
إن أي منصف يدرك بدون أي شك أن الأعمال الباقية لتوفيق الحكيم هي تلك التي أبدعها خلال هذه السنوات العشرين، وهي إبداعات لا تلغي ما قبلها، ولكنها أفضل منها وأبقى، وهي للأسف آخر ما أبدعته قريحة وعقل هذا المفكر الكبير فلم يُلحق بها أي ابداعات في الفترة التي عاد له فيها وعيه.وما زلت أذكر ما كتبه الدكتور غالي شكري في مقدمة كتابه «ثورة المعتزل ـ دراسة في أدب توفيق الحكيم» والتي يقول فيها: «إن الأعمال الباقية لتوفيق الحكيم هي التي أنتجها وهو غائب الوعي، وإذا كانت غيبة الوعي تدفعه لكتابة مثل هذه الأعمال فليت وعيه ما عاد».
السلطان الحائر ينتقد عبد الناصر
كان توفيق الحكيم قادراً على أن يكتب ويبدع خلال تلك السنوات التي يدعي أن وعيه غاب خلالها، وخلالها جاء الكثير من إبداعاته، ولكن من يقرأ «عودة الوعي» قد يتبادر إلى ذهنه أنه إذا كان صحيحاً أنه كان قادراً على الكتابة، فإنه لم يكن قادرا على النقد، وهذا أيضاً بدوره افتراض غير صحيح. فقد كان الحكيم على رأس الذين قدموا نقداً حاداً، وانتقاداً محدداً، لتوجهات وإجراءات جرت في عهد عبد الناصر.
فهو ـ وليس غيره ـ الذي كتب مسرحية «السلطان الحائر» عام 1959، والتي يندد فيها بالسيف وينتصر للقانون، والذي يراجع ظروف وملابسات تلك الفترة من عمر ثورة يوليو سيجد أنها كانت تخوض الكثير من المعارك في الداخل والخارج، وفي تلك الفترة كانت هناك حبسة الشيوعيين الشهيرة.
جاءت رؤية الحكيم في «السلطان الحائر» وكأنها جرس إنذار وتنبيه إلى أهمية الانحياز إلى القانون ونبذ منطق السيف، وكأنه يوجه حديثه مباشرة إلى عبد الناصر، حيث يؤكد أن شعبية الحاكم لن تتأكد إلا بتعميق التجربة الديمقراطية وأن شرعيته لن تتدعم إلا بمقدار تمسكه بهذا المبدأ، وأن الفهم الحقيقي لشرعية القانون يهدف – أول ما يهدف – إلى خير ومصلحة الحكام والمحكومين على حد سواء.
كانت الرسالة في «السلطان الحائر» موجهة مباشرة إلى عبد الناصر،فماذا كان رد فعل دولة عبد الناصر على المسرحية وكاتبها؟.. قد تظن وأنت تقرأ «عودة الوعي» أن المسرحية لم تصدر أو أنها منعت من العرض، لكن حقيقة ما جرى على العكس تماماً، فقد سمحت دولة عبد الناصر ووافقت الرقابة في عصره على نشر المسرحية وتم عرضها على مسارح الدولة.
ولعلك تقول بينك وبين نفسك : لعلها كانت مرة ولم تتكرر بعدها أبداً، فلا يمكن أن تكون دولة عبد الناصر بمثل هذا التسامح مع أعمال الحكيم، ثم يأتي هو ليقول بعد رحيل عبد الناصر بسنتين فقط : «العجيب أن شخصا مثلي محسوب على البلد هو من أهل الفكر قد أدركته الثورة وهو في كهولته يمكن أن ينساق أيضا خلف الحماس العاطفي، ولا يخطر لي أن أفكر في حقيقة هذه الصورة التي كانت تصنع لنا، كانت الثقة فيما يبدو قد شلت التفكير سحرونا ببريق آمال كنا نتطلع إليها من زمن بعيد، وأسكرونا بخمرة مكاسب وأمجاد، فسكرنا حتى غاب عنا الوعي. أن يري ذلك ويسمعه وألا يتأثر كثيرا بما رأي وسمع ويظل على شعوره الطيب نحو عبد الناصر. أهو فقدان الوعي. أهي حالة غريبة من التخدير».
بنك القلق
والحقيقة أن توفيق الحكيم لم يكن مخدراً، بل لعله كان واحداً من هؤلاء الذين بادروا إلى انتقاد الأوضاع آمناً من أي انتقام، مطمئناً إلى تقدير عبد الناصر له، وهو التقدير الذي تبدى في أكثر من مناسبة، ولعل أهمها وأشهرها تلك التي جرت وقائعها في سنة 1957 حين بدأت حملة نقد ضد كتابات توفيق الحكيم بدأها الكاتب الكبير رشدي صالح فما كان من عبد الناصر إلا أنه صرح بأنه تأثر برواية «عودة الروح»، وبادر إلى منح الحكيم أرفع وسام في الدولة، وتوقفت الحملة النقدية في جريدة الجمهورية.
إذن كان توفيق الحكيم قادراً على الكتابة، وكان قادراً على الانتقاد، ولم يقتصر نقده على مسرحية «السلطان الحائر» في سنة 1959، ولكنه في عام 1966 قبل هزيمة يونيو بسنة كتب روايته «بنك القلق» ونشرها في أوسع الصحف انتشاراً وأكثرها تأثيراً وهي صحيفة «الأهرام»، وقدم فيها نقداً حاداً لأجهزة الأمن وحذر القيادة السياسية من أن غياب حرية المواطن يقود حتماً إلى فقدان حرية الوطن.
حين عرض الحكيم «بنك القلق» على محمد حسنين هيكل رئيس تحرير «الأهرام» وقتها، أخذها هيكل معه إلى البيت وقرأها في نفس اليوم، وبدا أمامه بوضوح أن القصة نقد في الصميم لأجهزة الأمن والمخابرات في شكل عمل أدبيّ، وقرر هيكل نشرها على صفحات «الأهرام»، وعندما عرف الحكيم قرار هيكل بدا عليه الارتباك مؤكداً أنها مجرد رواية تجريبية، وتساءل حول إمكانية التروي قبل نشرها، فقال له هيكل: «إذا كانت لديك الشجاعة لتكتب، فلديّ الشجاعة لأنشر».
عبد الناصر ينحاز للحكيم
ولا شك في أن الأجهزة الأمنية قد أقلقها بشدة نشر «بنك القلق»، وذكر هيكل إن عبد الحكيم عامر طالب بوقف النشر، ولكن عبد الناصر انحاز مجدداً لحق الكاتب الكبير في كتابة ما يشاء وقال: «كيف يتمكن توفيق الحكيم في العهد الملكي أن ينقد المجتمع المصري في كتابه «يوميات نائب في الأرياف»، ثم لا يستطيع في عهد الثورة أن ينقد ما يراه مستحقا للنقد في حياتنا»
الحكيم نفسه قال ـ بعد عودة وعيه ـ إنه أراد أن يبعث رسالة إلى جمال عبد الناصر عبر «بنك القلق» يعبر فيها عن قلق المجتمع من قمع السلطة، وملاحقة أي محاولات للتعبير عن قلق مختلف فئات المجتمع واقترح أن تصارح السلطة الشعب بما يقلقها أو بالعقبات التي تواجهها وأن تترك الحرية للمواطنين بالتعبير عن قلقهم، ويقول إنه تأكد أن الرسالة وصلت لعبد الناصر.
ليس غريباً في نظري أن الدولة في عهد عبد الناصر ساهمت بشكل مباشر في رواج إبداعات توفيق الحكيم بل إنها حولت بعض أعماله إلى مسلسلات إذاعية وتليفزيونية وأفلام سينمائية وعروض مسرحية، وقررت أن تكون بعض كتبه ضمن مقررات التعليم الرسمية.
وإذا كان وعي الحكيم قد غاب طوال عشرين سنة، أبدع خلالها أفضل ما أنتج، فقد كان عليه ـ أولاً ـ أن يتبرأ من كل هذا الإنتاج الذي جاء في مرحلة كان فاقداً للوعي فيها، وكان لابد ـ ثانياً ـ أن يكون شجاعاً كما ذكر الدكتور غالي شكري في كتابه «ثوة المعتزل» ويفعل ما فعله كتاب آخرون في كل الأزمنة ويحرق كتبه في أوسع ميادين القاهرة ويحرم على الناشرين طبعها، وأن يناشد القراء اتلافها أينما وجدت، وهذا ما لم يحدث، بل ظل الحكيم يعيد طبع ما أنتجه خلال الحقبة الناصرية ويفتخر به.
إن أي مطلع مدقق لإنتاج الحكيم خلال تلك السنوات سيوقن أنه لم يكن غائب الوعي حين كتب وحين انتقد، ولا كان غائب الوعي حين أيّد وبارك وهلل لإنجازات عبد الناصر، بل سيتلمس صدقه ومصداقيته في كل ما كتب في تلك الفترة. والمحزن أن الحكيم هو الذي أهدر بنفسه أفضل ما أنتج من ابداعات، ولم يستطع أن يقدم لنا إجابة مقنعة على سؤال: لماذا كل هذا الإبداع في مرحلة «الوعي المفقود»، ولماذا توقف نهر ابداعه عن الجريان حين عاد وعيه؟!
إن أي قراءة موضوعية لكتيب «عودة الوعي» ستكون نتيجتها أنه ليس إلا منشور سياسي ،استخدم من قبل نظام السادات ومن جماعات وأفراد كانت ولاتزال معادية لجمال عبد الناصر ولعصره ولكل ما فيه، وكان هذا الكتيب هو باكورة الهجوم على ذلك العصر. وفي المحصلة النهائية ذهب الكتيب وسقطت الحملات وبقي عبد الناصر شامخاً حتى اليوم، وبقيت كذلك أعمال توفيق الحكيم التي نادت بالعدل الاجتماعي وبالحرية شاهدة ضد وعيه العائد.
بعد ما يزيد على 350 صفحة من كتابه «المثقفون» يعود «بول جونسون» ليقول في خاتمة الكتاب:
«ألمس اليوم تشككاً عاماً من الناس عندما يقف المثقفون ليعظوا، وصار المعتقد السائد أن المثقفين ليسوا أكثر حكمة ولا أكثر قيمة ـ كمصلحين ـ من السحرة أو رجال الدين القدامى»…
إن أحد الدروس الرئيسية التي نخرج بها من هذا القرن المأساوي الذي شهد التضحية بالملايين من الأبرياء في مشروعات تحسين أحوال البشرية هو: حذار من المثقفين، لا تثق بالبيانات التي تصدر عنهم، لا تصدق شهاداتهم عن القادة السياسيين أو الأحداث المهمة، وقبل ذلك كله علينا أن نتذكر دائماً ما ينساه المثقفون عادة: الناس أهم من الأفكار، الناس أولاً، وأن أسوأ أنواع الاستبداد هو استبداد الأفكار الذي لا يرحم.
____________________
[i] بول بيد جونسون (من مواليد 2 نوفمبر 1928 في مانشستر، إنجلترا، وهو صحفي لامع ومؤرخ بارز، هو مؤلف عدد من المجلدات التي لقيت استحسانًا على نطاق واسع، مثل: «تاريخ الشعب الأمريكي»، و«العصر الحديث»، و«تاريخ اليهود»، و«الفن: تاريخ جديد». كما يصدر جونسون دراسات موجزة للجيب، مثل الدراسة الشهيرة «عصر النهضة ونابليون». وجونسون يشارك كثيرًا بمقالات في صحف نيويورك تايمز، ووول ستريت جورنال، وسبيكتاتور، ودايلي تيليجراف، ويلقي محاضرات في جميع أنحاء العالم، ويعيش في نوتينج هيل (لندن) وسمرست.
ظهر جونسون لأول مرة في الخمسينيات كصحفي يكتب لمجلة نيو ستيتسمان، ثم قام بتحريرها لاحقًا. كاتب غزير الإنتاج، وقد كتب أكثر من 50 كتابًا وساهم في العديد من المجلات والصحف. بينما يرتبط مع اليسار في بداية حياته المهنية، فهو الآن مؤرخ شعبي محافظ.
كتب جونسون عمودا للمجلة الأسبوعية البريطانية المحافظة The Spectator من 1981 إلى 2009؛ وكتب عمودا لصحيفة ديلي ميل حتى عام 2001، كان مساهماً بصفة منتظمة في صحيفة ديلي تلغراف، بشكل رئيسي كمراجع كتب، وفي الولايات المتحدة لصحيفة نيويورك تايمز، وصحيفة وول ستريت جورنال، والتعليق، والمجلة الوطنية. يكتب أيضًا لعمود الأحداث الحالية في Forbes.com. لفترة من الوقت في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي،
**
[ii] هنري كيسنجر: أحد ألمع السياسيين الأمريكيين، ومهندس السياسة الخارجية الأمريكية في إدارتي الرئيسين ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد، شغل منصب مستشار الرئيس ريتشارد نيكسون لشؤون الأمن القومي في الفترة بين (1969 ـ 1973)، وشغل في الفترة بين (1973ـ 1977) منصب وزير الخارجية لدى كل من نيكسون وفورد.
عرف كيسنجر بدوره المؤثر على صعيد الصراع العربي الإسرائيلي من خلال جولاته المكوكية في المنطقة في أعقاب حرب أكتوبر سنة 1973، في إطار سياسته المعروفة بسياسة الخطوة خطوة. وأفضت هذه الجولات، والدور المحوري الذي قام به كيسنجر، إلى التوصل إلى اتفاقيات الفصل بين القوات الإسرائيلية من جهة والسورية والمصرية من جهة أخرى. ومهدت الطريق أمام الصلح المنفرد بين مصر وإسرائيل ووضعت أسس العلاقة المستجدة بين القاهرة وواشنطن.













