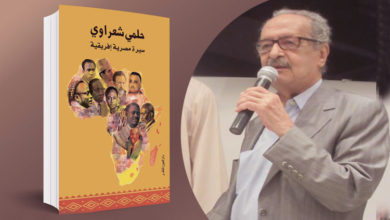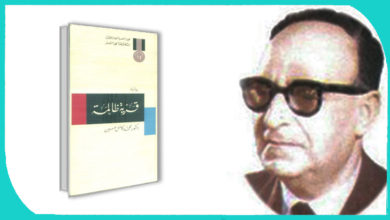شغلت قضية الفتح العربي الإسلامي للأندلس حيزا هاما في كتاب «الكفار… تاريخ الصراع بين عالم الإسلام وعالم المسيحية»، والذي يرصد فيه الكاتب «أندرو هويتكروفت» قصة ومراحل تطور الصراع ما بين العالمين الأوروبي المسيحي، وبلاد الشرق الإسلامي، وهو صراع ممتد الحلقات منذ ظهور الإسلام وحتى وقتنا الراهن.
بحسب الكاتب، فقد كانت إسبانيا التي سيبني فيها المسلمون مملكتهم التاريخية المعروفة بالأندلس بالنسبة للأوروبيين أرضا بعيدة في الجنوب الأوروبي، تفصلها عن شمال أوربا سلسلة جبال (البرينيس)، الوعرة مما يجعل الاقتراب منها ليس بالأمرالسهل. وقد وصل حد تناسي تلك الأرض أن أسطورة شعبية مجهولة المصدر روجت لفكرة أن الشيطان عندما وقف أمام المسيح ليزعم أن له السيادة على الأرض كلها، فإنه نسي إسبانيا!

الأرض السهلة
أما على الجانب الآخر (أي جانب العرب المسلمين)، فقد كانت إسبانيا أرضا سهلة، وما أن تمنحها الماء حتى تزدهر، وإذا كان المحيط الأطلنطي قد وقف عائقا في سبيل عقبة بن نافع ذات يوم، بعد أن خاض بحصانه حتى كاهله في الماء، شاهرا سيفه مكبرا و معلنا رغبته في اقتحام أرض الغرب المجهولة لإعلاء كلمة التوحيد، فإن الطريق ما بين أوربا وإفريقيا المتمثل في المضيق المائي الضيق، والذي سيحمل اسم القائد العربي الفاتح طارق بن زياد– فيما بعد-، لم يكن بتلك الوعورة.
وفي إبريل من عام 711 ميلاديا جرد القائد العام في طنجة طارق بن زياد حملة قوامها سبعمائة فارس على بلاد إسبانيا، التي كانت تحكمها قومية القوط، وقد لقوا مقاومة ضعيفة من ملك إسبانيا رودريك الذي خر صريعا في أول مواجهة. ثم توالت الفتوحات شمالا نحو قرطبة وطليطلة على أيدي طارق بن زياد وموسى بن نصير.
كانت أول رواية تاريخية كُتبت عن احتلال المسلمين لإسبانيا في حوالي عام 754ميلاديا، وقد خضعت هذه الرواية للكثير من التهويل والمبالغة والتضليل. فعلى طريقة وصف «صفرنيوس» بطريرك بيت المقدس لدخول المسلمين للقدس، فقد صورت الرواية – بمزاعم مقصودة – بشاعة وقسوة موسى بن نصير، الذي أذل وعذّب النبلاء، وقتل الأطفال، وبقر بطون النساء، وغلبت التفسيرات الكنسية للهزيمة وأسبابها، وبات السؤال هو: لماذا تخلى الرب عن شعبه؟ بطبيعة الحال كانت الإجابة هي رغبة الرب في تطهير شعب القوط من الخطيئة والشهوة التي غلبت على قادتها ونبلائها، فاستحقوا العقاب على أيدي العرب الأشرار –بحسب بعض الروايات التاريخية، ..«كانت أعنة خيولهم مثل النار وكانت وجوههم سوداء قاتمة، أكثرهم وسامة في سواد قدر الطهو، وعيونهم تشع مثل النار، وخيولهم سريعة كالفهود، وفرسانهم قساة مؤذين أكثر من الذئب الذي يأتي ليلا لالتهام الغنم».

صناعة الكراهية
كان الهدف- فيما يرى الكاتب- هو صناعة حالة أسطورية عن بشاعة العرب المسلمين تساوي بينهم وبين المسيحيين القوط في إسبانيا في الرذيلة، فإذا كان المسيحيون يخطئون فإن الرب عاقبهم، أما هؤلاء فمخطئون ومنغمسون في الرذيلة دائما، لأنهم ليسوا شعب الرب، لقد كانت هذه محاولة للحفاظ على نواة ممتلئة بالثقة في المستقبل سيتشكل من خلالها إنبعاث مسيحي يقود حروب الاسترداد، أُخترعت من أجله العديد من الأساطير الدينية التي جعلت من المسلمين امتحاناً وابتلاءً من الرب إلى شعبه. وعلى الرغم من خضوع إسبانيا لحكم المسلمين لنحو خمسة قرون امتدت من عام 720، وحتى 1200 ميلاديا، إلا أن نواة للكتلة المسيحية تشكلت خلف نهري الإبرو، والديورو والجبال العالية حول ضفافهما في شمال إسبانيا، بينما تشكلت في الجنوب مملكة المسلمين المعروفة بالأندلس وقد نقل إليها العرب والمسلمون أساليبهم في الزراعة والري، لتصبح من أفضل المناطق الزراعية فى العالم، وشهدت مملكة المسلمين حالة من التعايش بين المسلمين الوافدين من العرب والبربر، والمسيحيين المستعربين، واليهود الذين وجدوا في الفتح الإسلامي إنفراجا من قسوة الاضطهاد الذي تعرضوا له على أيدي المسيحيين القوط.
غير أن هذا التعايش والتجاور لم يتسم دائما بالاستقرار النفسي والتغاضي عن الاختلاف في الأديان والطبائع والثقافات، فقد كان هناك العديد من المحاذير للمسلمين للتجاور مع المسيحيين من سكان البلد الأصليين، كارتداء ملابسهم، أو تدليك أجسامهم، أو اختلاط المسلمات بمجتمع الكنائس،
غير أن ثمة نقطة هامة يجب التوقف عندها، وهي حرص مؤسسة الحكم في الممالك الإسلامية على الحفاظ على النساء المسيحيات اللاتي كن يقمن بتقديم الخدمات في الكنائس، وكذلك الأطفال المسيحيين، من الاستغلال الجنسي من قبل القساوسة، الذين لم يكن كثير منهم يتورع عن أن يكون له امرأتان أو ثلاث. كما يؤكد الكاتب أن تبادل فكرة (النجاسة) بين الطوائف الثلاث (الإسلامية والمسيحية واليهودية) التي يسعى لإقحامها دونما سياق مبرر- كانت نتيجة تراكم تاريخي، وعوامل ترسخ لمشاعر الكراهية.
يشير المؤلف إلى أنه مع تنامي أعداد المسلمين في القرنين الأول والثاني، ليس فقط بسبب الهجرات العربية إلى الأرض المفتوحة، وإنما بسبب التحولات الكبيرة في صفوف المسيحيين إلى الإسلام، فقد كان الأمر يصل إلى حد اعتناق مدن باسرها للدين الجديد دفعة واحدة دون اضطهاد. فقد كانت حرية العبادة مكفولة للجميع، وإن بقي المسيحيون بطبيعة الحال مهمشين اقتصاديا واجتماعيا، ولم يكن ثمة فارقا هائلا في نظر البعض يمنع دخولهم للدين الجديد. غير أن فئة قليلة غيورة على دينها حاولت إقامة الحواجز بين مكونات المجتمع من خلال افتعال أحداث يجري تضخيمها لتصبح رمزا للعداوة بين الديانتين والثقافتين المتولدتين عنهما، ويصف الآخر بالشيطانية. ومع مرور الوقت تحولت تلك الأكاذيب إلى أساطير رسخت في اللاوعي لتبرر الكراهية تجاه الآخر المسلم، الذي ربط بينه وبين المسيخ الدجال، وهكذا يمكن تفسير عشرات من قصص ما أُطلق عليهم شهداء قرطبة والأبطال المسيحيين في الأندلس.

تعمد الإساءة للإسلام
في نظر الكاتب- كان الاستشهاد لبنة في حائط، يبني أسطورة سوداء عن إسلام يقتل الشهداء، إذ كان البعض يجلب لنفسه القتل ليصير شهيدا ويتحول لأسطورة. فعلى مدار تسع سنوات رصد الكاتب وفود 48 شخصا إلى قرطبة، حيث جلبوا لأنفسهم القتل بتعمدهم إهانة النبي محمد علنا. وعلى الرغم من أن الهرطقة كانت تجلب القتل في البلدان المسيحية أيضا، إلا أن وقائع قتل هؤلاء وحدها جرى تضخيمها لتصبح أساطير للاستشهاد.
وقد أورد الكاتب العديد من القصص التي تعمد أصحابها السعي للقتل، ومن هؤلاء الراهب اسحق الذي كان عالما باللغة، وعمل سكرتيرا بأحد دواوين الحكومة، وقد تقدّم إلى القاضي في قرطبة بطلب لينطق أمامه الشهادتين، حتى إذا ما حضر أمامه في ساحة أمام العامة قام بسب نبي الإسلام، ودعا القاضي إلى ترك عقائد المسلمين المهلكة. وحين اشتد غيظ القاضي وقام بلطمه، منعه معاونوه من الاستمرار في إهانته وذكّروه بما له من حقوق.. غير أن هؤلاء سينجحون في النهاية في إقامة جدار الكراهية الذي ستظهر آثاره على مدار قرون من الحروب لن تتوقف عند مجرد استرداد الأندلس من الحكم الإسلامي، وإنما توجيه سهام الكراهية تجاه المشرق الإسلامي عبر قرون متوالية.

(يتبع)