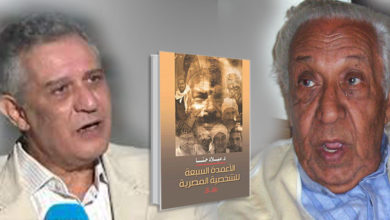«قد يمعن البعض في الشطط حتى ليتساءلوا عما إذا لم يكن في شعر المتنبي بذور وجودية كامنة. الشيء المؤكد هو أن ذلك الشعر يدعو بشدة إلى مثل هذه المغالاة. أليس هو أول من جرؤ في أدبنا على أن يقارن الإنسان بالله تعالى عندما هتف في هوس صباه: أي محل أرتقي/ أي عظيم أتقي/ وكل ما قد خلق الله/ وما لم يخلق/ محتقر في همتي/ كشعرة في مفرقي». قد يقال: «ولكن ذلك عين الجنون. وهو صحيح ما في ذلك شك. ولكن هل يمكن لأحد أن يدعي أن فلسفة نيتشه أو فلسفة الوجوديين خلو تمام من خطرات الجنون؟».
هكذا يختتم طه حسين مقالا له باللغة الفرنسية نشرته مجلة valeurs في عددها للعام 1946/ 1947 تحت عنوان «مسيرة الشاعر الكبرى». الشاعر المقصود في العنوان هو أبو الطيب المتنبي، والمقال وضعه المترجم المصري عبدالرشيد الصادق محمودي ضمن كتاب «مِن الشاطئ الآخر: كتابات طه حسين الفرنسية». يتضمن هذا الكتاب ما تيسَّر لمحمودي جمعه منذ ثمانينيات القرن الماضي مِن كتابات طه حسين بالفرنسية وترجمتها إلى اللغة العربية والتعليق عليها، صدرت الطبعة الأولى منه في بيروت في العام 1989، وقبل أيام صدرت طبعة مزيدة منه في القاهرة عن المركز القومي المصري للترجمة.
في المقدمة يذهب محمودي إلى أن طه حسين إذ يكتب بالفرنسية فإنه يفكر من جديد فيطور مواقفه المعروفة أو يطرق موضوعات جديدة. ففي مقالة «مسيرة الشاعر الكبرى»، مثلا، لا يكتفي طه حسين، كما يقول محمودي، برواية حياة المتنبي كما عرضها في كتابه «مع المتنبي»، بل يتوقف في ختامها ليلقي نظرة إجمالية يحدد بها أهمية المتنبي في تاريخ الأدب العربي والوعي القومي ويبرز القيم الباقية في شعره. يفصل بين المقالة والكتاب نحو عشر سنوات، ولكن طه حسين في الحالتين كان قاسياً في نظر البعض لجهة إبرازه مثالب شاعر العرب الأكبر.
المقالة نشرت في العددين السابع والثامن، أكتوبر 1946، ويناير 1947 في مجلة valeurs وقد صدرت تلك المجلة في الإسكندرية بداية من سنة 1945 وأصدرت ثمانية أعداد قبل أن تتوقف. وكان يرأس تحريرها رينيه إتيامبل، الذي – كما كتب المترجم – دعاه طه حسين في عام 1943 ليتولى إدارة أول قسم للغتين الفرنسية واللاتينية في جامعة فاروق الأول (الإسكندرية حالياً). وكانت المجلة على اتصال وثيق بمجلة «الكاتب المصري» وكان يساهم فيها عدد من الكتاب البارزين في فرنسا ومصر. ومن بين المصريين الذين كتبوا فيها بالإضافة إلى طه حسين، توفيق الحكيم وحسين فوزي ونجيب بلدي. وأضاف محمودي على ما ورد في الطبعة الأولى من الكتاب ثماني رسائل من طه حسين إلى إتيامبل، حصل المترجم على صور منها خلال لقاء جمعه بالأخير في مقر اليونسكو في باريس، بعد وساطة قام بها مؤنس طه حسين. ويقول محمودي إن تلك الرسائل لا تتضمن مناقشات فكرية أو أدبية، وليس لها إذن إلا أهمية تاريخية، فهي تلقي بعض الأضواء على ما كان هناك من علاقات بين أسرتي طه حسين وإتيامبل، ومن تعاون بين الرجلين في مجالي الكتابة والنشر.
يبدأ الكتاب بما اعتبره المترجم تمهيداً وضع له العنوان التالي: «أنا لا أكتب وإنما أُملي»، وتحته ردود طه حسين على استبيان من ثلاثة أسئلة وجهته إليه مجلة un effort في عددها السابع والأربعين الصادر بتاريخ أكتوبر 1934. أسئلة الاستبيان هي: كيف تكتب؟ لماذا تكتب؟ لمن تكتب؟. وهذه المجلة التي كانت تصدر في مصر بالفرنسية عن جماعة من الكتاب على علاقة بالسرياليين المصريين.
نهضة الشعر
وكان طه حسين قد مهَّد على ما يبدو لمقالته عن المتنبي بمقالة بالفرنسية أيضا تحت عنوان «نهضة الشعر في العراق في القرن الثاني للهجرة»؛ نُشرت في مجلة المجمع العلمي المصري دورة 1941/ 1942 ومما جاء فيها: «مكة والمدينة كانتا أحفل بلاد العالم الإسلامي بأسباب المتعة… صحيح أن المدينتين عنيتا بعلوم الدين، ولكنهما تحلتا في ذلك بسعة أفق وتسامح مستحب… وفيهما أزهرَ شعرُ الغزل وتألق… كانتا مهد الموسيقى والغناء حتى قبل ظهور الإسلام. وما إن حلَّ منتصف القرن الثاني الهجري وجاءت الدولة العباسية في أعقاب دولة بني أمية، حتى أصبحت البصرة والكوفة مثل مكة والمدينة، موطنين للمتعة والبهجة، وأصبح الغناء، بل والرقص فيهما في عِداد الأمور الطبيعية».
في هذه المقالة التي تضمنها كتاب «الشاطئ الآخر»، ينفي طه حسين أن يكون مرد ذلك إلى التأثير الفارسي. ويشير إلى حقبة أهملها مؤرخو الأدب العربي، لجهة أنه قد «أُريد للدولة الأموية، بما إنها عربية خالصة أن تكون من جميع النواحي نموذجاً للتقشف والمحافظة كما ينفرد بهما بدو الصحراء. ولم يكن ذلك من الواقع في شيء. فكل الشواهد تدل على أن بني أمية – وإن تباهوا بالمحافظة والفضيلة الصارمة خلال فترة تقع في القرن الأول ولا تتعداه – يمكن أن يُعترف لهم أيضا بقدر لا بأس به من الرياء. فما إن انقضى القرن الأول حتى تغيرت الأوضاع وبسرعة. وكان ذلك التحول من عمل بعض الأمراء من شباب بني أمية. فقد ضاقوا بالحياة العابسة التي كانت تسود دمشق وأخذوا شيئا فشيئا يختلفون إلى المدينة، وكثرت رحلاتهم إليها وإقامتهم فيها بازدياد ما وجدوا هنالك من ألوان اللذة واللهو. وتلك كانت المرحلة الأولى، فعن الحجاز صدر الانقلاب الذي أحدث الثورة في الشام بادئ ذي بدء. أما المرحلة الثانية فهي انتقال هذه التيارات الفكرية والفنية من الشام إلى العراق. كان العراقيون الذين يسكنون دمشق أو يقيمون فيها لفترات طويلة ومتواترة هم صناع الثورة الثانية. ويلاحظ أن الأجانب كانوا هم أصحاب الدور الرئيسي في هذه التحولات سواء في الحجاز أو الشام أو في العراق بعد ذلك بقليل. فبينما كان شعراء المدينة عربا، كان جميع الموسيقيين والمغنين والمغنيات والراقصين والراقصات إما من الفرس وإما من الروم. وهكذا كانت النهضة الأدبية والشعرية التي شهدها العراق في القرن الثاني الهجري ترجع أساسا إلى الدور الذي لعبه الغرب العربي ولا ترجع بالدرجة نفسها إلى المؤثرات التي تعزى إلى الشرق الفارسي. المثل الأهم على تلك النهضة هو بشار بن برد الذي كان يحاكي جرير في شيخوخته، ولم تتجل عبقريته الشعرية إلا بعد أن وقعت تلك الثورة».
المسيرة الكبرى
وجاء في خلاصة مقالة طه حسين عن المتنبي: «كان العالم العربي في فترة ما بين الحربين، ومازال إلى اليوم (1947) يشبه على نحو يدعو إلى الدهشة ما كان عليه في عصر المتنبي. عالم لم ينس ماضيه ولم يتهيأ لنسيانه. وهو لا يستطيع أن يتعزى بفقدان ما كان له من أهمية في الماضي وعن خضوعه اليوم للسيطرة الأجنبية. وكان الأجنبي في عصر المتنبي فارسياً أو تركياً أو زنجياً، وهو اليوم يأتي من الغرب. ولكن الشعوب العربية ترى سخطها وآمالها في هذا الشعر الذي يتميز بالكبرياء الجامحة. بيد أن القيمة النهائية لشعر المتنبي لا ترجع إلى ذلك الاعتبار. فهذا الشعر، وإن كان مصنوعا متكلفا من حيث الشكل، يتمتع بخاصية تعد ركيزة أساسية لا بالقياس إلى الشعر العربي وحده ولكن بالقياس إلى الشعر العالمي عموما. وذلك أن المتنبي أدخل في أدبنا التشاؤم الفلسفي. فقد صدر عنه مباشرة الشاعر العظيم أبو العلاء، كما صدر عنه بطريق غير مباشر عمر الخيام. ويضاف إليهما بداية من القرن الرابع كل من أراد من كتاب المشرق والأندلس أن يقدم تفسيراً متشائماً للحياة الإنسانية. ويمكننا بناء على ذلك أن نلتمس العذر لبعض النقاد المعاصرين إذا اشتطوا فرأوا في المتنبي سلفاً لنيتشه (في إشارة إلى العقاد بحسب المترجم). وذلك أن الفرد في أدب المتنبي يتجاوز نفسه على نحو يغري قارئه بأن يستحضر فكرة السوبر مان».
ولد المتنبي وفقاً لطه حسين بعد ثورتين وقعتا في أواخر القرن الثالث الهجري، هما ثورة الزنج وثورة القرامطة، «ثورتان مختلفتان في ظاهر الأمر، غير أنهما تشتركان في خاصيتين. فقد انبثقت كلتاهما عن حركة اجتماعية عميقة، واتسمتا بالعنف الشديد» صـ91. ولد المتنبي في الكوفة عام 303 هـ وانتقل منها في سن 17 عاماً إلى بغداد ومنها توجه إلى الشام حيث قضى كل شبابه. كان شديد الذكاء وكانت له فضلاً عن ذلك ذاكرة خارقة، فكان يكفيه أن يقرأ كتاباً في اللغة مرة واحدة كي ينطبع في ذاكرته. وسرعان ما علَّم نفسه مذاهب الباطنية الشائعة في عصره. وكان كرهُه للسلطة القائمة وإيمانه بالفرع المضطهد من آل البيت واعتقاده أن الله يحل في بعض الأفراد الممتازين، واقتناعه العميق بضرورة الاطاحة بالنظام الاجتماعي، عوامل تكاتفت «لتجعل منه قرمطيا من أنشط القرامطة»؛ «فما من شاعر قبله تفوَّق في تمجيد المجازر والتعطش للدماء بضراوة تكاد تخرج عن نطاق البشرية». بعد تجربة السجن، التالية لتحريضه على الثورة، أتيح للمتنبي أن يتفكر مليا في أمره، بدا له من المؤكد أنه لن يحقق شيئا إذا هو تمسك بمعتقداته الثورية. فليعدل عن القرمطية إذن، أو فليظهر ذلك على الأقل. كان في الثلاثين من عمره عندما أتيح له أن يمدح أمير حلب سيف الدولة الحمداني ليصبح بعدها شاعره الرسمي، بل وصاحبه وصفيه، فلم يكن يفترق عنه في وقت السلم أو في وقت الحرب. لكن ذلك لم يدم لأكثر من عشر سنوات، إذ فجأة غادر المتنبي حلب إلى دمشق، وأخذ يسعى لكي يدعى إلى بلاط مصر. هو أبدى في ذلك كثيرا من الحيطة والحذر، فالذهاب إلى مصر لم يكن يعني فحسب خيانة أميره وصديقه سيف الدولة، وإنما كان يعني أيضا بداية الطريق نحو خيانة أشد نكرا.
في مصر وجد المتنبي نفسه سجين عاصمتها في ذلك الوقت؛ الفسطاط، بما أن رجلها القوي؛ كافور الإخشيدي كان يرتاب في أمره وكلف من يراقبه عن كثب، وبالتالي لم يجد أمامه سوى الخروج منها سراً قاصداً الكوفة. كان المتنبي قد بلغ السابعة والأربعين من عمره وقد أضحى من الأثرياء بفضل عطايا سيف الدولة ومن بعده الأخشيدي. وما أن استقر في الكوفة، حتى أخذ يوجه إلى كافور من الأهاجي أقذعها، وتجاوزه إلى مصر والمصريين. لم يحدث قط أن أصاب هذا البلد تحقير من شاعر أو كاتب مثل ما أصابه من قلم المتنبي. وراح كذلك يدافع عن الكوفة ضد القرامطة، وهكذا تنكر تماما لكل معتقدات صباه ورجولته، ولم يعد إلا شاعرا يضنيه همان مقيمان، هما المجد الأدبي والمال. ولما لم يتمكن من حصدهما في بغداد، لأسباب تتعلق بتقلباته التي جعلته محل ارتياب الجميع، ذهب إلى بلاد فارس سعيا إلى مزيد من الثروة. وهناك كما يقول طه حسين تألق شعر المتنبي لآخر مرة على نحو باهر.
نظم قصيدته الأخيرة وفيها استأذن الملك الديلمي عضد الدولة في أن يذهب إلى العراق ليأتي بأهله. كان ذلك في سنة 345 للهجرة. وفي الطريق هاجمته جماعة من البدو كان قد هجاهم من قبل، فقتلوا ابنه وعبيده ونهبوا متاعه. فهل كان هؤلاء يطلبون متاعه؟ كلا على وجه التأكيد وإنما قتلوه بغية الانتقام. وكان ذلك انتقاماً شخصياً لأن المتنبي قد هجا هؤلاء القرامطة الذين أغاروا على الكوفة. كما كان انتقاماً حزبياً، ذلك أن الشاعر خان قضية القرامطة وقضية العرب وصار مدافعاً عن طغيات الأغنياء والأجانب.
نقلا عن: إندبندنت عربية