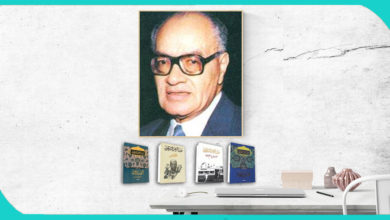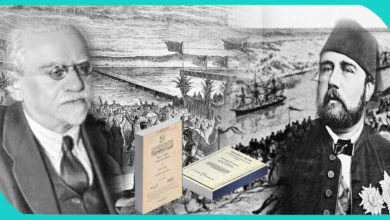في الذكرى 101 لميلاد الرئيس الراحل أنور السادات (من مواليد 25 ديسمبر 1918) تذكرت السؤال الذي طرحه الروائي والأديب الكبير «أحمد هاشم الشريف» في مقال له نُشر في مجلة «صباح الخير» أواسط التسعينيات من القرن الماضي، تحت عنوان: «رسالة إلى محمد حسنين هيكل». كان السؤاال :«هل انتهي بموت أحمد بهاء الدين عصر المفكر شريك الحاكم في صنع القرار؟».
توجيه السؤال إلى الأستاذ «هيكل» كانت له دلالته بالطبع، فالرجل واحد من قلة من الكتاب والمفكرين صاحب تجربة خاصة ومميزة، اقترب خلالها من صناعة القرار على مدى نصف قرن، ولا يمكن مقارنة تجربته في هذا الخصوص بتجربة أحدٍ آخر، بمن فيهم الأستاذ «بهاء الدين». فقد كان ـ يرحمه الله ـ يشارك بالرأي مع «السادات» عندما يطلب منه، ويستدعى إليه، وهي ـ وإن حُسبت مشاركة ـ فقد كانت أغلب مشاركاته ـ حسب روايته ـ تهدف إلى «منع» قرارات أكثر منها مشاركة في «صنع» قرارات. الأستاذ «بهاء» لم يدعِ لنفسه هذا الدور، بل لعله حاول التأكيد أكثر من مرة، وفي أكثر من مناسبة، على عكس ذلك.

أنور السادات، أحمد بهاء الدين
المفكر والحاكم
وقد جاء إقحام اسم «بهاء الدين» ضمن سؤال عنوانه مشاركة المفكر مع الحاكم في صنع القرار ليثير لديَّ ملاحظة أراها جديرة بالتسجيل، فالملاحظ أن مسألة المشاركة في صنع القرار لا تطرح إلا مع أشخاص ذوي وزن خاص، وأن مجرد الاقتراب من السلطة، لا يدعو وحده إلى الحديث عن مشاركة، أو ادعاءٍ بتأثير في صناعة القرار، فوزن الشخص، وثقله الخاص، يشكلان لاعبين رئيسيين في تأهيله للقيام بمثل هذا الدور.
ويمكن أن نضرب مثلاً بعلاقة الأستاذ «موسى صبري» مع الرئيس « السادات»، وهي العلاقة التي قرّبته من الرئيس إلى درجة الالتصاق، وكان لهما تاريخ مشترك في بدايات كل منهما، الأمر الذي أتاح لصبري أن يحظى بعلاقة خاصة ومميزة وتأثير كبير مع السادات حين صار رئيساً، لكن أحداً لم يتحدث عن «موسي صبري» بمثل ما جري الحديث فيه عن «هيكل» بهذا الخصوص.
مثال آخر، اقترب الكاتب «أنيس منصور» من الرئيس «السادات» في آخر أيامه، كما اقترب ـ كذلك ـ من الرئيس الأسبق «حسني مبارك»، ومع ذلك لم يذكره أحد في الموقع ولا في المكانة التي يُذكر فيها «هيكل»، أو يُوضع فيها «أحمد بهاء الدين». والحقيقة أن المقارنة بين الدورين، غير واردة، وتكاد تكون ظالمة للطرفين، أو بالأحرى هي ظالمة لكل أطراف العلاقة، فلا «هيكل»، ولا «بهاء» من صنع السلطة، ولا هما ممن يرضون لأنفسهم بأن يكونوا تابعين، أو مجرد أبواق دعاية لها، كما كان الحال مع «موسى» و«أنيس».
«السادات» نفسه لم يكن ينظر إلى «موسى صبري» أو إلى «أنيس منصور» نفس نظرته إلى «هيكل» أو «بهاء»، وقد كان حريصاً حتى النهاية على إبقاء «هيكل» إلى جانبه بشروطه، حتى بعد ما انقطعت بينهم السبل، وافترقت الطرق، وتبدلت الرؤى، واختلفت الأدوار، ورغم وجود «موسى» و«أنيس» إلى جانبه، إلى النهاية، لكنه كان يتوق إلى أشياء أخرى في «هيكل» غير الدعاية الفجة. كان «السادات» يتوق إلى خبرة «هيكل» في التعبير عن السلطة، وكان يتطلع إلى خبرته التي تراكمت من طول اقترابه من السلطة. وكان يسعى ـ فضلاً عن ذلك ـ إلى مصداقيته التي صنعها طوال تاريخه، وهي لا تتوفر عند الآخرين الذين ينظر إليهم كأبواق لا أكثر ولا أقل. وعندما انقطع حبل الوصل بينه وبين «هيكل» نهائيا وبدون رجعة حاول أن يجعل من «أحمد بهاء الدين» امتداداً للدور نفسه، خاصة وأنه صاحب مصداقية خاصة، واحتراماً مشهوداً لدى قرائه، وكان «بهاء» يمثل إلى جانبه ثقلاً لا يراه متوفراً في الآخرين، فكان «السادات» يستدعيه من الكويت حين تلم به الملمات، ليستطلع رأيه، ويستمع إلى مشورته، فيما كان الآخرون قابعين قانعين بأدوارهم تحت أقدامه.

أنور السادات، وأنيس منصور
عبد الناصر المثقف
لا يمكن أن تكون علاقة الحاكم بالثقافة معزولة عن علاقته بالمثقفين، وهي بالضرورة تؤثر سلباً في مسار تلك العلاقة، ونظرة سريعة على تجربة واحد مثل الأستاذ هيكل تفصح عن ذلك الاختلاف في علاقته مع كل من عبد الناصر و«السادات» من بعده، ذلك لأن علاقة كل من الرئيسين بالثقافة كانت مختلفة.
فعبد الناصر الذي اشتهر عنه أنه كان قارئاً محترفاً، كان مثقفاً يقدر الثقافة والفكر، وكان اهتمامه بالكتاب عظيماً، وكان اهتمامه بالقراءة معروفاً، وكل الذين اقتربوا منه بلا استثناء واحد، بمن فيهم «السادات»، يؤكدون ولع عبد الناصر بأن يقرأ. وعندما أراد جورج فوشيه أن يكتب عن عبد الناصر كتابه الشهير ذهب إلى مكتبة الكلية الحربية واطلع على كشف استعارات الطالب جمال عبد الناصر، ومن خلال معرفة هذه الكتب تكتشف أنه قرأ في فترة مبكرة سيرة حياة الزعيم مصطفى كامل، ومقدمة «حماة الإسلام» التي كتبها زعيم الحزب الوطني، كما قرأ في تلك الفترة للكواكبي وكتاب أحمد أمين «زعماء الإصلاح في العصر الحديث»، وفي المرحلة الثانوية قرأ فولتير وحياته، وكتب عنه مقالاً بعنوان «فولتير رجل الحرية»، وقرأ جان جاك روسو والترجمة العربية لرواية «البؤساء» لفكتور هوجو من تعريب وتلخيص حافظ إبراهيم، وقصة مدينتين لـ «تشارلز ديكنز»، وقرأ أحمد شوقي، إضافة إلى «عودة الروح» لتوفيق الحكيم.
وفي الكلية الحربية قرأ عبد الناصر أربعة كتب عن نابليون بونابرت، كذلك قرأ عن أتاتورك وبسمارك وفوش وغاريبالدي بطل التوحيد الإيطالي وهندبرج ولورنس ومالبورج وتشرشل وجوردون. وقرأ كذلك تاريخ الثورة المصرية لعبد الرحمن الرافعي بأجزائه الثلاثة، وكان نابليون موضع اهتمام عبد الناصر الأساسي مع تاريخ ألمانيا منافسة القوة البريطانية المحتلة لمصر وقتها، فنجد ثلاثة كتب عن ألمانيا النازية على لائحة قراءاته في تلك الفترة ،وكان على نفس اللائحة ايضاً ثلاثة كتب لونستون تشرشل، وبعد سنة 1943 قرأ عبد الناصر ثلاثة كتب عن اليابان وكتابين عن ألمانيا النازية، وأعاد قراءة توفيق الحكيم وكتاب «وبنيه» عن الشرق الأوسط ،وكتاب أرنولد ولسون حول السويس وبنما وآخر عن حرب البوير.
(الكتب التي كان يقرأها عبد الناصر في المرحلة الثانوية).
مراجعة مدققة لهذه العناوين وغيرها تدلنا بوضوح على أن اهتمامات عبد الناصر تنوعت على ثلاثة محاور رئيسية: أولها تاريخ مصر الحديث، وثانيها تاريخ المعارك الحربية والأفكار والشخصيات صاحبة الأدوار المهمة في التاريخ، وآخر هذه المحاور يتعلق بالثقافة الأدبية، لنجد أنفسنا أمام رجل كان مهتماً بدراسة التاريخ وفي الوقت نفسه اهتم بعدد كبير من الشخصيات التي صنعت التاريخ، ولهذا كان إنسانياً في رؤيته للتاريخ.

اقرأ أيضا:
لم يتوقف عبد الناصرعن القراءة حين أصبح رئيساً، بالعكس زادت قراءاته، وتنوعت، ولا زلت أذكر السفير محمد وفاء حجازي، وكان قد عمل إلى جوار عبد الناصر إبان عمله وزيراً للداخلية في أوائل أيام الثورة، وهو يروي لي عن اهتمام عبد الناصر بالقراءة وسط كل هذه المسئوليات، وذكر مثلاُ بكتاب «في الدولة» من تأليف هارولد لاسكي وترجمه كامل زهيري، والذي قرر عبد الناصر بعد أن فرغ من قراءته أن يجري توزيعه على العديد من قيادات الثورة ليقرأوه. وحين قرأ عبد الناصر «بدلاً من الخوف» للكاتب الفرنسي الشهير «بيفان» عمل على أن يكون بيفان أحد كتاب جريدة «الجمهورية».
كل هذا يدل على اهتمام خاص بالثقافة، فقد كان عبد الناصر مثقفا قبل ان يكون رئيس دولة. يقول هيكل: «إن بعض الكتب كانت تلفت نظر جمال عبد الناصر بطريقة تشعر معها أنها تركت أثرا في نفسه، أتذكر مرة كتابًا عن تروتسكي من ثلاثة أجزاء، كتبه «ايزاك دويتشير» أستاذ التاريخ السوفييتي في جامعة هارفارد وقتها. وقد أعطاه لي الرئيس ـ الجزء الأول كان عنوانه: النبي الأعزل، والثاني عنوانه: النبي مسلحا والثالث عنوانه النبي منبوذا أو النبي في المنفي. والرئيس أعطاني الأجزاء الثلاثة. وقال لي اقرأه. ووجدت علامات على الجزء الأول».

السادات والقراءة
لم يترك عبد الناصر وراءه مؤلفا واحدا رغم أنه كان قارئا محترفا، على حد تعبير كامل زهيري، في المقابل ترك السادات وراءه مؤلفات عديدة، لم يكتب بنفسه واحداً منها، وهو الذي اشتهر بأنه كان يمل القراءة، ويرى أنها هي التي قتلت عبد الناصر مبكراً في سن الثانية والخمسين من عمره.
ذكر لي سامي شرف وزير شئون رئاسة الجمهورية، والذي عمل مع السادات تسعة أشهر أن السادات لم يكن يكره القراءة فقط، ولكن – بالإضافة إلى ذلك – كان يحب أن يعرض عليه التقرير في صورة حكاية أو قصة. يضحك سامي شرف ثم يتابع: «السادات كان عنده قناعة إن عبد الناصر مات من كثرة القراءة»؟
وعلى عكس عبد الناصر ،الذي كان قارئا حتى النخاع ،بل لم يكن ينام إلا عندما يقرأ، كان «السادات» يحب الملخصات بمنطق «البعد عن وجع الدماغ»، وشهادة كاتب ومثقف كبير مثل أحمد بهاء الدين تؤكد: «لا أكاد أذكر أنني رأيته يوماً جالساً في مكتبه، ولا أكاد أذكر أنني رأيته يوماً وأمامه في الحديقة أو في الصالون أي أوراق أو ملفات، كان يدير الدولة كلها بالتليفون فقط».
فوزي عبد الحافظ سكرتير السادات أكد هذا المعني لأحمد بهاء الدين: «أنت عارف الرئيس من زمان ما لوش خلق ع القراية، ودلوقت بقت مشاغله كثيرة جداً، أنا باحطله التقرير على الكمودينو جنب السرير كل يوم، لكن يفضلوا يزيدوا لحد ما يبقوا عشرين تقرير، وبعدها يقول لي :شيلهم بقي لازم الحاجات اللي فيهم بقت قديمة».

محمد حسنين هيكل، وسامي شرف
رغم عزوف السادات عن القراءة إلا أن واحداً من مفاتيح شخصيته أنه كان يحب أن يكتب، أو يقال عنه أنه يكتب. وقد استغل موسي صبري هذا المفتاح، فكان يحاول أن يضع ألفاظا يحبها السادات ويكثر من تداولها، حتى يظهر وكأن السادات هو كاتب الخطاب، كان موسى يتقمص شخصية «السادات»، ماذا لو كتب هو بنفسه هذا الخطاب، ويكتب على هذا الأساس، وكان «السادات» يقول له أنا فعلا أحس بنفسي عندما أقرأ الخطاب عندما تكتبه بالروح التي اكتب أنا بها فأحس بنفسي طبيعياً.
موسى صبرى والسادات
يشير كامل زهيري إلى أن موسى صبري ظلم نفسه لأنه سجن قلمه في إعجاب عاطفي مبالغ فيه بالسادات ،وكان إذا كتب كذب، وإذا كذب بكي،وإذا بكي تهدج وهذه «ميلودرامية» على مقاس ومزاج «السادات»، ولهذا اقترب منه، وظل عربون الاقتراب أن يبقي دائما في موقع المدافع عن السادات، إن بالحق وان بالباطل.
يخصص موسي صبري ثلاث صفحات كاملة في كتابه «السادات الحقيقة والأسطورة» لاستعراض ثقافة السادات، فيخبرنا أنها «بدأت خلال سنوات الحرب الثلاث الأولي التي أمضاها في السجن مؤكداً أن تلك كانت سنوات لقاء مع النفس، وكانت سنوات قراءة في فلسفة الحياة وتجارب الإنسان وقد أثر في تكوينه مقال قرأه في مجلة «الريدرز دايجست» (المختار) وهي مجلة المختصرات، بطريقتها التبسيطية المعروفة، والمفروض أنها تسقي عامة القراء «الثقافة» بجرعات سهلة. كان العنوان: «كيف تظل بمنجاة من أيدي الأطباء المشتغلين بعلاج الأمراض النفسية»، ولم يكن، كما قال موسي صبري «مقال عن النفس».
ولا ندري ما الذي استوقف السادات وهو في زنزانته بالسجن في ذلك المقال، اللهم إلا إذا كان قد شعر بثقل الضغوط النفسية الواقعة عليه في تلك الفترة المتجهمة من حياته، و التي يقول موسي صبري إنها «كانت سنوات تعبد وابتهال إلى السماء أن ينقذه الله من حبل المشنقة».
ويخبرنا موسي صبري أن السادات «ظل يذكر هذا المقال طوال حياته. وعندما التقى الرئيس السادات مع أحد رؤساء الريدرز دايجست في عام 1974، وقد حضرت هذا اللقاء (التاريخي) في المعمورة، كان أول ما طلبه منه موافاته بهذا المقال وحدد له سنة نشره، وأرسلته إليه إدارة المجلة العالمية التي تنشر طبعات في 28 لغة، وكانت سعادة السادات لا تُوصف عندما تلقي المقال من إدارة الريدرز دايجست بعد أكثر من ثلاثين عاماً من قراءته له».

السادات، وموسى صبري
موقف السادات من المثقفين
كان السادات لا يطيق المثقفين، وكان دائماً ما يقول عليهم الأفندية بتوع القاهرة، ويطلق عليهم قذائف التشهير بهم، وكانت كلمة الأراذل، تتكرر على لسانه في وصف هؤلاء المثقفين الذين يعارضونه.وبعد يناير سنة 1977 أحاط السادات نفسه بنوعية مختلفة من المثقفين على طريقة «ندماء الملك» يقصون عليه القصص، ويحلقون به بعيداً عن الواقع ومشاكله، ويكتفون منه بالرضا السامي والنفحات الكريمة.
ونعيد طرح السؤال الذي سأله الروائي والأديب الكبير «أحمد هاشم الشريف»: «هل انتهي بموت أحمد بهاء الدين عصر المفكر شريك الحاكم في صنع القرار؟»، وإجابتنا بالتأكيد: نعم، ففي الخمسينيات و الستينيات من القرن الماضي كانت المهام المطروحة على المثقف العربي تحمل عناوين القومية، والاشتراكية، والعصرية، والعقلانية، والاستقلال، وهي عناوين تحتاج إلى أدوار يلعبها المثقفون، وتجعل هذا الدور محورياً. ولكن بعد حرب أكتوبر1973، ومع اكتساب «السادات» شرعية جديدة، راح يفتش لنفسه عن طريق جديدة، لها مهام جديدة، وعناوين مغايرة، وتبحث لنفسها عن منفذين جدد، وكان الكثير منهم قيد الجاهزية للدور المستجد.
وكان هذا بمثابة بدء تاريخ جديد، تراجع فيه دور المثقف مع تراجع المهام التي كانت قد استقرت نصف قرن على جدول أعمال الوطن،مع الاتجاه العكسي لهذه المهام.وعند هذه النقطة على خريطة التراجع كانت الأجواء مهيأة أكثر لأن يسدل الستار على دور واحد مثل الأستاذ «هيكل»،وكان محتماً عليه ـ وسط الأجواء الجديدة ـ أن يتراجع دوره، ويراجع موقعه وموقفه، كان هو الذي حاول أن يطوع المثقفين لمصلحة دولة عبد الناصر ومشروعه الذي كان يكتنف هذه المهام، وجاء عليه الدور لكي يرفض أن يطوع نفسه وقدراته وخبراته واتصالاته لمصلحة «السادات» الذي أصبح هو الدولة، أو يذهب إلى حيث أراد «السادات»، إلى الظل مع نزول كلمة النهاية على دور المثقفين وبدء دور الأبواق.

وخرج المثقفون الذين اقتربوا من قمة السلطة من مواقع التأثير في صناعة القراروانطووا تحت جناح السلطة، واستقروا في حظيرة النظام على حد قول أحد وزراء الثقافة في نظام الرئيس ألأسبق حسني مبارك. ليسدل الستارعلى عهد كان فيه المفكرون والمثقفون من صناع القرار.