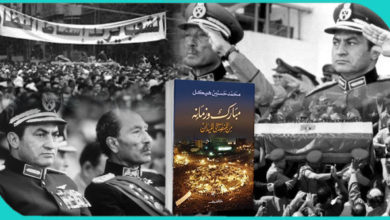تظل صورة القرية القديمة بأشيائها وملامحها وعلاقات ناسها ساكنة فى أعماقنا جميعا نحن أبناء الريف، مهما تباعدت هذه الصورة ومهما تعرضت لتحولات وتطورات الزمن.. والقرية موضوع رئيسى فى الرواية المصرية منذ رواية «زينب» لمحمد حسنين هيكل وقرية محمد عبد الحليم عبد الله مرورا برواية «الأرض» لعبد الرحمن الشرقاوى وأعمال خيرى شلبى ويوسف أبو رية ويحيى الطاهر عبد الله الذى صور القرية الجنوبية على أروع ما يكون فى «الطوق والأسورة».

جماليات الكتابة البينية
يدور كتاب «عجائز القرية» للكاتب الدكتور «عمار علي حسن»، والصادر مؤخرا عن الدار المصرية اللبنانية، فى فلك القرية – قريته تحديدا –، تلك «القرية الصغيرة المنسية فى المنيا… وهى قرية «الإسماعيلية» التابعة لمركز المنيا». وهو كتاب يتماس مع الرواية والمتواليات القصصية التى تشترك فى وحدة المكان ووحدة الراوى والسيرة الذاتية حيث تعكس مشاهدات الصبى الذى يقوم بدور السارد وتصور مشاعره ورؤيته لمحيطه الريفي، والذى انحصر بدوره بين عالم البيت وعالم الحقل، الكتاب إذن ينفتح على هذه الأجناس ويستفيد من جمالياتها لكنه لاينتمى – بوضوح – لأى منها بل يمكن وصفه بالنص الأدبي المفتوح بعد أن تراجعت فكرة الأجناس الأدبية الصارمة وأصبح من المتاح استفادة الشعر من تقنيات السرد والمسرح والفن التشكيلي والسينما واستفادة القصة القصيرة من جماليات لغة الشعر ومجازيتها وتكثيفها أما الرواية فهى تعرف بأنها الجنس الأدبي الذى لا «شكل» له أى أنها لاتتبع شكلا واحدا محددا سلفا.
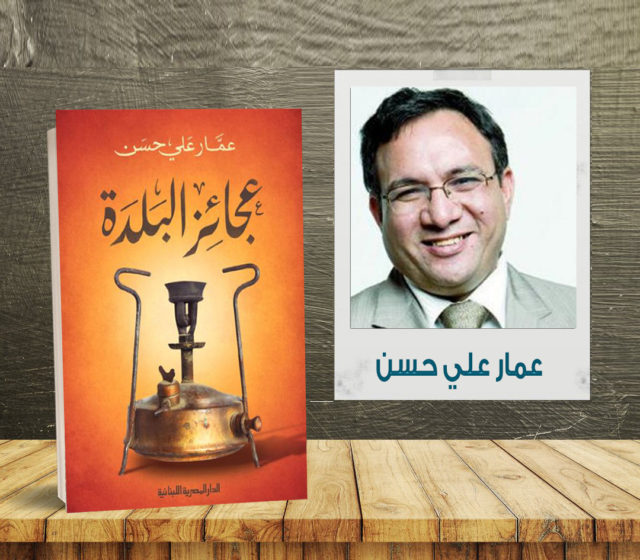
كتاب عمار علي حسن يقع على الأعراف بين هذه الأجناس الأدبية وهو فى هذا يستجيب لطبيعة العصر الذى شاعت فيه العلوم البينية وانزياح الحدود بين المدارس النقدية تحت ما يسمى بعلم «النص»
نوستالجيا للماضى القريب
عمار علي حسن مسكون بهذه النوستالجيا الدائمة إلى قريته وصباه الباكر فيها، وقد ظهر ذلك فى سيرته الذاتية التى حكى فيها عن مساعدته لأبيه فى أعمال الفلاحة قبل انتقاله إلى القاهرة والعيش فيها. وهاهو يعاود الحنين إلى هذه الذكريات القديمة فى كتاب «عجائز البلدة» وهو عنوان يؤكد دور الجدة فى تشكيل وعي الأطفال والصبية من خلال حكاياتها التى لاتنفد.
لكن الخبرة التى يتحرك بها الراوي – هنا – تأتيه من مخالطة الواقع أكثر من الحكايات المقتضبة من قبل الأم والتى غالبا ما تكون ردا على استفساراته حول شىء من الأشياء المستعملة فى القرية وفى أعمال الزراعة، والراوي مشارك فى الحدث وليس منفصلا عنه أو ناظرا إليه من أعلى على عادة المثقفين بل هو ابن جماعته الاجتماعية الريفية البسيطة بمتطلباتها التى لاتزيد عن الكفاف والستر، والراوي فى هذا الكتاب يتمتع بالفضول تجاوبا مع مرحلته العمرية كثيرة التساؤل والاستفسار طلبا لمعرفة ما حوله.

أشياء البيت والحقل
الأشياء هى مدخل عمار علي حسن إلى قريته، لهذا كان من الطبيعي أن يقسم هذه الأشياء بين البيت بوصفه مكان الراحة والإقامة الدائمة، وبين الحقل بوصفه مكان العمل والإقامة المؤقتة فنجد من ناحية: الحصير والمصطبة والمنقد والكانون والطشت والفرن والزراوية والنملية والطبلية والبلاص والزير ولمبة الجاز بوصفها أشياء بيتية تلبى حاجات الإنسان ومن ناحية نجد أشياء تنتمى لعالم الحقل مثل: النورج والشادوف والخص والمحراث والساقية على سبيل المثال، وتقسيم الأشياء بين مكانين فحسب دليل على بساطة الحياة حيث لم نر أى مظهر من مظاهر الترفيه غير جلسات السمر والألعاب البسيطة.
إن الكاتب يثبت فى وعي القارىء هذه الفترة الآفلة من حياة الريف، لاستعادة بساطتها الفطرية المحببة كأنها فترات البراءة الأولى التى كان الإنسان فيها على علاقة مباشرة مع الطبيعة، فى حالة من التآلف الذى يجمع مابين الإنسان والحيوان والطيور والزروع. والراوي مغرم بهذه الحياة حيث يرصد خصائص البيت المصري وهو ما يذكرنا بقرية المعمارى المصرى الأصيل حسن فتحى ففى حديثه عن «المصطبة » يقول «إنها باردة فى القيظ ودافئة فى الصقيع» «ص33» إننا أمام مكان مكتفٍ بذاته لايحتاج إلى أجهزة تبريد أو تدفئة.. مكان يستفيد من وضعه الجغرافي وحركة الشمس وتغير فصول العام وهو يعكس الفروق العمرية حيث «يجلس العجائز فى المنتصف وعلى الأطراف الشباب» «ص33» بينما يظل الصغار يحومون حولها حتى ينصرف من عليها فيأخذون دورهم فى الجلوس ويستمر هذا «التكيف» مع الأشياء المستعملة، فالحصير – مثلا – نوعان الأول وهو اللين المصنوع من الديس يستخدم فى الصيف «حين تستلقى عليها الأجساد المكدودة فى الغرف المقتضبة التى تغالب العتمة والصمت» والثانى وهو الخشن المصنوع من الحلفا يستخدم فى «أيام الشتاء القارس حيث يمنح احتكاك الأجساد بها بعض دفء مبتغى» «ص14»

الإنسان أولا
لايجعل الكاتب من الأشياء غاية فى حد ذاتها فهى خادمة للإنسان أولا وآخرا حتى وإن بدت لعبة صبيانية على نحو مانرى فى حديثه عن «البكرة» وهى «العجلة» التى كان يصنعها الصبية من أغطية زجاجات المياه الغازية بعد ثقبها من المنتصف تماما و«لضمها» بواسطة «أستيك» بغرض اللعب بها بعد أن يصنعوا منها «عجلة» هذه العجلة يصفها الكاتب بقوله إنها «شىء بديع ومتساو ومسل إلى أقصى حد وله فضل على الأبدان» وهى أوصاف تحدد شكل هذا الشىء ثم تحدد فائدته للإنسان فهى تسلية ولعب من ناحية وهى رياضة من ناحية أخرى، وكما ذكرت فإن الكاتب لايفصل بين الإنسان والأشياء والحيوان ففى حديثه عن «الربانة» وهى عبارة عن منجل صغير نجد هذا التداخل حين يقول «تراقبه البهائم بلهفة وهو يمسك بيمناه قوس الأذى الذى لاغنى عنه – يقصد الربانة – تكاد ترقص وهى ترى أعواد البرسيم تترنح صريعة تحت قدميه فيلمها متلاحقة ثم يحملها على كتفه ويلقيها أمام الأفواه المفتوحة إلى آخرها» «ص20» وأكثر من ذلك فإن الكاتب يتوحد مع سرب اليمام حين يذبح صاحب الربانة إحداها حين يقول «لكننى هرولت بعيدا أرفرف كبقية سرب اليمام الذى وقف فوق أغصان شجرة السنط العالية يراقب احمرار واحدة منه فوق الجمرات الصافية ويبكى بصوت لم يسمعه هو – يقصد صاحب الربانة – لكننى أنا الذى رحت أنصت إليه» «ص21» إن التواصل الحسى و الوجدانى أصبح بديلا للغة البشرية وأصبح هناك ما يشبه وحدة الوجود بالمعنى الصوفى.

مجد آفل
فى نص «الحصير» يصبح جابر العراقى بطلا خيِّرا يردد دائما هذه العبارة المحبة للأخرين «تربينا على أن نريح خلق الله» لكن زحف الآلة جعل مصير هذا الحصرى بائسا حيث دخلت بيوت هؤلاء الريفيين «الحصر المصنوعة من البلاستيك المجدول بين أنياب المكن فى مصانع لانراها» وراح العراقى «يتطلع بعينين كليلتين إلى حصر البلاستيك المحمولة فوق الرءوس ويردهما حسيرتين إلى حصره الواقفة عند الجدار» «ص15» والأمر نفسه يحدث مع النورج الذى كان على عهد جد السارد وجدته وبموتهما جاءت الجرارات – على زمن والد السارد – بصوتها المخيف وزمجرتها الصاخبة ورغم ما وفرته هذه الجرارات من وقت وجهد ظل حنين الكثيرين دائما «إلى بقرتين تجران أريكة خشنة كنا نركبها فى سرور متطلعين إلى أرزاقنا النائمة تحتنا فى سلام» «ص19» وينتهى دور «الزير» مع دخول مواسير المياه إلى البيوت، والطنبور مع اختراع ماكينة الرى، لكن لاينبغى أن نستنتج من هذا أن الكاتب ضد التطور والآلات الحديثة وآية ذلك ما أبداه من فرح بماكينة الرى فى آخر نص «الطنبور» حين يقول «بعد أن كنا نجلس أمام الطنبور نروض الإرهاق والضجر أصبحنا نترك آذاننا لتطربها تكتكات ماكينة الرى المتواصلة» «ص31»

إن عمار على حسن لا يتخذ موقفا سلبيا من تطوير حياة الإنسان بداهة لكنه يعرب عن حزنه لفقدان العلاقات الإنسانية و لسيادة العزلة التى أصبح يعانيها الإنسان ويظهر ذلك فى نص «المنقد» الذى كان الجميع يلتفون حوله ويتسامرون لكن «مع توالى السنين راح عدد المناقد يتناقص بينما تزيد الدفايات والأغطية ويكسل الجيل الجديد عن جمع الحطب بدأب طيلة الفصول حتى يأتى الشتاء وينزوى فى غرفته متدثرا بالدفء المصطنع» «ص40» لقد انزوى كل فرد من أفراد الأسرة فى غرفته وابتعدوا عن «المنقد» الذى كانوا يلتفون حوله واكتفوا بالدفء المصطنع الذى تبعثه الدفايات. إننا أمام مرثية لزمن إنسانى أليف سعى الكاتب إلى تصويرها ببراعة لكى تظل محفورة فى ذاكرتنا نستمد منها قيم الحب والتواصل والتآلف التى غابت عن حياتنا المعاصرة.