مجلة «آخر ساعة»، عدد 676، الأربعاء 8 أكتوبر عام 1947
فى عام 1947 م هبت الرياح التى حملت وباء «الكوليرا» على مصر، فبثت الرعب فى أنحاء العالم بأثره وسط مخاوف من انتقاله إلى غيرها من الدول، وبقدر ما انعزلت مصر عن العالم، كانت عزلة قرية القرين بمحافظة الشرقية أشد قسوة بعد أن أعلنتها الحكومة المصرية كبؤرة أولى للمرض. ولكن الصحفي الشاب محمد حسنين هيكل كان قد قرر اختراق الحصار الصحي والأمني المفروض على القرية، ليخرج لنا بتحقيق صحفي هو أشبه بتقرير اجتماعي أنثروبولوجي يرصد المعدن الحقيقي للمصريين الذي يظهر أوقات الأزمات والمحن.
………………….
علي رؤوس النخيل وبين الأكواخ المظلمة المتداعية وعلي شواطئ الترع والغدران وفي الوديان وفوق رمال الصحراء يسعي ميكروب الكوليرا في قرية القرين ويجر في أنيابه الموت أينما ذهب.. إن معركة الموت والحياة علي أشدها في القرين.. ينشر الوباء دخانه القائم الخانق علي القرية الصغيرة لتنهض الحياة لتبدد بسماتها المشرقة هذا الدخان وتظل تقاومه وتقاومه.. وقد تختفي الابتسامة المشرقة أحيانا وتحل محلها الدموع ومع ذلك فان الحياة لا تستسلم أبدا ولا تزال تثبت في القرين أنها الأقوي.. جزء كبير من سكان القرين من غير أهلها .. معسكر التل الكبير يقع علي حدودها وقد نزح إليه عمال كثيرون من كل أنحاء القطر ليعملوا فيه واستقر جمهور كبير من هؤلاء في القرين وأصبحت هذه القرية التي كان تعدادها 15 الف نسمة تضم 25 ألف دون أن يزيد علي مبانيها بيت واحد.. وربما كان أهل القرين دون غيرهم من سكان قري مصر قد أخذوا بنظام البنسيونات.. فكل فلاح كان له بيت وكل بيت كان صاحبه يوفر من حجراته حجرة أو حجرتين يؤجرها لغريب من العمال الذين يعملون في القرين..
وحين تفشي وباء الكوليرا انتشر بادئ الأمر بين عمال الجيش الغرباء وكان الفلاحون من أصحاب البيوت يخافون التبليغ عن الإصابات خيفة أن يعزلوا هم الآخرون.. ويموت «الغريب» وليس هناك من يسأل عنه.. ويحمله أهل البيت إلي الجبل فيدفنونه ويعودون فإذا سئلوا عنه في الغد قالوا: لقد فر من القرين.. متي؟.. قبل الوباء..
وحدث أن فاحت من الجبل روائح خبيثة وذهب بعض المستطلعين وعادوا يقولون أن هناك جثثا.. ويظهر أن الذين قاموا بدفنها كانوا في عجلة من أمرهم فدفنوها علي بعد قريب من سطح الأرض.. وأعلن ُعمد القرية – وفي القرين أكثر من عمدة- أنهم يتبرعون لإقامة مقابر للغرباء وحدهم.. هؤلاء الذين لا أهل لهم ولا أحباب يبكون عليهم ويحزنون لأجلهم..
وفي اليوم التالي بدأت إجراءات الحفر والبناء.. وخرج عدد كبير من أصحاب القرين يساهمون في بناء المقابر للغرباء وكان بين العاملين رجل اسمه رفاعي فقد أباه وزوجته وابنا له صغيرا.. افترسهم جميعا ميكروب الكوليرا وبقي رفاعي علي قيد الحياة.. ولقد حفر بنفسه ثلاث مقابر لأبيه وزوجته وابنه.. ومع ذلك فإن هذا لم يمنعه من الاشتراك في حفر المقابر.. للغرباء..
ولقد ظهر نوع من الفتيات في القرين.. نوع الحزينات بلا سبب.. أو هكذا يري أهلهن.. ولقد كان وجودهن ضرورة لوجود الغرباء.. الغرباء من العمال الشبان رواد السينما وسكان المدن.. وحين هبطوا علي القرين لم يكن هناك مفر من حدوث قصص غرام بينهم وبين عذاري القرين الجميلات.. وبعض هذه القصص انتهي بالزواج بين عذاري القرية والغرباء.. وبعضها لم يتسع له الوقت.. وأقبل الوباء وماتت أغاني الغرام فوق الشفاه.
ويقبل أحد الآباء علي بيته في الليل وتقابله ابنته الشابة تسأله أين كان؟.. ولماذا تأخر وطرق القرية كلها مفاجآت؟.. ويجيب الأب المتعب: كنا نشترك في دفن «غريب».. وتسأله ابنته: من هو؟.. فيقول لها اسمه.. ثم ينسي أن يلاحظ ابنته وهي تهرب لتخفي الدموع فجأة من عينيها.. وكل يوم يموت غرباء.. وكل يوم تسيل دموع..
ومستشفي القرين الذي شهد احتدام الصراع ما يزال يشرق بابتسامات مرحة عالية.. إن هذا المستشفى ملئ بشخصيات تستحق الخلود.. هناك طبيب المستشفي الشاب يخرج من خيام المرض فيطلب من إحدي الممرضات أن تربط له يديه حتي لا يصافح أحدا.. ويقابلك وهو يضحك ويمد يديه المربوطتين ويقول: لا فائدة غير هذا.. قد أنسي وأسلم علي أحد.. والله وحده يعلم ماذا في يدي.. ثم ترتفع ضحكته مرة أخري ويقول: كوليرا.. ثم تلمح سربا من الفتيات الصغيرات المجاهدات.. إنهن الممرضات اللواتي يكافحن الوباء يدا بيد.. تخرج إحداهن من خيام المرض فتجد جنازة امرأة تخرج من المستشفي.. امرأة كانت تعني بها بالأمس وتذرف دمعة من عينيها.. ثم تسمع مريضا يستدعيها فتجفف دموعها وتضع علي وجهها ابتسامة ثم تعود إلى الخيمة. وكان الوباء علي أشده في منطقة «الجرن» وأبلغت بإصابة جديدة لسيدة في الخمسين من عمرها.. وطارت إلي بيتها سيارة المستشفي وسيارة التبخير وحملت السيدة علي النقالة وقفل موكب المستشفي في طريقه عائدا إليه .. تلاحقه صرخات من أقارب المريضة.. وتلاشت الصرخات.. وكان الموكب يجتاز آخر حدود «الجرن» ليدخل في الطريق العام الي المستشفي ووقف طفل صغير في السابعة أو الثامنة من عمره علي باب أحد المنازل وتابع بلا مبالاة موكب المريض يمر أمامه.. ثم استدار لينزل درجة السلم وهو يغني: حمودة ياني.. وابتسم الطبيب وابتسمت الممرضة.. ولم يستطع الطفل أن يدرك أي شجاعة كانت تجيش في صدره…
ولقد كان الهاربون جميعا من الغرباء.. إن العمال الذين وفدوا للعمل في الجيش لم يستطيعوا الصمود لمأساة القرين.. فهرب منهم من استطاع الي الهروب سبيلا وبقي منهم من لم يستطع الهروب لسبب أو لآخر وهؤلاء هم يمثلون جانب الخوف في القرين.. أما أهل القرين الأصليون فما أروع المثل الذي يضربونه للشجاعة والإيمان.. انك تقابل بعضهم فلا تكاد تحس انك تعيش في قرية الموت.. إنهم جميعا يعرفون الخطر المحدق بهم فقد قابلوه يفتك بأهلهم وأصدقائهم ومع ذلك فالإيمان العجيب بالقدر لا يفارقهم.. وبعض نواحي الحياة هي.. هي لم تتغير.. اللحم المعلق في الأسواق للتراب وللهواء.. والخضر معروضة لمن يشتري.. والبلح من كل الألوان والأنواع.. والحركة دائبة ولكنها خالية من الصخب المعتاد. وحين تمر أمامهم مواكب المرض أو مواكب الموت تلمح في عيونهم للحظة خاطفة نظرة خوف.. ثم يستعيد الإيمان مكانه وتنتصر الحياة.. ومصر كلها تلح في طلب اللقاح.. والقرين ميدان الخطر ومصدر الوباء لم يلقح إلا ثلثها ومع ذلك فلا تكاد تسمع شكوي..

وحين يظهر الوباء في أحد المنازل ينقل سكانه إلى المعزل ويقفل البيت وترسم علي بابه دائرة داخلها نقطة ومعني هذه النقطة أن المنزل موبوء.. وكثيرا ما استيقظ رب أسرة في القرين ليجد منزل جيرانه وقد رسمت عليه الدائرة في وسطها نقطة.. لقد حدث كل شئ أثناء الليل.. زحفت الكوليرا.. وحمل المصاب ونقل أهل البيت وترك الميكروب علامته المخيفة علي الدار.. وانتهي كل شيء.. والعجيب أن هذا لا يحدث ذعرا ولا يسبب رعبا.. كان بيومي عامل تبخير.. ونام ذات ليلة منذ أسبوع واستيقظ في الليل علي أعراض الكوليرا فنقل إلى المستشفى ونقلت عائلته إلى المعزل.. وجاء أخوه في الصباح يعرف ما حدث حين رأي الدائرة ذات النقطة المستديرة مرسومة علي الباب.. وذهب إلى المستشفى ليشيع جنازة أخيه.. وفي المساء كان قد أخذ مكانه في حمل عدة التبخير والطواف بها علي المنازل النوبية. وربما لم يكن الوباء أشد ما يقاسيه أهل القرين.. الفلاحون منهم انقطعوا عن حقولهم وقلعوا داخل القرية وهم يعلمون أن بعض العرب «البدو» يغيرون عليها ويسرقون ما فيها.. والعمال يعلمون أن بينهم وبين العمل في الجيش أسلاكا شائكة وألغاما تفجر الأرض تحت أقدامهم نارا ودما.. كل هذا والقرية محاصرة.. لا دخول ولا خروج.. وكل ما تقدمه الحكومة من معونة هو عشرة قروش لكل رب عائلة يتقدم إلى طلبها.. ثم هو لا يستطيع بعد ذلك أن يشتري بها شيئا.. ولقد كان بعض أهل القرين يكسبون في الزمن السعيد الماضي خمسين جنيها في الليلة أحيانا.
ولا تخلو القرين بعد ذلك من فلاسفة لا يشعرون بالكوليرا ولا بالوباء وتبتسم ابتسامة مرة وأنت تسمع أن أحد مدرسي الإلزامية قد حبس نفسه في بيته أياما ليفكر في مشكلة هامة هي اسم القرين ومن أين جاء؟.. ثم يخرج الرجل من عزلته ليعلن للملأ اكتشافه.. القرين.. لقد أطلق هذا الاسم علي القرية السلطان قايتباي.. وكان السلطان قد زارها ليصلي في مسجدها الذي أنشئ في عهده ولاحظ وهو يدخلها أن أمامها نخلتين متعانقتين بالخلاف كالمقص المفتوح وقال السلطان: أنهما مثل القرنين.. ومع الزمن تحول اسم القرنين علي الألسنة إلى القرين.. وتقابل الشيخ حيثما تقابله فيفاجئك: هل عرفت من أين جاء اسم القرين؟.. ومهما كان ردك نفيا أو إيجابا فإنه لن يتركك حتي يروي لك قصة اكتشافه لأصل اسم القرين.
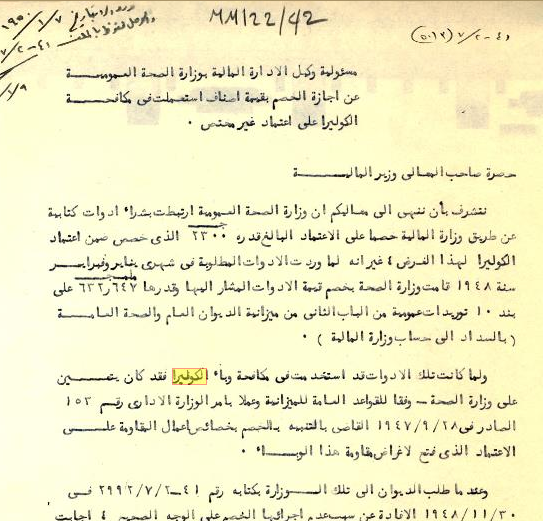
أنشأت الحكومة وحدة صحية و6 طلمبات للمياه، وأمرت بهدم العشش والمبانى القديمة، وفتحت باب التبرعات فجمعت 70 ألف جنيه لم يصرف منها مليما حتى اكتوبر1948.









