مع «محمود السعدني» تموت على نفسك من الضحك، وأحياناً تجعلك سخريته اللاذعة تموت في نفسك من الخوف، وهذا ما حدث معي، في المرة الأولى التي رأيت فيها السعدني وجهاً لوجه، كدتُ أموت من الخوف، كان ذلك في قاعة واسعة من قاعات مدرسة السعيدية الثانوية، وكنت طالباً بها، جاء السعدني يحاضرنا في ندوة مفتوحة، ربما باسم منظمة الشباب أو الاتحاد الاشتراكي، لم أعد أذكر، وسمعته وهو يسخر سخرية لاذعة من المشير عبد الحكيم عامر ومن الشارات والنياشين العسكرية التي كان يزين بها صدره وكتفيه، وشبهه بمخبول الحسين الشهير الذي كان يرتدي جاكيت كاكي فوق جلباب بلدي ويضع على صدره أغطية الكازوزة كأنها النياشين العسكرية، ولم يكن قد مضى على رحيل المشير عامر إلا القليل، خفتُ خوف الشاب اليافع الذي لم يتجاوز وقتها السادسة عشرة من عمره، وأحسست بأن الطرق قد تاهت بي وأوصلتني إلى إحدى قاعات المعارضة للنظام، وملأني سؤال كبير: لماذا كل هذه السخرية من واحد من رموز النظام القائم، ولم أعرف الإجابة إلا بعدها بسنين طويلة.
مكالمة مع السعدني
لم يطمئن قلبي في تلك الأمسية إلا بعدما تنقل السعدني من الكلام عما أسماه «الخيبة» التي جرت وقائعها في يونيو سنة 1967 إلى خيبات أخرى في حياتنا السياسية والاجتماعية والفنية والثقافية، وبدا لي كأنه يمسك كاميرا خفية تقف خلف ما يجرى أمامنا من صور، ليلتقط بها ما يخفي عن أعين الجميع، لنفاجئ بالفرجة على حقيقتنا كما هي، لا كما تصورها الكاميرا الرسمية المزروعة في ميكرفونات إعلامنا.
من يومها لم أترك للسعدني كلمة مكتوبة، إلا قرأتها بنفس الشغف الذي تلبسني مع أول لقاء لي مع كلماته المنطوقة، ولم يدر بخلدي طوال الوقت أن يوماً يمكن أن يجمعني مع السعدني، اسمع له، وحدي، أو مع آخرين.
بعدها بسنوات كدت أقع على ظهري من الضحك حين باغتني عمنا «السعدني» رحمه الله، بمكالمة هاتفية على الجريدة، وقبل أن يكمل سلامه عليَّ قال: «انت يا بني بتكتب ليه زي ما تكون بتكتب في آخر زادك؟»، ورغم السخرية البادية في سؤاله الاستنكاري إلا أنني قلتُ بيني وبين نفسي: جاء اليوم الذي يتصل بي فيه عمنا «الكبير»، ليهنأني على «عمود» كتبته في جريدة «العربي»، وبطريقته المعهودة والساخرة نصحني أن أركز على فكرة واحدة في «العمود»، واستمر كالمدفع الرشاش: «هو الجرنال ده مش ها يطلع تاني؟، هو انت لازم تقول كل حاجة في مقال واحد؟»، وبدأ يشرح لي النصيحة بطريقة أبوية ودودة ومحبة ولاذعة في الوقت نفسه: «انت بتكتب كويس، ودول يا بني قُليلين، ركز بقى، وبطل تكتب وانت بتنهج كده، على مهلك، الدنيا مش ها تروح، وإن راحت تبقى عملت اللي عليك، قلت اللي انت عايز تقوله، في الوقت المناسب، وياما ها تكتب، لسه السنة قدامنا طويلة على رأي الواد سعيد صالح».
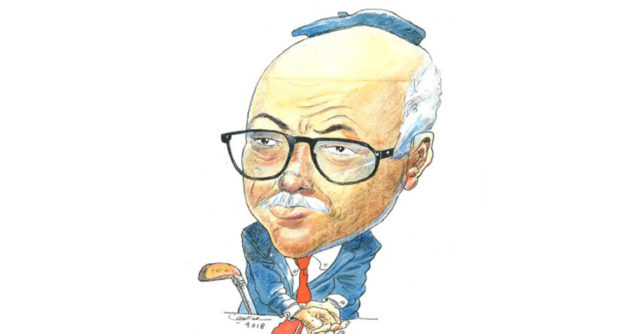
محمود السعدني بريشة الفنان «سعد الدين شحاتة»
ملك الأمسيات
أول تعرفي المباشر على أستاذنا محمود السعدني كان في منزل أستاذي المرحوم فريد عبد الكريم، الذي كنت أعمل معه في مكتبه إبان عملي بالمحاماة أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، وتوثقت معرفتي بالسعدني في منزل أستاذي الراحل الكبير محمد عودة الذي تتلمذت على يديه في الصحافة، وكان السعدني في كل الأحوال يكاد يكون هو المتكلم وحده، لا يشرك أحداً معه في الكلام إلا لماماً، وكان يوجه حديثه إلى هؤلاء العمالقة بنداء موحد: يا واد يا عودة، يا واد يا فريد، يا واد يا كامل.. يقصد أستاذنا كامل زهيري..الخ الخ.
هو ملك الأمسيات بلا منازع، في بيته، أو في بيوت الأصدقاء، في النادي النهري للصحفيين الذي يرجع إليه الفضل في إنشائه، وفي كل مكان يحل فيه، خلقه الله كما خلق الناس جميعاً، ولكن زاده بسطة في الكلام، فكان أبو الكلام بدون منازع، يدخل علينا في بيت أستاذنا الراحل محمد عودة، وعيناه تلمع وهي ترصد الموجودين، وتحدد المنافسين المتوقعين، وكلهم أصحاب باعٍ في الكلام لا يُبارى، ويبادر الجميع فور وصوله وعلى حين غرة: أخدت بالك معايا؟، فينصت الجميع، ويطير طرف الكلام ممن كان يمسك به، ولا يسترده أحد إلا في تعليق مؤيد سريع وخاطف، والويل لمن يحاول أن يخطف حبل الكلام من السعدني، فقد أوقع نفسه في شر أعماله، ودعت عليه أمه في ليلة يستجاب فيها الدعاء.
ويظل السعدني المتحدث الرسمي والوحيد في الجلسة التي يحضرها حتى تنفض، وتتجلى عبقريته وهو يتنقل من موضوع إلى آخر بسلاسة وعذوبة وعمق، فهو في الأدب والشعر ناقد كبير، قبل أن يكون مبدعاً كبيراً، يحفظ من الشعر أعذبه، وهو قارئ للتاريخ كما لم أعرف أحداً مثله، غير محمد عودة، وكان أول من لفتني إلى عبقرية الجبرتي، ومؤلفات ابن إياس، وابن تغري بردي، وهو يحكي عنهم بلغتهم ومفرداتهم ما يفتح أمامك طاقة نور على التاريخ، وكان بارعاً في أن يُرجع ما هو حادث إلى ما كان، ويربط بينهما بحبل سري لا تراه إلا عين فاحصة وقلب منير.

على باب الله
يتحدث السعدني في السياسة بطريقة لن تسمعها إلا منه، وكان حين تعرفت عليه من قريب، قد طلق السياسة بالثلاثة، ولم يتبق له منها غير علاقات غزيرة من الشخصيات النادرة، من النادر أن تجدها في مضيفة أحد غير محمود السعدني.
كان السعدني حكاءً من نوع فريد، يحكي كأنه يكتب فصلاً من رواية مصورة، يرفع صوته ويخفضه، ترق كلماته وتحتد، حسب المشهد الذي يصوره، ويتلبس الشخصية التي يحكيها أو يحاكيها، حسب الحبكة التي يتقنها ببراعة ليست لغيره، وأزعم أن إنتاج السعدني الحقيقي ليس فقط في كتبه الموجودة في كل بيت، ولا حتى في هذا الكم الكبير من كتاباته المنتشرة على صفحات العديد من المطبوعات، إنتاج السعدني الكبير مثل بعض عمالقة عصره، يتمثل في هذا الكم الهائل من الكلام المنثور على صفحات ألوف المساءات التي كان دائما ملكها المتوج.
عاش السعدني حياته بالطول والعرض والعمق، عانى الكثير، وسافر طويلاً، في المنفى، ودخل السجن في زمن عبد الناصر، وفي زمن السادات، وصادق حكاماً وأمراء ووزراء، وأذكره يوماً وهو يقول للسيد شعراوي جمعه وزير الداخلية في زمن عبد الناصر، حبستوني وأول ما خرجت من السجن تعرفت عليك وعملت معك في التنظيم البطيخي، وقلت لنفسي اطممن يا واد، صاحبت وزير الداخلية، فلن يجرؤ أحد على أن يحبسك بعد اليوم، فإذا بي أنا وأنت في السجن»، ويضحكان من سخرية الزمن قبل سخرية السعدني.
وظل السعدني حريصاً على ملازمة الصعاليك، وقد كان يعتبر نفسه منهم، دائماً ما يقول أنا مثل هؤلاء الذين هم على «باب الله»، حكي السعدني مرة أن الأستاذ «هيكل» طلب إليه العمل في مجلة ساخرة كانت «الأهرام» تنوي إصدارها، وحدد له موعداً في الساعة الثامنة صباحاً، غير أن السعدني وصل متأخراً عن موعده بنحو ساعتين، فلم يحادثه هيكل في أي شيء يتعلق بعرض العمل في «الأهرام»، ودار الحديث في موضوعات عامة، وبذكاء السعدني وخفة ظله أراد أن يخفف وقع عدم الالتزام بالموعد المحدد له، فقال لهيكل: «لأنك بتصحى بدري، وأنا أصحى زي ما أنت شايف، فأنا محمود السعدني اللي على باب الله، وأنت هيكل اللي مع الرئيس».

محمد حسنين هيكل، ومحمود السعدني
حكاية مع مبارك
نكتة السعدني لاذعة، تضحكك وتبكيك في نفس الوقت، كثيرون ممن جالسوا الكاتب الساخر الكبير تحدثوا عن «خفة دمه» الطبيعية والغير متكلفة، أذكر أن الكاتب الكبير يوسف ادريس كتب عنه مرة يقول: «ساعة مع محمود السعدني نعمة من نعم الله، حين يحضر تصبح الجلسة متفجرات من الضحكات»، وفي رأيي أن ضحكات السعدني التي كان يثيرها في جلسات المثقفين خاصة، وفيها كبار الكتاب والفنانين والأدباء وغيرهم، هي على الحقيقة من نوعية الضحك الذي هو كالبكاء، فقد كان السعدني ساخراً، يسخر من كل ظواهر التخلف في مجتمعاتنا العربية، شعوباً وقبائل وحكاما وحكومات، وأكثر سخرياته وجعاً تلك التي تتعلق بنقد الاستبداد، وما جرَّه علينا من ويلات وما نتج عنه من مآسي.
عندي الكثير من الحكايات التي سمعتها منه، أو منقولة عنه، وكلها تؤكد المعنى الذي أشرت إليه، لكني أكتفي هنا بحكاية رواها الأستاذ محمد حسنين هيكل[1] يقول: جاءني الكاتب الكبير والساخر الأكبر الأستاذ «محمود السعدني»، مرَّ على مكتبي دون موعد يقول: «إنه لا يريد غير خمس دقائق وسوف ينصرف بعدها»، ودخل إلى مكتبي، وسحبني من يدي إلى شرفة المكتب يقول لي بصوت هامس: «مصيبة، كنت عند الرئيس مبارك الآن»، وأبديت بالإشارة تساؤلاً مؤداه، وأين المصيبة؟، وراح «السعدني» يروى:
جلست مع الرئيس ساعة كاملة كلها ضحك ونكت، وعندما حان موعد انصرافي سألته مشيرا إلى المقعد الذي كان يجلس عليه: يا ريس، ما هو شعورك وأنت تجلس على الكرسي الذي جلس عليه «رمسيس الثاني» و«صلاح الدين» و«محمد على» و«جمال عبد الناصر»، بماذا تظنه أجاب علىَّ؟، ولم ينتظر «محمود السعدني»، بل واصل روايته: نظر إلى الكرسي الذي كان يقعد عليه، والتفت إلىَّ وسألني: هل أعجبك الكرسي؟، إذا كان أعجبك، فخذه معك. ويخبط «محمود السعدني» كفاً بكف وهو يقول: «وخرجت وطول الطريق لم أفق من الصدمة ــ الرجل لم يستطع أن يرى من الكرسي إلا أنه كرسي، لم يدرك المعنى الذي قصدت إليه».
يقول هيكل: حاولت طمأنة «محمود السعدني»، وأنا نفسي لا أشعر بالاطمئنان، وكان تعليقي: «الحق عليك وليس عليه، لماذا تحدثه بالرمز؟، لماذا تفترض أن رئيس الدولة يجب أن يكون عليما «بالمجاز» في أدب اللغة؟، وكان تعليق «السعدني» لفظا واحداً لا يجوز نشره».
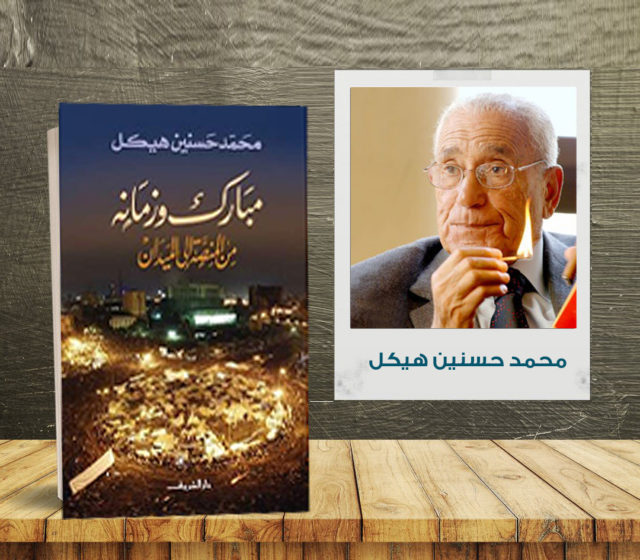
أختي الكبيرة!
رأيت السعدني مع بسطاء الناس، ورأيته مع كبارهم، وكان هو نفسه في الحاليْن، بل ربما تجده أكثر عدوانية تجاه الكبار الذي يَؤمون مجالسه، وهم لا زالوا على كراسيهم، وتجده شفوقاً عطوفاً كأم حنونة بمن خرج منهم من السلطة، وتراه منشرح الصدر لاذعاً في سخريته، مقبلاً على بسطاء الناس، وتحس أن همومهم قريبة إلى قلبه، يفهم الواحد منهم قبل أن ينطق بكلمة، يقصر عليه الطريق، وينفذ إلى صميم ما جاء من أجله، بأسرع مما يتصور طالب الحاجة، وكان عنده لكل حاجة، من يقوم على انجازها، ويتدخل بنفسه في الحاجات الكبيرة التي تحتاج تليفوناً منه إلى صاحب السلطة، يلبي بعدها المطلوب بإذنٍ من رب العالمين.
قلبه رهيف، ومحبته صافية، سمعته مرة في برنامج رمضاني على الإفطار والمذيعة تسأله عن علاقته ببعض عظماء عصره، ولست أنسى ما حييت إجابته عن علاقته بالأستاذ عودة، قالت المذيعة: بالنسبة للكاتب الكبير الأستاذ محمد عودة، ماذا يمثل لك: قال السعدني: محمد عودة أختي الكبيرة، وعندما سمعها مني عودة انطلقت ضحكته الصافية تملأ أرجاء المكان.

محمد عودة بريشة الفنان «سعد الدين شحاتة»
ظل السعدني طوال مشواره مثل سنديانة مثمرة، وافرة الظل، يستظل بها كل صاحب حاجة، وكل صاحب موهبة، وكل صاحب حقيقي لا يغدر مع الأيام، عرفت في معيته الكبار والصغار، مسئولين سابقين وحاليين، تعرفت في مصطبته على الموهوبين وأنصافهم، ورأيت عنده طالبي الحاجة وطالبي المحبة الخالصة التي كان هو ينبوعها الصافي، وسيبقى انجاز عمنا محمود السعدني الحقيقي في هؤلاء الذين زرعهم في بستان الكتابة الحقيقية، انجاز السعدني الكبير هو تلك المواهب التي ترعرعت على يديه في الكتابة الساخرة، وقد كان هو المبرز فيها وهو شيخ طريقتها وكبير نقبائها.
**
[1] في كتابه «مبارك وزمانه، من المنصة إلى الميدان».
اقرأ أيضا:













