الدِّين، كما يراه المفكر العراقي عبد الجبار الرفاعي، هو الذي يعطي معنى لوجود الإنسان في هذه الحياة، فهو يقدم أجوبة للأسئلة الكبرى التي يجابهها الإنسان، حتى لو لم تكن مقنِعة للجميع، فكما ينقل الرفاعي عن هايدجر، فإن الإنسان هو الكائن الوحيد المسكون بمشكلة منح معنى لوجوده [عبد الجبار الرفاعي، إنقاذ النزعة الإنسانية في الدين، دار التنوير، 18]، فالدين ببساطة هو مجموعة منتظمة من الأفكار والمعتقدات التي يؤمن بها الإنسان، بحيث تقدّم له تفسيرات مطمئنة وسهلة للغاية عن وجوده في الكون، وعلاقته به، من خلال تفسيرات غيبية أو ميتافيزيقية تمثّل أساسا في بنيوية الدين لا عرَضًا فيه.
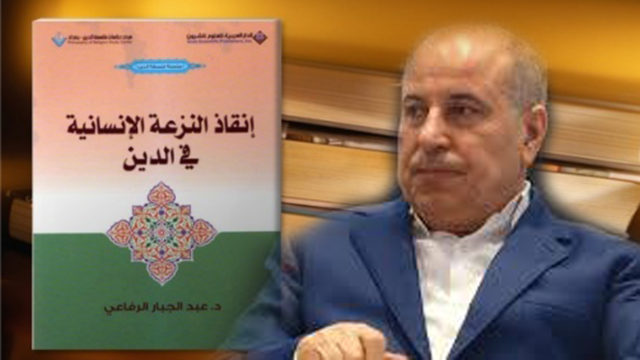
المفكر العراقي «عبد الجبار الرفاعي»، وكتابه «إنقاذ النزعة الإنسانية في الدين»
أما الفكرُ الديني فلهُ مفاهيم وتطبيقات مختلفة باختلاف المكان والزمان واختلاف المجتمع، فهو بمثابة فهم الدين، بيْد أنه يكتسب في مجتمعاتنا قداسة زائفة بسبب ارتباطه بالدين، لذلك خلط الناس بين الدين والفكر الديني، فصارت أقوال الفقهاء واجتهاداتهم، وآراء علماء أصول الفقه والتفسير والحديث وعلم الكلام وغيرها من العلوم الإسلامية، بمثابة دين موازٍ، اكتسب بمرور الزمن القداسة نفسها التي تميز الدين، وصارت آراؤهم مرجعية ربما تعلو فوق النص المؤسس، لذلك لم يكُن غريبا أن تحدث هوّة بين تلك العلوم والواقع المعيش، لأنّ المسلم المعاصر لما يزال يعتمد في فهم الدين وأحكامه وقضاياه على الاجتهادات القديمة التي كانت تناسب زمانا ومكانا وظروفا وملابسات تختلف تمام الاختلاف عن الظروف الحالية وتعقيداتها.
معنى ذلك أن الدينَ سابقٌ على الفِكر الديني، فالدين هو المرجعية عند مَن يعتنقه، أما الفكر الديني فهو تفسير وشرح له، فهو لا يتلبّس بالتقديس من قريب أو من بعيد؛ لأنه نتاج بشري بحْت، فلا يُحسَب على الدين، ولا يُعدُّ جزءًا من بنيته، بل هو عرَض له، وبالتالي فلا حرجَ أن يتوجّه إليه نقد ومراجعة، بل استبعاد لما يخالِف ظروف وأحوال وملابسات وتمثُّلات الواقع المعيش، بحيث يمكننا في النهاية أن نصف الدين بأنه (ثابت)، فيما نصف الفكر الديني بأنه (متغير)، وبين الثبات والتغير تضيع الحقائق الآن، وتتلبّس الأمور وتختلط بعضها ببعض، لأننا لم نفرّق بين الإسلام في نصه الثابت والمؤسس وهو القرآن الكريم، وبين الفهم البشري له، وفي الحق فهو ليس فهمًا واحدًا كما يبِين من اللفظ، وإنما هو آراء متعددة وصلت إلى حد الاختلاف الظاهر بين الفقهاء والمفسرين والمجتهدين؛ لتبايُن اجتهاداتهم ومعارفهم وثقافاتهم، بل وبيئاتهم نفسها، فممَّا هو معلوم أن الفقيه أو المفسّر أو المتكلم إنما هو ابن بيئته وتأثيراتها المتنوعة، السياسية والاجتماعية والأخلاقية.

إشكالية تقديس الفكر الديني
إنّ الفكر الديني ليس هو المعيار الذي لا ينبغي الانفلات منه كما يشيع بعض الجامدين المقلدين، بل هو مجمل الآراء التي تمثّل ما يمكن أن نسميه تاريخ الفكر البشري المسلم، أو الفهم البشري للدين، وهو فهم قد يصيب وقد يخطئ، قد يتناسب مع زماننا بتعقيداته وظروفه ومشكلاته، وقد لا يتناسب ألبتّة، بل قد يثير استهجانا وتساؤلات خطيرة لا نجد أجوبة عنها، مما يُوقِعنا في إشكاليات متعددة، نحن في غنىً عنها إذا ما اعتمدنا على أن الفكر الديني متغير، بشري، ليس مقدَّسًا، لأنه تشكّل من خلال قراءات متتالية زمنيا للنص المقدّس، الذي خلطنا – بمرور الزمن- بينه وبين اللامقدَّس، فصارت مخالَفة بعض الفقهاء أو المفسرين أو المتكلمين فيما ذهبوا إليه جريمة تستوجب عقابا، ومخالَفة صريحةً لأصول الدين؛ لذلك لم يكن غريبا أن تسمع أو تقرأ كلام واجتهادات وآراء أولئك الفقهاء والعلماء حتى الآن، دون أدنى اعتبار لتغير الزمان والمكان!
تكمن الإشكالية، بالتأكيد، في تقديس الفكر الديني من خلال ترسيخ الممارسات التاريخية والايديولوجية عبر عصور التاريخ الحضاري للشعوب الاسلامية، وهي ممارسات وظّفت النصوص بحسب الوقائع المختلفة التي لم يعد لها وجود الآن، ولا أدل على ذلك من أن كثيرا من ملابسات وقائع الاختلاف بين المذاهب والفِرَق الإسلامية قديما لم تعُد موجودة في هذا العصر، مهما تشابهت الخطوط العريضة لها مع بعض الظروف الحالية، بل إن العودة إلى تاريخ الفرق والمذاهب الإسلامية بموضوعية وتجرد تام، يرصد بنفسه بشريتها وتاريخيتها واوهامها وخداعها من حيث التأسيس والوجود والإستمرار [ماجد الغرباوي، النص وخطابات النفي].

إسلام النص.. وإسلام التاريخ
ويمكننا أن نطلق على الفكر الديني مصطلح «إسلام التاريخ»، على حد تعبير عبد الجواد ياسين في كتابه (السلطة في الإسلام)؛ وهو يفرّق بين إسلام النص الثابت بالوحي كتابا أو سنة متواترة، وبين إسلام الواقع التاريخي المتمثل في أنظمة الحكم المتعاقبة، والمتمثل كذلك – وهذا هو ما يهمنا في هذا المقال – في قواعد الفقه الاجتهادية، وهي ليست أكثر من انعكاس لاحق على الواقع الذي فرضه الحُكَّام، معبِّرة عنه وشارحة له، فنجم عن ذلك كله اختلاط التاريخ بالنصوص، واختلاط الفقه بالشريعة، وعمّ الخلط جميع الأطراف، يقول عبد الجواد ياسين: “لقد أتى على الإسلام حينٌ من الدهر لم يكن شيئا سوى النصّ، ثم أتى على الإسلام حينٌ آخَر من الدهر أصبح الإسلام فيه هو النص مضافا إليه الفقه والفِكر، وقد صارت للفقه مكانة مرجعية مساوية لمكانة النص من الناحية العملية، ثم راحت تلعب في تكوين العقل المسلم على مدار الزمن، دورا تجاوز بهذه المرجعية مكانة النص بقدر غير يسير” [السلطة في الإسلام، دار التنوير، 60].
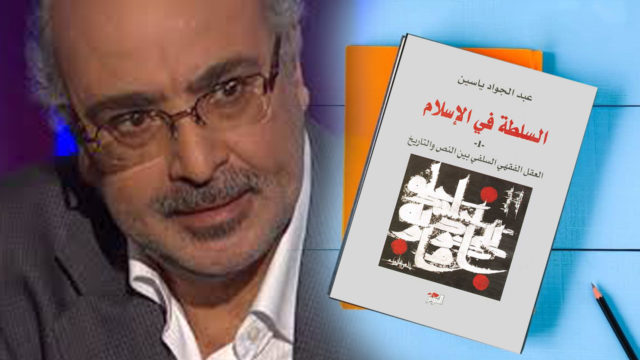
الباحث عبد الجواد ياسين وكتابه (السلطة في الإسلام)
إن الانعتاق الفكري من سطوة الماضي والتاريخ يجعل الفكر الديني في مكانه الصحيح؛ بحيث لا قداسة له ولا إلزام في القضايا الجديدة المتغيرة المعقَّدَة، وليس في دعوتنا تلك أي انتقاص لأفكار القدماء واجتهاداتهم ما دامت تُوضَع في نطاقها التاريخي، وما دامت لا تتلبّس بأي صيغة من صِيَغ القداسة والتمايُز، لأن المرجعية الأساسية تكون للدين نفسه، أي للنص الديني الثابت قطعا، أما ما سواه من اجتهادات الفقهاء والمفسرين والمتكلمين فما هي إلا آراء تعبّر عن وجهات نظر خاصة بهم، وليس معنى التقادُم في الزمن تقديس أفكار الأقدمين وجعلها منغرسة في حياتنا وأحوالنا، وقد تنبّه الأستاذ الإمام محمد عبده (توفي 1905) إلى ذلك فقال بوضوح تام: «لكل مسلم أن يفهم عن الله من كتاب الله، وعن رسوله من كلام رسوله، من دون توسيط أحد من سلف أو خلَف»، فليس لرأي أحد من السابقين- مهما كان- قداسة صاحب السلطة الدينية، وقد أسّس الفقيه الشهير أبو حنيفة بن ثابت (توفي 150 هـ) في عبارته الخالدة «هم رجال ونحن رجال»، قاعدة أصيلة في التعامل مع آراء السابقين، ونزع قداستها، وشرعية التفسير المتعدد للنص، وقابليته لذلك، وخطأ جعله نصا مغلَقًا كما يروم المقلدون الجامدون.













