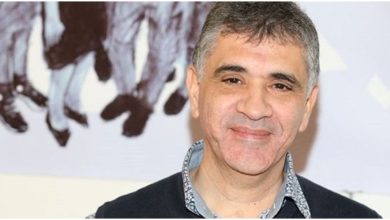في فيلمه التسجيلي «وير تو إنفايد نيكست» أو «أي بلد يجب أن نغزوه الآن» يزور المخرج الأمريكي المثير للجدل مايكل مور عدة بلدان حول العالم متسائلاً عما يميزها عن بلده: الولايات المتحدة وما الذي يمكن أن يقتبسه كأمريكي من تجربه تلك الدول ويكون ذا نفع لبلده.
وفي أحد أهم مشاهد الفيلم يزور المخرج ألمانيا ويبدي إعجابه بتجربة قام بها هذا البلد الأوروبي وهو تسمية شوارع وأحياء باسم ضحايا الجرائم النازية لكي لا ينساها أحد.
مشهد من فيلم «أي بلد يجب أن نغزوه الآن»
يطرح مور سيناريو متخيلاً حول ماذا يمكن أن يكون شكل الشوارع في الولايات المتحدة لو أنها حذت حذو ألمانيا، فهل ستستبدل أسماء الشوارع بأسماء السكان الأصليين الذين قتلوا أو الأفارقة الذين تم استعبادهم و جلبهم من أفريقيا بأسماء الساسة والمشاهير البيض التي تزين لافتات هذه الشوارع؟
الطريف هنا أن مور قدم هذا السيناريو في فيلمه عام ٢٠١٥ وفي عام ٢٠٢٠ تحول ما تخيله إلى واقع كرسته التظاهرات المناهضة للعنصرية في كل من أوروبا وأمريكا الشمالية، حيث تخللها هدم التماثيل التي اعتبرها المتظاهرون رموزاً للعنصرية البيضاء تجاه السود أو تجاه السكان الأصليين وتغيير أسماء عده شوارع بما يتناسب مع أجندة المتظاهرين، لدرجه أن شارعاً مقابلاً للبيت الأبيض أصبح يحمل الآن اسم «حياة السود مهمة» وهو شعار الحركة المناهضة للعنصرية والعنف الأمني ضد السود.

بدا إسقاط التماثيل عند بعض الأمريكيين بل وعند بعض العرب أمراً مستغرباً فلماذا يهدم الأمريكيون مثلاً تمثالاً للرحالة الإيطالي كريستوفر كولومبوس علماً بأنه -وفقاً للتاريخ الرسمي- هو الذي «اكتشف» بلادهم.
هنا تتبدى إشكالية التاريخ الرسمي في مواجهة التاريخ الشعبي» ففي كتابه «التاريخ الشعبي للولايات المتحدة» الذي أصدره مطلع الثمانينات يطرح المؤرخ الأمريكي اليساري الراحل هوارد زين تاريخاً مغايراً لما اعتاد عليه الطلاب الأمريكيين من خلال نظامهم التعليمي.

يرى زين أن التاريخ الرسمي في بلد كالولايات المتحدة يقوم على أسطورة، حيث يضخم من شأن شخصيات بعينها عبر التركيز على «إنجازاتها» و إخفاء أجزاء أخرى من تاريخها، ويؤكد زين أننا يجب أن نكون صادقاً مع التاريخ وآلا يسلم بهذه الأسطورة.
فكولومبوس مثلاً وفقا لزين لم يكن إطلاقا ذلك الرحالة المغامر الذي خاض غمار المحيط واكتشف أرضاً لم تكن معروفة من قبل، إذ كيف يمكن القول أن شخصاً ما اكتشف أرضاً إن كان هناك بالفعل شعب يسكن تلك الأرض.
ويعرض زين شهادات معاصرين لكولومبوس تؤكد أن هدفه الأساسي لم يكن اكتشاف الأرض وإنما اكتشاف الذهب وفي سبيل ذلك لم يتورع عن إبادة سكان جزيرة هيسبانيولا (كوبا حالياً) وترسيخ مؤسسة جديدة لم يعرفها هذا الجزء من العالم من قبل وهي العبودية.
ويمضي زين على نفس النهج في تفكيك أساطير أخرى يكرسها التاريخ الرسمي مثل ثيودور روزفلت الرئيس السادس والعشرين للولايات المتحدة الذي تصوره الدعايه الرسميه إضافة إلى عشرات الأفلام والكتب كرئيس عظيم وقائد عسكري فز، في حين يقدم زين صوره مغايره لروزفلت كشخص متعطش للدماء وقائد لم يجد أي حرج في تهنئة أحد جنرالاته على ارتكاب مجزرة مروعة في الفلبين.
وفي مقابل هذه الرموز الرسمية التي يفككها واحداً تلو الآخر٫ يقدم زين لقراءه خاصه من جيل الشباب ما يعتبره بطولات حقيقية تجاهلها التاريخ الرسمي لأنها لم تكن بطولات ساسة وحكام وإنما كانت بطولات للسكان الأصليين من أمثال «الثور الجالس» الذي ألحق الهزيمة بالقوات الأمريكية في موقعه «ليتل بيج هورن» أو بطولات عبيد متمردين مثل نات تيرنر الذي قاد عشرات العبيد في انتفاضة ضد ملاكهم من البيض أو بطولات معارضين للحرب مثل الكاتب الأمريكي مارك توين الذي شجب المجزرة الأمريكية في الفلبين المشار إليها سابقاً وسخر من الجنود الأمريكيين الذين ارتكبوها في مقال بعنوان «تحية للسلاح» أو بطولات المنتمين للفكر الاشتراكي مثل إيما غولدمان الناشطة النسوية واللاسلطوية التي جاهرت بمعارضتها للحرب العالمية الأولى ومشاركة الولايات المتحدة فيها أو يوجين ديبس القيادي العمالي والنقابي الذي رشح نفسه من سجنه لمنصب الرئاسة.
بشكل أو بآخر، يبدو وكأن المتظاهرين في كل من أوروبا والولايات المتحدة يطبقون تلك الفكرة التي دعا إليها زين في كتابه، فهم يتعاملون مع التماثيل وفقا للرواية الشعبية لا الرسميه.
فهم يزيلون تمثال الملك البلجيكي ليوبولد الثاني مثلاً الذي يصوره التاريخ الرسمي كأحد أهم ملوك بلجيكا وأوروبا بشكل عام وكشخص حارب العبودية في أفريقيا، إلا أن المتظاهرين ينتصرون لتاريخ آخر، تاريخ جرت فصوله في الكونغو التي احتلها ليوبولد الثاني واعتبرها مزرعته الخاصة وسخر أهلها لزراعه المطاط في عملية راح ضحيتها نحو عشرة ملايين أفريقي، وحتى من نجا من الموت منهم تعرض لبتر الأذرع أو الأيدي إذا لم يقدم حصته المفروضة من المطاط.
الأمر ذاته تكرر في لندن حين تعرض تمثال وينستون تشرشل الذي يراه كثيرون كبطل قاد بلاده إلى النصر في الحرب العالمية الثانية لمحاولة هدم، لكن محاولة الهدم هنا مردها هو أن المتظاهرين لا يرون تشرشل كبطل وإنما كرمز استعماري ساهم في تأسيس الدولة الصهيونية على حساب شعب فلسطين ولم يعبأ بمجاعة ضربت الهند وراح ضحيتها نحو ٣ ملايين شخص بل كان رده على ما ورده عن تقارير عن نقص الغذاء هناك «لماذا لم يمت غاندي بعد؟».
أما تماثيل الرؤساء الأمريكيين مثل جورج واشنطن وتوماس جيفرسون الذين يتعلم الأطفال الأمريكيين في المدارس أنهم «أباء الأمة» مؤسسوا الولايات المتحدة وكاتبوا دستورها فقد استهدفها المتظاهرون بسبب الجزء المخفي من تاريخهم وهو كونهم ملاك عبيد سود.
https://youtu.be/LKIhfrjuCWM
إن إسقاط التماثيل ليست مجرد محاولة من جيل جديد من الأمريكيين لتغليب رواية تاريخية على أخرى وإنما يبدو وكأنه محاولة للتطهر والاغتسال من تاريخ استعماري وعنصري لازال يؤرق هؤلاء.
وليس الأمر ببعيد عن عالمنا العربي وخاصة مصر، في ظل دعوات متصاعدة من البعض لإعادة تمثال الفرنسي فرديناند ديليسبس إلى قاعدته على مدخل قناة السويس في مدينة بورسعيد، ذلك التمثال الذي نال ما تناله اليوم تمثال قادة أمريكا وأوروبا على يد المتظاهرين في ذلك اليوم البعيد من عام ١٩٥٦ حين نسفه فدائيوا بورسعيد كرمز للاستعمار و كعلامة على انتصارهم على قوى العدوان الثلاثي التي كان من بينها بلده الأم: فرنسا.