التحرش الجنسي بالنساء من قبل الرجال هو أمر لا يمكن التغافل عنه في المجتمع المصري، وغالبًا ما يكون عارضا لمشاكل اجتماعية أخرى خفية، وفي محاولة لكسر الصمت الذي عادةً ما يحيط بهذا النوع من أشكال سوء المعاملة، تتجه الضحايا لمشاركة تجاربهم الأليمة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.
في مطلع يوليو الحالي وعلى غرار حملة #MeToo الإليكترونية لمناهضة التحرش الجنسي ضد النساء في الغرب، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بحملة اتهامات بالاغتصاب والتحرش، استهلتها فتاة مصرية بإنشاء حساب على «الانستجرام» بعنوان «شرطة التعدي» assault – police -لتضمين شهادات وأدلة اتهام من الفتيات ضد الشباب.

وفي خضم ردود الفعل على الحملة الأخيرة، استرجع ناشطون نبرة حملة «الستر الانتقائي» التي أحاطت بحملة اليكترونية مماثلة اُتهم فيها لاعب كرة قدم شهير بمنتخب مصر، وظهر اتجاه لتبرير الفعل ورمي مسئولية التحرش على الفتيات، بدعوى قبول الفتاة لمحادثته أولاً، وصغر سنه ووضعه ثانيا، «كان الله في عونه ده في سن صغير.. يعمل إيه يعني ما هو شاب وطايش.. هوة يعني أتحرش بملايكة».
كما ظهر اتجاه يربط التحرش الجنسي بلباس المرأة ومظهرها، وهو الاتجاه الذي تم تدعيمه من قبل بعض الدعاة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبررت بعض التغريدات والمنشورات عملية الاعتداء والتحرش الجنسي بمظهر المرأة «لباسك استفز ذكورتي وأنا هاوريكي.. خروجك من المنزل فتنة يستوجب معه التحرش.. كلنا متحرشون لولا ستر الله».

أرشيفيه
الحقيقة لا نحتاج مقدمات طويلة عن آفة التحرش وأسبابها وأشكالها، على أي حال باتت مصر من الدول التى تعاني من مستويات عالية من هذه الظاهرة، وللأسف لا تزال الثقافة المجتمعية في بلادنا تتعامل مع الضحية على أنها المُلامة، بل ويتم تبرير التحرش على مستويات مختلفة، «ما هيّ الّلي غلّطانة.. إيه اللي وداها هناك.. شوف لابسة أيه.. تستاهل ايه اللي يمشيها في الشارع فالوقت ده؟! ..إلخ».
كما نرى باقة من أجمل وأمتع المبررات كلها تلقي باللوم على الضحية، وفي سياق عملية التبرير تلك تكشف حقائق (محزنة- مخزية) عن المجتمع المصري، فمفهوم التبرير نفسه سمة مشتركة في معظم تحليلات المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، وعند كل مشكلة سنجد دائمًا أولئك الذين يعملون بكل جهد لتبرير المشكلة، بأسباب غير صحيحة.
وعلى الرغم من تنوعها وتباينها فإن مبرر التحرش الجنسي في مصر غالبًا ما يسير في مسارين، المسار الأول: الاستناد على مظهر الضحايا وأنماط حياتهن، أما المسار الثاني: فهو المحافظة على «قيم المجتمع المصري» واستباحة أجساد الخارجين عليه.
في الواقع لدّي في هذا المقال أخبار غير سارة بخصوص تلك الفكرتين.. فهما مجرد مسكنات ألم سطحية لمشكلة أساسية ضمن سلسلة متصلة من العنف الجنسي ضد النساء.
الانتهاك الحلال
في المسار الأول لتبرير التحرش هناك اتجاهين، الأول حينما يرى البعض أن الضحية تستحق الاعتداء، وانتهاكها حلال، فهي ترتدي ملابس استفزازية، وتتواجد بمفردها مع الجاني، وتتصرف بشكل متحرر، حينها يتحول التحرش إلى واجب ديني واجتماعي مقدس، وكأنها غزوة ودعوة للجهاد.

وفي تفسير هذا المسار نستدعي نظرية «العالم العادل»، ففي كتابه «القناعة بعالم عادل» يشير ميلفن ليرنر أستاذ علم النفس الاجتماعي بجامعة ووترلو، إلى أن تصورنا للعالم على أنه مكان عادل، بمعنى عندما يدرك الأفراد بأنهم سينالوا ما يستحقون، تمكن الأفراد من الحفاظ على مستوى معين من السيطرة المتصورة.
فرضية ليرنر مبنية على أن كل فعل نقوم به يستدعي نتيجة من نفس النوع؛ «أنت تستحق ما فيه، سواء كان جيدًا أو سيئًا بسبب أفعالك»، فرضية هذه النظرية هي أساس انتشار لوم الضحايا، وترسخ لثقافة التطبيع مع التحرش وخلق مبررات لحدوثه، فاستجابة «العالم العادل» راسخة في المجتمع، ولوم الضحية هي استجابة مشتركة عندما لا يستطيع الأفراد إقامة عدالة، على سبيل المثال، التحرش الجماعي بـ«فتاة المنصورة» ألقي اللوم على الفتاة وتم ربط الحدث بمظهر الفتاة وأنها استحقت ما حدث، في هذه الحالة لم تتأذى الفتاة بسبب تعرضها للتحرش الجنسي فقط، بل تأذت مرات عندما ألقى المجتمع باللوم عليها بسبب مظهرها.

التحرش الجماعي بـ«فتاة المنصورة»
يقول ليرنر: «في سبيل تقبل فكرة الظلم في هذا العالم القاسي، فإننا نلجـأ لاستخدام مغالطة العالم العادل لكي يمنحنا الشعور بالطمأنة كونها آلية فعّالة لصعوبة الاعتراف بأننا في عالم غير عادل وأن بعض الظلم غير مبرر، وبالتالي الحد من التنافر المعرفي عندما يدرك المرء أن كل شخص سينال ما يستحقه»، على طريقة «هيَ الليَ غلطانة».
الاتجاه الآخر في هذا المسار الإدّعاء بإرسال رسائل خاطئة من الضحية إلى المعتدي كمبرر لاستباحتها، فكيف تكون الضحية ذات قامة طويلة وملابس محتشمة ضحية للاعتداء إذا لم يكن ذلك بموافقتها ضمنيًا؟!.
لتفسير هذا الاتجاه نستدعي نظرية «أسطورة قبول الاعتداء»، تتعلق هذه النظرية بنشر المفاهيم الخاطئة الخاصة بالاعتداء الجنسي، مما ينتج عنه سوء فهم الأفراد للاعتداءات الجنسية الحقيقة. على سبيل المثال، عادة ما تصور وسائل الإعلام بأن الاعتداء الجنسي عادة لا يحدث لـ«ضحية طويلة القامة»، أو لمن ترتدي «ملابس محافظة»، أو لـ«المرأة التي لا تكون بمفردها»، تشمل تلك الخرافات الشائعة أن الاعتداء يستلزم قوة جسدية، وأن الضحايا تقع عليهم مسؤلية جزئية نتيجة فقد السيطرة بسبب ظروفهم، وقبول تلك الخرافات يرتبط بقوة بلوم الضحية، وكلما زاد التناقض بين سمات الاعتداء الجنسي الحقيقية والنسخة «النمطية»، كلما زاد إلقاء اللوم على الضحية ومحاسبتها كمتسبب مشارك، وأنها «هيَ اللي غلطانة».

ينسحب هذا على تفسير شعبي غير منصف إطلاقًا، ويعبر عن الجهل القاسي والمخزي تمامًا وهو تعبير «دوّاية الحبر»؛ وتفسيره أنه لا مجال لتعبئة قلم الحبر إلاّ إذا كانت دواية الحبر ثابتة ومفتوحة، إسقاطًا على مقدار التباين بين النسخة «النمطية» وسمات الاعتداء الحقيقي وإحالة مسؤلية الاعتداء إلى الضحية.
وبعيدًا عن هذا التفسير الذي يديم «براءة» الرجل، ولا يعبر إلا عن فكر مجموعة لم تتدرب على احترام المرأة، فإن استسهال التبرير غير منصف إطلاقًا.
الحقيقة الواضحة أن النساء يتعرضن للتحرش بغض النظر عن (شكلهن، مظهرهن، أين ومتى يمشون أو يتواجدون، عمرهن، موقفهن، طبقتهن الاجتماعية)، يتم التحرش بهن سواء كن يرتدين ملابس محافظة أو تلك الكاشفة، محجبات منقبات أو حاسرت، سواء في المواصلات العامة أو سيارتهن الخاصة، سواء تواجدن بالشارع في ساعة ذروة أو في منتصف الليل.
الذكورية اللّوامة
المسار الثاني من تبرير التحرش هو الدفاع عن «قيم المجتمع» الذي يعمل على تعزيز امتياز الذكور وهو مسار مراوغ، فـ«قيم المجتمع» مصطلح يستخدم في أكثر من موضع لتبرير أفعال العنف ضد المرأة، لكن ما هي «قيم المجتمع».. هل هناك قيم ثابتة لأي مجتمع لنجعلها معيارا تقاس عليه الثوابت الأخلاقية؟.. وهل تلك القيم مدرجة في النظام القانوني أم أنها مسألة ذاتية متروكة للحكم الذاتي الفردي؟.. ولماذا تتحمل المرأة دائمًا مسئولية الإخلال بقيم المجتمع؟.. لما لم نسمع من قبل عن ذكور اُتهموا بالإخلال بقيم المجتمع والأسرة بسبب مظهرهم أو نمط حياتهم أو أماكن تواجدهم؟.
الحقيقة المؤلمة التى تعكسها مبررات التحرش، هي إدامته عبر السياق الأبوي الذكوري والمنحاز، فالمشكلة تكمن في نمط التفكير المنحاز الذي يشوه المرأة، ويتم رعايته تحت تفاعلات اجتماعية تمييزية ضد المرأة، كإرث التمييز بين الجنسين، وأشكال القمع ضد النساء والتى تثنيهم عن التحدث علنًا عن تجاربهم المؤلمة باعتبارها «حوادث فردية».
ينسحب ذلك مع نظرية «التحيز الجنسي المتناقض»، التي اعتمادها من قبل جليك وفيسك عام 1996، ويتألف التحيز الجنسي المتناقض من بعدين (التحيز الجنسي العدائي، والتحيز الجنسي الخيري).

ويعتبر البعد الأول المرأة أدنى من الرجل، وهو نوع التحيز الجنسي الأكثر شيوعًا بين الناس وتكشف عنه المظاهر التي تنبع من كراهية المرأة، كالمعتقدات المبالغ كالتي تصف المرأة بأنها بـ«نصف عقل»، إلى جانب العديد من المعتقدات الأخرى المتعلقة بعدم الكفاءة واللاعقلانية، كل ذلك يرتبط باتجاه سلبي بشكل عام نحو النساء، ومن المنطقي أن يتسبب هذا التحيز السلبي تجاه النساء اللواتي تم الاعتداء عليهن جنسياً، ليتم إلقاء اللوم عليهن أو تحميلهن مسؤولية جزئية على الأقل.
على النقيض من «التحيز الجنسي المعادي»، يحدث «التحيز الجنسي الخيري»، عندما تكون للنساء قيمة وسمات محددة سلفا، مثل (البراءة والدفء والتربية)، وفي كثير من الأحيان تبدو تلك السمات إيجابية على السطح، لكنها في الواقع تعمل على تقويض النساء.
ينتج «التمييز الجنسي المتضارب» عندما يحدث «التحيز الجنسي الخيري» و«التحيز الجنسي المعادي» في وقت واحد، على سبيل المثال، المعتقدات التي تقول إن المرأة بريئة لكنها غير كفء، وجميلة لكنها غير عقلانية، وممتعة جنسياً لكنها متلاعبة.
وبالتالي يشعر المتحرش بالأريحية من كونه متحرش، بل يشعر بأنه يمارس حق من حقوقه وآلية لتمكين سيطرته على المرأة، وتعزيز وضعها الثانوي في المجتمع، وبالتالى ليس من المستغرب تشويه الضحايا وإهانتهن، فتستباح الضحية، ويساند المجتمع المُعتدي لأنه الجانب الأقوى، «إيه يعني ماحصلش حاجة.. انتي اللى غاوية تبقي أتنشن هور.. ما تدوله فرصة تانية.. بلاش تعملي له محضر مستقبله هيضيع.. ما يمكن مايقصدوش».

كل تلك المبررات المعلبة سلفا لا تصدر من رجال فقط، بل الكثير من النساء أيضًا يصطففن ضد جنسهن، فيدافعن عن المُعتدي ضد الضحية، وفي محاولة فهم منطقهن، يمكن تفسير ذلك على ضوء «متلازمة استوكهولم»، كآلية لمواجهة القمع حيث تعاني الإناث من العبودية النفسية، ففي المجتمعات الأبوية يتم ترسيخ مجموعة من المسلمات في سن مبكرة، فالدونية هي مصدر قوة الإناث، والامتثال للسيطرة الذكورية يؤدي إلى التوافق الاجتماعي، والخضوع للمسيئين أفضل من التمرد، وبالتالي فمساندة المُعتدي وتأييده يجعلهن يشعرن بالقوة المتصورة، لأنه الطرف الأقوى، فيواجهن الأخريات اللواتي يرفضن الاعتداء، وبدلاً من دعم جهودهن، يصبحن أكثر عدائية، ويصلن إلى مرحلة من الخضوع في قبول الإساءات وتبرير سلوك المتحرشين إلى حد الرضا عن أوضاعهن الحالية، هؤلاء النساء يظهرن نمطًا سلوكيُا يُديم إساءة معاملتهن، ففي أذهانهن لم يخطيء المعتدي أبدًا،..لأنها «هيَ اللي غلطانة».
في رأيّ يتساوى كل من المتحرش ومبرر فعل التحرش (ذكر وأنثى)، كلاهما لديه مشكلة في ذاته التي يحتقرها دون وعي، فهم يغذوا قيمتهم وذواتهم المتورمة بالفراغ بفرض سيطرتهم على الضحية، وهي عقد نفسية لا تتعلق بالمركز الاجتماعي أو العلمي أو الوظيفي، أو بالطبقة الاجتماعية.
فبعد إذن المجتمع، ابذلو المزيد من الجهد والسعرات الحرارية في محاولة لتربية الذكور وتعليمهم اللياقة، والكرامة، واحترام المرأة، واحترام الذات، ومحاولة إصلاح الوضع المخزي الذي تعاني منه المرأة المصرية، والكف عن النظر للمرأة بأنها الفئة «الناقصة» التي تخضع للتهديد الدائم، والتوقف عن التبرير وإلقاء اللوم على الضحية باعتبارها مسؤلة عن الاعتداء، فلا علاقة تربط بين مظهر المرأة وشخصيتها وحالتها بالاعتداء..لأنها «هيّ مش غلّطانة».






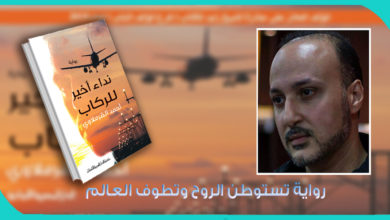







مقال ممتاز