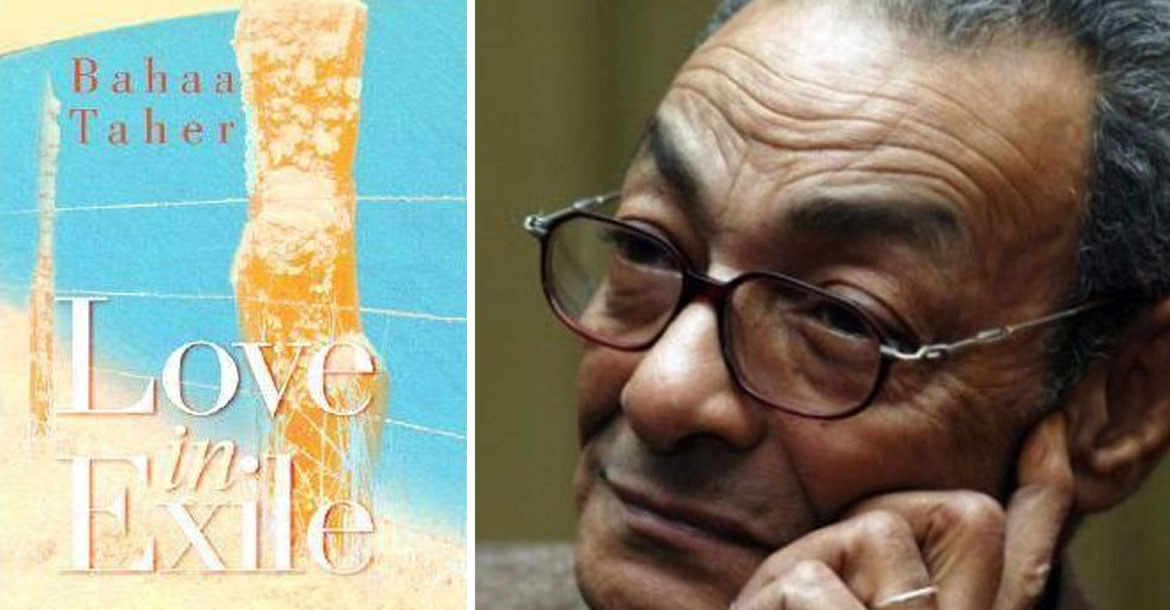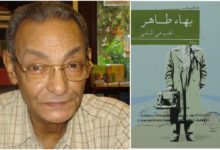تتوزع أحداث تلك الرواية البديعة على ١١ فصلاً، وكلمة ختامية يوضح فيها الأستاذ ” بهاء طاهر ” حقيقة الشخصيات والوقائع التي جاءت في سياق الرواية، كاسم ذلك الشاب الذي هرب من مُعتقله في شيلي، وشقيقه الذي مات مقتولاً بالرصاص في شوارع العاصمة سنتياغو ، وشهادات حقيقية من صحفيين ورجال ونساء عملن في مجال الرعاية الصحية وكانوا شهود صدق على جرائم إسرائيل خلال احتلالها لعاصمة بلد عربي، لبنان الحبيب، أثناء غزوها المٌجرم عام ١٩٨٢!!.
الفصول الإحدى عشر تحمل أسمائها عناوين ذات دلالة، فهي على سبيل المثال ” مؤتمر كغيره، ماضٍ بعيد،ماضٍ ميت، هشة كفراشة، كم أنت جميل، طبول لوركا لدم الشاعر، كل أطفال العالم، صعود الجبل ” وغيرها.
والقارئ لهذه الفصول يجد أنها تتكامل في كل جوانبها، فلا يعني أنك انتهيت من قراءة الفصل الأول، بأنك لن تلتقي بأبطاله مرة ثانية، فالشخوص في الرواية البديعة يرافقون مسيرتك حتى الصفحة الأخيرة، وهذه ميزة كبيرة لاحظتها في كل أعمال ” بهاء طاهر “، فكثير من أبناء الجيل الذي تلاه، يترك أبطاله من الفصل الأول ولا يعود اليهم مرة ثانية، كأنه يركب قطاراً ويُلقي بأبطاله في كل محطة ولا يريد أن يذكرهم بالخير أو الشر!!.

ولذلك تبدو رواية ” الحُب في المنفى ” رواية شديدة التماسك والترابط، تكاد لا يوجد بها ثغرة تسقط منها، رؤية أو رأي أو حكاية!.
ويزداد هذا الأمر جمالاً وبهاءاً، بتلك اللغة الجميلة والبسيطة للغاية، حتى يٌهيّء لك كقارئ أن ” بهاء طاهر ” من فرط حبه لك يُفضي الّيكّ بمكنون قلبه وأدق مشاعره، بكلمات حانية ونقية وصافية ” حاجة تفكرك بعبدالحليم حافظ ” في بساطة الأداء، وشفافية الكلمة، وذلك الصوت الهامس الذي يُلقي السمع في قلبك قبل أُذنيك! .
بهذه اللغة البسيطة التي لا تُكلف المؤلف جُهد التّكّلُف والتّصّنُعْ تقع، أنت كقارئ ك، تحت أسر هذا العمل الآثر الجميل، مما يجعلنا نطمئن إلى تلك الرحلة التي يأخذنا بها صاحب هذا العمل البديع وعالمه الجميل رغم الشَجن والحُزن وخيبات الأمل التي تلازمك في تلك الرحلة التي يصحبك فيها ” بهاء طاهر ” على مدى ٢٥٠ صفحة من القطع المُعتاد للأعمال الأدبية، فتجد نفسك مُلازماً له خلال تلك الحياة التي عاشها في بلد غريب، حيث وجد نفسه مُقيماً فيها رغم أنفه، مُراسلاً لجريدة كان يعمل بها في مصر، ووصل فيها إلى أعلى درجات التّرقي في عالم الصحافة، ليجد نفسه من ضحايا أحداث مايو ١٩٧١ مُراسلاً بلا رسالة صحفية، مُراسلاً غير مرغوب فيه، فهو ممن أُطيح بهم من عمله بسبب انتماءه السياسي الناصري، وإيمانه بمشروع ثورة يوليو الاجتماعي والوطني والقومي.
بهذه الصفة المهنية، وذلك الانتماء السياسي والفكري، نجد العالم الفسيح لتلك الرواية، التي جرت وقائعها في إحدى العواصم الغربية، في الغالب هي مدينة ” چنيف ” حيث كان يعمل الأستاذ ” بهاء ” في المقر الأوروبي للأمم المُتحدة، ولذلك نجد أن الصفة المهنية التي اتخذها لنفسه في تلك الرواية لا تغيب عن الحقيقة كثيراً.
فالعنوان العام لنشاط أبطالها، ممن يعملون في الصحافة وفي مجال حقوق الإنسان، ولذلك نجد أن حكاية ” الحب في المنفى ” تقوم على ثلاثة أقطاب، وبعض الشخصيات التي تترك بصماتها في الأحداث بقوة، ولكنها لا ترقى إلى مرحلة الفعل المؤثر والصانع للأحداث.
القُطب الأول هو ” الراوي “والذي يحكي طوال صفحات الرواية أحداثها الكبيرة والصغيرة، ولكننا لا نعرف له ” اسماً ” ورغم ذلك فهو الحاضر بقوة، والذي نعلم عنه، وعن حياته وعائلته وأفكاره ومشاعره كل شئ، فهو من أبناء الصعيد، وواحد من أسرة شديدة الفقر، ولم يأت حبه ل ” عبدالناصر “من فراغ، فثورته هي التي أطعمته بعد جوع، وأمّنت له ولكل طبقته الكرامة في التعليم والعلاج وامتلاك المستقبل.
أما القطب الثاني فهو صديقه الماركسي ” إبراهيم المحلاوي ” والذي نعرف أنه ابناً لأحد كبار الإقطاعيين في عصر ماقبل ثورة يوليو، إقطاعي شديد الظُلم والقهر للفلاحين، ويخون زوجته بغير حياء، لكنه يُحافظ على التقاليد الأرستقراطية العريقة، فيُقبل يديها في الصباح والمساء، ولا يناديها إلاّ بالهانم، وبسبب فساد أبيه وظُلمه وجد في الشيوعية خلاصه، والانضمام إلى تنظيماتها طريقه إلى قهر ماضيه الملوث بتاريخ أبيه!.
كان ” إبراهيم ” من بين معتقلي الحركة الشيوعية المصرية في أول أيام يناير ١٩٥٩، وخرج من المُعتَقل وعاد إلو عمله في تلك الجريدة التي يعمل بها الراوي، اثر المُصالحة الكُبرى بين الشيوعيين ودولة يوليو في عام ١٩٦٤، ولكنه يّلقى نفس المصير الذي لقيه زميله الناصري في أحداث مايو ٧١، ليختار بعد ذلك العمل مع إحدى الصحف التابعة لإحدى فصائل المقاومة الفلسطينية في بيروت، ليُعاصر تطورات الحرب الأهلية اللبنانية ويتابع أحداثها الدامية والوحشية، حتى الخروج الحزين لفصائل المقاومة الفلسطينية من كل لبنان إثر مذابح صبرا وشاتيلا!.

بين هذين القطبين تقع ” بريچيت شيفر ” تلك الفتاة الجميلة القادمة من النمسا لتعمل مع الدكتور ” موللر ” كمتطوعة في مجال حقوق الإنسان، والتي نعرف أنها تعمل في مجال السياحة، وتجيد أكثر من لُغة، وأنها ابنة محامٍ كبير، ماركسي الاتجاه لا يعمل إلاّ في القضايا العمالية والنقابية والدفاع عن الفقراء، ومعرفة أدق تفاصيل معاناتهم، ولا يجد فرحاً إلاّ معهم، غير أن الرجل العظيم الذي شارك الدكتور ” موللر ” الحرب الأهلية الأسبانية في أعوام الثلاثينيات مُلازماً ” أرنست همنجواي وأندريه مالرو وبيكاسو وبابلو نيرودا ” يقع فريسة المرض العُضال، في الوقت الذي يتوجه فيه رفيقه الدكتور ” موللر ” إلى فراش زوجته ليكون عشيقاً لها!.
” بريچيت شيفر ” التي تعامل معها الدكتور ” موللر ” كإبنة ومُترجمة له من لغته الألمانية والإنجليزية إلى الأسبانية، تحمل له مرارة داخلية ونفسية عميقة، فهي المُحبة والعاشقة لأبيها الذي رحل، والكارهة لأمها التي خانت!!.
مع الأقطاب الثلاثة هؤلاء ” الراوي وابراهيم المحلاوي وبريچيت شيفر ” تتحرك الأحداث في وجود شخصيات أخرى كثيرة، من بينهم ” منار ” زوجة الراوي ، ذات الأصول الاجتماعية المتواضعة، والتي كانت تعمل معه في نفس الجريدة، والتي بدأت حياتها ناصرية الهوى وانتهت إلى اهتمامات سنوات الإنفتاح الساداتي، وابنه ” خالد ” الطالب بكلية الهندسة، الرياضي الذكي والعاشق للعبة الشطرنج، وابنته ” هنادي ” طالبة المرحلة الإعداداية، الصبية الجميلة والمُحبة لأبيها، لكننا نُدرك من وقائع المكالمات الهاتفية بين الراوي وولديه ” خالد وهنادي “من البلد الأوروبي التي يقيم فيها والقاهرة، أنهما يعيشان مع أُمهّما ” منار ” التي باتت طليقة أبيهما.
وثمة شخصيات أخرى ، مثل ” بيدرو إيبانيز ” المُعتَقل الهارب من سجون ” بينوشيه ” والذي تولى الدكتور ” موللر ” عرض قضيته خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره الراوي مُراسلاً لجريدته المصرية، وقامت ” بريچيت شيفر ” بالترجمة من الأسبانية التي يتحدث بها إلى الألمانية والإنجليزية، وكذلك نجد الصحفي ” برنار ” وهو ممن يعملون بالصحافة في هذا البلد، لكننا نعرف أنه صديق الراوي منذ زمن، ولا يهتم بمظاهر الحياة من مّلبس ومأكل بعد وفاة زوجته، وتبنيه لطفل ڤيتنامي من أطفال القوارب الهاربين من الجحيم الأرضي الذي صنعته طائرات ” بي ٥٢ ” قاذفة القنابل العملاقة بأرض بلاده.
ونأتي إلى ” إيلين ” صاحبة الكافتيريا التي عادة ما يلتقي عليها الراوي وصديقه ابراهيم القادم من بيروت ليعرض قضية العدوان الإسرائيلي على لبنان، والدكتور موللر وبريچيت شيفر ” فنعرف أن ” إيلين ” هذه والتي غادرت سنوات الشباب منذ زمن تتزوج من ” يوسف ” ذلك الشاب المصري، خريج كلية الإعلام، وواحد ممن تظاهروا ضد الرئيس السادات خلال المظاهرات الطلابية في السنة السابقة لحرب أكتوبر ٧٣، غير أننا نعرف أيضاً أن ذلك الشاب الذي ضاقت به أرض بلاده، هرباً من مضايقات أجهزة النظام، يعمل كطباخ في تلك الكافتيريا التي تملكها ” إيلين ” ويعمل أيضاً مُساعداً لأمير عربي قادم من منطقة الخليج، والراغب في إنشاء جريدة ذات طابع قومي تقدمي، تكون ناطقة باللغة العربية في هذا البلد الأوروبي، وعينه على الراوي ليكون رئيساً لتحريرها!

الأحداث تتوالى، والرواية تتشابك جوانبها بصورة رائعة وبديعة، حتى أنك كقارئ لا تتوقف عن القراءة، فتنتقل من صفحة تلو الأخرى، فالمصائر مُتشابكة ك، والأحداث مُتلاحقة، فلا يمكن الفصل بين تاريخ الراوي ومشكلاته السياسية مع نظام بلاده، ولا عن خوفه من ذلك المصير الذي آل إليه ابنه ” خالد” وقلقه على ابنته ” هنادي “،وبماذا تصنع بهما الحياة مع غياب الأب المُحِب!
ونفس الحال الذي يطارد صديقه ” ابراهيم ” ، الذي تحطمت أحلامه منذ زمن، بحل الحزب الذي قضى بين جدرانه أجمل سنوات العمر، و حبيبته ” شادية ” زميلته في نفس الجريدة التي كان يعمل بها مع الراوي، والتي لم يصل إلو جمالها وفتنتها أحد من العاملين بتلك المؤسسة، فضلاً عن إخلاصها ل ” ابراهيم ” طوال سنوات الإعتقال، ولكن ما إن خرج الحبيب وعاد إلى عمله في الجريدة، ذهب كل منهما إلى طريق، حتى بات الفُراق لغُزاً لم يفهم طلاسمه الراوي أو غيره!
وتلك الفاتنة التي لم تتجاوز الثلاثين من العمر ” بريچيت شيفر ” والتي كرهت وطنها، ولا تحب أن تعود إليه لكراهيتها لأمها التى خانت أبيها الذي لم يكن من العدل أن يُغدر به وبتاريخه العريق، ومع من ، مع رفيقه الدكتور ” موللر “‘!!
ثلاثة أقطاب قامت عليها أعمدة الرواية، فيما كان دور باقي الشخصيات هو العمود الرابع الذي قام عليه ذلك البناء المعماري الأدبي المُدهش!
لكن هؤلاء الثلاثة، كانوا أصحاب الأحلام المُجهضة، فالراوي ظل أسيراً لمشروعه القديم، الذي انقلب واحداً من رجاله على سلفه الكبير، حتى بات القول أن لكل حُلمْ في الخلاص ” يهوذا الإسخريوطي ” عليه بيع صاحبه ببضع من الفضة!
وزميله ” إبراهيم ” الذي كثيراً ما اختلف مع زميله، حول قضايا الوحدة العربية وحرب اليمن والديمقراطية، وجد نفسه مُدافِعاً عن ثورة يوليو، ولكن في أرض غير أرضه، وبعيداً عن وطن بات غريباً عليه، و” بريچيت شيفر ” تلك الزهرة العفية، هي المُطاردة من ذكرى الوفاء لأب عظيم، وأم لا تحمل لها حباً أو احتراماً!
” بريچيت “وجدت في حبها للراوي، طريق الخلاص من تاريخ يطاردها، فهل استجابت أشرعتها بالرسو في مرفأ من أحبها حُباً جماً، ووجد فيها وفي الوفاء لها ترميماً لمشروعه الثوري القديم، وبعثه من جديد!