في رسم كاريكاتوري أبدعه الرسام الفلسطيني الشهيد ناجي العلي يقف البدين الذي كان يرمز به العلي إلى كل ما هو سلبي وفاسد وقبيح في مجتمعاتنا العربية ليسأل إحدى شخصيات العلي المفضلة وهو الفقير النحيل الذي كان دوماً في رسومه رمزاً للمواطن العربي البسيط والمطحون سواء كان مصريا أو مغربياً أو سودانياً…الخ.
يسأل البدين نقيضه التام قائلاً له: هل أنت مسلم أم مسيحي؟ وإن كنت مسلماً فهل أنت سني أم شيعي؟ وإن كنت مسيحياً فهل أنت كاثوليكي أم أرثوذكسي؟ وقبل أن يتم البدين سؤاله يقاطعه النحيل بفطرته النقية والسليمة بجواب قاطع حاسم وموجز في نفس الآن: “أنا عربي يا جحش”.
جاء هذا الرسم الذي أبدعه العلي كرد من هذا الفنان العربي اليساري على مناخ الطائفية الذي بدأ يسود المنطقة العربية وخاصة لبنان، حيث كان يقيم منذ منتصف السبعينات وكان رد النحيل تعبيراً عن إيمان كثيرين من بينهم العلي أن السبب الأساسي في هذا المناخ هو تراجع المشروع القومي العربي في أعقاب نصر أكتوبر عام ١٩٧٣، وبداية مشاريع التسوية في المنطقة.

حيث أن العروبة وفقاً لمن يؤمنون بها ومن بينهم ذلك الفنان الشهيد هي الصيغة الجامعة التي تتجاوز كافة الطوائف الدينية، وهي في ذات الوقت الصيغة المانعة للتعصب والتنافر، حيث أنها تساوي بين جميع من ينطقون بلسان الضاد أياً كانت انتماءاتهم العقائدية.
استحضرت هذا الرسم المعبر وأنا أشاهد على شاشات التلفزة بعض العرب يستجدون الساسة الغربيين أن “يأتوا ليحكموهم”، تصوراً منهم أن عودة المستعمر القديم هي الدواء لصيغة المحاصصة الطائفية التي تسود أكثر من قطر عربي أو قد يكون المخرج من نفق الاقتتال الداخلي المظلم على أساس الديانه الذي ضرب المنطقة على مدار العقد الماضي.
هذا التصور الساذج ينسى أصحابه أو يتناسون أن هؤلاء الذين يستنجدون بهم هم من أوجدوا هذا المناخ الطائفي المسموم في بلادنا طيلة فترة استعمارهم لها، كانت فكرة العروبة الجامعة تهديداً لهؤلاء حيث استبدلوها بتقسيمات عرقية ودينية بحتة.
فقبل مجيء الاستعمار الأوروبي إلى بلادنا وخاصة المشرق العربي في القرن التاسع عشر،عرفت المنطقة محاولات عدة لتأسيس دولة مدنية لا تفرق بين المواطنين على أساس العقيدة.
كانت البداية في مايو من عام ١٨٠٥ حين ثار المصريون على واليهم العثماني خورشيد باشا، وولوا حاكماً اختاروه بإرادتهم الحرة وهو محمد علي باشا، وصاغ ممثلوهم من فقهاء وشيوخ طوائف الحرف ما عرف بالمشروطيه وهو ما يمكن وصفه في عصرنا الحالي بوثيقة دستورية توضح حقوق الحاكم والمحكوم.
بدا واضحاً حرص من وضعوا المشروطية على أن يكون بين الموقعين عليها ممثلون للأقباط حتى تكون وثيقة تشمل كافة سكان مصر.
وحين تمكن إبراهيم باشا ،نجل محمد علي وقائد جيشه، من ضم بلاد الشام إلى ولاية أبيه فيما يسميه الكاتب الصحفي الراحل محمد عوده “أول دوله عربية موحدة” ساوت هذه الدولة التي دامت نحو عشر سنوات بين كافة مواطنيها.

وتشير المؤرخة المصرية الدكتورة لطيفة محمد سالم في كتابها عن “الحكم المصري في الشام” إلى أن الإدارة المصرية في الشام تألقت في إدارة “الشأن الديني” حيث “أعلنت المساواة بين الأجناس والديانات والغيت الفوارق الموجودة ومنحت الحرية الدينية ونشر ذلك على الجميع ونودي به في الشوارع والأزقه”.
ورفع إبراهيم كافة الأعباء المالية التي كانت مفروضة على مسيحيي الشام وتم القضاء على ظاهرة قاطعي الطرق الذين كانوا يتعرضون للحجاج المسيحيين المتوجهين إلى القدس مما زاد عدد الوافدين على المدينة.
ولمنع أية صدامات بين الطوائف المسيحية المختلفة في القدس، كتب إبراهيم إلى متسلم القدس “لا تدعوا أحداً يعتدي على أحد ويمتنع من بينهم القيل والقال” كما أخذت الدولة على عاتقها مسؤولية ترميم العبادة ومن بينها بطبيعة الحال الكنائس والأديرة.
وتضيف سالم “فتحت باب الوظائف بأنواعها المختلفة أمام المسيحيين ولم يكن ذلك متاحاً من قبل” مما جعل أساس التوظيف هو الكفاءة وليس الانتماء الديني، كما مُثل المسيحيون في مجالس الشورى وتم الاستماع إلى رأيهم وحصلوا -في تلك المجالس- على نفس الحقوق الممنوحة للمسلمين.
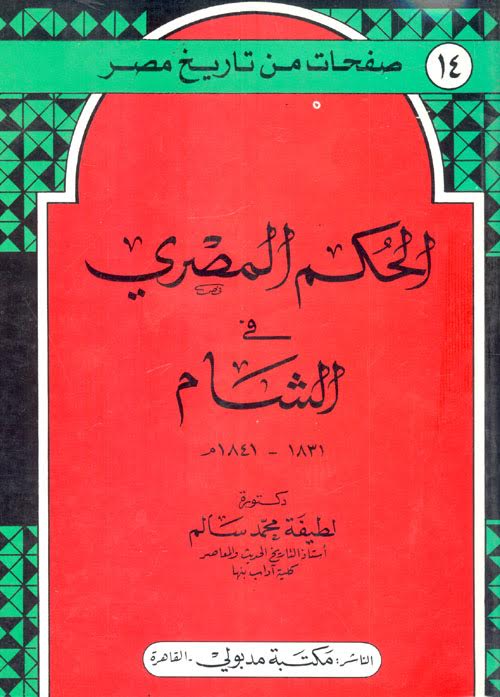
لكن الاستعمار الأوروبي أبى إلا أن يجهض هذه التجربة الوليدة، حيث بدأت السفن الأوروبية محاصرة شواطئ بيروت عبر سواحل الكرنتينا، ورفض سليمان باشا حاكم سوريا ورئيس أركان الجيش المصرى تسليم بيروت، وابتداء من 11 سبتمبر 1840، بدأ القصف لمدينة بيروت، فدمر القصف المنازل وأحرق المحال والحوانيت التجارية وقتل الأبرياء من المدنيين العزل، وواجهت القوات المصرية التى بلغ عددها 10 آلاف مقاتل قوات الحلفاء مع الجيش التركي التى وصل عددها لأكثر من 17 ألف مقاتل.
وبطبيعة الحال وبعد إجهاض التجربة تم دعم مشروع إقامه دوله يهوديه علي أرض فلسطين وإنشاء مستعمرات ليهود أوروبا، واعتبر وزير خارجية بريطانيا اللورد بالمرستون إقامة هذه الدولة في منتصف الطريق بين مصر والشام وسيلة لمنع ظهور زعامات مثل محمد علي في المستقبل.
وهو ما تكرر مع محاوله أخرى لتأسيس دولة عربية مدنية من خلال ما عرف باسم “الثورة العرابية” في مصر عامى ١٨٨١-١٨٨٢ حيث يشير الكاتب محمد عوده في كتابه “قصة ثورة” أن الانتفاضة الشعبية التي قادها عدد من صغار ضباط الجيش آنذاك كانت تحظى بتأييد الرؤساء الروحانيين الثلاثة وهم إمام الجامع الأزهر وبطريرك الأقباط وحاخام يهود مصر.

وكان طموح الضباط الشبان كما أسر أحدهم وهو محمود سامي البارودي إلى أحد القناصل الأوروبيين هو أنهاء الحكم الفردي المطلق وإقامة جمهوريه برلمانية على النمط السويسري، بل والتوسع لكي تكون هذه الجمهورية جمهورية عربية تضم إلى جانب مصر كل من الشام والحجاز.
هنا أيضاً حال المستعمرون ضد هذا الحلم وسارعوا لاحتلال مصر عام ١٨٨٢ وحل جيشها وإيقاف تجربتها البرلمانية وإعادة حكم الخديوي المطلق مدعومًا هذه المرة باحتلال عسكري أجنبي.
وحين حاول العرب تأسيس دولتهم المستقلة عقب ثورتهم على الدولة العثمانية خلال الحرب العالمية الأول، كانت سوريا مسرحاً لتلك التجربة، حيث دخل الأمير فيصل نجل الشريف حسين إلى العاصمة دمشق مع ما عرف بالجيش العربي عام ١٩١٨ وأعلن من هناك عام ١٩٢٠ قيام مملكة عربية في كل من سوريا ولبنان منفصلة عن الحكم التركي وفقا لاتفاقات سابقة مع الإنجليز.
وتشكلت حكومة في دمشق راعى فيها فيصل أن تكون ممثلة لكافة الطوائف الدينية التي تتكون منها بلاد الشام.
لكن فرنسا لم تمهل هذه التجربة أيضًا، حيث أزاحت حكومة فيصل في يوليو من عام ١٩٢٠وأقامت مكانها إدارة استعمارية كان جُل همها تقسيم البلاد على أسس دينية.
ويشير الكاتب كمال ديب في كتابه “تاريخ سورية المعاصر” إلى أن القائد الفرنسي الجنرال غورو قام بخلق دولة ذات أغلبية مارونيه في سبتمبر من عام ١٩٢٠ وشرع بعدها في تقسيم سورية إلى أربعة كيانات مذهبية: دولة سنية عاصمتها دمشق ودوله سنية أخرى في حلب ودولة ثالثة علوية ودولة درزية وهو- ويا للسخرية- سيناريو يتشابه إلى حد التطابق مع ما انتهجته الإدارة الأمريكية في العراق عقب احتلاله عام ٢٠٠٣.
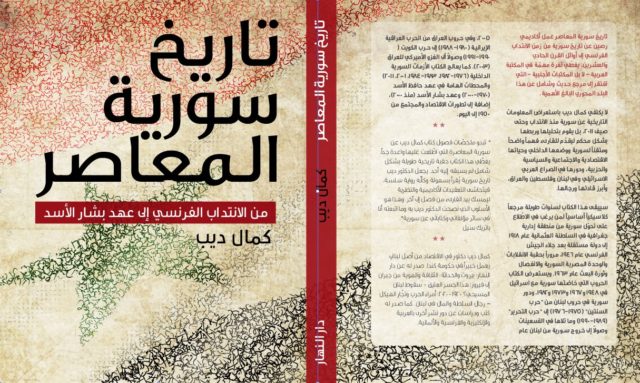
إن تصور بعض الفئات في عالمنا العربي أن الأوروبي أو الأمريكي هو مخلصها أو منقذها هو تصور تفنده كافة حقائق التاريخ الحديث، إذ لا يمكن أن يكون من زرع المرض في بلادنا هو الطبيب المداوي لهذا المرض.













