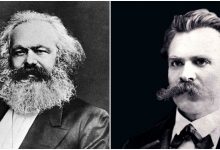كتب – تيسير خلف
نقلًا عن جريدة القدس العربي
على امتداد السنوات العشر الأخيرة، كان المؤرخ والمحقق السوري تيسير خلف، قد خطا خطوات جديدة في إعادة النظر بتاريخ أبي خليل القباني؛ إذ بدا هذا المسرحي والموسيقي الكبير، من خلال الحفريات الجديدة لخلف، شخصية نشيطة، ومحبوبة لدى الدمشقيين، العامة منهم والخاصة، خلافا للصورة التي رسمت حوله بوصفه شخصية منبوذة بعد التحريض الذي تعرض له على يد رجال الدين، كما قيل لاحقا.
ولعل الأهم في أعماله حول هذه الشخصية، أن خلف لم يقتصر في بحثه هذا على مسرحياته، أو شخصيته وأفكاره، بل كان أكثر ميلا إلى اعتبار هذه الشخصية مدخلا لإعادة النظر بالتاريخ الاجتماعي والثقافي لدمشق، في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، وكيف كانت علاقة العلماء ورجال الدين بالفن، وبالحداثة. وقد نجح في كشف اللثام عن صورة أخرى مغايرة للصورة الكلاسيكية، التي حاولت القول بأن عصر القباني كان عصرا مظلما، سيطر فيه رجال الدين على المشهد، ومنعوا أي مظهر من مظاهر الحداثة.
ولعل هذه الصورة هي التي حاول الراحل سعد الله ونوس رسمها لنا في مسرحيته «سهرة مع أبو خليل القباني» التي صدرت بعيد هزيمة يونيو/ حزيران، يومها كان ونوس وصادق جلال العظم وغيرهما قد وجدوا أن الدين هو سبب الهزيمة، وأن سيطرة العقل الديني، كما جرى تخيله مع القباني، هو الذي أجهض أي نهضة عربية.
وما يلاحظ أن خلف، وبعد أن تتبع رحلة القباني المجهولة إلى شيكاغو، والموقف الإيجابي لقسم من العلماء مع مسرحياته في دمشق، عاد في السنتين الأخيرتين ليجمع خيوطا وأحداثا أكثر عن فترة القباني، من خلال الكتابة عن بعض الشخصيات التي كانت قريبة من القباني في تلك الفترة، أو كانت تحوم في المحيط ذاته الذي كان يشتغل فيه هذا الفنان؛ وكانت أول الأعمال حول شخصية هدى كوراني، وهي فتاة لبنانية، سافرت وشاركت في المعرض الذي شارك فيه القباني في شيكاغو 1893؛ أما العمل الآخر فتمثل في إعادة إحياء مذكرات مسرحي مصري يدعى عمر وصفي، الذي عمل لفترة طويلة مع القباني في مصر، قبل أن يرافقه في زيارة إلى دمشق وحلب، وهناك رسم لنا وصفا إثنوغرافيا مدهشا وطريفا حول المجتمع السوري في نهاية القرن التاسع عشر.
وكان عمر وصفي، قد نشر مذكراته في مجلة «الصباح» القاهرية طوال عام 1931، في ست وثلاثين حلقة، وقد أعاد خلف جمع مذكراته، وهو أمر لم يكن باليسير، في ظل فقدان جزء كبير من الحلقات، ما أجبره على البحث في أكثر من جامعة ومصدر ليكملها، ويعيد تحقيقها من جديد، إلى جانب تحقيق نصوص ممثلة مسرحية سورية، مريم سماط. ولعل ما يسجل لخلف في هذا العمل، أنه حافظ على اللغة المركبة للمؤلف (فصحى/عامية) بدون أن يتدخل مثلا بالجانب العامي، ويعمل على نقله بلغة فصيحة، كما فعل عدد من المؤرخين والمحققين، في سياق تحقيقهم لبعض النصوص في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ما أتاح لنا الإلمام بلغة تلك الفترة، وبشخصية وصفي الطريفة والمرحة، التي سيلاحظها أي قارىء لهذه المذكرات.

من هو عمر وصفي؟
في هذه المذكرات، التي ستصدر خلال الأيام القليلة المقبلة عن منشورات المتوسط/ميلانو، يوفر لنا وصفي مادة أثنوغرافية عن حياته وعن علاقة المصريين بالفن في نهاية القرن التاسع عشر. كان والده يعمل مؤذنا وقارئا في مسجد الحسين، وفي أحد الأيام سيصطحبه إلى مدرسة شويكار هانم، ليكمل حفظ القرآن، كي يتولى وظيفته بعد وفاته. لم يدرك الطفل يومها، أن والده كان يشعر بدنو أجله، ولذلك فضل له هذه الوظيفة على إكمال تعليمه باللغة الفرنسية، وما هي إلا أيام حتى توفي الوالد، لكن وصفي كان ما يزال صغيرا، إذ لم يبلغ يومها الثانية عشرة من عمره، ولذلك لم يتمكن من أداء كار والده بدون تعلم علم الفلك والتجويد، ولذلك ستقرر عائلته إرساله إلى الأزهر، وهناك، كما يذكر، أجبر على خلع «البدلة الإفرنكية» وارتداء عمامة وجبة وقفطان، «أصبحت شيخا صغيرا اسمه السيد عمر محمد الميقاتي». وفي أحد أيام الدراسة، ولحسن حظه كما يقول، اصطحبه أحد أصدقائه إلى منطقة بولاق، لرؤية عرض مسرحي، وكانت أول مرة يسمع عن «المشخصاتية» بعد هذه الزيارة أخذ يرتاد هذا المسرح لمدة شهرين، وفي إحدى زياراته سيطلب من أحد المخرجين المشاركة في أداء دور صغير، وبالفعل وافق الرجل على تكليفه بدور خادم في الرواية، وبعد أداء هذا الدور سيتاح له الدخول أكثر إلى هذا العالم، والمشاركة في مسرحيات أخرى.
ومما يذكره عن بداياته المسرحية، أن موقف الأهالي والعائلات من عمل أولادهم في التمثيل كان موقفا سلبيا، ولذلك ومن «شدة خوفنا أن يظهر أمرنا وننكشف.. اتفقنا على أن نكتم أمرنا، وأن لا نبوح لأي كان بأننا سوف نمثل في المسرح، وكان لا بد لذلك من أن نغير أسمائنا» وهكذا أطلق على نفسه اسم عمر وصفي.
أخذ الإقبال يتزايد على المسرحيات التي شارك فيها مثل مسرحية «هند بنت الملك النعمان» وقد عمل في البداية مع فرقة ميخائيل جرجس، الذي كان صاحب خمارة قبل أن يتحول إلى داعم وممول للمسرحيات، وقبل العمل وقف وصفي على شاطئ النيل، ونزع عمامته وألقاها في النهر، ليكمل دربه مع الفرقة الجديدة في بني سويف وأسيوط، في أداء مسرحيات تاريخية. ومن الأمور الطريفة التي يأتي على ذكرها هنا حادثة، قد تذكرنا قليلا بما درسه بعده بعقود الأنثربولوجي المصري سيد عويس في كتابه «رسائل إلى الإمام الشافعي» ففي أحد الأيام كان زميلهم محمود حبيب جالسا على باب التياترو، فتقدم إليه رجلان من الفلاحين في يد أحدهما ورقة كبيرة، ووقفا على مبعدة منه وهما يترددان في التقدم، فنظر إليهما المرحوم حبيب متطفلا وسألهما ما حاجتهما؟ فأجاب أحدهما أنهما سمعا أن هارون الرشيد سيحضر هذه الليلة (كانت المسرحية حول الرشيد) فتوسلا إلى الأستاذ حبيب أن يرفع عريضتهما إلى هارون الرشيد، لأنهما يشكوان العمدة والصراف سوء معاملتها، ولا شك في أن الرشيد يستطيع أن يأمر العمدة والصراف أن يمنع عنهما الأذى.
فيلم الورشة الذي ظهر فيه عمر وصفي
اللقاء مع أبي خليل
كان قد ظهر في مصر أبو خليل القباني بفرقته السورية عام 1890، ولأول مرة شاهد في هذه الفرقة رقصة السماح المربع والدبكة، كما ظهرت كذلك فرقة سليمان القرداحي من جديد، وكانت فرقة إسكندرانية جميع ممثليها من الإسكندرية من بينهم علي وهبي، والشيخ درويش المشيشي، والشيخ إبراهيم أحمد الإسكندراني، كما ظهرت فرقة إسكندر فرح التي تكونت من شراكة عائلة بيروتية تشتغل بالصياغة (والممثلة مريم سماط) وقد عملت هذه الفرقة على ضم الشيخ سلامة حجازي، فأقبل الجمهور إقبالا كبيرا، في هذه الأثناء كان العمل مع جرجس، قد أوصل وصفي لقناعة بأن التمثيل عمل «ابن كلب كما يقولون عنه الآن» إذ كان عليهم الانتقال من مكان لآخر، وتمضي بهم الشهور بدون رؤية عائلاتهم، بينما لم تكن الفرق الأخرى تغادر العاصمة إلا نادرا، ولذلك تمكن من الانضمام لفرقة القباني. وكان القباني قد اتفق مع شريكه عبد الرزاق بك عناية على إعداد دار جديدة للتمثيل قريبة من مسرح إسكندر فرح، فاستأجر قطعة أرض كبيرة أمام سوق الخضار في العتبة الخضراء، وابتدأ العمل على تأسيسها.
كان القباني كما يذكر، طيب الخلق، لا يسمح للممثل أن يهفو هفوة في النحو، أو الصرف، وكان موسيقيا عظيما أكثر منه ممثلا، كما بدا آنذاك ظاهرة شعبية، فقد كان أدباء العصر يزورونه، ومما يذكره عن مسرحه، أن عروضه شهدت إقبالا كبيرا للغاية، مع ذلك، بقي الجمهور يحجز تذكرتين واحدة لمسرحه والأخرى لمسرح إسكندر لسماع الشيخ سلامة، ولذلك قرر القباني الذهاب إلى سوريا، لجلب صوت ينافس به صوت هذا الرجل. في هذه الأثناء، سيرافق وصفي القباني في رحلته هذه، وهنا سنعثر على مشاهدات وصور شديدة الذكاء حول المجتمع السوري، وعاداته، وعن مقارنات ذكية بين أحوال وعادات المصريين والشوام، وربما الجميل في سرده هنا، أنه بدا معجونا بالنكتة المصرية. ومما يذكره عند وصوله لدمشق، أن بيت القباني بدا وكأنه قصر، وفي كل غرفة نافورة. إلا أنه يبدو في أماكن أخرى متململا ومستغربا من طرق الدمشقيين في مجاملة بعضهم، كما يذكر أن الأركيلة كانت تقدم لهم في الجلسات، «وفي هذا المنزل، بل ربما وفي كل بيوت أهل هذه البلد، لا أحسب أن في البيت أقل من أربعين منها» ولعله يبالغ في ذلك.
توثيقي عن مسرح أبو خليل القباني
فطور شامي
ومما أثار دهشته أيضا أن القوم كانوا يخرجون في ثيابهم من الصباح وبلا إفطار «ولكنني علمت أننا مدعوون إلى الفطور، ولعلك مثلي (في إشارة للقارئ المصري) لم تسمع من قبل هذا بدعوة على الفطور في الصباح». ومما كتبه أيضا أن التمثيل في دمشق كان صامتا، فلم يكن التمثيل الناطق مباحا في تلك البلاد، خشية التعرض للسياسة، أو ما يشتم منه رائحة التعرض للسلطان. ولا ينسى ما وجده في المدينة من تنعم أهلها وعنايتهم بالرياضة الفكرية بين الحدائق والبساتين، فعقب صلاة العصر تغلق متاجر المدينة كلها، ويخرج الأهل إلى الرياضة بين الأنهر الجارية في الحقول والحدائق «واحذر أيها السائر فالويل لمن تطلع لحسناء في الطريق بنظرة خبيثة أو ابتسامة مغرية أو كلمات بذيئة».
وبعد دمشق، سافر القباني ووصفي إلى حلب، وسيمران في الطريق على حمص، وقد بدت له هذه المدينة أقرب إلى قلبه من دمشق، ولا نعرف ما سبب هذا الشعور، لعله يعود لامتلاك أهلها حس الفكاهة ذاته الذي تميز به، ومما يذكره أنه قد اشتكى من الرسميات المبالغ فيها في دمشق، فما كان من القباني إلا أن أخبره عند اقترابهم من مدينة حمص: «سوف تجد في حمص ديمقراطية ولهوا وتسلية ما ينسيك رسميات دمشق» ولا نعلم هنا ما الذي قصده القباني بكلمة ديمقراطية، وهل كان يستخدمها بكثرة في تلك الفترة؟ أم جرت إضافتها لاحقا من قبل وصفي؟
وقد وجد أهالي حمص يلهون ويلعبون ويعبثون عبثا بريئا ويعدون، وكأنهم أطفال صغار، وكان يقضي النهار بين ضحك ولعب وجري ولكن ..»لا شراب، نعم لا شراب هنا». بعد ذلك سيمران على مدينة حماة، وهناك سيسجل أنه وبينما كان ينتظر الطعام، فإذا به يحس بعبير وقد ملأ الجو ..»عبير لم أستنشقه من زمن بعيد في هذا الجو الصالح الورع، وأخيرا عبير العرق ..عرق الزبيب».
وقد عانى هو والقباني في الطريق إلى حلب من مشقة الطريق واللصوص، بيد أنهم وصلا ولم يعثرا على مغنيتهما، إذ كانت قد رحلت إلى بيروت، ولذلك قررا السير إلى مرسين لأخذ سفنية تقلهم إلى مصر، ومما يذكره في مرسين أن سكانها كانوا أتراكا.
ولا ينسى هنا العودة لأبي خليل من جديد، فقد كان ذا لحية مستديرة يضع على رأسه طربوشا يلفه شال اغباني، ويرتدي قفطانا من الحرير، وعليه جبة قصيرة، وكان الرجل يوم صرف المرتبات يطلب كل ممثل منفردا في غرفته فيجلسه إلى جانبه، ويأمر له بالقهوة، ثم يقص عليه قصة ظريفة، أو يتلو نكتة ظريفة، ثم يقدم له المرتب ملفوفا في ورقة عليها اسم الممثل، وفي ذلك ما يدل على مبلغ تواضع هذا الرجل وظرفه.
بعد القباني، عاد وصفي للعمل في فرقة القرداحي، وسافر معه إلى بيروت في عام 1901، ومما يتذكره، أن البيروتيين كانوا يصمتون أثناء التمثيل فلا تسمع همسا، ولا كلمة تقطع على الممثلين حديثهم، بل إنه سكون عميق وانتباه لا يقطعه إلا صوت النرجيلة، و«هذه النرجيلة هي ذراع ثالثة للسوري.. ليس في وسعه التخلي عنها حتى في أماكن التمثيل». ومما دوّنه أيضا رؤيته حول قبضايات بيروت، وهيئتهم وأجسادهم، بل حتى لكنتهم، وكيف كانوا يشتمونه أحيانا. واضطر مرة أخرى إلى ترك فرقته، وكان ترك الفرق، وفقا لوصفي، أمرا عاديا. ولا ينسى أن يصف علاقات الممثلين ببعضهم، إذ يذكر أن الهيام والهوى لم يكونا قد عرفا الطريق إلى قلوب الممثلين، كما تشهد هذه الأيام، وكأنه يشير إلى أن الجيل الأول كان اكثر التزاما بالفن، أو ربما ظروف الفن وتحسنها دفعت الفنانين أكثر للبحث عن المتعة والحب، ويقول أن الممثلين كانوا شديدي الحرص على الشرف.
ويذكر في حلقاته الأخيرة أنه أصيب بمرض غامض أجبره على الجلوس بيد أنه سيبقى متابعا لأعمال الفرقة، وبعد هذا، لن نتمكن من الاستمتاع ببقية قصته، لأنه كما يبدو قد توقف عن نشر حلقات جديدة حول سيرته الشيقة والممتعة، لنخسر بذلك فصولا من واحدة من أغنى وأمتع السير الذاتية الفنية المبكرة في عالمنا العربي.