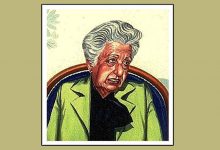تطوقني المدينة، بطرقاتها الضيقة وبيوتها القديمة التي تختفي تباعا، تخبرني المدينة أنَّها في الصباح الباكر كثيرا ما تخطئ معالمها.. كثيرا ما تجد نفسها باكية عند النهر، المدينة التي تجنبت ضفة النهر الأخرى أزمنة طويلة.. صارت توغل في ذلك الاتجاه.. حتى أنَّها حملت في ملابسها آخر مرة ذرات رمل وأشواك صبار وبعض ثمار جافة.. بعدها نفضت المدينة عنها بهجتها الخضراء، وارتدت أثواب الغبار في ظهيرة ستمتد بامتداد الفصول، فلا أعرفها ولا أصطفيها ولا أنكرها نكرانا كاملا بأثر المودة الباقية.. حيث يسهل أن ينقبض قلبي في أوبة وئيدة، إثر تذكار قديم يندلع من شرفة واطئة مَلَّتْ المشهدَ الواحدَ في شارع ينتهي إلى حائط.
أنسالُ كما موجة رائقة عند الغروب من طرفها الشمالي حيث تتحرر ضفتي النهر من كل قيد غير تلك النباتات الغابيَّة النامية في تجمعات متداخلة، تنحدر قليلا نحو الماء في رسوخ، أعرف رائحة الليل آتيا بابتسامة باهتة يحمل نسائمه الرطيبة إلى وجهي.. في طريقي الوعرة قبل أن أصل إلى الجادة التي صنعتها يد التحديث الغشوم.. سَأُخَلِّصُ القلب من بعض متاعبه بالسير المتسارع عكس تيار النهر.. نصف ساعة من المشي تعيد لتلك الشرايين حيويتها؛ طاردة عنها مسببات الضيق والاختناق والصور الشائهة للرفاق الراحلين في كامل بهائهم الثوري إلى حيث لم يعد بإمكان أحد معايرتهم بالنقاء والمثالية واليسارية الطفولية.. ما أشقَّ رحلة الماء!
رأيت الأبنية تتراص على طول الطريق بموازاته لا تأبه لمعاناته في رحلة شقائه الأبدي.. رأيته جوارا لا يعرف الحقوق ولا الصلة.. جوار للتباهي والتمايز الطبقي السافر.. من ناحية أخرى كانت يعتبرونها وجه المدينة الذي يُصبغ بالأبيض الناصع كلما زادت معدلات الجوع والخوف والتلوث في أحشاء أحيائها الداخلية، أو عند اقتراب حلول مسئول ينحدر من العاصمة متأففا في زيارة خاطفة يفرضها روتين العمل.. لكنها من ناحية أخرى كانت تتمرد على ذلك الوضع المصطنع المداهن؛ فتنفض عنها بسرعة هذا الأبيض الميت مستعيدة ملامحها الأولى.. كما أنها تُفَضِّل الخواء فلا تبقي ساكنيها بين أحضانها طويلا. تبعدهم إلى التغرب في البقاع البعيدة.. وتهدأ بوضع تلك السلاسل القوية على بواباتها الخارجية.
عندما جلست لبعض دقائق لأستريح؛ جاء واتخذ مكانه الأثير قُبالتي وقال: قل شهادتك.
قلت: الحق أقول أن طبيعة الماء الكامنة في روح المكان بالغمر والإحاطة باليابسة فيما يشبه الحصار- أورثتنا منطق الجُزر في انقطاعها وعزلتها وتوجسها وتَمَثُّلاتِها الجوانية.. هنا نرتاب طوال الوقت، ونصنع من الشك قصصا نبقيها بمعزل عن متناول الأطفال؛ ليشبوا مثلنا لهم القدرة على البكاء منفردين في الليل؛ إذا هم داهمتهم مشاعر الضعف؛ فيتجدد فيهم قانون الفرد الذي يؤطر ذواتهم.. أقول هنا.. حيث لا نُكران؛ فهو معروف لدينا على نطاق واسع، يتبادل معنا تحية الصباح، ومن يلتقيه منا ساعة الغسق يُقرِئه السلام من الجميع.
حين اغتربت اختارت لي أقداري مدينة الجبال التي تعرف الماء معرفة طفيفة في مواسم الغيث والثلج والبرد.. صرتُ تنتابني رؤى الجدب.. استعارُ العطش بجفاف الريق وتحجُّرُ الحلق.. أحلامٌ تعود بي لأرى انحسار البحر وغَوَرِان النهر وانكشاف البحيرة عن مئات الجثث في ثياب الجند والصيادين والعمال.. هل حملت روحي إليها كل هذا الظمأ؟.

“… كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ”. نحو القلعة في أعلى الجبل سأتوجه في الصباح.. لقد أداروا قدرا من الماء بطريقة ما لينحدر فوق الصخور قبل ان يُعاود الصعود من جديد بفعل محركات الرفع عبر أنابيب تنام بحذر بين الصخور.. كان الوقت مبكرا.. ظللت لنحوٍ من ساعة أجول في المكان حتى أداروا المحرك ليبدأ العمل.. لا سبيل للوصول إلى حيث يسقط الماء.. كما أنَّ أصواتا طغت على وشيشه، وهو لا يندفع ذلك الاندفاع الذي أعرفه.. لو سُئلت عن تعريف له وقتها لقلتُ أنه الوهن.
في المدينة الثالثة أحلُّ في قيظ الصيف.. ضيفا على سبيل الحزن، أخفي أملي بلقاء الماء في مدينة التاريخ.. لا أصارح أحدا برغبتي في رؤية النهر الذي سكن الأغنيات؛ فالمناسبة عزاء ولا يصح أن أشغل الرفقة بشأن خاص.. يتجدد الحنين هنا حين تتشابه معالم المدينة بشقيقتها في إقليم الجنوب.. هذا الحنو وتلك المودة البادية لا تزيد الأمور إلا تعقيدا. بعد مُضي أيام أنهكت روحي صارحت صديقي. خذني إلى النهر. قال: نذهب في المساء. لا شيء مما رأيت يمت لمعنى النهر بِصلة. حدثني عن السدود والانطمار والانقطاع والبدد.. تركت له القصائد التي كانت معي ومضيت.
كان عليَّ أن أعود في الشتاء لأصعد الجبل الذي انشق كرامة للقديسة؛ وأشرب من ماء النبع وأدخل إلى الدير لأسمع من الكاهن شهادته المعمدة بماء المحبة عن المكان الذي مسته يد الله بالمعجزة المتحققة بالفعل والمُصدَّقَة بالشواهد.. لكنِّي ما مسني شيء من ذلك.. كنت ملحدا بتلك الطبيعة القاسية..يا لعتو تلك الشواهق.. هذا الترصد لا أطيقه.. يا رفاق: أنتم لا تعرفونني رغم طول الرحلة ومشقة السفر. أنا ابن الماء والجُزر وانبساط الوديان.. أنا متغرب في مدنكم كالطريد.. أنا مُعطل الحس بكل ما تحمله الكلمة من معان.. سلبتني مدينة الماء كل شيء قبل أن تلقي بي إليكم كوغدٍ كامل الخيبة والانكسار.. عِلَّة الروح لا شفاء لها هنا.. صدقوني. هذا الصخر لا أنتمي إليه مهما حاول إخافتي؛ فأنا ابن الطينة السوداء أنفرطُ حذرا قبل أن يجمعني الماء وتشكِّلُنِي العزلة.

صارحت نفسي أنَّ النبذ لا يعني أن أفتض القصيدة بتلك الروح العدائية.. وأن أحاول الهرب بجريرتي من الأعين الساكنة.. قلت: سأعاود المواجهة إن أنا حملتني الريح مجددا إلى حيث يصبر الناس حتى يجبر الله الخواطر.. ولا تموت الوعود في الأعين الواهنة.. ولا ينحسر الماء عن اليابسة إلا ليفيض بمهابة تليق بتدفقه وعطائه الوافر وحميمية اختلاط الماء عند المصب في وهن البرزخ أمام تجلي القدرة المانحة للحياة.. إلى حيث أنتمي بتفرد العاشق اليائس عند انحسار الوهم. هكذا قلت لأجد نفسي ذات ظهيرة حارقة أهبط سلم الحلم، لا أعبأ باللهب والغبار ولا شراسة تلك الوجوه الشرهة للإيذاء ولا المستجدية في لزوجة.. ذلك الترحيب الذي أعرف تفاصيله جيدا لم يمس مني إلا نعل حذائي.
إن الذين لم يخذلوا البحر ستغفر لهم الأمواج ذلك التغرب القسري حين يؤوبون في امتثال وهدوء.. وها أنا ذا أفعل.. أجلس قبالته في ليلة الوصول لأناجيه وقد استحضرت كامل الوعي والرهبة في آن.
قال: قل شهادتك.
قلت: أشهد الله أني لم أبرح بالروح قط. كان الجسد المُعنَّى يجول في تلك الأصقاع.. لا يَألفُ ولا يُؤلفُ تتقاذفه ريح الخواء.. أشهد أن تغرُّبه إنَّما كان ضياعا موثقا وافتقادا مؤكدا لا يُرغم القلب إلى على إياب موعود بالمسرة بزوال أثر السفر.
قلت: هل يُرى عليَّ ذلك الأثر؟
قال: لا.
قلت: ذلك لأني لم أبرح.
قال: صدقت.
رُغم ما كان بعد ذلك من حوادث أنضجت الروح على نار الأسى لسنوات بالإخفاق والتردد والعجز إلا أنَّ اعتقادا راسخا لازمني كوشم أبدي على جدار الروح، لا تطاله يد الغفلة ولا يصل إليه ارتياب.. كن دائما على عهد الماء، ولا يكونن لك من غُربة الصخر نصيب؛ فتهلك.