عرض وترجمة: أحمد بركات
قبل سنوات قليلة، قمت بتطوير نظرية داعمة حول تأثير حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مدى السنوات الأربع الماضية. كانت هذه الفكرة قد راودتني بينما كنت أقوم بتغطية الانتخابات الرئاسية الفرنسية في عام 2017، حيث كان واضحا آنذاك أن عددا قليلا للغاية من الفرنسيين يشعر بانجذاب نحو النسخة الأنجلو أمريكية لليبرالية التي يعتنقها ماكرون، لكنهم صوتوا له باكتساح ضد ماري لو بان لأنهم شعروا بأن الواجب الوطني يدعوهم إلى الدفاع عما يطلق عليه قيم الجمهورية في مواجهة شعبوية لو بان. كان الفرنسيون يمتلكون ذاكرة جمعية عن اقترابهم من – أو ربما تلاقيهم مع – الفاشية في حقبة فيشي وفي ثلاثينيات القرن الماضي. وهكذا كان الأسبان أيضا، الذين تمكنوا من وضع معسكر اليمين في بلدهم قيد السيطرة. ربما – كما اعتقدت حينها – تكمن المشكلة الأمريكية في حالة الرضا التاريخي عن الذات حد التهاون في مواجهة الحقائق. إذا كان الأمر كذلك، فإن بإمكان ترامب أن يقدم نوعا من العلاج المثلي الذي من شأنه أن يوفر لقاحا ضد مرض الاستبداد المتجذر دون أن يؤدي ذلك إلى الإصابة بمرض خطير آخر.
لكن، سرعان ما تبين لي أنني كنت مخطئا. فحالة ’التنفيس‘ الديمقراطي التي توقعت أن تصدر عنها هذه الانتخابات لم تحدث. لست بحاجة إلى سرد الأدلة، فقد سبقني إلى ذلك كثيرون. ويكفي في هذا السياق أن أقول إن ترامب استغل حالة ازدراء المعايير الديمقراطية التي كانت موجودة مسبقا ليزيدها سوءا.
والآن.. ما الذي يجب عمله؟ ومَن الذي يتعين عليه القيام بهذا العمل؟ لقد كان كل ما قاله الرئيس المنتخب جو بايدن بشأن توحيد الصف الأمريكي صحيحا، ولا أشك في أنه سيواصل قول المزيد حول هذه القضية، لأنه ببساطة يؤمن بها. وباعتباره رجلا أبيض مسنا، وشخصا خلوقا ودمثا، فضلا عن كونه – ككثير من الأمريكيين – مذعورا مما آلت إليه الأوضاع، فإن بايدن ربما يكون أصلح لأداء هذه الرسالة من سلفه باراك أوباما، الذي أثارت هويته السوداء وعضويته في “رابطة اللبلاب” (Ivy League) ضده الكثير من الشكوك والحنق حتى في الوقت الذي وجه فيه مناشدات مكثفة وحماسية للتواؤم والانسجام. لكن.. إلى أي مدى يمكن أن يفيد الخطاب الرئاسي، أو حتى الأعمال الرمزية؟
في الأيام الأخيرة، طرحت هذا السؤال على عدد من الخبراء والباحثين، أملا في الحصول على أفكار عميقة من تجارب دول وحقب أخرى. وقد اتفق هؤلاء بوجه عام على توافر نماذج شحيحة سابقة عن ديمقراطيات ناضجة ضلت طريقها قبل أن تعاوده مجددا، رغم أن التاريخ يعرض على الجانب الآخر لعدد من الديمقراطيات، مثل ألمانيا فايمار، التي هوت من عليائها وعلقت في الاستبداد. وإجمالا، لم تسد حالة من التفاؤل بهذا الشأن.
لقد أكد الباحثون منذ زمن على أن الديمقراطيات المهتزة يجب أن تُولد أولا حتى تصبح راسخة بعد ذلك. والآن يتضح جليا أن هذا المبدأ ينطبق أيضا على الديمقراطيات الناضجة في أوقات تراجع أسسها الأولى. إن الديمقراطية الأمريكية لم تهتز في فترة الكساد، كما فعلت العديد من الديمقراطيات الأوربية، لأن الرئيس فرانكلين روزفلت ابتكر حينها تجربة تدخل الدولة من أجل التخفيف من حدة الفقر واستعادة الإيمان بالنظام ذاته. وفي الوقت الذي أدى فيه النموذج الرأسمالي السائد مرة ثانية إلى الركود والخوف والاستياء، حتى في ظل الوفرة الهائلة، يتم استدعاء بايدن، الذي يمثل أحد رموز الوضع الراهن، من أجل البدء في تشكيل نظام داخلي جديد يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى كسر شوكة هذه الحالة من الحمى القومية.

لكن بايدن سوف يكون قادرا فقط على العمل حول الأطراف ما دام مجلس الشيوخ يقبع في يد زعيم الأغلبية ميتش ماكونيل، الذي يتمثل نموذج النجاح السياسي عنده في إفشال الطرف الآخر. ومن ثم، فإن تحقق نتيجة أفضل في انتخابات التجديد النصفي في عام 2022 ربما تحرر مساحة سياسية أكبر لتغيرات واسعة النطاق تتعلق بمنظومتي الضرائب والإنفاق اللتين التزم بهما بايدن. ومع ذلك، فإن الاعتماد على برنامج ديمقراطي طموح سوف يعمق فقط حالة الغضب الحزبي، على الأقل طالما أن ترامب لديه ما يقوله بهذا الشأن. ومن ثم، فإن تحقق الأهداف سوف يستغرق أجيالا، أما رد الفعل العنيف فسيكون فوريا.
إن التفكير بشأن ما ينبغي عمله الآن نحو المرض المزمن الذي تعانيه الولايات المتحدة لن يؤدي بها إلا إلى اليأس. ربما تكمن الإجابة – إذن – في الرجوع خطوات إلى الوراء والتفكير في إجابات طويلة المدى توفر إشباعا أقل فورية. في هذا السياق، يعتقد معظم الباحثين الذين تحدثت إليهم أن البنى والهياكل السياسية الأمريكية قد قادت الأمريكيين إلى طريق مسدود، وبالتالي يتعين عليهم تغيير هذه البنى حتى يجدوا لأنفسهم مخرجا. ومن ثم، فإن أي إصلاحات من هذا القبيل قد يتم إعاقتها من قبل المقاومة الحزبية التي ستثيرها أي أجندة جديدة تتعلق بالضرائب والإنفاق. رغم ذلك، يجب أن يبدأ الإصلاح الهيكلي على مستوى كل ولاية قبل الارتقاء إلى مستوى السياسات الوطنية العامة.
في هذا السياق، أكد “لي دروتمان”، من “مؤسسة نيو أمريكا”، أن نظام الحزبين أشبه بالطريق المسدود الذي يشعر فيه كلا الحزبين بأنه “لا يمكنك التخلي عن شبر واحد، وإلا ستخسر الحرب برمتها”. وفي كتابه الجديد، Breaking the Two-Party Doom Loop: The Case for Multiparty Democracy in America (الهروب من حلقة الموت: قضية الديمقراطية التعددية في أمريكا) دعا دروتمان إلى التحول إلى نظام التعددية الحزبية.
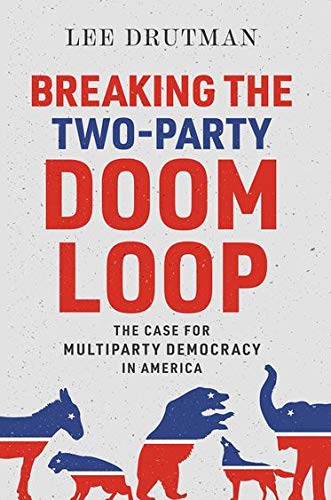
لقد أشار دروتمان إلى أنه في ثمانينيات القرن الماضي علقت نيوزيلندا – صديق اليوم المقرب للولايات المتحدة – في نظام حكم جامد ومعطل حتى أوصت إحدى اللجان الوطنية بالتحول إلى نظام التعددية الحزبية على النموذج الألماني يسمح للناس بتصنيف أنفسهم وفقا لآرائهم الفعلية ومنح هذه الرؤى قدرا جديدا من التمثيل السياسي. واقترح دروتمان أن يشكل الرئيس بايدن لجنة كهذه، وأن يكلفها بتقديم توصيات بإصلاحات واسعة النطاق بحيث لا يستطيع أي من الحزبين التأكد مسبقا مما إذا كان سيفوز أو سيخسر من وراء هذه الإصلاحات.
ورغم عدم إمكانية إصدار مرسوم بتغيير البنى الحزبية، إلا أنه بالإمكان تغيير نظام التصويت. ففي “نظام الفائز بأكثر الأصوات”، كذلك المعمول به في الولايات المتحدة، يفوز فقط الحائز على أكبر عدد من الأصوات في الدائرة الانتخابية. وغالبا ما يعجز ’الحزب الثالث‘ عن جمع أصوات كافية للفوز. وقد أبدى كل من دروتمان ولاري دايموند، المتخصص في دراسات الديمقراطية في “مؤسسة هوفر”، تأييدا كبيرا لنظام التمثيل النسبي في الدوائر متعددة الأعضاء، حيث يختار الناخبون حتى خمسة مرشحين في الدوائر الانتخابية الكبرى، وهو ما يسمح للأحزاب الجديدة بالحصول على مقاعد. ويعتبر دايموند أحد أكثر المتحمسين لنظام “الاقتراع بالاختيار التراتبي” (أو الاقتراع التفضيلي)، الذي أسماه بـ “الإصلاح الرئيسي”، والذي من شأنه أن يمَكن لمجموعة من الإصلاحات الأخرى. فبمجرد أن يتمكن الناخبون من إدراج خيار ثان أو ثالث، فإن مرشحي الأحزاب الكبرى سيكون لديهم حافز للتمدد إلى ما وراء قواعدهم للحصول على أصوات هؤلاء الذين يفضلون مرشحا آخر. وقد أكد دايموند أن هذا من شأنه أن يكبح جماح تطرف الحزب الرئيسي وأن يقدم حوافز مشجعة للأحزاب الأخرى.
يكمن الحل طويل الأمد المفضل لدي في الديمقراطية التشاورية والتشاركية، التي تتماهى مع شيء عميق جدا في الشخصية الأمريكية وفي التقاليد السياسية الأمريكية. لقد كان انخراط المواطنيين العاديين في المناصب المحلية وهيئة المحلفين هو ما أقنع ألكسيس دي توكفيل بأن الديمقراطية لا يجب أن تتردى إلى أن تكون شكلا من أشكال الديماجوجية. لقد أفسح عالم القرية الصغيرة الذي نعيش فيه المجال لثقافة نوادي وآلات المدن الكبرى الأكثر صخبا وتحضرا، تلك الثقافة التي كانت بمثابة أدوات للمشاركة السياسية لأجيال من الوافدين الجدد.
ثم تلاشت هذه الحقبة مع صعود الدولة القومية (الدولة التنين عند توماس هوبز) والسياسات الوطنية المتشددة. ويجب الآن العثور على وسائل جديدة لحقبة يعبر فيها المواطنون عن إحساسهم باللامبالاة تجاه دورهم كمواطنين، وربما بعبثية هذا الدور. ففي عام 2019، أسس دايموند وزميله جيمس فيشكن تجربة “”America In One Room، التي جمعت 526 مواطنا من خلقيات وقناعات فكرية متباينة في مناقشات امتدت على مدى أربعة أيام حول موضوعات مثيرة، مثل الهجرة. وقد أعلن عدد قليل من المشاركين تغير قناعاتهم، لكن كثيرين أبدوا مزيدا من الاحترام تجاه مصداقية وجدية هؤلاء الذين يحملون قناعات أخرى، فيما تم تصنيفه على أنه نتيجة تبعث على الأمل.
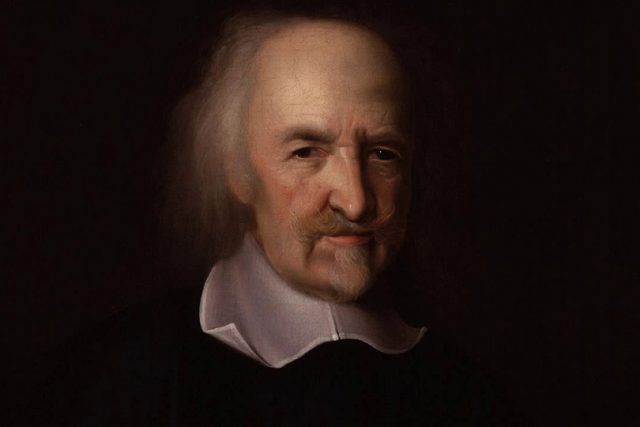
لا شك أن الديمقراطية التشاورية تمثل خيارا جيدا في ذاته. وإنني لآمل أن يوافق العديد من المليارديرات ممن يحملون الهم العام التكفل بهذا النوع من التجارب. لكن النقاش دونما أمل في تغيير أي شيء لا يؤدي سوى إلى التباعد. إن الديمقراطية التشاركية الحقيقية، حيث يكتسب المواطنون قدرا ما من سلطة صناعة القرار، لا يمكن أن تتحقق على الأرض إلا عندما يوافق المشرعون الحاليون على التنازل عن بعض سلطتهم.
—————————————————–
جيمس تروب: كاتب في مجلة Foreign Policy، وزميل في “مركو التعاون الدولي”، التابع لجامعة نيويورك، ومؤلف كتاب What Was Liberalism? The Past, Present and Promise of a Noble Idea
*هذه المادة مترجمة*
يمكن مطالعة النص الأصلي باللغة الإنجليزية من هنا









