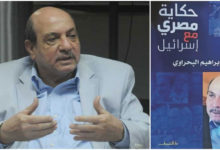زرت السودان مرتين، كانت الأولى في نوفمبر 2007 عندما سافرت بالفعل ضمن وفد إعلامي مصري للخرطوم لحضور إحدى المناسبات هناك، وكانت الثانية في صيف 2011 عندما قرأت بالقاهرة جانبا كبيرا من مشروع عبد العزيز بركة ساكن الروائي، حين حل بها ضيفا مؤقتا في محطة انتظار وترقب لمنفى إختياري بعد سنوات طويلة من التضييق والمعاناة.
في المرة الثانية كانت الرؤية أعمق وألذ وأكثر شغفا. سافرت بعقلي وخيالي إلى أرض السودان وناسها لأشاهد وأتابع شوارعها الخلفية وبيئاتها المتنوعة من خلال أربعة روايات شيقة صدرت للروائي عبد العزيز بركة ساكن عن دار رؤية للنشر بالقاهرة، وهي “العاشق البدوي”، “رماد الماء”، “الطواحين”، و” الجنقو: مسامير الأرض”.
وكانت الأخيرة هي التي فازت قبل أيام بجائزة الأدب العربي في باريس بعد أن نقلها إلى اللغة الفرنسية كزافيير لوفان، وهي جائزة هامة يمنحها معهد الأدب العربي في فرنسا، بالتعاون مع مؤسسة جين لوك لاجاردار، بشكل سنوي للروايات العربية المترجمة إلى اللغة الفرنسية.
بدا الخبر لي مُبهجا لأنني توقفت كثيرا عند روايات ساكن وما تقدمه من مشاهدات مُدهشة للحياة في السودان، وقررت متابعة مسيرته الأدبية باعتبارها نمطا مُختلفا للأدب الهارب من قيود المجتمع والسلطة على السواء.
كنت قد التقيت بالأديب السوداني قبل نحو عشر سنوات في القاهرة، وشعرت أنه مُبدع فريد، لديه قدرة حكي عظيمة، مشدود رغم غربته بجذور قوية تربطه ببلاده التي تعشق الثقافة وتستنشق الإبداع، وأدركت من حوار خاص معه كيف قاوم بخيال لذيذ خلاب لا حسابات له، حواجز القهر السلطوي، وتحدى قمع المُجتمع مُدعي التدين.
كان المبدع الشاب الواقف أمامي في القاهرة (وقتها) يتحدث عن جمال بلاده المحجوب بواسطة أدعياء الدين، يسرد باعتزاز سحر أرضه وناسها، ويفخر بقيم الصفاء والمودة والأخوة السائدة والمُستقاة من المُجتمع القبلي الفطري غير المؤدلج والمُسيس. كان لديه إصرار أن الصراعات مصطنعة وأن الحروب مُتعمدة وموجهة لخدمة مصالح ضيقة، وأن الناس بطبيعتها تنشد السلام والأمان.
كان محدثي يُعبر عن ضيقه بالرقابة وسطوتها وأردية الدين التي يرتديها النظام السوداني في وجه معارضيه، ويرى أنه لا سبيل للمقاومة إلا من خلال الكتابة، والكتابة هنا هي الكتابة الصادقة الجميلة والعفوية، والقادرة على التأثير فيمن يتلقاها.
ربما رأى عبد العزيز بركة ساكن أن فراقه للوطن، وتشتته في تجربة الاغتراب لاجئا ضرورة ليبقى قادرا على رسم بلاده للعالم أجمع عبر الأدب كما أحبها، لا كما حاولوا تصويرها.
من هنا لم يكن غريبا أن يعلن الأديب حلمه بسيطا كحديثه، فهو لا يرغب سوى في في حياة هادئة، بلا قهر أو كراهية، بلا تكفير أو تخوين، ساعيا نحو فرصة استقرار وعيش في أوروبا حيث المدنية، والتحضر، وإحترام سيادة القانون.
وفي سبيل حلمه، كان على عبد العزيز بركة ساكن أن ينتقل من بلد إلى بلد، ومن محيط ثقافي لآخر ليستقر في النهاية في مدينة مونبيليه بفرنسا، ليبزغ هناك كمبدع عربي معروف يقدم كتابة مختلفة بلغة متجددة.
بالطبع كان الرجل يعي جيدا أن استمراره في الكتابة أمر لا فصال فيه، ليُقدم كلمة الإنسان المقاوم للحرب، للدمار، وللوجع الذي لا تبرره مصالح، أو أيدولوجيات أو عقائد دينية.
وقال لي عبد العزيز بركة ساكن الذي ظللت على اتصال به بفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة عقب نبأ فوزه بالجائزة، إنها إعتراف بأن الكلمة هي أفضل مقاومة للصراعات الأزلية لبني الإنسان.
فالتكريم، والإحتفاء أي كان نوعه يعد دليلا واضحا على أن المدنية والتحضر والتعايش تنتصر في النهاية باعتبارها القيم الحاضنة للإبداع والجمال، وأنه لا سبيل للإنسان من الثقافة والابداع لأنها لغة التواصل بين المختلفين لغة، لونا، وعقيدة.
وأوضح الروائي السوداني أنه سعيد لأن رواية “الجنقو.. مسامير الأرض” تحديدا هي الفائزة بالجائزة لأن هذه الرواية تمثل ـ في رأيه ـ صرخة احتجاج ضد الحروب والصراعات الدموية، وتنتصر للتسامح الديني وتقبل الآخر، فقد ولدت في ظل أوجاع إنسانية عايشها وتابعها بنفسه.
والحقيقة، فإن الأوجاع الإنسانية مثلت جانبا هاما في تشكيل شخصية الكاتب السوداني و ساهمت في تكوين جانبا هاما من مشروعه الأدبي، فالرجل الذي ولد وتربي وعاش طفولته ومراهقته وشبابه في ظل حروب وصراعات طويلة ومريرة، آمن بالسلام والتعايش بين المختلفين كأساس عام ينبني عليه مجد الإنسان.
حروب دائمة
ولد عبد العزيز بركة ساكن في مدينة كسلا، شرق الخرطوم سنة 1963 وكان والده جنديا بالجيش، ومات كثير من أقاربه في حروب غريبة نشأت وتواصلت نتيجة صراعات تافهة، ولم تترك للناس سوى الخراب والوجع والمعاناة.
وعلى مدى نصف قرن وأكثر والحرب دائرة لا تنقطع في مناطق مختلفة من السودان: في الشرق، وفي الجنوب، وكردفان، ودارفور، والخرطوم نفسها وكأن الحرب فعل اعتياد يومي لدى الناس، وكأن مشاهد القتلى وحكايات المشردين أمرا مكتوبا على الجميع.
كُل ذلك أولد نفورا وكراهية شديدة لدى المبدع الصغير تجاه الحرب والقتل، وربما شعر في قرارة نفسه أن مهمته الأولى ـ كمبدع ـ هي أن يصرخ في وجه القتلة ليتوقفوا.
وهنا، لم يكن هناك أفضل من الحكاية للجهر بكلمة “لا” عالية ضد الحروب وموجات الكراهية، وكان الفتى الصغير قد تعلم فن الحكي من جديه اللذين ارتحلا من أرض لأخرى، ومرا بغابات ووديان ومُدن عديدة ليستقرا في النهاية في كسلا بعد أن عايشا أعراقا متباينة.
وقال ساكن في إحدى محاوراته الصحفية السابقة أنه نشأ في بيئة تحتفي بالغرائب،فلم يكن يمر أسبوع أو شهر إلا ويتداول الناس حوله حكاية مدهشة حدثت للبعض، ولم يكن مهما إن كانت تلك الحكاية قد حدثت بالفعل، لكن المهم أن الناس تصدقها وتحكيها للأطفال، ليتم تحريفها مرارا.
وفي سن الثالثة عشر كتب ساكن أولي قصصه الطويلة ليعجب بها مدرسه ويطلب منه قراءتها على زملاءه، ما آثار لديه شعورا بالأهمية والتميز في الكتابة.
كانت الواقعة دافعا للفتى الصغير أن يُقرر ضرورة التحول من الهواية للاحتراف، طالبا دراسة الأدب بشكل فعلي في أكاديمية الفنون، غير أن عائلته رفضت وأرسلته إلى مدينة أسيوط بمصر، جنوب القاهرة لتعلم التجارة. وكأنهم حرروه وساعدوه على التعلم حيث استغل إقامته في مصر في الإطلاع وقراءة كُتب جيل الأدباء الرواد، والارتباط بالوسط الثقافي والأدبي المصري، ما كان له أثر بالغ في تكوين ذائقة أدبية متميزة، وما أهله أن يُصدر مجموعته القصصية الأولى بعنوان ” على هامش الأرصفة” سنة 2005.
يقول الأديب السوداني عن تلك الفترة ” كنت متأثرا بقصص الخوف والرعب لإدجار آلن بو، وحكايات ألف ليلة وليلة، كما كنت مهتما بكتابات فيكتور هوغو، إميل زولا، وتشارلز ديكنز، وكنت أرى أن السودان لديه قصص وحكايات أكثر رعبا وتشويقا.”
من هنا ، كان عليه أن يكتب بعين الإنسان الحقيقي، دون تهوين أو تهويل، مُتخذا لذاته خطا جديدا يُبشر بالمنسيين.
ضحية المصادرات
وإذا كان مناخ القمع السطوي السائد في الخرطوم، والمتدثر بثياب التدين الظاهري لم يحتمل صراحة وعفوية الأديب الصاعد، إذ لجأت السلطات إلى مصادرة مجموعته الأولى قبل توزيعها، فإن ذلك جعله معروفا ومطلوبا لدى شرائح واسعة من القراء والذين يرون كل ممنوع مطلوب، وكان من الغريب أن تستمر سياسة المصادرة لأعماله عملا بعد آخر بشكل آلي وروتيني بعد أن ساد اعتقاد جازم لدى الرقباء في السودان أن ذلك الكاتب الشاب يكسر التابوهات ويتخطى حدود العادات والتقاليد ويكشف عورات المجتمع.
كانت السمة الغالبة على كتابات بركة ساكن وحدها هي الصدق الإنساني، أن ينقل حيوات المهمشين والمنسيين والمُبعدين عن الصورة الرسمية، أن يتوغل في مجتمعات ثانوية أو ثالوثية بعيدة عن العاصمة السودانية وبعيدة عن الإعلام المقروء والمرئي، كان يخترق حدود الرسمي ويتسلل إلى بيئات القبائل والمناطق النائية حيث العادات مختلفة، والقيم متباينة، وسجلات المنسيين أكبر من أن تستوعبهم حكاية واحدة. كان الأديب السوداني، ومازال مهموما ومنشغلا أن يحكي عن الفقراء، المرضى، الجوعى، الشحاذين،المثليين، القوادين، المتشردين، العمال الموسميين، والمجانين، وغيرهم من الناس الساقطين من أي حسابات.
في تلك الأثناء تحديدا، ولدت بدائعه الروائية والقصصية مثل “مسيح دارفور”، “الجنقو.. مسامير الأرض”، “موسيقى العظام”، “الرجل الخراب،” الطواحين”،”ما يتبقى كل ليلة من الليل”، و”مانفيستو الديك النوبي” وغيرها من الإبداعات التي سرعان ما وجدت مكانا ومكانة لدى قراء الرواية.
ولم تكن قائمة الاتهامات المُكررة تجاه الأديب سوى دافعا للترويج له بشكل أكبر ليختاره الشباب السوداني باعتباره مبدع الجيل والمعبر عن أمانيهم وأحلامهم وأفكارهم.
وفي هذا الإطار كان من الطبيعي أن يحصد المبدع ثمار كده ونبوغه ليفوز في سنة 2016 بجائزة الطيب صالح للإبداع الروائي، ثم يتوج في سنة 2017 بجائزة سين للأدب بمعرض جنيف الدولي للكتاب بسويسرا عن رواية ” مسيح دارفور”.
أسلوب فريد
ويمكن القول أن أبرز ما يميز أسلوب ساكن السردي حرصه على تشكيل لغة خاصة به تمثل خليطا بين الفصحى واللغات واللهجات المحلية الخاصة بأبناء مناطق متباينة من السودان، وهي أقرب في نطقها للشعر المحلي، وكأنه يُقر بأن السودان نتاج فسيفساء ثقافية واجتماعية ثرية.
كما يعتمد الأديب تكنيكات فنية متعددة في أعماله مثل السرد بضمير الأنا، أو الروائي العليم، أو التنقل بين أصوات متباينة ومتعددة. ونجده مهتما بالربط الدائم بالتاريخ، وكأنه دائري الحركة إذ تتكرر شخوصه وأحداثه وأوجاعه بتغييرات طفيفة. كما نجده مكررا للتفاصيل والوقائع الغرائبية التي تمثل سمة غالبة على حكي أبناء القبائل البعيدين عن المدن، وكأنه يقول إن السودان ليس الخرطوم، وحده، وليس صراعات الدم والحروب العبثية وجرائم الإسلاميين، وإنما هو مجموعة عوالم عدة تبدو متناقضة لكنها تصلح نموذج لأرض تعايش وتواصل إنساني فريد.
ويبدو بركة ساكن في مهجره موصولا ببلاده، متابعا ثورتها، مساندا شبابها الطامحين للتغيير وإزاحة قوى التسلط الديني، إذ يقول في إحدى إطلالاته إبان الحراك الشعبي في السودان في العام الماضي إن الجوع، الظلم، المرض، الفساد السياسي، والمحسوبية هو المولد الحقيقي لثورة السودانيين ضد النظام البغيض.
إن السودان في تصوره بلد التعدد لا التوحد.أرض التنوع والاختلاف، لا تمثل حضارة واحدة، ولا شعبا واحدا، أو فكرا واحدا، وإنما هي بلد جمالها في اختلافاتها وألوانها،وتعددها، وأن انتعاشها يكمن في احترام ذلك التعدد، والتأقلم معه، وتحويله إلى طاقة إنتاج وإبداع وتحضر، وهو ما يستلزم في البداية والنهاية حرية بلا حدود.
لقد كان الأديب الخمسيني يدرك قيمة الحرية، ويتصورها الطريق الأيسر لبزوغ المبدعين، ما جعله جديرا بحيازة جائزة باريس، وقبلها محبة قراءه وجمهوره من السودانيين والعرب.