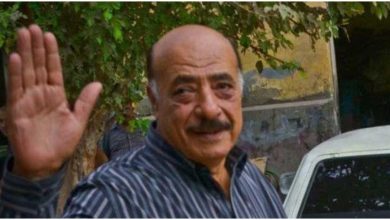إذا أراد شخص ما أن يطلق على عام 2020 لقب ما، فربما يكون «عام الأوبئة والصحة العامة» هو اللقب الأقرب لوصف هذا العام المثقل في بدايته بالحديث عن تفشي فيروس كورونا وفي نهايته بالحديث عن تحور الفيروس بدرجة بات معها أكثر انتشارا بنسبة تصل إلى سبعين بالمائة مثلما أُعلن مؤخرا بعدد من البلدان الأوربية وهو ما جعل أزمة تفشي وباء كورونا والصحة العامة حديث الساعة ليس بمصر وحدها وإنما بالعالم أجمع على اختلاف مستويات البشر الاجتماعية والثقافية.
لم تكتفي بعض البلدان بالحديث عن الوباء والصحة العامة بل عمدت بعضها إلى تكريم ضحايا الوباء مثلما حدث بالنمسا منذ عدة أيام حينما اشعل أعضاء مبادرة «بعضنا لبعض .. معا من أجل الإنسانية» -التي أُطلِقَت عقب تفشي الوباء- عدد من الشموع تعادل عدد ضحايا الوباء تكريما لأرواحهم.
الدكتورة لافيرن كونكه في دراستها المعنونة «أرواح في خطر .. الصحة العامة في مصر القرن التاسع عشر» التي نقلها للعربية الدكتور أحمد زكي تطرح قضية الصحة العامة في مصر خلال القرن التاسع عشر وكيف تعامل محمد علي باشا مؤسس نهضة مصر في النصف الأول من القرن التاسع عشر مع منظومة الأوبئة والأمراض المتوطنة -الكوليرا والطاعون والجدري- التي كانت دائمة التفشي بمصر من حين لأخر خلال هذا القرن.

أوبئة النصف الأول من القرن التاسع عشر
تعرضت مصر خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر بشكل عاصف لوبائي «الكوليرا والطاعون» جاء وباء الكوليرا إلى مصر عن طريق قوافل الحجيج الذين انتقل إليهم الوباء بمكة عن طريق أفواج الحجيج القادمة من الهند، وانتشر الطاعون بها عن طريق السفن البحرية القادمة من سوريا والأناضول المحملة بالفئران المصابة بالطاعون من آسيا الوسطى.
عانت مصر من تفشي وباء الكوليرا بصفة خاصة حتى أن غالبية الأوربيين كانوا يعتقدون أن مصر هى مصدر وباء الكوليرا وزادت حدة الوباء وفقا للدكتورة لافيرن كونكه نتيجة التوسع في نظام الري الدائم الذي اتبعه محمد علي باشا والقائم على التوسع في عدد القنوات والمجاري المائية الأمر الذي ضاعف من فرص انتشار المياه الملوثة التي تعد السبب الأول في انتشار وباء الكوليرا.
كانت بلدان العالم بذاك الحين مع كل أزمة وبائية تعاود طرح الجدل الدولي الحاد حول ماهية الاتفاقات الواجب إبرامها حول ما يجب أن تكون عليه الإجراءات والتدابير الفنية الصرفة أو الإنسانية الصرفة لوقف انتشار الوباء. غير أن التنافس القوي ما بين الدول الأوربية المنخرطة بالتجارة العابرة للبحر المتوسط غالبا ما كان يُفشل عملية الوصول لأي اتفاقات دولية حول ضوابط مكافحة الأوبئة.
مدرسة الطب المصرية
بعد مرور عشر سنوات على خدمة الطبيب الجراح الفرنسي أ.ب كلوت بك الذي استعان به محمد علي باشا لإدخال النظام الصحي الغربي إلى مصر كان يرى أن مصر أكثر صحة من أوروبا بدرجة ملموسة وقد أعاد ذلك من وجهة نظره إلى ذلك المزيج المنسجم ما بين المناخ الطيب و المأكل والمشرب المعتدل إضافة لانتشار عادة أخذ حمامات ساخنة بشكل متكرر وكان البارون دومنييك الجراح العام بالحملة الفرنسية كان قد سبقه في اكتشاف أن مناخ وادي النيل الجاف المشمس مفيد للغاية في جعل الجروح تلتئم بصورة أسرع.
توارث المعالجون الشعبيون في مصر أساليب العلاج المتعددة عن أجدادهم فقاموا بعمليات الطهارة والحجامة والتشريط والتكبيس بكاسات الهواء وخلع الأسنان وفتح الخراج والجبائر وتطبيب الجروح والكدمات وغيرها من فنون العلاج الشعبي التي كانت شائعة ولم يكتفي هؤلاء المعالجون الشعبيون بالعمل في مجال تقديم الخدمات العلاجية بل حرصوا على إيجاء أعمال أخرى لكسب قوت يومهم، وقد اكتسب المعالجون المصريون بالقرن التاسع عشر فهما عميقا لطريقة استخدام العقاقير الطبية وطريقة المزج فيما بينها بأسلوب يتناسب مع رؤيتهم حول سبل إعادة التوازن للجسم وفقا لتصورهم عن طبيعة الخلل الذي يعاني منه المريض غير أن محمد علي باشا حين أراد التوسع في قوات الجيش رأى ضرورة الاعتماد على الأطباء المحترفين.
استعان محمد علي باشا بالعديد من الأطباء الغربيين في علاج المُجنديين بالجيش المصري وحين أراد تأسيس مدرسة طب مصرية أوكل مهمة تأسيسها إلى طبيبه كلوت بك الذي استعان بهؤلاء الأطباء الغربيين كهيئة تدريس بمدرسة الطب المصرية التي تأسست عام 1827.

خرجت مدرسة الطب المصرية إلى النور على نسق المستشفى الملحق بالمعهد التعليمي لتدريب الطلبة عمليا وهو النسق الذي أصبح فيما بعد عُرفا من أعراف التعليم الطبي في إنجلترا وفرنسا في ثلاثينيات القرن التاسع عشر.
اقترح كلوت بك على محمد علي باشا أن تقدم مدرسة الطب المصرية دورة تدريبية مدتها خمس سنوات لمائة من شباب مصر شريطة أن يكونوا من الملمين جيدا باللغة العربية والحساب وهكذا استعان كلوت بك بطلاب الأزهر وهو ما جعله يرى ضرورة أن تكون هناك دراسات تمهيدية تساعد هؤلاء الطلاب في الانتقال من دراسة العلوم الدينية والتشريعية إلى دراسة المناهج العلمية الغربية تمهيدا للتخصص بمجال الطب، فدرس الطلاب فصولا في الهندسة والعلوم الطبيعية مع التشديد على الفيزياء والفلك لتحفيز اهتمامهم بملاحظة العالم الطبيعي وبعد مرور السنة الدراسية الأولى تلقى الطلاب منهجا دراسيا طبيا مدته أربع سنوات على النموذج المعمول به في فرنسا.
كانت مدرسة الطب المصرية تتبع بشكل مباشر إدارة ديوان الحرب التي كان يشرف عليها ضابط جيش تركي وارتدى الطلاب زيا عسكريا وكانوا يعتمدون في غذائهم على نظام «الجراية» أي الطعام الذي توفره لهم المدرسة إلى جانب المسكن إضافة لمكافأة شهرية قيمتها مائة قرش، وعند تعرض أحد طلاب المدرسة للفشل في اجتياز الامتحان المقرر عليه كان يعاقب بالطرد من المدرسة ومن ثم يتم تعينه برتبة عريف بالجيش فيشغل وظيفة ممرض نظامي بالمستشفيات التابعة للجيش.
حين يتخرج طلاب المدرسة يتم تعينهم بالجيش برتبة أقل وبمرتب أقل من نظرائهم الأوربيين ففي حين كان الطبيب الأوروبي برتبة مساعد ضابط يتلقى أجر يعادل 350 قرشا شهريا كان نظيره الطبيب المصري يتلقي 150 قرشا شهريا أي ما يزيد عن تلك المكافأة التي كان يتلقاها وهو طالب بخمسين قرش فقط لا غير.
قام كلوت بك بترجمة قسم أبقراط المستخدم بكليته الأم «كلية مونبلييه للطب» بفرنسا إلى العربية وقدم نسخة هديه منه لكل متخرج من مدرسة الطب المصرية إلا أنه رفض أن يسمح لخريجي المدرسة أن يحملوا لقب «دكتور» ذلك أنه رأى أن لقب «مسئول الصحة» هو الأنسب لخريجي طلاب مدرسة الطب المصرية على أن يتم تصنيف خريجي المدرسة بوصفهم كبار مسئولي الصحة بالخدمة الحكومية المصرية مع أو بدون حصولهم على الرتبة العسكرية.

تمصير مدرسة الطب المصرية
كان الأثنى عشر من خريجي دفعة 1832 بمدرسة الطب المصرية الذين تم اختيارهم لدراسة الدكتوراة في باريس موضع تكريم خاص وراهن الجميع على أن يصبحوا نواة لهيئة التدريس المصرية بالمدرسة في المستقبل وصدرت الأوامر لهؤلاء المبعوثيين بأن يجيدوا تعلم اللغة الفرنسية بدرجة تمكنهم من ترجمة الكتب العلمية ومن ثم تم توزيع الطلاب على ست ميادين دراسية «التاريخ الطبيعي، والفيزياء والكيمياء، والصيدلة والمستحضرات الطبية، والتشريح وعلم وظائف الأعضاء، وعلم التغييرات المرضية في الأعضاء والأمراض الباطنية، والجراحة».
رتب كلوت بك تسجيل الطلاب بثلاث مستشفيات كبرى بباريس وعين لجنة فرنسية تقيم امتحانات ربع سنوية لهؤلاء المبعوثين مع القيام بعمل التعديلات الملائمة بالمقرر الدراسي ومن ثم كتابة التقارير عن مدى تقدم الطلاب الدراسي كي تُرفع للوالي.
عاد خمس أطباء من هؤلاء المبعثوين لينضموا إلى هيئة تدريس مدرسة الطب المصرية عام 1836 بعد حصولهم على الدكتوراة وبذلك بدأت مرحلة تمصير المدرسة وأصبحت المقررات الدراسية تدرس باللغة العربية دون الحاجة لوجود مترجم وسيط ما بين الطلاب وأساتذتهم.
تسارعت حركة الترجمة في مجال المراجع الطبية فارتفع عدد المراجع المترجمة إلى العربية من 12 مرجع إلى 24 مرجعا ما بين عامي 1833 و1840، وحين خلف عباس محمد علي كوالي للبلاد في 1849 قام أعضاء هيئة التدريس المصريين والدكتور جي أم بيرون مدير مدرسة الطب المصرية بترجمة 55 عنوانا بمجالات الطب المختلفة.
لم يتمكن من خلف كلوت بك في إدارة مدرسة الطب المصرية من ممارسة نفوذه السياسي الذي مكنه من الحفاظ على مكتسبات المدرسة وكان أسوء ما منيت به المدرسة قد جرى حين عطل والي مصر الجديد سعيد باشا الدراسة بالمدرسة عام 1855 حيث قام بتسريح الطلاب من المدرسة وتوزيعهم على وحدات الجيش المختلفة.
حين عاد كلوت بك في العام التالي من فرنسا عمد لإعادة فتح المدرسة ليشرع في إدارتها إلا أنه سرعان ما تدهورت صحته ما دفعه للتقاعد نهائيا عام 1858 ولم تسترد مدرسة الطب المصرية عافيتها حتى انتقلت إدارتها إلى أيدي المصريين عام 1863 حيث تحسنت النظرة العامة من قبل المراقبين الأوربيين لمستوى خريجي المدرسة خلال عهد إسماعيل باشا إضافة لزيادة الرعاية المقدمة لبعثات الخرجيين للدراسة بالخارج.
اتبع إسماعيل نموذج جده محمد علي باشا في التوسيع بالقوات المسلحة ومن ثم تزويدها بالمستشفيات اللازمة الأمر الذي دعاه للاهتمام بمدرسة الطب المصرية التي كان يديرها آنذاك الدكتور محمد علي البقلي وهو أصغر وألمع أعضاء البعثة العلمية الأولى التي تم إرسالها إلى باريس عام 1832.

شجع البقلي على البحث الطبي بكافة المجالات والميادين وافتتح أول صحيفة طبية مصرية «يعسوب الطب» أي ملكة النحل خلال عمادته لمدرسة الطب تلقى خلال ذلك الوقت 175 طالبا مقيما تدريبا ومعاشا كاملا وفي المقابل التزم كل منهم بدخول الخدمة العسكرية أو بعض الهيئات الصحية العامة بعد التخرج.
مات البقلي عام 1876 خلال خدمته العسكرية مع جيوش إسماعيل بالحبشة وتوقف نظام الدعم المالي الذي كانت تقدمه الدولة لطلاب المدرسة مما تسبب في تراجع أعداد الملتحقين بها وبحلول عام 1896 لم يكن بمدرسة الطب سوى 27 طالبا فقط … توالت الرحلة حتى مطلع القرن العشرين وتأسيس الجامعة المصرية عام 1908 ومن ثم أصبحت مدرسة الطب المصرية أحد ركائزها الأساسية لتبدأ مرحلة جديدة من تاريخ التعليم الطبي في مصر.
وللحديث بقية.