لم يكن رمضان في تلك السنة، كما روت لي جدتي، كأي رمضان آخر، أو حتى كأي شهر آخر في السنة.
اعتادت قرية الشيخ عبد الله، وهذا اسم قريتنا، في رمضان أن يجتمع أهلها، مسيحيين ومسلمين، قبيل أذان المغرب بنصف ساعة في الطريق الطويل الذي يقسم القرية ويربط أولها بآخرها.
ومكان الاجتماع هو أرض الطريق التي يفرشها مجانا الحاج توفيق صاحب محل الفراشة. ثم يأتي كل من يستطيع بما طبخه ليشاركه الآخرون فيه. كان طول المائدة أحيانا يصل إلى سبعين مترا. وكان أولاد القرية، ينظفون الطريق كل يوم من أيام شهر الصيام ويرشون الأرض، ثم يفرشون الفرشة. وكان بعض أولاد القرية يقف عند مدخلها ويضعون بعض الأحجار لمنع مرور السيارات خلال فترة الإفطار.
وكان على رأس هؤلاء الأولاد ميلاد جرجس ابن عم جرجس صاحب مخبز القرية الذي كان يُعرف بـ”طابونة الهنا“، وممدوح الشاب المفتول العضلات الذي رفع اسم قريتنا عاليا بعد فوزه على مستوى البندر في حمل الأثقال، وسعيد، وحنا، وعلي، ونرجس، وليلى من طالبات وطلاب المدرسة الثانوية النابهين.
في تلك السنة، كما قالت جدتي، شهدت قرية الشيخ عبد الله تغييرات كبيرة. فقد تغير العمدة، وأفلتت ”العمدية“ من عائلة البدري، وتولى المنصب فتح الله الشريف، وكان شابا في أوائل الأربعينيات حصل على قسط وافر من التعليم آنذاك، فأنهى تعليمه الثانوي، ثم حصل على دبلوم المعلمين واشتغل بالتدريس فترة في المدرسة الإعدادية، ثم تمكن من الحصول على شهادة جامعية في التربية عن طريق نظام الانتساب. وكان رجلا شريفا فعلا، ومحبوبا من أهالي القرية وكان أيضا نشطا في خدمة الناس ومساعدتهم في قضاياهم في المركز، وفي حل مشكلاتهم حتى الأسرية منها لرجاحة عقله وهدوئه حكمته.
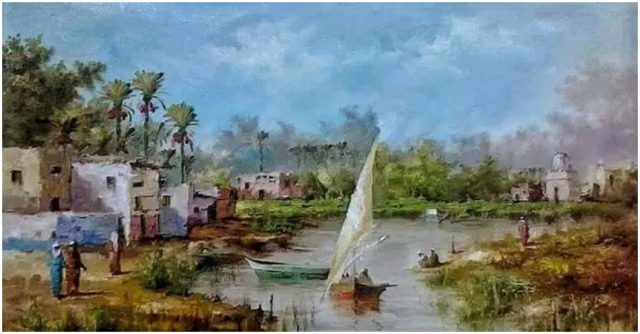 وكان تعيينه أمرا مفاجئا لبعض أهالي القرية، خاصة بيت أولاد زيدون، الذين نزل خبر تعيينه عليهم كالصاعقة، بعد أن عاشوا أكثر من عشر سنوات في ظل العمدة السابق، الحاج عطوان البدري، يفعلون ما يريدون، ويزدادون نفوذا في تجارتهم التي لم ينافسهم فيها أحد، وهي تجارة الخنازير. ويطيحون في سبيل ذلك بأي واحد يحاول أن يقف أمامهم، لأنهم كانوا يعلمون أن العمدة سيطبخ لهم الطبخة التي تجعلهم يخرجون من المشكلة كالشعرة من العجين، سواء أمام مأمور المركز، أم أمام إدارة المحافظة، أو حتى أمام أهالي القرية بدهائه وأسلوبه الناعم المسموم. لكنهم أحسوا بعد تعيين العمدة الجديد أنهم فقدوا سندهم، وعليهم أن يفكروا في مخرج.
وكان تعيينه أمرا مفاجئا لبعض أهالي القرية، خاصة بيت أولاد زيدون، الذين نزل خبر تعيينه عليهم كالصاعقة، بعد أن عاشوا أكثر من عشر سنوات في ظل العمدة السابق، الحاج عطوان البدري، يفعلون ما يريدون، ويزدادون نفوذا في تجارتهم التي لم ينافسهم فيها أحد، وهي تجارة الخنازير. ويطيحون في سبيل ذلك بأي واحد يحاول أن يقف أمامهم، لأنهم كانوا يعلمون أن العمدة سيطبخ لهم الطبخة التي تجعلهم يخرجون من المشكلة كالشعرة من العجين، سواء أمام مأمور المركز، أم أمام إدارة المحافظة، أو حتى أمام أهالي القرية بدهائه وأسلوبه الناعم المسموم. لكنهم أحسوا بعد تعيين العمدة الجديد أنهم فقدوا سندهم، وعليهم أن يفكروا في مخرج.
ولما سألت جدتي عنهم قالت لي لا أحد في قرية الشيخ عبد الله يعرف لهم أصلا. قالوا إنهم وفدوا إلى قريتنا من قرى مجاورة، وقالوا أيضا إنهم دفعوا للحاج عطوان مئات الجنيهات حتى يسمح لهم بالاستيلاء على أرض الساحة الكبرى التي كانت تقع في نهاية القرية. وبين يوم وليلة شاهد أبناء القرية الساحة وقد أحاط بها سور عال كبير من الطوب، تخترقه بوابة كبيرة من حديد، فلم يعد أحد يستطيع رؤية ما وراء السور.
وحكى من اختلسوا بعض النظرات أنهم رأوا شيئا عجبا. فقد اخضرت الساحة، بأشجار وكأنها نبتت شيطانيا فجأة، وغصت ببيوت صغيرة متلاصقة بلون واحد ومن طابق واحد. وتحولت الساحة إلى قرية صغيرة داخل قرية الشيخ عبد الله.
ولم يكن أحد يعرف عن أولاد زيدون شيئا، إلا تجارتهم في الخنازير، التي كانت ظاهرة للعيان لأنهم كانوا يحضرون سوق الثلاثاء يبيعون ويشترون فيه. ولم يعرف أحد ملتهم ولا دينهم. لكن الأمر الذي أكده كثيرون أنهم لم يكونوا مسيحيين. بل كانوا يتمسحون بالنصارى، لأنهم ينتفعون منهم. وأحيانا كانوا يتوددون للمسلمين بجلب بعض البضائع من البندر، مما لا يجده أهل القرية في دكاكينهم، مثل سجاجيد الصلاة، وفوانيس رمضان التي تنير بالبطاريات، وبعض المكسرات والياميش التي يقبل عليها الناس في رمضان. وكانوا جميعا يلبسون مثل بعضهم، وكأن لهم زيا واحدا: جلابيب قصيرة غير مسدلة إلى أقدامهم، بلون رمادي باهت، ويزينون أكتافهم بكوفيات قطنية زرقاء.
في تلك السنة وقبيل تعيين العمدة الجديد، اشتبك أحد أبناء أولاد زيدون أمام باب كنيسة القرية، التي كانت تقع قريبا من أرض الساحة القديمة، والتي كنا نسميها “كنيسة الشيخ عبد الله”، وكان وجودها يزعج أولاد زيدون. وكم من مرة لمحوا فيها إلى دفع أموال طائلة لشراء أرضها، لكن العمدة عطوان لم يستطع مساعدتهم في ذلك.

ونشبت معركة بين ابنهم برهومة وبعض أولاد القرية، الذين كانون ينظفون الساحة الصغيرة الواقعة أمام باب الكنيسة وكان أولاد زيدون يسرحون ببعض الخنازير في المكان فتلطخ المكان بوسخها. وحاول ميلاد جرجس أن يهدئ من احتداد النقاش، ولكن برهومة عاجله بسكين في بطنه فبقره، وسال دمه أنهارا، وفر برهومة وأصحابه محتمين وراء السور العالي.
ولجأ أولاد زيدون إلى العمدة، واستطاع الحاج عطوان أن يعقد جلسة صلح بين أولاد زيدون وأسرة ميلاد، التي كانت أسرة لا حول لها ولا قوة. وأقنع العمدة أولاد زيدون بدفع دية لأسرة ميلاد، وقبل أفراد الأسرة على مضض. وانتهى الحادث، كما ظن بعض الناس.
لكنه لم ينته.
وأخذ الرعب يدب في قلوب أولاد زيدون، وبدا أهل قرية الشيخ عبد الله يحسون بحركة غير عادية في خلفية القرية حيث يوجد سور أولاد زيدون العالي: أناس يخرجون، وأناس يدخلون، وعربات ”كارو“ تجرها البغال تخرج وعربات كارو تدخل، مغطاة بملاءات وبطاطين.
وأحس أولاد القرية بأن قتل ميلاد، ذلك الشاب الوديع، ابن عم جرجس الطيب القلب، صاحب النكتة البشوش، وصاحب ”طابونة الهنا“، التي أصبحت بعد غياب ميلاد مغلقة الأبواب، هو بداية قد تتوالى بعدها أحداث أخرى ربما يفتقدون بعدها كنيسة قريتهم الوحيدة، إن ظل الحاج عطوان في العمدية، وإن سكتوا هم على ما حدث.
لكن العمدة تغير، وتغير معه الكثير من الأمور.
كان نسيج القرية مثل قطعة القماش التي تختلط فيها الخيوط. تدرك فيها ألوانا مختلفة، لكنك لا تستطيع تحديد كل خيط منها على حدة. كان المسيحيون والمسلمون فيها جيرانا متحابين، يتبادلون في أعياد كل منهم الكعك والقرص والتمر، وغيرها من الهدايا. وكان بعض المسيحيين يشارك المسلمين صيام بعض أيام رمضان. وكان أولاد المسلمين يشاركون النصارى في تنظيف الساحة الواقعة أمام الكنيسة. وكان المسلمون في عيدي الفطر والأضحى يتخذون من هذه الساحة مصلى لهم، بعد أن سد أولاد زيدون عليهم الساحة الكبرى وسوروها بحائطهم العالي المنيع.

دبر أولاد القرية أمرا.
وفي ليلة السابع والعشرين من رمضان، من تلك السنة دبت حركة غير عادية، كما قالت جدتي. وكانت مائدة الإفطار أطول مما اعتاده أبناء القرية. وقالوا إن أولاد قرية الشيخ عبد الله دعوا شبانا من قرى أخرى مجاورة لتناول الإفطار معهم.
وعندما هز الصمت صوت المؤذن، وقف أحد الشباب داعيا، وقد ظلل الحاضرين نور ”الكلوبات“ الساطع التي قسمت المائدة إلى بقع نور مضيئة، بقبول صيام الجميع، وإعانتهم على استكمال الشهر، في تلك الليلة التي ربما كانت فيها أبواب السماء مفتحة. ثم دعا بالترحم على روح ميلاد جرجس الذي يفتقدونه لأول مرة. وكادت الدموع أن تنهمر من الأعين، عند ذكر اسمه.
وانتهى الإفطار، ودبت الحركة في المكان، فرفع كل شيء من الشارع، وأخذت الظلمة تحل في المكان بعد أن حمل الشباب ”الكلوبات“ في أيديهم، وعاد كأنه لم يشهد تلك المائدة التي قيل إن طولها ليلتها زاد على المئة متر.
واصطف الشباب بعد تنظيف المكان، في طوابير متعددة، واتجهوا إلى نهاية القرية. كانوا يمشون مشدودي القوام، عارفين وجهتهم. وكان بعضهم يتمتم ببعض الآيات من القرآن الكريم ومن الأناجيل، وكأنهم يتجهون إلى ساحة معركة. وأنوار ”الكلوبات“ تنتقل معهم من بقعة إلى بقعة.
وعندما وصلوا إلي السور الكبير، توجهوا في عزم إلى البوابة الكبرى. وطرق بعضهم الباب، لكنهم فوجئوا به مفتوحا، فدخلوا. وتواتروا وانتشروا داخل الساحة، ينتثرون هنا وهناك، بين الأبنية، وهم يصرخون: اخرجوا يا أولاد زيدون.
ولكنهم لم يسمعوا ردا أو استجابة، بل رن صوت صراخهم في المكان، الذي تبين لهم أنه أصبح خاويا من أي ساكن.









