ما هي الثقافة؟!.. وهل تُمثِّل أحدَ عناصر تكوين المجتمع؟!.. وإن كانت، فما هي ثقافة المجتمع؟!.. وما الفارق بينها كـ”مصطلح”، وبين الثقافة في المجتمع كـ”تعبير” يؤشر إلى فئة خاصة تتمتع بهذه التسمية: “المثقفون”؟!.
لا نروم هنا الإسهابَ في تحديد الثقافة كـ”مفهوم” أو “المثقفون” كـ”تعبير” أو أزمة الثقافة العربية كـ”حالة” واضحة للعيان؛ بقدر ما نَتَغَيَّا وضع اليد على الملامح التي تسم الواقع الثقافي لأي مجتمع؛ الواقع الذي لا يمكن تحليله بطريقة تجعل في الإمكان تبيان عناصره ومستوياته، إلا بالنظر إليه من خلال المفهومين: ثقافة المجتمع، والثقافة في المجتمع.. كل على حدة، من جهة؛ وفي تداخلهما وتقاطعهما، وتأمل الكيفية التي يحدث بها هذا وذاك، التقاطع والتداخل، من جهة أخرى.
ثقافة المجتمع
من الجهة الأولى، إذا نحن نظرنا إلى ما يعنيه مفهوم “ثقافة المجتمع”، فإنَّ أول ما سيفرض نفسه علينا كمُعْطَى محددٍ ذي دلالة معينة، أنَّ هذا المفهوم يتوازى مع لفظة الثقافة كما يستخدمها علماء الاجتماع، والتي ـ غالبًا ـ ما يتم التعبير عنها بأنَّها: “ذلك الكلُّ المركب الذي يشمل المعرفة والاعتقاد والفن والقانون والأخلاق والعُرف، وأية عاداتٍ وقدراتٍ أخرى يكتسبها الإنسان بوصفه فردًا في المجتمع”.
لكننا على نحو متشدد، بالضرورة، سوف نُعطي لها معنى أكثر تحديدًا، من ذلك الذي يبدو أنَّه متأثر إلى حد كبير بالتعريف الذي قدَّمه “إدوارد تايلور” للثقافة، في كتابه: “الثقافة البدائية، 1871”. ومن ثم، فإنَّ الثقافة –في نظرنا– هي: “المضمون المعرفي لحصيلة تفاعل الإنسان مع الطبيعة ومع غيره في مجتمعٍ معينٍ في مرحلةٍ زمنيةٍ معينةٍ”.
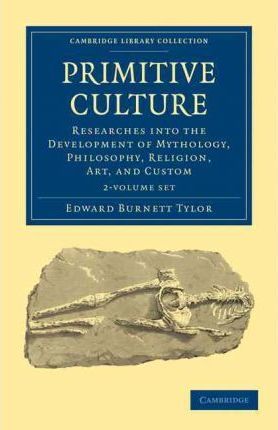
بهذا الشكل تأخذ الثقافة، ضمن معانيها المتعددة، معنى “اجتماعيًا”؛ لأنَّ الثقافة هنا، توصف بأنَّها سِمَة للمجتمع نفسه أي: “صفة لا يكتسبها الإنسان إلا بحكم انتمائه لمجتمع معين”. وهي بهذا المعنى تُمَثِّل نقطة “البداية” أو بالأحرى النقطة “المحورية” في حياة الإنسان الواعية. إذ إنَّ كل إنسان يبدأ باكتساب ثقافة مجتمعه، أي باكتساب القيم والاتجاهات التي تسود في هذا المجتمع، عن طريق “التنشئة المجتمعية” (نقول: “مجتمعية” للدلالة على مختلف جوانب تركيبة المجتمع في شمولها، لا على الجانب “الاجتماعي” وحده).
الملاحظة الجديرة بالانتباه، أنَّ “الثقافة المجتمعية” (كتعبير أكثر دلالة، في اعتقادنا، عن ذلك الذي كان عالم الاجتماع العراقي علي الوردي أول من استخدمه وهو “الثقافة الاجتماعية”)، تتسم بالديمومة، بالرغم من أنَّها بطيئة الحركة، خصوصًا في المجتمعات “التقليدية”، بحكم اعتمادها على الانتقال من جيل إلى آخر، من خلال “التوارث” في ما يقال له “تواصل الأجيال”.
المهم، أنَّ الثقافة المجتمعية تتجسد في واقع الحياة، عبر تفاعل الأفراد والجماعات مع الطبيعة ومع بقية الناس في المجتمع. وبالتالي، فهي ليست أفكارًا أو قيمًا مثالية مجردة، بل تنعكس في الواقع المعيشي الذي يصنعه الإنسان.
هذا، وإن كان يشير إلى أنَّ مكونات الثقافة (المجتمعية) كعملية تراكمية تاريخية، تخضع لقانون التطور؛ بمعنى أنَّه ليس هناك ثقافة لقوم أو مجتمع ثابتة خالدة عبر العصور، وإنَّما هي في حركة متصلة عبر الزمان، ومن خلال متغيراتها الداخلية، و/أو ما يحيط بها من مؤثرات خارجية.. فإنَّه يؤكد، في الوقت نفسه، على أنَّه مهما كانت قوة المتغيرات الخارجية وتأثيرها (كمثال: مدى التأثير الثقافي للثورة العلمية والتقنية، التي نعايشها راهنًا في: الاتصالات والمعلومات والمرئيات)، فإنَّ العناصر المميزة في الثقافة المجتمعية سوف تستمر في البقاء، أيًا تكن درجات الاستمرار في هذا البقاء ومداه.
بيد أنَّ هذا لا يمنع أن تكون بعض مكونات هذه الثقافة (العناصر المميزة لها)، من “الثوابت” نسبيًا، وبعضها من “المتحولات” المتلاحقة في سرعتها النسبية.
الثقافة في المجتمع
من الجهة الأخرى، إذا نظرنا إلى ما يعنيه مفهوم “الثقافة في المجتمع”، فإنَّنا سنجد أنفسنا أمام مُعْطَى آخر مختلف، لكنَه واقعي عنيد، إنَّه كمفهوم يلتقي مع لفظة الثقافة بالمعنى الإنساني “الرفيع”، والتي عادة ما تُوصف بأنَّها: “صقل الذهن والذوق والسلوك، وتنميته وتهذيبه، وما ينتجه العقل البشري لتحقيق هذا الهدف”.

ويُلاحظ أنَّ الثقافة على هذه الصورة، ترتبط بالأصل اللغوي للكلمة في اللغة العربية، لأنَّ الأصل “ثقف” يحمل معنى التهذيب، والصقل والإعداد. كما يلاحظ –أيضًا– ارتباطه بالأصل اللغوي لكلمة “Culture”، في اللغات الأجنبية، وهي كلمة تعني تعهُّد النبات وحرثه ورعايته حتى يُثمر (منها جاءت كلمة زراعة “Agriculture”). وهنا، فإنَّ الثقافة تعبر عن عملية رعايةٍ وإعدادٍ مستمرٍ للنفس الإنسانية والعقل؛ أما معناها بوصفها “منتجًا” يؤدي هذه الوظيفة، فلم تكتسبه إلا في ما بعد.
بهذا الشكل، تأخذ الثقافة معنى “فرديًا” لأنَّ عملية الصقل والتهذيب تتعلق بفرد معين، أو مجموعة من الأفراد يتَّسم كلٌّ منهم بشخصيته المستقلة. وهي بهذا المعنى، تمثل “نقطة النهاية” في حياة الإنسان الخاصة، أو بالأحرى النقطة “المستهدفة” التي يسعى الفرد (الإنسان)، طوال حياته، إلى تحقيقها والوصول إليها.
الملاحظة الأساسية، هنا، أنَّ “الثقافة المعرفية” ـ إذا جاز لنا استخدام مثل هذا التعبير، بحكم أنَّ كلَّ إنسان يمتلك نسبة ما من المعرفة ـ تتسم بالديمومة، مثلها في ذلك مثل الثقافة المجتمعية؛ هذا بالرغم من اختلافها عن هذه الأخيرة بكونها سريعة الحركة، لأنَّ قوامها هو صقل الذات وسعيها الدائم إلى تحقيق مستويات أعلى.
في هذا السياق، فإنَّ المعادلة التي تجمع في ما بين هذين المفهومين: ثقافة المجتمع، والثقافة في المجتمع، توضح بجلاء لماذا استطاع الجيل العربي “الشاب” إنجاز “التغيير”، الذي لم تستطعه الأجيال السابقة عليه، في أكثر من ساحة عربية، فيما أُطلق عليه “الربيع العربي”.. لقد تحقق الإنجاز عندما تمَّ التحول من المفهوم الأخير وممارساته، إلى المفهوم الأول ومرتكزاته؛ أي عندما تمَّ التحوُّل من جانب المعادلة الخاص بـ”ممارسات” الثقافة في المجتمع، إلى الجانب الأهم –مجتمعيًا– وهو “مرتكزات” ثقافة المجتمع.
تجديد الفكر والخطاب
هذا يوضح لماذا فشلت “النخب” العربية –وما تزال– في تلمُّس الهموم المعيشية للمواطن العربي، ولماذا غابت عن صناعة حالات الاحتجاج التي تحولت إلى ثورات شعبية شاملة، لم تتوقف عند حدود إصلاحات هنا أو هناك، بل رفعت سقف المطالب إلى “إسقاط النظم الاستبدادية”.. فكان لها ما أرادت.
بل، لنا أن نتأمل كيف كان “بوعزيزي” الشرارة في انطلاق الثورة في تونس؛ وكيف كان “خالد سعيد” الشرارة في انطلاق الثورة في مصر، قبل عقد من الزمان.. إذ، لم يكن الأول من “المثقفين”، ولم يكن الأخير من “النخبة”.

ولعل هذا يضعنا، مباشرة، في مواجهة أزمة النخب العربية، ومثقفيها على وجه الخصوص. بيد أنَّ البحث في عوامل هذه الأزمة، أسبابها وتداعياتها، لابد أن يسبقه –منطقيًا– البحث في عوامل أزمة الفكر ذاته، الذي تعتمده النخب العربية، وترى من خلاله الواقع والمستقبل؛ وهي الأزمة التي عبرت عن نفسها في مقولات من قبيل: تجديد الفكر العربي، تجديد الفكر السياسي العربي، تجديد الفكر القومي (و/أو الخطاب الوحدوي)، تجديد الثقافة العربية.. وغيرها.
والواقع أنَّ هذه المقولات كانت قد تسيدت ساحة العمل الثقافي، والسياسي، العربي خلال السنوات الماضية، حتى قامت الثورات الشعبية العربية لتؤكد على أهميتها وضرورتها. بل، إنَّ الملاحظة التي تنأى بنفسها عن التشديد؛ أنَّ الناظم المشترك في ما بين هذه المقولات جميعًا، هو “التجديد”، كمحاولة للبحث في الأزمة العربية الراهنة ـ والممتدة منذ زمن ـ وكيفية الخروج منها.
ومن ثم، فإنَّ “التجديد” المستهدف، إنَّما يكتسب أهمية مركزية عبر مسألة أساسية، تنطوي على جانبين مترابطين ومتناقضين في آن: الاعتراف شبه الكلي من التيارات الفكرية العربية المختلفة بالأزمة من جانب.. ومن جانب آخر، عدم إمكانية هذه التيارات (المختلفة)، من تجاوز الأزمة، وإنجاز تصورات بديلة للعقائد الموجِهة (الأيديولوجيات)، والنظم الفكرية، أو الممارسات السياسية، التي واكبت الأزمة، وما تزال تعبر عن نفسها حاليًا.









