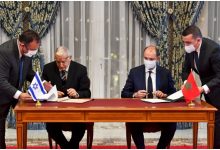بقلم: حسين عبد الغني، نقلًا عن موقع مصر 360

طرحت الأزمة الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا وعوامل خلل بنيوية داخلية تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصري ستؤدي إلى خفض توقعات مشجعة للنمو في 2022 كانت محل اتفاق من جهات محلية ودولية، وستؤدي -وهذا هو الأخطر- إلى رفع معدلات التضخم وغلاء الأسعار بما يضع مستويات معيشة عشرات ملايين من المصريين «تحت خط الفقر وعند خط الفقر والشرائح الصغيرة والمتوسطة من الطبقة الوسطى» في أوضاع بالغة الصعوبة.
ينتمي هذا المقال -لا كاتبه- إلى ما يمكن وصفه بالمدرسة الواقعية في السياسة، فهو لا يناقش النموذج الأمثل للاستقرار السياسي (نمو اقتصادي شامل ومنصف لا يترك خلفه فقيرا، انفتاح ومشاركة سياسية، سيادة حكم القانون واعتماد تام لفكرة المواطنة.. إلخ)، ولا يناقش أولويات التنمية بطريقة تتعارض مع طبيعة النظام الرأسمالي، ولكن يناقش ما هو مستقر -براجماتيا- من أن هدف مؤسسات الأمن والاقتصاد والإعلام.. إلخ، هو حماية استقرار ووجود النظام السياسي والتعامل مع التحديات التي تواجهه في كل مرحلة بكفاءة ومرونة، تحول دون أن يصبح هذا الاستقرار وهذا الوجود مهددا.
كما ينتمي هذا المقال أيضا إلى المدرسة الاجتماعية المعتدلة «الكينزية» التي تطورت إلى نظم رفاه اجتماعي في الاقتصاد السياسي، في مواجهة مدرسة «شيكاغو النيوليبرالية المتوحشة» أو الطبعة الأكثر استغلالا والأقل رحمة من الرأسمالية. فهي تدرك أن توفير الحد الأدني من الرضا العام وسد منافذ السخط الاجتماعي هو شرط أساسي من شروط استقرار النظام العام في أي مجتمع وأن عدم توافره يجعل الهدوء الأمني والسياسي معرض للتهديد في اي لحظة باحتمال وقوع أحداث مفاجئة وغير متوقعة.

وأخيرا فإنه ينتمي إلى التعريف الأصلي القديم للاقتصاد باعتباره( اقتصاد سياسي) مربوط بالسياسة والسياسة مربوطة به، وليس كاقتصاد متخصص يشق على الطالب المتوسط فهم ومتابعة كتاباته، وبالتالي فالإشارات هنا إلى إجراءات وسياسات مقترحة تتم على سبيل الإشارة، إلى ما يمكن وصفه بـ«التوجه العام» أما الإجراءات المحددة فهي بالقطع وبكل الاحترافية هي مهمة المتخصصين.
بتطبيق هذا المنظور الثلاثي الأبعاد، سنجد أن التهديد الرئيسي للنظام السياسي المصري وللعديد من النظم السياسية في الدول النامية حاليا وعلى المدى القصير هو تحدي انعكاسات أزمتي جائحة كورونا والحرب الأوكرانية في صورة ارتفاع مقلق لنسبة التضخم بما يساويه مباشرة من تأثير سلبي على النمو الاقتصادي ومن تأثير سلبي -وهذا هو الأخطر- على ارتفاع نفقات المعيشة وتراجع قدرة غالبية المصريين على تحمل ضغوطاتها اليومية على بنود الغذاء والوقود والسلع الأساسية .
بعبارة أخرى فإن ما يفترض أن الأجهزة الأمنية والاقتصادية في الدولة تقوم به من «تقدير موقف» دوري يحدد أولويات دورهما في حماية الحكومة والنظام السياسي لابد أن ينتقل أولًا لمساعدة نخبة صنع القرار في اتجاهين. الأول هو تحويل تركيز اهتمامها وسلم أولوياتها إلى مواجهة آثار غلاء الأسعار على المجتمع وبالتالي على الاستقرار السياسي. وأن ينتقل في الاتجاه الثاني إلى إعادة ترتيب مهام الجهازين الأمني والاقتصادي لاستخدام كل قدراتهما لحماية الفئات الفقيرة والمهمشة من هذا الغلاء وإعادة توزيع أعباء الوضع التضخمي على الفئات القادرة وليس فقط على الدولة ومواردها المحدودة .
في السنوات الثماني الأخيرة كانت مهمة الجهاز الأمني بمؤسساته المختلفة هي مكافحة الإرهاب ولقد نجحت في هذه المهمة في بعدها المباشر، وما التراجع الحاصل في العمليات الإرهابية إلي مستوى الصفر أحيانا في شهور بأكملها إلا دليل على ذلك .
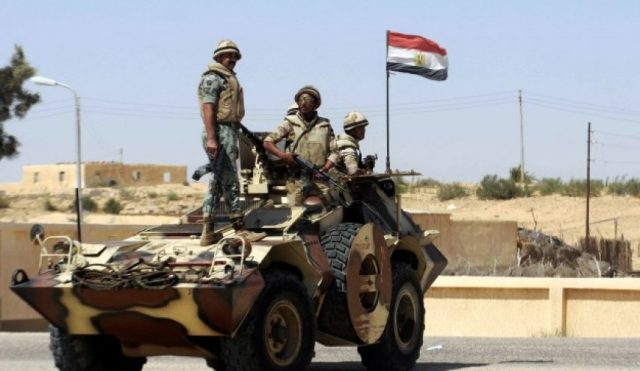
وفي السنوات الثماني السابقة كانت مهمة الجهاز الاقتصادي بمؤسساته المختلفة من وجهة نظر نخبة صنع القرار هي إعادة تحديث وتجديد وتوسيع نطاق «البنية التحتية» في مشروعات طرق وجسور في المدن وبين المحافظات ومشروعات نظم ري وتبطين ترع ومدن جديدة.. إلخ، ويمكن القول إن معظم هذه المشروعات قد اكتمل أو كاد.
هذا الوضع الجيد -مع إبقاء اليقظة في مواجهة الإرهاب- يجعل من الميسور تحول الأولوية الأمنية الآن لمواجهة العنصر الأخطر على استقرار النظام السياسي، وهو تراجع مستويات المعيشة بسبب انفجار الأسعار بتأثير عوامل التضخم من كورونا، وأوكرانيا، وانتهاز قوي اقتصادية محلية لهذه الظروف لخطف مزيد من الأرباح والمكاسب.
ويجعل من الميسور تحول أولوية الجهاز الاقتصادي -مع إنجاز القسم الأساسي من البنية التحتية الذي تحتاجه عمليات الإنتاج- إلى التركيز على الزراعة لتقليل الفجوة الغذائية ووارداتها بالعملات الحرة، وعلي الصناعة لإحلال الواردات والتصدير .
من المعروف أن قيام نظام سياسي بحسم قرار الأولوية (رقم 1) في أجندة عمله يعني مباشرة تخصيص أقصى ما هو متاح من الموارد المادية الموجودة في الدولة للنجاح في إنجاز هذه الأولوية أو في التغلب على التحدي الذي تمثله .
ويعني ثانيا تعظيم السياسات وأدوات العمل المطبقة من قبل، ويعني وهذا هو الأهم إنهاء التردد في استخدام ما هو في صلاحيات الدولة لكن غير مطبق حاليا في تعديل البيئة السياسية والقانونية والاقتصادية، بما يخفف العبء على الجهازين الأمنيين والاقتصاديين ويمكنهما من حفظ الاستقرار الاقتصادي ومعيشة المصريين من وحش الغلاء والنقمة الاجتماعية التي يتسبب فيها .

وهنا يتأكد الطابع السياسي لتحديد الأولويات، فإذا وافقت نخبة صنع القرار على أن الأولوية هي للحيلولة دون تراجع التحسن الذي حققته في النمو الاقتصادي، والحيلولة دون حدوث توتر اجتماعي بسبب ارتفاع نسبة التضخم وغلاء الأسعار، فإن مؤسسات الدولة ستخصص كل جهودها ومواردها إلى الأمن الاقتصادي وليس للأمن السياسي.
أو بعبارة أصح إلى فهم أن الأمن والاستقرار السياسي سيتحقق الشق الأكبر فيه بتحقيق الاستقرار والأمن الاقتصادي وإنصاف الفقراء.
فمواجهة تحدي الغلاء والتضخم وتأثر مستويات النمو، سيقتضي شجاعة وجرأة لا تقتصر فقط على تشجيع البنك المركزي وغيره من المؤسسات على استخدام كل السلطات المتاحة لهم في استخدام الأدوات النقدية والمالية (رفع سعر الفائدة مثلا لامتصاص السيولة النقدية الزائدة لتخفيف حدة التضخم.. الخ)، أو الأدوات الاقتصادية مثل تقييد الواردات وتحجيم جزئي للانفتاح الاستهلاكي على الخارج، وإنما أيضا إلى تغيير جوهري في البنية القانونية، مثل بنية نظام الضرائب بحيث تعفى الشرائح الدنيا إعفاء تاما أو شبه تام، وترفع نسب الضرائب بشكل تصاعدي عادل علي الفئات الغنية.
و يدعم الدولة في هذا -إذا حسمت قرارها- أنه يتفق مع الدستور المصري، ويتفق مع حقيقتين أخريين، الأولى: هي أن البند الوحيد الذي لم يطبق بشكل حاسم في بنود الحكومة مع روشتة صندوق النقد الدولي هو الإصلاح الضريبي في اتجاه مزيد من العدالة وزيادة الموارد (تم تنفيذ الأجزاء التقنية الجيدة مثل الميكنة ووحدة الضريبة إلخ..)، والثانية هي ما أثبتته الإحصائيات المدققة أنه بينما ازداد فقر الطبقات الدنيا، وانحدرت إليها شرائح كانت تقليديا من الطبقة الوسطي و«مساتير» الناس ازدادت وأحيانا تضاعفت عدة مرات ثروات أغنى 1٪ من السكان.

مواجهة تحدى التضخم وأثره على أمن واستقرار الدولة ونظامها السياسي سيجعل البنك المركزي يتصرف بكامل ما هو متاح للسلطة النقدية في البلد من سلطات في إنفاذ قراره الأخير بجعل الاستيراد عبر اعتمادات بنكية كاملة وبدون استثناءات أو تراجع تحت ضغوط مجتمع الأعمال.
وسيجعل من التسعير الجبري والاسترشادي للسلع الأساسية والغذاء والوقود وخدمات الصحة «حتميا» على الأقل حتي استعادة معدلات نمو مرتفعة للاقتصاد الكلي وكبح جماح التضخم.
سيجعل مهام الأمن الأساسية مهمة أمن عام وأموال عامة ومكافحة فساد مثل تعقب الاحتكار والمحتكرين والمسؤولين عما يسمي بـ«تعطيش السوق» ومصادرة ما في مخازنهم وردع من يرفع الأسعار في أي جزء من سلسلة حلقات الجملة والتجزئة وكشف الفساد المحتمل مع هؤلاء وأقسام من البيروقراطية بهدف التحايل على القواعد الجديدة بالإضافة للتأكد من أن المنافذ التابعة للدولة التي تم تكليفها قبل أيام قليلة بتوفير السلع في منافذها بأسعار مخفضة تعطي السلعة للمواطن الذي يحتاجها وليس لتجار يشترونها ثم يخفونها ويعيدون بيعها بأسعار مرتفعة .
الإرادة السياسية هنا ستواجه تحديات كثيرة، لكن أخطرها هو ما اسميه بـ«ابتزاز نخبة المصالح النيو ليبرالية»، في المجتمع والاقتصاد المصريين، وهي ليست نخبة اقتصادية فقط بل تمكنت تدريجيا في الـ48 عاما الأخيرة من خلق نخبة ثقافية وإعلامية وقانونية نافذة للغاية مدعومة من النظام الاقتصادي الدولي ومؤسساته النقدية والمالية، وهي نخبة تضع مصالحها الخاصة فوق كل مصلحة عامة، بوهم ان تحقيق مصالحها هو بمثابة تحقيق المصلحة العامة نفسها.
هذه النخبة ستقيم الدنيا وتقعدها وتسعى إلى إفشال قرارات للمصلحة العامة كما فعلت من قبل -ضريبة الثروة لمرة واحدة فقط، ضريبة أرباح البورصة، الضرائب التصاعدية- أو قللت من أثر قرارات معينة بحصولها على استثناءات عبر مساومات وضغوط ساندها فيه (جناح إعلامي وإن كان في معظمه تابعا للدولة إلا أنه بنى علاقات وشيجة مع القطاع الخاص الاحتكاري في نصف القرن الماضي) مثل الضجة التي صاحبت قرار البنك المركزي الأخير الممتاز بقصر كل عمليات التصدير عبر اعتمادات (مستندية) بنكية .
على الدولة فقط أن تواجه هذا الابتزاز النيوليبرالي بالتذكير بما فعل زعيما أكبر نموذجين للنيوليبرالية في عالم اليوم، وهما الولايات المتحدة وبريطانيا. الرئيس الأمريكي الأسبق بارك أوباما قام في مواجهة الأزمة العالمية 2008 بنقل ملكية شركات خاصة إلي الدولة بصورة تقترب من التأميم. أما رئيس الوزراء المحافظ الحالي بوريس جونسون فللإبقاء على استقرار حكومته في مواجهة جائحة كورونا تصرف وكأنه رئيس وزراء عمالي!!، إذ قام بإنفاق غير مسبوق على خدمات الصحة العامة المجانية وعلى برنامج دعم رواتب كل العاملين في الدولة وفي القطاع الخاص “فاقا معا المائة مليار جنيه استرليني”.
مما يدعم قدرة الدولة المصرية في اتخاذ ما يلزم لحماية استقرارها السياسي من آثار التضخم والغلاء، هو ما أظهرته في السنوات الأخيرة من التجرؤ على مناطق محرمة -تفاداها مبارك لثلاثة عقود- وما أظهرته من صرامة -كانت موجعة للطبقات المحدودة- عندما تعلق الأمر بقرارات مثل تعويم الجنيه وإزالة مناطق للنفع العام كانت تعترض مشروعات للبنية التحتية، ومن شأن وصول هذه الصرامة إلى منطقة توزيع الأعباء علي الأغنياء أن يشعر الجميع بقوة الدولة أمام جميع الفئات سواء الأعلى صوتا ونفوذا أو تلك الأخفض صوتا ونفوذا .
اقتصاد الأزمة اقتصاد غير عادي يحتاج -خاصة عندما يتعلق الأمر بمصير الدولة- إجراءات غير عادية وهنا لن ينفع حكومة في دولة نامية مثل مصر أن تستمع الآن لنصائح صندوق النقد الدولي النيو ليبرالية المكررة والتي يرددها مسؤولوه كالببغاء في كل ظرف على أي بلد.. فكما نقول هنا في مصر “اللي إيده في المية مش زي اللي أيده في النار”.
من المعلوم من السياسة بالضرورة أن توجيه إعلان سياسي للناس في هذه الظروف يخصص برمته لطرح حزمة إجراءات ناجعة لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار وضمان الاستقرار سيكون من شؤونه تهدئة نفوس قلقة وقلوب مشحونة وتعاملا مباشرا مع منسوب صبر كاد أن ينفد.