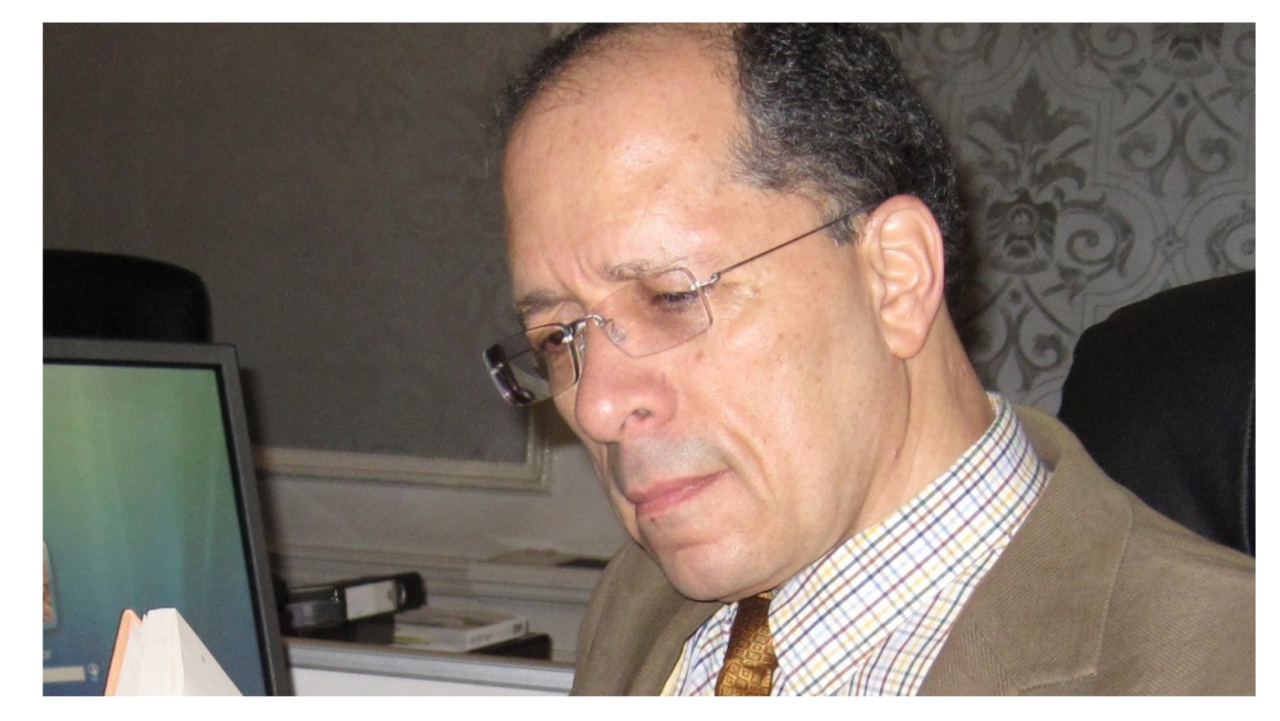إنها الحياة تمضي أسرع كثيرا مما نتخيل، حلم سريع ما نلبث أن نستيقظ منه، كثيرون مروا من هنا يوما ما؛ لكننا لا نجد الآن لأي منهم أثرا، إلا بعض خيالات أو صوّر محفورة في الذاكرة، تتلاشى شيئا فشيئا مع مرور الأيام.
صور إنسانية من حيوات بشر، يظن كل منا –وهو يطالع السطور ويلتهم بناظريه الكلمات– أنه يعرفهم جيدا، وأنهم كانوا خلال فترة من الفترات؛ يمثلون جزءا من عالمه الخاص؛ قبل أن يطويهم النسيان بعد الرحيل.. هذا هو الانطباع الذي يخرج به المرء، وهو يقرأ المجموعة القصصية “حرم المرحوم” للكاتب محمد رياض العشيري.
تتألف المجموعة من عشر قصص قصيرة، تبدو كل منها كلوحة دقيقة التكوين؛ تجسد مشهدا إنسانيا فارقا، حيث يلوح في الكثير منها سيف الفراق المر، الذي كُتب على البشر أن يتجرعوه بين الحين والأخر، حين يرحل عزيز أو قريب.
أصر المؤلف بعد الإهداء، على أن يُطلع القارئ على بعضٍ من تفاصيل تعلقه بالكتابة منذ وقت مبكر، حين أحسّ بها تجري في دمه، منذ بلغ عامه الرابع عشر، يوم بدأ الطريق بمشروع مجلة أدبية مع شقيقه محمود، وعن أول محاولة للكتابة القصصية في حياته يقول العشيري “كانت أول محاولة، لي لوحة قصصية لحريق شاهدته فعليا، عندما كنت أمارس هوايتي في القراءة فوق سطح منزلنا، ورأيت عن بعد ألسنة النيران، وهى تلتهم بيتا كان يقبع على بعد شارعين أو ثلاثة من منزلنا”.
ويضيف في مقدمة مجموعته القصصية “لازمني هذا التعلق بالكتابة طيلة حياتي، وخلال سنوات الدراسة الثانوية والجامعية.. بيد أني للأسف لم أكرس لها وقتا كافيا، وظلت محاولاتي الأدبية حبيسة دفاتري ومذكراتي، حتى عينت معيدا في كلية البنات بجامعة عين شمس، وشجعني وجودى بين أساتذة كبار في الأدب والنقد على نفض الغبار عن دفاتري القديمة”.
” لماذا تركوني هنا وحدي.. برودة الغرفة تقشعر لها عظامي.. أسمع أصوات شجارهم من بعيد، إنهم أبنائي وأنا أعرفهم جميعا من أكبرهم إلى أصغرهم”.. في قصة “حرم المرحوم” التي حملت المجموعة القصصية اسمها؛ يُشخّص لنا الكاتب حياة الأم المصرية التي تحمل عادةً بعد الإنجاب اسم أحد أبنائها أو بناتها، الجميع ينادون بطلة القصة بأم نعمة، وحتى الجيران يشككون في أن يكون أحدهم يعرف –من الأساس– اسمها الحقيقي الذي أطلقه عليها أبوها عندما جاءت إلى هذا العالم.
بعد عدة سنوات، تغيّر اسم الأم مرة أخري، فأصبح الجميع ينادونها بأم شوكت، بعد أن رزقت بمولود ذكر لأول مرة.
تبدو المرأة في مجتمعاتنا العربية –رغم ما شهدته من تحولات كثيرة– مفعولا بها في الكثير من الأحيان؛ فحتى اسمها يتوارى ويتم اختيار اسم آخر لها مستمد من أسماء أحد أبنائها، ويبقى صراخها دوما حبيس جدران صدرها، وقد اعتادت أن تتحمل في مقابل أن تصل بالسفينة الأسرة إلى بر الأمان.
يقدم لنا الكاتب وصفا دقيقا للأم المصرية عندما يفيض بها الكيل “كم أنا متعبة، لقد اشتد بي المرض أكثر في اليومين الأخيرين، تعبت من عصبية صفية، وسرعة غضب شوكت سنوات وسنوات، ولكني أشفق عليهم جميعا، وأثق أن قلوبهم –بالرغم من الجعجعة– في صفاء اللبن الحليب، لكن أنّى لى أن أرتاح؟ بعد سنوات العناء التي تجرعت مرارتها، عقب ذلك الحادث الأليم”.
نكتشف بعد ذلك أن الأب قد رحل في حادث مروع.. صدمته سيارة عندما خرج صباح يوم اثنين لشراء طلبات البيت ولم يعد، ظلت الأم بعدها هى كل شىء في حياة صغارها، لا تذكر هل كان ذلك قبل عشرين أم أربعين عاما؟ ولكنها تعلم جيدا أن كل شىء قد انقلب رأسا على عقب، بعد هذا الزلزال الذى ضربها بكل قوة في مقتل.
“أعرف أن الأولاد اشتاقوا إليك؛ لكن اشتياقي أنا أكثر، فقد انقضم ظهري برحيلك، غير أن شعورا بالسكينة يملأ الآن ضلوعي، سكينة غريبة يتساوى معها كل متاع الدنيا، انتظرني يا عبد الله فأنا آتية في الطريق، انتظرني يا “أبو نعمة”.

في مشهد صادم نكتشف أن الأم التي كانت تسترجع كل هذه المشاهد قد رحلت بالفعل، وأن الأبناء حولها ينتحبون، تبكي صفية بحرقة رحيل أمها الصدر الحنون، التي ماتت فجأة وتركتها وحيدة في هذا العالم، شوكت يعلم أنها قد تكون غاضبة عليه؛ لكنه يصر على أن يتشبث بالعادات والتقاليد حتى النهاية، طاهر العائد من إحدى الدول الأوروبية يضيق ذرعا بعقلية أخيه التي يراها رجعية، ولكن نعي الأم الذي يسدل عليه الستار يبقى أقوى من أى كلمة في نهاية القصة القصيرة والتي تجعلنا متشوقين لمطالعة ماذا سيجري في القصة التالية.
في لوحة قصصية أخرى حملت عنوان “مرثية أب” تصاب طفلة صغيرة اشترى لها أبوها زوجا من أسماك الزينة – بصدمة عندما تموت إحداهما.. وللوهلة الأولى تتهم الصغيرة أباها بأنه هو من قتل السمكة.
ليس من شيء أصعب على أبٍ من أن يوضع في مثل هذا الموقف، ماذا يتوجب عليه أن يفعل؛ كى يُخلّص ابنته من حالة الحزن غير المسبوقة التي تعتصر قلبها؛ بعد أن شاهدت شبح الموت لأول مرة في حياتها.
يتذكر الأب تلك اللحظات الصعبة، التي عاشها من قبل عندما تسلل الموت إلى منزلهم، وهو في مثل سنها تقريبا، حين عايش مشهد رحيل أبيه، وقد اكتسى البيت بالحزن.. فالنساء يتّشحنَ بالسواد وأصوات الصراخ تصم الأذان، لحظة دخول أبيه إلى المنزل محمولا على الأعناق.
في قصة السجين.. يقدّم الكاتب صورة لشخص أثقلته الهموم، حتى لم يعد يدري الفارق بين الحلم والحقيقة، ودوما يجد نفسه في قلب كابوس مفزع، يركب الأتوبيس وفجأة يقرر أن يسرق “الكمساري”.. ويلوذ بالفرار كي يتمكن من سداد الديون التي ترهق كاهله؛ ولكن مطاردة قوية تجري حيث يجد نفسه محاصرا، وأمين الشرطة يتمكن من الإمساك به، ومع دوى الرصاص يكبح سائق الأتوبيس جماح الفرامل بقوة، فيتشبث بذراع الكرسي ويكتشف أن السائق كاد أن يصدم طفلا وأن المطاردة كلها كانت تجري في خياله.
وهكذا تمضي المجموعة بحبكة سردية متقنة؛ لتنتقل من لوحة قصصية بديعة إلى أخرى، وهى تسبح في حيوات عدد كبير من البشر الذين نشعر بأننا نعرفهم جيدا، وأن كُلا منا قد يكون واحدا من بين هؤلاء الذين أتعبتهم السباحة في بحر الحياة، حيث لاتهدأ العواصف لحظة واحدة ولا مكان أبدا للراحة أو التقاط الأنفاس.