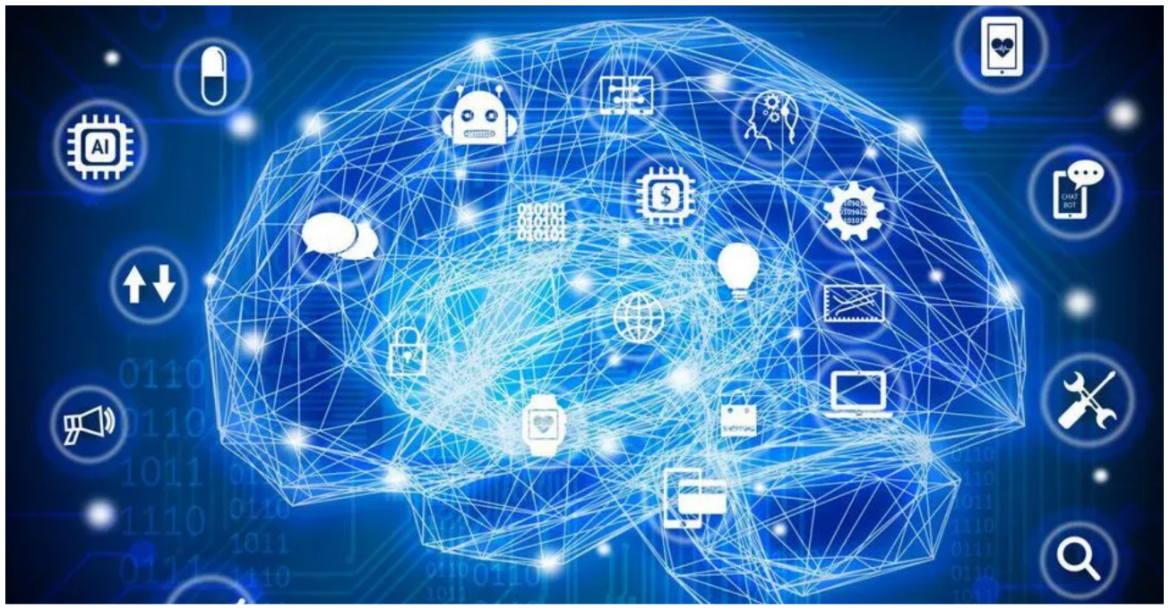ربما لا نكون في حاجة إلى التأكيد أهمية العلم والتقانة، وأنهما عنصران من عناصر الحضارة، ومعارف ومهارات “إنسانية” تندرج في إطار ما هو مشترك إنساني عام، وبالتالي فهما لا يدخلان في علاقة جوهرية مع الهوية الوطنية والقومية، بمعنى: إن عدم امتلاكهما والاضطرار إلى استيرادهما؛ لا ينال من الكيان الوطني والقومي، لا على مستوى السيادة ولا على مستوى الهوية.
رغم ذلك يبقى من الصحيح، أنهما عندما يتحولان إلى وسيلة يوظفها أهل حضارة معينة، في فرض قيم هذه الأخيرة على المجتمعات الأخرى، بقصد التوسع والهيمنة؛ فإن الأمر جد مختلف.
هذا هو الحاصل فعلا في عالم اليوم.. فالهيمنة الحضارية من طرف القوى المالكة وسائل فرضها، وهي وسائل متنوعة وجد متطورة، أصبحت ـ من الوجهة الاستراتيجية ـ ضرورية لتكريس وتعميق الهيمنة الاقتصادية والسياسية.
قولنا الأخير هذا، إذا ما حاولنا صياغته قياسا إلى الطفرة المعلوماتية الراهنة، يشير إلى أن هذه الطفرة سوف تؤدي إلى تركيز “الاستلاب” الحضاري، وربما تقويض الاختلافات الحضارية، عبر محاولة خلق نموذج واحد له آليات تعميمه الواسعة، خاصة إذا لاحظنا كيف أن “التقانة” كانت على مدى التاريخ محركا أساسيا للتغير “الثقافي”، وإفرازًا له في الوقت نفسه.
التقانة.. وعناصر المنظومة الثقافية
يبدو ذلك بوضوح، إذا تأملنا كيف أن التقانة عمومًا، وتقانة المعلومات على وجه خاص، هي التي جعلت من الثقافة صناعة قائمة بذاتها، لها مرافقها وسلعها وخدماتها.. بل، إننا لا نجاوز الحقيقة إذا قلنا: إن أثر التقانة في الثقافة يكاد يشمل جميع عناصر منظومتها، والعلاقات البينية التي تربط هذه العناصر وبعضها البعض، ولا تشمل هذه العناصر الإدارة الثقافية والموارد الثقافية فقط؛ بل أيضا -وهذا هو الأهم- بنية المعرفة داخل المجتمع، والأسس والمبادئ التي قامت عليها هذه المعرفة، وقاعدة القيم التي انطلقت منها.
والأمثلة على أثر التقانة في الثقافة عديدة.. ويمكن الإشارة هنا إلى أمثلة ثلاثة:
المثال الأول، هو ما أدت إليه تقنيات الطباعة بظهور آلة جوتنبرج في منتصف القرن الخامس عشر. لقد أسرعت هذه التقانة في محو الأمية وكسر احتكار المعرفة، وهو الأمر الذي يعد من الأسباب الرئيسة التي أدت إلى تدمير النظام الإقطاعي، ذي السلطة المطلقة للنبلاء ورجال الدين، والتكوين السريع للمراكز الحضرية، والتوسع في النشاط التجاري؛ وهي التغيرات الاجتماعية التي أدت بدورها إلى تصنيع أوروبا، وتحول مؤسساتها السياسية جهة الديموقراطية.
وما تجدر الإشارة إليه هنا، هو مدى التأثير المباشر لتقنية الطباعة على تجربة الفكر الغربي في توجهه نحو العقلانية، وتطور مؤسساته العلمية والتعليمية والثقافية. فالمعرفة في صورتها المطبوعة لم تساعد وحسب على نشر المادة المعرفية؛ بل ساعدت أيضا على تنمية المهارات العقلية من خلال الانفعال “البارد” مع النصوص، بعيدًا عن سلطة المتحدث والانفعالات العاطفية التي تصاحب عادة عملية التواصل اللغوي الشفاهي.
المثال الثاني، هو أثر تقنية التصنيع وظهور الرأسمالية في الفكر المسيحي في أوروبا. لقد أدت إنجازات العلم الباهرة – في ما أدت إليه- إلى ظهور نوع من الفكر الفلسفي، قائم على تقديس العلم والعقل، والإيمان بقدرة الإنسان على السيطرة الكاملة على الطبيعة، نوع من الفكر: “يتمادى، أحيانًا، ليبشر بظهور دين بشرى بلا لاهوت ولا كنائس ولا إكليروس”.
وما تجدر الإشارة إليه هنا، ما يعطينا إياه التاريخ الاجتماعي للمجتمع الأمريكي في نهاية القرن قبل الماضي (القرن التاسع عشر)، كحالة مواجهة لتلك السابقة في أوروبا، للعلاقة بين التقانة والدين.. فقد صاحب تحوّل المجتمع من مرحلة الزراعة إلى مرحلة الصناعة، ظهور ما يمكن تسميته بـ”الأصولية العقائدية”، وخروج كثير من التيارات الدينية الفرعية عن المسار الرئيس، لـ”الديانة المسيحية”، ما أدى إلى تعدد الكنائس وتنوع فصائلها.
المثال الثالث، هو أثر العلم والتقانة، ليس في النتاج الفكري والأدبي، بل وفي نفاذ هذا الأثر إلى صميم العملية الإبداعية نفسها.. وهنا نجد أن الأدب والدراما والفن على صلة وثيقة بالعلم والتقانة. إذ لا يخفى مدى الصلة بين اكتشاف نيوتن ألوان الطيف وظهور المدرسة الانطباعية في فن التصوير، وهو التأثير الذي يعبر عنه بشكل واضح أسلوب “التنقيطية” الذي ابتدعه الفنان الفرنسي جورج بيير سيورا، عند ما استبدل بقع الألوان بمزيجها المقابل من نقاط ألوان الطيف.. أيضًا، لا يمكن تجاهل العلاقة بين انتشار العلم التحليلي وقيام المدرسة التجريدية التحليلية على يد “بيكاسو” و”براك”.
الثقافة والتقانة.. العلاقة التبادلية
هذه الأمثلة الثلاثة، في الوقت الذي تؤكد فيه على تأثير التقانة في الثقافة؛ إلا أن هذا، في الوقت نفسه، لا يعني قطعًا أنه تأثير ذو اتجاه واحد؛ لأن التقانة والثقافة طرفا علاقة حركية تبادلية، فإن للثقافة -هي الأخرى- تأثيرًا على التقانة؛ وليكن شاهدنا هذه المرة، هو فن العمارة.. كمثال من بين العديد من الأمثلة..
فهذا الفن، يمثل أحد المواضع المثيرة للقاء الثقافة مع التقانة؛ فهو مزيج من فنون التشكيل والنحت وهندسة البناء وتقانة المواد و”ميكانيكا” الإنشاءات.. ولعل أثر سلطة الحاكم “الفرعون الإله”، و”فن الأساطير” (Mythology)، على العمارة المصرية القديمة، وموقف الإسلام من الفن التشكيلي وأثر ذلك علي العمارة الإسلامية، لدليل آخر علي أثر الثقافة في العمارة.
هذا.. وإن كان يوضح العلاقة التبادلية، أو التأثير المتبادل بين كل من التقانة والثقافة.. وإن كان يشير، أيضا، إلى مقولة: “إن كل مجتمع جدير بالتقانة التي يستحقها”، وهي المقولة التي توضح علاقة الارتباط القوية بين مستوى ارتقاء المجتمع وقوة التقانة التي يفرزها لتغيره بدورها.. فإنه إضافة إلى هذا وذاك، يؤكد علي أن ما نشاهده اليوم من اختلاف نوعي بين المجتمعات الإنسانية، مرجعه إلى التضخم الهائل في حجم المعلومات، وتوافر الوسائل العلمية القادرة علي التعامل مع مثل هذا الكم من المعلومات، وكذلك الدور الحيوي الذي تلعبه هذه الأخيرة، في جميع الأنشطة الاجتماعية.. وهو الوضع الذي جعل منها (تقانة المعلومات) مصدرًا أساسيًا للقوة السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية.
وهكذا، هل تمتلك مجتمعاتنا العربية مثل هذه المقدرة، أم أننا نعيش في إطار المعلومات المتاحة لنا من الحضارة الأقوى في هذا المجال، الحضارة الغربية؟!.. وإلى متى تظل مجتمعاتنا تنتظر هذا القدر من المعلومات المتاحة لتعيش عليه؟!.. وهل يمكن تجسير هذه الفجوة بيننا وبين تلك الحضارة الغربية؟!..
بكلمة.. إننا نعيش في عصر المعلومات، وهذا العصر لا يعتمد إلا على العقول.. فلنفسح لعقولنا المجال للإبداع والتعامل مع هذا العصر، دونما وصاية من الذين يتخيلون أنهم أوصياء على الشعوب وعلى المستقبل.