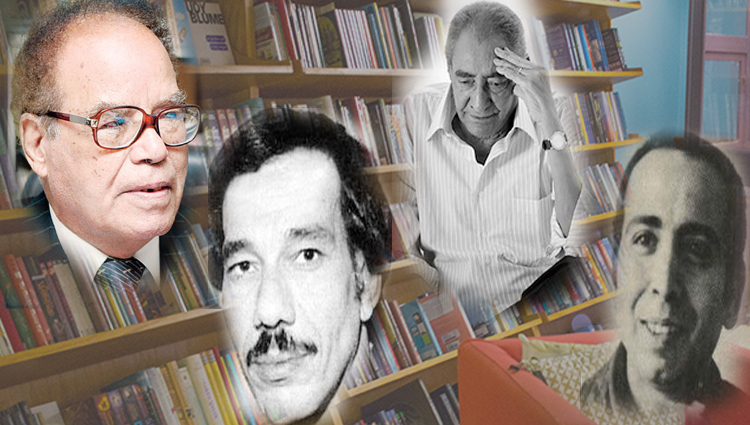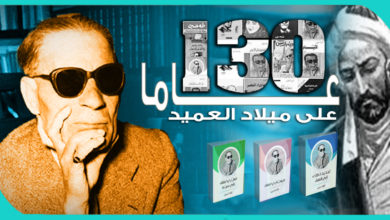في وسط زخم الإبداع المصري، يظهر صوت الجنوب المنسي والمُهمّش، ليجعل الجميع ينصتون إليه، وليصبح مركزا للإبداع، هذا لا ينفي ما عاشته وتعيشه القاهرة من حضور للأضواء وللإبداع، تلك التي جذّرت لفكرة المركز والمحيط، وصار الأمر بالنسبة لكثيرين، قاعدة دونها الاستثناء، وفي زمننا هذا، كسرعدد من مبدعي الجنوب القاعدة، فارضين عبر- همسات خافتة وجميلة – منذ البداية – أسلوبهم الرشيق المتسرب عبر شرايين الفن والأدب، ثم تحولت هذه الهمسات إلى صرخات مدوية تخترق حاجز المحلية، لتنتشر في أرجاء الوطن العربي.
من الجنوب ظهرت أصوات، صارت متونا – بل وعناوين كبيرة – للثقافة وللإبداع المصري، بحيث أصبح لتناولهم رهبة ومهابة، بحجم ما قدموه من عطاء، أسماء يضيء استحضارها عتمة الطريق، ويثير نوازع الإبداع والإلهام، أمثال: أمل دنقل، يحيي الطاهر عبد الله، عبد الرحمن الأبنودي، عبد الرحيم منصور، الطاهر مكي،، محمود أمين العالم، إدوار الخراط، جورج البهجوري، وغيرهم الكثيرون في شتى المجالات الإبداعية.
هؤلاء كانت القاهرة عتبتهم، كي يصبحوا – يومًا – ما يريدون، أما عن هؤلاء الذين اختاروا أن يسبح صوتهم إلى القاهرة والعالم العربي دون انزياح وهجرة، بقصدية الوجود، فهذا هو موضوعنا، عن هولاء الذين جعلوا من الهامش متنًا في الحياة الثقافية المصرية.

عبد الرحيم منصور عبد الرحمن الأبنودي أمل نقل الطاهر مكي
ظرف جواب
الشاعر “عبد الستار سليم” هو أحد هؤلاء المبدعين الجنوبيين الذين آثروا أن يبقوا بعيدا عن العاصمة وغوايتها ..سليم المولود والمقيم بقنا، و رائد فن الواو يقول عن تجربته بعيدا عن غواية القاهرة..”لا شك أن تقسيم مصر ثقافيا إلى قلب وأطراف، «القاهرة هي القلب، وما عداها من مدن وقرى هي التي يطلق عليها لقب الأطراف، هو من أسخف التقسيمات التي توارث أتباعها على مدى أجيال وعقود كثيرة وطويلة. فالعاصمة تستحوذ على كل مستلزمات صناعة الثقافة، من أول وسائل النشر المقروءة، والمسموعة والمرئية، إلى ماكينات الطباعة لطبع الكتب والمجلات، إلى التسويق، وحتى كبار المسؤولين عن الثقافة ومتطلباتها ومشاكلها وحلولها، إلى النقاد والصحفيين، وحتى الجمهور المتلقي هو بدوره يتركز فى العاصمة.

عبد الستار سليم
ونظرًا للامتداد الهائل لمدن وقرى مصر على طول وادى النيل، فإن هذا الوضع تسبب بشكل مباشر فى عدم قدرة المثقفين على التوافد على العاصمة، إلا القليل النادر، من الذين لهم القدرة المالية والجسدية وعامل الوقت، بينما يعيش العدد الأكبر من المبدعين فى قراهم أو مدنهم التى ولدوا فيها.
ويضيف عبد الستار سليم “لحسن الحظ، أنا كنت واحدًا من هؤلاء الذين نحتوا فى الصخر، وجاهدوا وثابروا، بل وغامروا بالمجئ إلى القلب كزائر وليس كمقيم، فلقد كنت -وما زلت- مرتبطا أشد الارتباط بقريتى التى ولدت فيها، ونشأت وتربيت على عاداتها وتقاليدها، من أجل ذلك كنت زبونا على كل «لوكاندات» القاهرة، فى زياراتى الخاطفة للعاصمة، للتعرف على أهلها فى حقل الثقافة والفن”.
لم يحب عبد الستار سليم القاهرة “فكان لا يطيب لي فيها المقام، إلا بقدر وقت الغرض الذى أتيت من أجله، ورغم بعض المغريات التى تمتلكها القاهرة، التى يلقبونها بـ«الندّاهة»، وحيث عرض عليّ بعض الأصدقاء، أن أتخذ من العاصمة مقرًا دائمًا، لكن ذلك لم يحدث، وكانت وسيلة الاتصال الدائمة بينى وبين وسائل النشر من صحف ومجلات، وإذاعة، في هذه الندّاهة، هو «ظرف الجواب» وعليه طابع البريد، وكان أن شققت طريقى إلى عالم الثقافة، من خلال (ظرف الجواب)
بعيدا عن النداهة
الشاعر والقاص والأديب أشرف البولاقي أفلت هو أيضا من غواية القاهرة، وندّاهتها، غير أنها بقيت دائما بالنسبة له مزاره الأثير، لكنه كما يقول، لا يتحمل إلا أن يكون ضيفًا عليها، فحياته وحلمه وإبداعه هناك حيث التكوين والنشأة. ومازال «البولاقي» ينتج في مختلف صنوف الإبداع، قدم إلى الآن مايزيد عن سبعة عشر عملا ما بين الشعر والقصة والكتابات الفكرية، منها في مجال الشعر: «جسدي وأشياء تقلقني كثيرًا»، «سلوى وِرد الغواية»، «واحدٌ يمشى بلا أسطورةٍ” ، وفي مجال الدراسات الشعبية: «أشكال وتجليات العدودة في صعيد مصر»، وفي مجال الأدب الساخر «رسائل ما قبل الآخرة»، وغيرها من أعمال ، ليبقى «البولاقي»، واحدا من أبرز المحرضين على سياحة النص وسباحته، ليكون هو البطل.

أشرف البولاقي
أشواق إلى الموروث
عرف المشهد الثقافي المصري والعربي، صوت الشاعر “فتحي عبد السميع” عبر كتاباته الغارقة في محليتها، والتي تتقاطع مع هموم وقضايا العالم، نقل همومه وعالمه وموروثه الثقافي والفكري، عبر قصيدة النثر، والتي تجلت خلال دواوينه الشعرية، ولأن كلمة شاعر مازالت تحظى بسمعة في محيطنا، عبر مفاهيمها المختلفة. يبقى اسم الشاعر”فتحي عبد السميع”، عبر كتاباته الممتدة، يُسرّب أشواقه إلى موروثنا الشعبي عبر القصيدة، وهذا يعنى تمامًا أن ثمة دهشة وغرابة، مقيمة ومتحفزة لكل من يقترب من تلك المنطقة، يمكنك مثلا أن تتلبس شخصية «قاطع الطريق الذى صار شاعرًا»، لتعرف أن الشعر سبقه إلى الطريق، وقطع عليه كل السبل سوى أن يكون شاعرا. في ديوانه «أحد عشر ظلا لحجر»، فتح «عبد السميع» باب التأويلات على مصراعيه للنقاد.

فتحي عبد السميع
مايخصني هنا ذلك الباب الواسع الذي أخذني إلى القرية، بكل ما تمتلكه من موروث شعبي، يتم استعادته عبر كتابة حرة شفيفة تلمس الروح، أشياء بسيطة قابلناها واشتبكنا معها، وكانت جزءا في تكويننا، بالطبع هي مازالت عالقة في وجداننا، ولكن ماحدث أن كل تلك الموروثات تم استعادتها عبر اشتباك مع الذاكرة، وترويض لفاشية اللغة، وعبر استخدامه لمفردات لا يمكن لغيره أن يجعلها جزءاأساسيا من القصيدة، يمكن لى أن أقول أننى استعدت طفولتى وقريتي، التي ظننت يومًا أننى قد نسيتها، عبر ديوانه (أحد عشر ظلا لحجر)

لا يمكن الوقوف فقط عند شعر فتحي عبد السميع، بل ثمة جانب آخر، هو جانب الباحث والمفكر، وهذا واضح في كتاباته عن «الشعر والطفل والحجر»، و«القربان البديل»، وذلك ضمن خماسية عن الثأر في الجنوب.
معاناة مزدوجة
الكتابة من وعن الجنوب لاشك هى ابنة بكر للمحنة، للألم والوجع، للرفض لكل أشكال السلطة، سواء مجتمعية أو سياسية أو حتى دينية، وعلى هذا خرجت أغلب كتابات مبدعي الجنوب، معلنة رفضها مبدئيا لأي وصاية مسبقة على الإبداع، ومشتبكة في نفس الوقت مع راهن وواقع ما تعيشه مجتمعاتها. ولذا كانت “منى الشيمي” إحدى أبرز كاتبات الجنوب، ومن أولئك اللواتى أثرن الدهشة، عبر كتابة جادة تحمل قضايا مجتمعها، وتشتبك معها.

منى الشيمي
وعن تجربتها تقول «الشيمي»، “لم يكن الأمر سهلا، فمجتمعي لم يكن منتجا لكُتّاب كثر، والكتابة هواية أو مهنة غامضة إلى حد ما في الصعيد. على كل حال كانت مرحلة البدايات عصيبة، لكنني اجتزتها دون إدراك كامل لحجم دهشة الآخرين واستنكارهم”.
وتضيف “لن أقول إن ما قابلته كان عاديا، بل كنت أشعر بالضيق، لكن غواية الكتابة كانت أكبر من أن أتوقف، خاصة وأن المجتمع المغلق يصيب من لها خيال مثلي بالجنون، مع الوقت لم أعد أهتم بكل ما يقال، بل لا أعرف إن كان الآخرون مازالوا يتناولون الأمر أم لا، والآن بعد كل هذه السنوات، لو رجع بى الزمن للوراء، لاخترت الكتابة مجددًا. ليس رفض المجتمع أيضا هو كل الصعوبات، بل الوصول للقاهرة عاصمة الثقافة ومركزها، في زمن لم يكن للإنترنت فيه وجود، والمسافة بين مدينتي في الجنوب والقاهرة تصل -إذا لم يتعطل القطار أو يحترق، أو لم يخرج عليه قطاع الطرق-، إلى تسع ساعات، إضافة إلى فوقية النقاد واستعلائهم، وندرة دور النشر الخاصة وقتذاك، تكتمل صعوبة الصورة، صدقني، كان إقناع الجنوب بموهبتي أسهل من محاولة ترسيخ اسمي وسط مجتمع لا يرى إلا مبدعى وسط البلد في القاهرة.