وقد مرت الترجمة من وإلى العربية، في عصرنا الحالي، بمراحل عدة واجهت خلالها الكثير من الصعوبات والتحديات،بدأت بشكل فردي في ظل تجاهل رسمي من الجهات المختلفة،وتطور الأمر ليصل إلى شكل مؤسسي يتمثل فى هيئات ومؤسسات للترجمة مثل المركز القومي للترجمة، سلسلة الجوائز،ومؤسسة كلمة وغيرها.
ومن الضروري هنا أن نضع في الاعتبار أهمية ودور الترجمة التى لا تقتصر فقط على نقل المعرفة بل توطينها والاستفادة منها، خلال السطور التالية، نحاول الاستماع من المترجمين أصحاب القضية والفاهمين لها الواعين بها إلى أهم ما يواجههم من أزمات خلال رحلتهم الإبداعية فيما يختص بالترجمة
مشهد خادع
تحت عنوان البدايات مفتوحة والنهايات مجهولة؛ يؤكد الشاعر والمترجم والطبيب عبد المقصود عبد الكريم صعوبة أن تكتب عن الترجمة، عن نقطة تختارها وتنطلق منها لتجد القضايا المتعلقة بهذه القضية المحورية تتزاحم في رأسك، ولا تعرف ماذا تختار. فهناك قضية الترجمة والتعليم والثقافة والقراءة والقارئ، ودور النشر الحكومية والخاصة ووزارة الثقافة ـوالموهبة والإبداع؛ الترجمة ومشاكلها والمترجم ومشاكله ووضعه وعلاقته بالمؤسسات الثقافية…

الشاعر والمترجم «عبد المقصود عبد الكريم»
ووفقا لعبد الكريم فإن الترجمة، وكما هو شائع، تحتاج إلى معرفة جيدة بلغتين على الأقل، إحداهما بالضرورة اللغة الأم، اللغة التي يتم الترجمة إليها، واللغة التي يتم الترجمة منها. لكن الترجمة تحتاج بالقدر نفسه إلى الموهبة والقدرة على الإبداع، فحين يتصدى المترجم لترجمة عمل ما، وخاصة ترجمة عمل أدبي، فإنه قد يقتل العمل، مهما كانت خبرته باللغة التي يترجم إليها واللغة التي يترجم منها، ومهما كانت دقته، إذا كان يفتقر إلى الموهبة والقدرة على الإبداع.
فالنص الأدبي في الترجمة – يضيف عبد الكريم – هو نتاج مشترك بين المؤلف والمترجم، بشرط أن يكون الأخير موهوبًا ومبدعًا، وإذا لم يكن الأمر كذلك يمكن أن أقول بدون تردد إن النص تم اغتياله أو أعتبر أنه لم يترجم.

ويضيف عبد المقصود عبد الكريم أن المُطّلع على مشهد الترجمة من الخارج يظن أن هناك رواجاً في سوق الترجمة إلى العربية في السنوات الأخيرة، في ظل وجود مؤسسات متخصصة في الترجمة؛ و مشاريع خاصة بالترجمة؛ بعض دور النشر الكبرى بالترجمة؛ والارتفاع النسبي في أجر المترجم مقارنة بما كان عليه الوضع في تسعينيات القرن الماضي، والارتفاع النسبي لعدد الكتب المترجمة. لكن علينا أن نعترف بأن الكتاب المترجم سلعة، وأنه لا يمكن لإنتاج سلعة أن يزدهر من ندرة الطلب عليها بشكل يقرب إلى العدم. فالقارئ عملة نادرة ولذا، وبعيدًا عن أعداد الكتب المترجمة، نعرف جميعًا أن معظم الكتب المترجمة باستثناءات قليلة يطبع منها ألف نسخة أو بضعة آلاف على الأكثر.
ومن المواقف الطريفة- يقول عبد الكريم – أنني حين عرفت ذلك أول مرة من الموظف المسئول عن النشر في المجلس الأعلى للثقافة وسألته عن سبب الاكتفاء بطبع ألف نسخة، كان الرد صادمًا ومحبطًا: «أصل المخازن عندنا ضيقة». فقلت هل تطبعون لتضعوا الكتب في المخازن. إنها أرقام محبطة للمترجم. تخيل أن تعمل عامًا في ترجمة كتاب وأنت تعلم أنه قد لا يُطبع منه أكثر من ألف نسخة سيُلقى بمعظمها في المخازن الضيقة لتأكلها الفئران في النهاية. هذه الأرقام تلغي الانطباع الأول بوجود رواج في الترجمة. وسيبقى الحال على ما هو عليه في نظري حتى يتم إصلاح أمور كثيرة، لعل أولها التعليم حيث يتخرج معظم الجامعيين بدون أن يعرفوا الكتاب في عصر الملخصات والدروس الخصوصية.

تحديات صعبة
الكاتب والمترجم المغربي فريد الزاهي، يرى أن مركزية الغرب تتمثل مرة أخرى، في ارتباط الترجمة إلى العربية به، فالمترجم الغربي محظوظ جدا لأنه يترجم من داخل المجموعة اللسانية اللاتينية نفسها، فلا يجد صعوبة في ترجمة المفاهيم المركبة ولا في المعاني الثقافية، أما المترجم العربي فيكدح أكثر من المترجم الغربي في الترجمة من اللغات اللاتينية (الإنجليزية والفرنسية والإسبانية).. وغيرها، فيما يتلقى أجرًا أقل.

الكاتب «فريد الزاهي»
لكن الزاهي يضيف أنه إذا كانت هذه الصعوبة العامة عقبةً، فهي أيضًا حافز للمترجم العربي، كي يبدع أكثر ويفجر مكنونات اللغة العربية في مجال النحت والاشتقاق والتأويل، وربما هذا ما يبرر أن أغلب الترجمات العربية غير ذات مستوى جيد (على الأقل من اللغة الفرنسية التي أتخصص في الترجمة منها).
ويشير الزاهي إل أن ثمة مستويات متعددة في صعوبات الترجمة إلى العربية، الأول يتعلق بما يسميه بالنصوص المتمنّعة على الترجمة، وهي في الأغلب نصوص شعرية ونصوص فلسفية (روني شار مثلا وجاك درّيدا)، وهي تحتاج إلى المترجم المحترف المحنّك، بيد أن ما يسري على النص يسري على المقطع، وأعني هنا الأمثال المصكوكة والعبارات الجاهزة المحمّلة بمعاني ودلالات ثقافية مرجعية في ثقافة النص.

وتتعلق الصعوبة الثانية بالنصوص أو المقاطع مستحيلة الترجمة، والتي تلعب على اللغة أو تتلاعب بها، رغبة في خلق معاني إضافية أو جانبية يُجهد المترجم في إيجاد مقابلات لها فيترجمها على وجه التقريب، شاحذا خياله الفكري أو اللغوي.
وتتمثل الثالثة في المفاهيم المركبة المنحوتة انطلاقا من اللاتينية أو الإغريقيةأ والفرنسية أو الإنجليزية، التي تمكن من الاختزال والتكثيف، والتي يصطدم بها المترجم العربي اصطدام الموج بالصخر.
ولا يمكن للترجمة أن تمارس هذا الفعل، إذا لم يتم تشجيع تعلم اللغات الأجنبية (والكتابة بها)، فالمترجم لا يمكن أن يجاوز مصاعب الترجمة إذا لم يكن عاشقا للغة التي يترجم منها، ومتمكنا منها وملما بثقافتها.

خيانة المترجم!
ويقول الباحث والمترجم أسامة جاد، إن الصعوبة في سؤال الترجمة في عالمنا العربي هي في ممارسة الترجمة بوصفها إبداعًا موازيا، تتوسل فيه اللغة المترجم إليها، بقدر توسلك المعنى الأصيل في اللغة الأصل.
لم يعد السؤال أنه لأجل أن تترجم، ينبغي أن تعايش، وتشعر، وتحس، وإنما يتركز السؤال حول محدودية «صحة الترجمة، أو عدم صحتها».

الباحث والمترجم «أسامة جاد»
ومع التسليم بمفهوم «خيانة المترجم» بشكل مركزي، فإن سؤال الترجمة -أدبي بالخصوص- انتقل من الفن إلى الحرفة. وثانيا أن الترجمة تحولت إلى «ضربة حظ»، فأنت تقع على كتاب، أو تقع في أسره (وهذا أجمل) أو تتاح لك الفرصة أو تصادف، لا يوجد برنامج ترجمة ينبغي الإشارة إليه بعد تجارب الألف كتاب وسلسلة «آفاق عالمية»، التى اعتمدت فكرة القوائم.
وأخيرًا، فالمترجم، هذا الخائن، مطلوب منه- كما يرى جاد- أن يرتكب تلك الخيانة، وهو لا يعرف: هل ستكون الترجمة محمودة، أو الكتاب المترجم «محظوظًا؟ والناشر مستعدا لدفع حقوق الترجمة، والسؤال الأخطر: كيف سيقيّم هذا الناشر ترجماتنا المقترحة؟

وبالطبع، هناك سؤال آخر، يخص ترجمة أدبنا العربي إلى اللغات الأخرى، لماذا لا يكون ذلك قسما جديدا في المركز القومي للترجمة؟ أو مركزا يجاور مهام «القومي للترجمة» ويضيف إليها.كلها أسئلة، وتجاورها أسئلة وصعوبات كثيرة، أتصور أني لن أضيف إليها شيئا أكثر مما هو مطروح بالضرورة.
نقد الترجمة
أما الباحث والناقد المغربى الدكتور محمد آيت لعميم، فيرى أن الحديث عن راهن الترجمة في البلدان العربية، حديث يتشعب لا محالة، فأولى الملاحظات أن هناك بطئا في ترجمة الجديد من اللغات المتعددة التي تنتج فيها المعرفة، مما يجعل التفاعل مع الفكر المتجدد متعثرا وبطيئا، النقطة الثانية أن هناك قلة في المترجمات بالمقارنة مع دول أجنبية تجعل من الترجمة رهانا لمواكبة مجتمعات المعرفة يمكن أن نعزو هذا التقشف الترجمي إلى غياب مشروع ترجمي نهضوي حقيقي، هناك محاولات لتبني مشاريع ترجمية لكن ما يسجل عليها أنها تعمل على ترجمة نصوص انتهت صلاحيتها أو مذاهب فكرية ومناهج عفى عنها الزمن، ولم تعد تثير أسئلة حقيقية وقضايا راهنة، لذلك يكون تلقي مثل هذه الأعمال باهتا لأنها لم تعد تلبي انتظارات القراء والنقاد ولم تعد تستأثر بمواطن الاهتمام.

الناقد المغربى «محمد آيت لعميم»
في وقت سابق كانت ترجمة كتاب نقدي أو فصول منه حدثا، بحيث تتلقفه أيدي القراء والنقاد والمهتمين ويدخلون معه في اشتباكات ويعرفون منه أجوبة عن أسئلة تشغلهم، هكذا نلاحظ أن الترجمة في السبعينيات والثمانينيات أحدثت دينامية فكرية وفلسفية ونقدية، انعكست في طبيعة الأسئلة التي تولدت عن هذه الكتب المترجمة، هذا الأمر يكاد اليوم يختفي أو يبهت رغم الإيهام بوفرة المترجمات في حقول عديدة ومتنوعة، لكن رجع صداها ضئيل، ناهيك عن أن بعض الترجمات يغلب عليها التسرع والاستسهال فتأتي مشوهة تحجب روح النص الأصلي أو تقدم معرفة مزيفة بمضمونه، وبذلك تتحول مثل هذه الترجمات إلى عائق لإنشاء معرفة حقيقية بما يترجم، من ثم ينبغي أن نمر إلى مرحلة نقد الترجمات، هو ما ينقص حقل الترجمة العربي، فدراسة الترجمات ونقدها أمر لا محالة منه وينبغي أن نكف عن التنظير والمرور إلى مرحلة نقد الترجمة الذي يسوغ إعادة الترجمة، لأن إعادة الترجمة للنصوص تحتمها التحولات اللغوية والتطورات الدلالية والاستيعاب للمضامين النصية عبر تداولها، إذ غالبا ما يعتور ترجمة نص جديد عوائق في الفهم والاستيعاب والإدراك، ومن هنا لابد من المسافة بين الترجمة والنص، ولابد من الانتباه لتحولات اللغة.
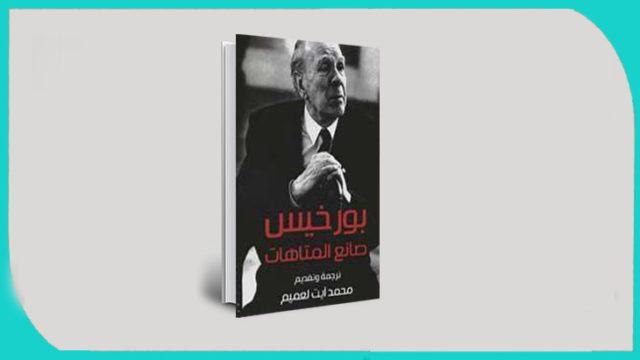
تجارب خاصة
وتشير المترجمة هناء نصير إلى ارتبط ازدهار الترجمة بالحكام المشجعين لها والحاضين عليها، فكم قرأنا عبارة «خلع عليه الحاكم» الفلاني، ويشار طبعًا للحاكم الذي يجزل العطاء للمترجمين تقديرًا لجهودهم في نقل حضارات شعوب أخرى تقدمت في فلسفة أو فن أو علم من العلوم.

المترجمة «هناء نصير»
وبقدر ما ترفض هناء نصير هذه الصيغة الماضوية التي قد تجعل المترجم مقيد الاختيار، تابعا للحاكم، فإنها تقر بانه بدون دعم مادي فى عصرنا الراهن، ومن قبله خلق منظومة مهنية محترمة لتذليل العقبات أمام المترجمين، وللتواصل الناجز للحصول على حقوق الترجمة من المؤلف أو الناشر الأجنبي، فلن تكون هناك حركة ترجمة مزدهرة، ومن ثم اللحاق بركب حضارات متقدمة في الوقت الراهن.
وتضيف: خبرتي الشخصية في نشر الأعمال المترجمة كانت سيئة، لم تشجعني على تكرار التجربة لمرة ثالثة، في المرة الأولى التي نشرت فيها ترجمتي لرواية وجيه غالي الوحيدة «بيرة في نادي البلياردو»، تحملت تكلفة طباعتها، ثم شرعت في ترجمة كتاب عن حياة وجيه غالي، عنوانه «بعد جنازة»، وتقدمت بطلب للمركز القومي للترجمة لنشر ترجمتي له فور انتهائي منها، ففوجئت بعد سنة من تقديمي الطلب بأن زميلة كانت قد تقدمت قبلي بطلب لترجمة نفس الكتاب، وقُبل طلبها، ولم يخبرني الموظفون الذين تلقوا طلبي بذلك توفيرًا لجهدي ووقتي.
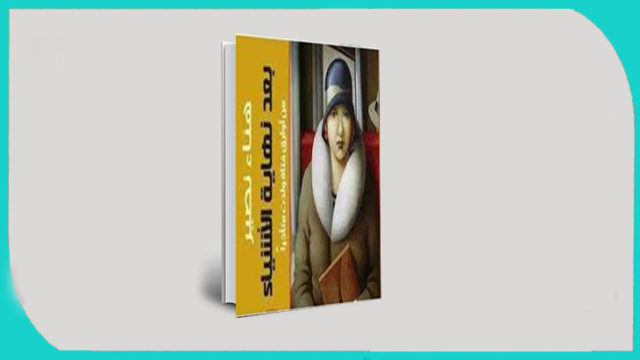
وتتساءل هناء نصير: لم لا توجد آلية محترمة لدى أكبر ناشر للكتب المترجمة في مصر العتيقة للتأكد من أن كتابًا بالعنوان الفلاني لم تطلب ترجمته قبلًا؟، وتضيف: ربما كنت سيئة الحظ، وربما وجد بعض الزملاء سهولة أكبر في نشر ترجماتهم، لكن الآلية الواضحة الحاسمة في حفظ الحقوق والجهود تنقصنا مع الأسف، فلا قوانين تحمي المشتغلين في الثقافة وتقنن تعاملاتهم مع الناشرين، ولا قنوات كتلك التي ابتدعها الغرب لحفظ الحقوق المادية والأدبية، واحترام الجهد.
وفي سياق متصل تؤكد مليكة معطاوي، وهي مترجمة شاعرة مغربية، أن الترجمة تلعب دورًا مهمًا في تطبيق المناهج الغربية على النصوص الإبداعية العربيّة، ويتطلّب ذلك مراعاة الواقع العربي على الصّعيدين الفكري والاجتماعي، تجنّبًا للتقليد الأعمى للكتابات الأوربية، وتفاديًا لعزل المنجز الإبداعي العربي عن سياقاته الخارجية الاجتماعية، والنفسية، والثقافية التي أفرزته. وتشير معطاوي إلى أن حركة ترجمة الدراسات الأدبية النقدية في المغرب تبلورت مع مطلع الثمانينيات من القرن العشرين، إلا أنها لاتزال تخضع لمحاولات ذاتية تظهر من خلال رغبة «الذات» في معرفة «الآخر» والانفتاح على فكره وثقافته، بشكل أوسع، خصوصًا وأن ثقافة الأنا تتموضع ضمن نسق ضعيف وتحتاج لثقافة الآخر.

المترجمة المغربية «مليكة معطاوي»













