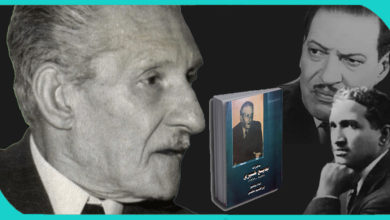ابتسمت دامعا وأنا أرد: شاعر عظيم، عاش ومات في بؤس بالغ، ونحس شديد، ومن العجيب أن يكون اسمه عنوانا لشارع فخيم فى منطقة راقية يسكنه ذوو الحظ والحظوة.

حياة بائسة وموهبة جامحة
ولد الشاعر عبد الحميد الديب سنة 1898 في قرية كمشيش التابعة لمحافظة المنوفية، لأسرة فقيرة، عائلها تاجر ماشية رزقه موسمي وليس ثابتا ويعول أسرة كبيرة العدد، وقد كان الطفل عبد الحميد كشأن أطفال القرى الفقيرة النائية في زمنها محروما بمعنى الكلمة، يرتدي الرث من الثياب، ولا يملك نقودا يذوق بها حلاوة الدنيا، ولا يعرف الفرح الحقيقي طريقا إلى قلبه المكلوم الحزين.
كان أبوه حريصا على تعليمه الأزهري على الرغم من فقرهم الشديد؛ فأرسله إلى المعهد الديني بالإسكندرية حيث نال شهادته المتوسطة. وقد كانت فرصة للشاب الذي يهوى الشعر، كي يخالط الأزهريين ويقرأ الشعر القديم بكثافة، وينفتح على عالم رحب زاخر بالمدنية وتعدد الثقافات وتنوع الطباع البشرية، لكنه لم يكن يعمل بجانب دراسته، بل كان ينتظر القروش اليسيرة التي يرسلها إليه أبوه كإعانة له على ظروف الحياة منشغلا بالاطلاع والتأمل، ومن معهد الإسكندرية انتقل الديب إلى القاهرة عام 1920 ليكمل تعليمه العالي بالأزهر الشريف، لكنه هناك انكفأ بشدة على كتب الأدب والتراث بدار الكتب منجذبا إلى موهبته بقوة جامحة ومحولا مسار دراسته إلى دار العلوم التي كانت في ذلك الزمان، قبلة المبدعين والملهمين وعشاق اللغة، وكانت – ولعل ذلك هو الأهم – تمنح طلابها مكافأة شهرية تعينهم على صعوبات الأيام، فحرمه البعد عن الأزهر من إتمام الدراسة فيه ومن ثم الالتحاق بوظيفة هو في أشد الاحتياج إليها على عكس أقرانه الذين أتموا تعليمهم واستلموا وظائفهم بسلاسة.. وقد كان إذا ذهب للالتحاق بعمل سألوه عن مؤهله فإذا ذكره (المعهد الديني بالإسكندرية وهو يعادل درجة البكالوريا) لم يقتنع أصحاب العمل به فرفضوه، ويعود هو بالخيبة منشدا:
قالوا المؤهِّلُ قلتُ الجوعُ والعَطَلُ.. يا أمَّةً ليس فيها النَّدْبُ والرَّجُلُ.
وليت الديب أتم رحلته الدراسية في دار العلوم، لكن قدره ساقه ليكون من خلصاء الشيخ «سيد درويش» الذي أبدى إعجابه به وحمله إلى قصره العامر، وكان من طبعه الإغداق على من حوله، فعاش الديب في كنف الشيخ لاهيا مفكرا في الشعر وصخب الغناء وحدهما؛ وكان من نتيجة ذلك أنه أهمل دراسته في دار العلوم تماما بل نسيها بالجملة والتفصيل، ولم يطل نعيمه الموهوم إذ لقي الشيخ سيد ربه فجأة و،هو في عز شبابه سنة 1923، وفي إثر وفاته تم طرد الديب من قصر درويش؛ فاستأجر غرفة بائسة في حي الحسين الشعبي وبدأت حياته الفعلية مع البؤس والصعلكة من حينها إلى أن قضى نحبه في سنة 1943.

سيد درويش
صدق فنى
أبرز ما يميز شعر عبد الحميد الديب صدقه الفني؛ فالرجل لم يكتب سوى نفسه بأمانة تامة، ولم يحك سوى أزمته ومأساته، ولم يثر قضية تبتعد عن قضاياه الشخصية ومعاناته في معيشته قيد أنملة، لا يعني ذلك أنه افتقر إلى الخيال فيما كتبه مقدار ما يعني التصاقه الأكثر حميمية بالواقع، ولا يعني أيضا خلو شعره من الظرف والفكاهة، فقد ولدتهما عذاباته في الشعر على أبدع ما يكون.. ينقل للناس جو غرفته فيقول:
أفي غرفةٍ يا ربُّ أم أنا في لحدِ؟
ألا شُدَّ ما ألقى من الزَّمنِ الوغدِ
أرى النَّمل يخشى النَّاس إلَّا بأرضِهَا
فأرجلُهُ أمضى مِنَ الصَّارم الهِنْدِي
تساكنني فيها الأفاعي جريئةً
وفي جوِّها الأمراضُ تَفْتِكُ أو تُعدِي
كان (يرحمه الله) خفيف الظل مرحا في قلب ضنكه الشديد، قيل إن أحدهم قال له مرة: ما أشبهك بالبحتري يا ديب؛ كانت له ضيعة واحترقت (يقصد الرجل أرضا). فقال من فوره: هو كانت له ضيعة واحترقت، أما أنا فلا أملك إلا «الضيعة» في هذا البلد (يعني الضياع)!
وفي الحقيقة تعرض الديب لسخرية هائلة من أصدقائه ومجايليه ممن كانوا يعرفون قسوة ما يحيا بين يديه، ومع ذلك لم يأخذوه إلى شاطئ آمن، لكن تسلوا به وتندروا عليه، وقد كانوا يستطيعون إصلاح حاله.. قال، بهذا الشأن، بعد أن ساء ظنه بالأصحاب وبالناس كلهم أجمعين:
كم مرَّت النُّعْمَى عليَّ بِبَسْمَةٍ
فأبعدها عنِّي وضيعُ الوسائلِ
وفي إطار إحساسه العالي بقيمة ذاته واجتراء الآخرين عليه وشعوره الكامل بالخذلان:
بينَ النُّجومِ أُنَاسٌ قد رفعتهُمُ
إلى السَّماء فسدُّوا باب أرزاقي
وكنت “نوح” سفينٍ أُرْسِلتْ حرماً
للعالمينَ فجازوني بإغراقي
وقال، منتصرا لشيمه الشخصية، كمن يعزي نفسه:
لو لم يكن نُبْلُ الحياءِ طريقتي
أقسمتُ ما عرفَ الشَّقاءُ طريقي
فبكًلِّ مضمارٍ سبقتُ وإنَّنِي
لأعيشُ عيشةَ خاسرٍ مسبوقِ
وقال أيضا:
حظِّي ومَصْرَعُهُ في لينِ أخلاقِي
وفيضُ عطفي على قومِي وإشفاقِي
يا أمَّةً جهلتني وهي عالمةٌ
أنَّ الكواكب من نوري وإشراقي
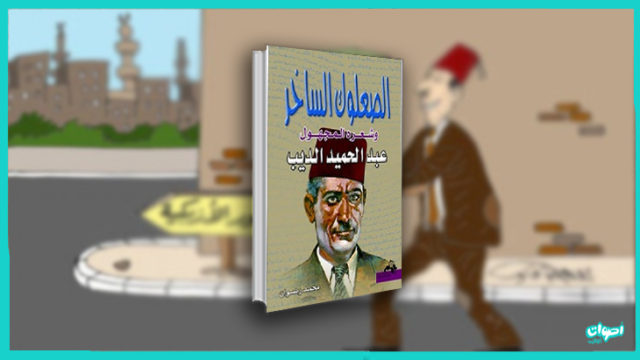
توبة ثم رحيل
وفي أواخر حياته اتجه الديب إلى ربه بمجامع قلبه، تائبا نافضا عن أثوابه غبار كل ما فات ودنسه ومبالغاته الجمة.. وبعد أن كان من يقول واصفا ما يجري في «حانة الخاخام» التي كان يؤثرها للسهر والسمر والشراب:
هات المُدَامَ فدينُ الله تيسيرُ
فأسعد النَّاس مخمور ومخدورُ
هات المُدَامَ ولا تَعْرَضْ لِمَتْرَبَتِي
مهما غلا العيش لم تَغْلُ القواريرُ
هات المُدَامَ الصَّبوحَ البكر يحملها
إليك أخنسُ ساجي الطَّرفِ مغرورُ
إذا دعوت تراخى عنك معتذراً
وأسكرتْ كالطِّلَا منه المعاذيرُ
فديتها حانة الخاخامِ هادئةً
سكرى يعربد فيها الحُسْنُ والنُّورُ
صار بعدها القائل:
إلى الله أشكـو ما فقدتُ من الصبا
بحانــةِ خمّارٍ وبيـتِ قُسٌـوسِ
فمَـن يدعُني للكأسِ بعـدُ فإننـي
اتَخِذْتُ الهدى كأسي وروحَ أنيسي
ومـاذا وراءَ الخمـرِ إلا روايـةٌ
تمثـلُ أحزانـي وشـدةَ بوسـي
والقائل:
أأكفُرُ من بؤسي بأحكامِ خالقـي
كفى بيَ رزقًا أنَّني الدهرَ مسلمُ
وقد مات عبد الحميد الديب وهو في منتصف الأربعينيات من العمر بانفجار في المخ في إثر حادثة غامضة، مات بعد أن ذاق التشرد قطعا لا ظنا، ودخل مستشفى الأمراض العقلية، إذ سقط في فخ الإدمان، وعرف السجن كثيرا بسبب العربدة والمشاحنات وعدم الوفاء بسداد الديون.. انطوت صفحته.. ويوم موته كتب صديقه الشاعر كامل الشناوي ناعيا: مات شاعر تعرى واكتست الأضرحة وجاع وشبعت الكلاب..

علا نجمه بالموت وأفَلت نجوم مهمِليه وقاتليه مهما طالت آجالهم بعده، وصار الفاشل في الدراسة منهجا شعريا يقوم الأكاديميون بتدريسه للطلاب في الجامعات ويحصدون باسمه الدرجات العلمية الرفيعة كالماجستير والدكتوراه، وصار الفقير المعدم شديد الثراء بغنى أشعاره وقصص حياته القاسية، يشبهونه بصعاليك الشعر العربي الكبار من أمثال «عروة بن الورد» و»تأبط شرّاً» وغيرهما، والأخطر أنه بقي علامة إدانة كبرى، لتاريخ الآداب ببلادنا، في دائرة مجافاة المقامات العلية، مما يؤكد وجوب تكريم النوابغ قبل أن يواريهم التراب، فما زال لدينا حتى الساعة نماذج إبداعية تماثل حالته، والناس عن هذه النماذج السامقة المشرقة في غفلة والمؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية في كهفي نعاسهما، وقد آن أوان إفاقة الجميع ووضعهم الأشياء في مواضعها اللائقة.