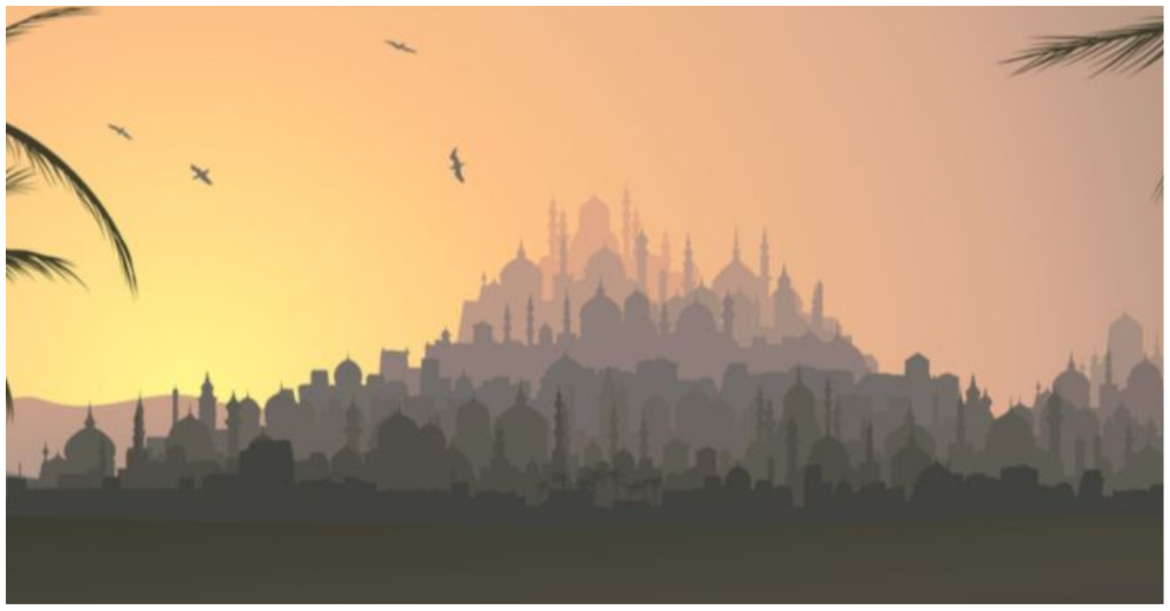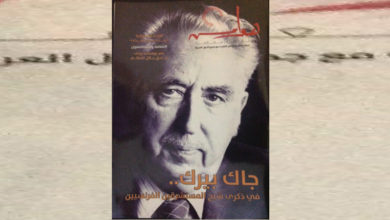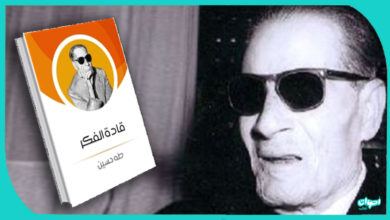التّأويل هو المساحة الّتي تشكل التّداخل الإنسانيّ مع المقدّس، وفق الظّرفيّة الزّمكانيّة، وهو محاولة للبعد عن الاغتراب الميتافيزيقيّ إلى الحيّز الإنسانيّ، الّذي ارتبط مفهومه بالعلل والمقاصد قديما، وبالقيم الماهيّة والمضافة في القراءات المعاصرة، فالتّاويل العلليّ قديما، واختراع أصول الفقه في التّعامل مع النّصّ، هو نتيجة طبيعيّة لتضخم الواقع الإسلاميّ جغرافيّا، وتكاثف التّعقل والتّفلسف زمانيّا، أمام نصّ مغلق في ظاهره، متسع في روحه، لهذا كان الإنسان عاملا في حفر النّص علليّا، وإنزاله تأويليّا، ليولد تراث طويل تتشكل به المذاهب الإسلاميّة الفقهيّة التّسعة: الإباضيّة والزّيديّة والحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة والجعفريّة والإسماعيليّة والظّاهريّة، هذا التّراث هو حالة إنسانيّة طبيعيّة، جاء ليجيب عن علاقة الإنسان بالإله والكون والطّبيعة والإنسان الآخر، محاولا لأنسنة النّصّ وفق آلة أوجدها ليتوسع في مساحة التّأويل.
واليوم في تشكل الدّولة القطريّة من جهة، وتشكل العالم في وثيقة حقوقيّة إنسانيّة واحدة، مع المفارقة بين حضارة الإنسان ذات النّزعة التّجريبيّة والعلمويّة الواحدة بين البشر، وبين الهويّات الثّقافيّة المتباينة من جهة، والمتداخلة مع الآخر بشكل كبير من جهة ثانيّة، بسبب الاقتصاد أو الإعلام أو السّياحة، أمام آلات لم تتجاوز فقط آلات القرون الأولى، في المنطق واللّسانيّات والأصول، بل تجاوزت عصر الأنوار، وما بعد الحداثة والدّراسات البنيويّة، هذا بذاته وسّع جهة الفردانيّة من جهة، وعمّق النّزعة الإنسانيّة من جهة أخرى، ليترتب على هذا مصاديق على مستوى الفرد والدّولة والتّعامل مع الآخر المختلف، لهذا اليوم التّأويل يتشكل في لباس جديد، يحمل من المراجعات أمام نصّ جاء في فترة مغايرة تماما، وبعيدة جدّا، وأما تشكلات روائيّة ولدت نتيجة التّدافع المذهبيّ والسّياسيّ، والتّثاقف مع الأديان والملل الأخرى، نتيجة التّوسع الجغرافيّ، وأمام اجتهادات تراثيّة حملت التّعدّد والتّناقض لطبيعة الإنسان ذاته، وأمام روح النّص وعلاقته بالماهيّة والقيم المطلقة من جهة، وبين تباين إسقاطاته التّأويليّة الزّمكانيّة المرتبطة بالإنسان كعقل مؤول، وآلة اخترعها ضبطا لتأويله وإسقاطه.

هذا إذا توقفنا عند الجانب الفقهيّ، الّذي هو واسع بذاته بالضّرورة، وحاول الفقهاء أنفسهم توسعته من خلال توسيع دائرة الرّأي، وكانت الحالة الفقهيّة تدور سابقا وفق المناخ السّياسيّ من جهة، ووفق المناخ الجغرافيّ من جهة ثانية، وأمّا من حيث المناخ المعرفيّ فلم يك بتلك السّرعة، وعادة تطوّره ضعيف، ومرتبط برغبات السّياسة وتوجهها، وبحركة الاجتماع البشريّ جغرافيّا، ويميل المناخ المعرفيّ فقها عادة إلى التّكرار، فيكرّر المتأخر العديد من أدبيّات من تقدّمه، وأحيانا بذات اللّفظ والعبارة، دون إشارة أو عزو، لهذا مال المحقّقون المتأخرون إلى ضرورة التّفريق بين المصدر والمرجع، فكم من كتاب متقدّم نوعا ما، لكنّه ليس مصدرا، ويدخل في دائرة المرجع لمصدر تقدّمه، وهذا واضح في الأدبيّات التّراثية، في التّفسير والسّير والفقه وغيرها.
وأمّا المناخ السّياسي؛ فبعض السّياسات قديما تنهج منهج التّعايش والتّعدّديّة، وبعضها تنهج منهج الإقصاء إمّا بشكل مباشر، بإلزام النّاس بمذهب كلاميّ أو فقهيّ معيّن، أو بشكل غير مباشر، من خلال إعطاء المزايا كالقضاء والرّتب العسكريّة والوظائف المهمّة وما دونها لمن يتبع مذهب الحاكم، أو الأسرة الحاكمة، وبالتّالي تهميش المذاهب والطّوائف الأخرى.
ومع التّجاذبات القديمة، وتشكل الدّولة القطريّة في العالم الإسلامي مع بدايات القرن العشرين الماضي، نجد التّشكل الجغرافيّ مرتبطا وفي حركة الاجتماع البشريّ بمذاهب كلاميّة وفقهيّة استقرت فيه، إمّا لأسباب سياسيّة أو اجتماعيّة أو معرفيّة لها ارتباطها التّأريخي العريق لهذه التّكوّنات المذهبيّة.
وفقهيّا مرت المذاهب الإسلاميّة قديما بحالات من الصّدمات المعرفيّة؛ كتشكل ثقافات لها مناهجها وأصولها الدّينيّة تحت لباس الفكر الإسلاميّ، ولأنّ الإسلام انفتح عليهم؛ هنا يدخلون بثقافتهم وخصوصيّاتهم، ثمّ بسبب جمود المسلمين على مذاهب فقهيّة معينة تشكلت بعد فترة طويلة من صدر الإسلام؛ طالب بعضهم بوقف الاجتهاد، والبقاء تحت مظلّة أصول المذهب الّذي ينتمي إليه، حتّى على مستوى الأصول الاجتهاديّة، فضلا عن أصول المذهب الكلاميّة، الّتي اعتبرها العديد منهم هي أصول الدّين، ولو في المسائل الكلاميّة الفرعيّة، فكفّر الآخر وبدّعه وضلّله.
وفي النّصف الثّاني من القرن التّاسع عشر الميلاديّ، وبدايات القرن العشرين، كان العالم الإسلاميّ يعيش صدمة الانفتاح على عالم آخر تقدّمه بكثير جدّا، بينما هو توقف عند نقطة زمنيّة كان الأفضل فيها من غيره حينها، ولكنّه راوح ذاته ومكانه، فتقدّمه غيره بفترة زمنيّة سريعة، فأفاق على حالة من الصّدمة، والتّخوّف من الاخر، حتّى جاء العطار (ت 1835م)، والأفغاني (ت 1879م)،والكواكبيّ (ت 1902م)، ومحمّد عبده (ت 1905م) وغيرهم، وحاولوا الموائمة بين الشّرق والغرب، وحاولو تقديم رؤية تبريرية للنّص والتّراث، مع شيء في سعة تأويل المتحرك من التّراث، ومع الانفتاح على حضارة الغرب في شقّها التقنيّ والتّطبيقيّ، وشيء من الجانب الثّقافيّ بما لا يتعارض مع أصول الثّقافة الإسلاميّة، كانت المدرسة الإصلاحيّة، والّتي عاشت في صراع طويل مع المدرسة التّقليديّة، وقد أوذوا بسببها، وأقصوا اجتماعيّا، وأحيانا سياسيّا ووظيفيّا، إلّا أنّها بتبني السّاسة لها أصبحت في مناطق عدّة أكثر شيوعا، والأزهر الّذي حاربها بقوّة أصبح اليوم يتمثل بعض جوانب الحركة الإصلاحيّة بعد عقود من الصّراع.

ومن المدرسة الإصلاحيّة ظهرت مدارس سياسية وفكريّة ونقديّة متعدّدة ومتباينة أحيانا، فالمدرسة التّجديديّة أيضا عاشت مع صراع التّقليديين من جهة، ومع من يوصفون بالمتغربين الّذين يرون أنّ نهضة الأمّة تبدأ من القطيعة مع التّراث كليّا، أو حتّى الدّين ذاته، ومنهم من يرى علمنة الفصل، فالدّين للفرد، ونهضة الدّولة تبدأ من العيش مع حاضرها وسنن تقدّمه.
كذلك ظهرت المناهج القرآنية، وإن كان ظهورها قديما، إلّا أنّها تشكلت في مناهج جديدة، ثمّ يعتبر العديد من الإصلاحيين أنّ محمّد رشيد رضا (ت 1935م) الوريث لحركة الإصلاح عند الأفغانيّ ومحمّد عبده، فيما يراه آخرون أحدث تراجعا في العقود الأخيرة من عمره، وربطوا به ظهور حركة الإخوان المسلمون عام 1928م على يدي حسن البنا (ت 1949م)، ومن حركة الإخوان، ولسبب الفراغ الّذي حدث بسبب سقوط دولة الخلافة العثمانيّة، بدأ تشكل الإسلام السّياسيّ، الّذي سيتمدّد جغرافيّا مع الشّيعة الإمامية عن طريق حزب الدّعوة، والإماميّة الطّائفة الإسلاميّة الأكبر بعد السّنّة، كما أنّها تقترب من الفكر السّياسيّ الإباضيّ، لتمثلها في الشّورى المطلقة خلافا للقرشيّة في الجملة، وتقترب أيضا من المذهب الزّيديّ.
ولأنّ كتب الإخوان المسلمون، كتابات سيّد قطب (ت 1966م) والمودوديّ (ت 1979م) وزينب الغزاليّ (ت 2005م) ومحمّد قطب (ت 2014م) وفتحي يكن (ت 2009م) والقرضاويّ (ت 2022م) وغيرهم، لقت رواجا كبيرا في الخليج خصوصا، ولخطاب الحركة المتقدّمة مقارنة بالمدارس التّقليديّة والسّلفيّة (الجاميّة) لقت تمدّدا جغرافيّا في العالم الإسلاميّ عموما، كما تزاوجت مع السّلفيّة الحركيّة لتنشأ السّلفيّات السّروريّة والصّحويّة، وهذه التّوجهات عموما لقت دعما سياسيّا وماليّا كبيرا في العقود الأخيرة من القرن العشرين؛ لأجل مجابهة الحركات اليساريّة، فظهرت مرحلة الصّحوة، والّتي تحجرت بعد نجاح الثّورة الإسلاميّة في إيران عام 1979م إلى الانقسام الطّائفيّ، كما في العقدين الأخيرين من القرن العشرين، وبداية الألفيّة الجديدة، فقد عاشت المنطقة حالة من إحياء أدبيّات الصّراعات الكلاميّة بين المسلمين، كما ولدت من التّيارات السّلفيّة الحركيّة جماعات اتّسمت بالعنف والتّكفير كالهجرة والقاعدة وغيرها.

وفي فترة هذا المخاض بدأت أقلام جديدة، وإن وجد بعضها مبكرا مع الحركة الإصلاحيّة، إلّا أنّها توسعت وتعدّدت أكثر في نهايات القرن العشرين، وصوتها أصبح أكثر مسموعا مع الفضائيات والشّبكة العالميّة، ومع وسائل التّواصل الاجتماعيّ.
ونحن اليوم بعد مرور أكثر من مائة عام على ظهور المدرسة الإصلاحيّة، وهذا المخاض الفكريّ والمذهبيّ الكبير مع نشوء الدّولة القطريّة، وسعة الطّباعة، وتقدّم الإعلام الحر، من المجلّات والصّحف والشّريط السّمعيّ (الكاسيت) إلى وسائل التّواصل الاجتماعيّ، ساهم هذا في إحداث تشكلات ومراجعات فاقت ما أنتجه المسلمون سياسيّا وكلاميّا وفقهيّا خلال الأف عام ما قبل القرن العشرين.
وعليه ونحن اليوم بدأنا شوطا كبيرا في بدايات القرن الحادي والعشرين، وأمام مرحلة جديدة حول الأنسنة وسعة التّأويل، ومنها بلا شك أنسنة المذاهب، وجعلها في حيّزها الطّبيعيّ؛ لأنّ القراءات اليوم أكثر تعقيدا من الأمس، ودخل حولها آلات ومفاهيم جديدة تحاكم بها، لهذا – كما ذكرتُ في كتابي لاهوت الرّحمة – أنّ العديد من القراءات الإسلاميّة بدأت تتجه ضمن اتّجاهات ثلاثة: اتّجاه الأنسنة من حيث المرجعيّة (الحاكميّة)، واتّجاه الأنسنة من حيث النّصوص الإجرائيّة (الظّرفيّة التّأريخيّة)، واتّجاه الأنسنة من حيث التّاويل (العلليّة)، وهي اتّجاهات تقدّمت في الدّراسات اللّاهوتيّة الغربيّة اليهوديّة والمسيحيّة، إلّا أنّ حضورها اليوم في الدّراسات الإسلاميّة ينقلنا إلى مراحل أكبر للتّعامل مع النّص الدّينيّ وتحقيق النّهضة والتّنوير في العالمين العربيّ والإسلاميّ من خلال الحاضر والإنسان، وليس من خلال الماضي وخصوصيّاته وصراعه، وليس أيضا من خلال الاغتراب الميتافيزيقيّ بدلا من واقع الإنسان وقيمه الكبرى.