تتصاعد كل يوم الدعوة إلى تنقية التراث الديني مما جاء فيه من غرائب ومتناقضات، وأحيانا تتسع هذه الدعوة لتشمل ما يبدو عصيا على فهم من لا حظ له من علم تأسيسي، ومن لا يمتلك أصلا الأداة الأولية لفهم أي نص عربي، وهي الدراية الواسعة بقواعد اللغة والبيان العربي.. ثم يعلو صوت الداعين إلى هذه التنقية مع كل حادث إرهابي، بزعم أن كتب التراث هي التي صنعت أفكار الغلو والتطرف الموصل حتما إلى العنف والإرهاب.
لكن الدعوة لما يسمى “تنقية التراث” بدت حائرة مرتبكة، وبدا أصحابها كأنهم لا يدركون ما يريدون، أو كأنهم ضلوا الطريق إلى مقصدهم، ووصفوا دواء لغير المرض الذي نعاني منه.
قديمة هي العناية بالتراث المكتوب في تاريخ العرب، حيث مارسوا مبكرا ما اصطلحوا على تسميته بـ”الضبط” و”التحرير” و”المقابلة”، وفي المعجم الوسيط: ضَبَطَ الكتابَ ونحوه: أصلح خلله أو صححه وشكَّله. أما التحرير فعَرَّفه أبو بكر الصولي في “أدب الكُتَّاب” بقوله: “تحرير الكتاب خلوصه، كأنه خلص من النسخ التي حرر عليها وصفا عن كدرها”. وأما المقابلة فهي مقارنة نسخ الكتاب بعضها ببعض من أجل ضبط النص وتصحيه.
وفي كتابه “سيبويه إمام النحاة” يقول الأستاذ علي النجدي ناصف: كان للقدماء عناية ملحوظة بضبط النصوص والمحافظة على صحتها، كانوا يروون أخبارها بالسند حتى يرفعونها إلى أصحابها، على نحو ما كانوا يصنعون بأحاديث الرسول عليه السلام، وكانوا ينسبون نسخ الكتب التي يكتبونها فرعا إلى أصل، حتى يبلغوا بها أوائلها التي تحدرت منها”.
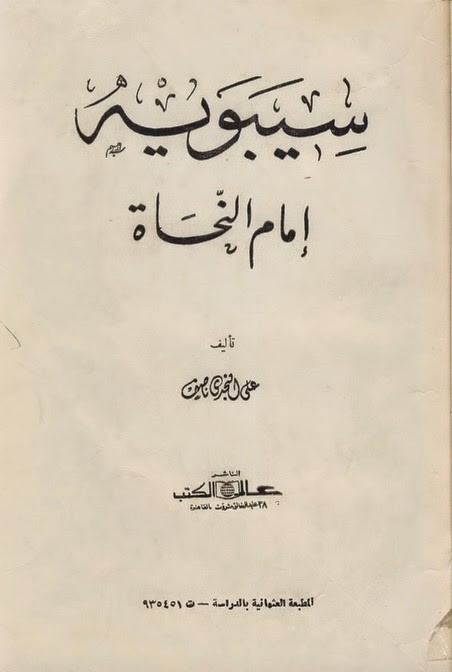
وقد تطور تعامل العرب مع الكتب والمخطوطات إلى أن وصلوا إلى المرتبة التي سميت لاحقا بـ”التحقيق”، الذي عرفه العرب عمليا قبل الأوروبيين، وإن لم يعرفوه كعلم ومادة مستقلة إلا بعد أن أنضجته أوروبا.
ومن أولى المهام التي يقوم بها المحقق، أن ينفي من الكتاب كل قول دخيل لم يكتبه المؤلف، وأن يثبت فيه ما كان قد سقط منه بالسهو والخطأ، وهذا ما فعله كل المحققين من العرب والمستشرقين، في القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديين.
ومن العجب إذن، أن ترتفع أصوات اليوم تنادي بقلب هذا المنهج، وبنفي ما أثبته المؤلف في كتابه، وإعادة طبع الكتاب بعد الحذف، يحمل نفس الاسم، منسوبا لنفس المؤلف.
لا سبيل إلى إنكار مشكلات التراث، ولا إلى تجاهل بعض الأحاديث النبوية التي يرى كثيرون أنها تعارض صريح العقل، أو منطوق القرآن، لكن مواجهة هذا الإشكال لا يكون بـ”تنقية البخاري”، فهذه دعوى صارخة، عالية الصوت، لكنها مستحيلة التحقق، أو هي بالأحرى لا معنى لها أصلا.
عبر قرون، عرف المسلمون في تعاملهم مع التراث “الشروح” و”الهوامش” والحواشي”، وفرقوا بحزم بين ما قرره المؤلف، وما يسوقه الشارح، وكان التعامل العلمي مع الحديث النبوي هو النقد لا الحذف، حتى مع تلك الأحاديث الموضوعة، التي يجزم أئمة هذا الفن بأنها مكذوبة على الرسول، بينوا تهافتها، وأسقطوا سندها.
وإذا ضربنا بالبخاري المثل، فلنا أن نتساءل: ماذا نعني بتنقيته؟ وكم حديثا نحتاج إلى حذفه من متنه؟ ومن يقرر هذا الحذف؟ وماذا لو اختلفت الجهات المنوطة بالتنقية على مقدار المحذوف؟ وإذا تم، فمن سيعترف به؟ وماذا سنفعل بملايين النسخ الأصلية في كل بقعة من بقاع العالم؟، وماذا لو استجدت مطالبات التنقية مرة أخرى، وارتفعت أصوات المطالبين بحذف المزيد؟
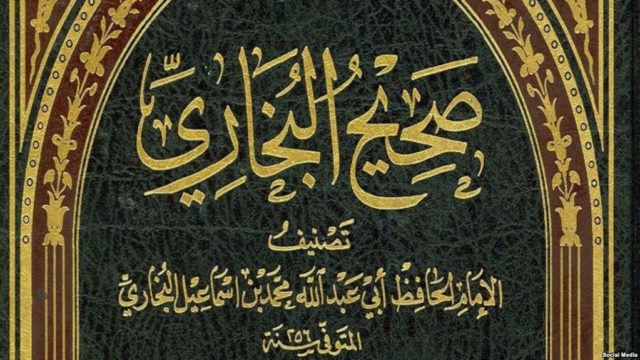
ثم لنا أن نتساءل: هل من الصنيع العلمي أن نغير في مؤَلَف ما بالحذف، ثم نصر على نسبته إلى مؤلفه؟ وهل تقبل مراكز العلم الأكاديمي في العالم بهذا العمل؟ وهل سيعترف أحد بـ”النسخة المعدلة” التي وقع عليها هذا التزوير؟
ويبقى السؤال الأهم: ما الذي ينبني عمليا على وجود نسخة من البخاري تخلو من بضع مئات من الأحاديث ذات الإشكال؟ هل سينتهي التطرف؟ هل سيتلاشى الغلو؟.. أظننا أننا نجهد أنفسنا، ونستنزف طاقاتنا، فيما لا طائل من ورائه، والأولى أن يذهب الجهد والطاقة إلى محاولة إدراك موضع الخلل، والبحث عن علاج حقيقي، وليس مسكنا مزيفا.
وفي سياق الدعوة إلى التنقية المزعومة، تتعالى بعض الأصوات بنقد مناهج الأزهر، ولا أظن أن أحدا يرفض النقد العلمي، أو يعادي التجديد والتطوير، لكن ليس من الصنيع العلمي تحميل مناهج الأزهر مسؤولية العنف والإرهاب، إذ إن أي حصر سريع لأسماء قادة جماعات العنف في مصر سيثبت أن الأغلبية الساحقة منهم ليسوا من خريجي الأزهر وجامعته.
كما أن هذه الجماعات لا تقر بمرجعية الأزهر ولا بمنهجه في العقيدة أو في الفقه، وأكثرهم يتطاول على رموز المؤسسة الأزهرية، وعلى مقام شيخ الأزهر، فأنى لهؤلاء أن يتراجعوا عن مواقفهم واختياراتهم الفكرية والفقهية إذا تبدلت بعض الكتب الدراسية الأزهرية بغيرها أو حذفت منها بعض الأبواب أو الآراء الفقهية؟.
في ظني أن الأولى بدعاة التجديد، أن يحرصوا على تشكيل وصياغة موقف مختلف من التراث، لا تغيير التراث، على تغيير النظرة الجماهيرية لكتب الأقدمين، وليس التلاعب بمحتوى هذه الكتب.









