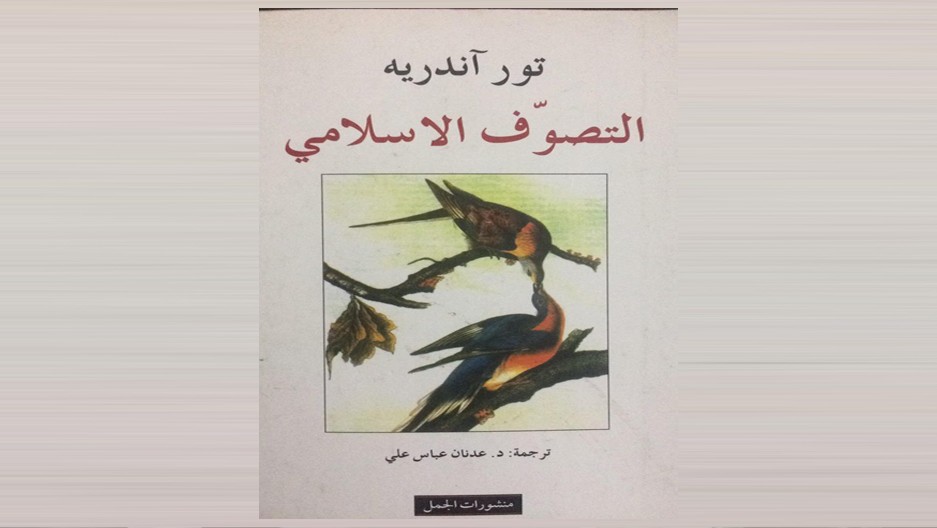يزعم الكاتب تور آندريه أن المسلمين كانوا يعتقدون أن الرهبان المسيحيين ما هم إلا أفراد ومجموعات هربت من اضطهاد الأغلبية المسيحية بعد تمسكهم بعقيدة ترفض اعتبار المسيح ابنا لله.
ويضرب مثالا بخالد بن يزيد، هذا الزاهد الذي عاش في القرن الأول الهجري، فهو أيضا كان يعتقد أن هؤلاء المتقشفين أو بعضهم على أقل تقدير نصارى مؤمنون بمبادئ العقيدة الأولى الأصلية التي تنسجم بلاشك مع الإسلام، فهم لاذوا بالفرار إلى الصوامع في المناطق النائية المقفرة الجرداء خوفا من أن يكرهوا على الأخذ بالرأي القائل بأن لله ابنا.
يتحدث خالد عن لقاءات مثيرة جرت بينه وبين بعض هؤلاء المتقشفين ورئيسهم فهم يقطنون في منطقة مجدبة في الجزيرة لا سبيل للوصول إليها.
وثمة أقاصيص خيالية يجري تداولها عن حواري المسيح، “فديار شعب عاد” مدينة أسطورية في مكان ما في قفار بلاد العرب الشاسعة ونوع من ملتقى أشباح يقطنه قديسون اختلفت آراؤهم، ولكنها اشتملت على عبادة الله، وهناك التقى حسب ما تنقله الرواية، سهل بن عبد الله بأحد حواري السيد المسيح عليه السلام.
يقول سهل: اجتمعت بشخص من أصحاب المسيح عليه الصلاة والسلام في ديار قوم عاد فسلمت عليه فرد على السلام فرأيت عليه جبة صوف فيها طراوة فقال لي: إنها عليّ من أيام السيد المسيح عليه السلام، فتعجبت من ذلك فقال: يا سهل إن الأبدان لا تخلق الثياب، إنما يخلقها رائحة الذنوب ومطاعم السحت. فقلت له: فكم لهذه الجبة عليك؟ فقال: لها على سبعمائة سنة.. إنها رواية أسطورية بلا شك لكن الكاتب يسوقها كغور في وجدان العقل المسلم ليعزز بها نظريته.
ينتقل تور للعصر الأموي الذي يصفه بأنه لم يكن متسامحًا فحسب، بل كان ينظر في نواح كثيرة، وعلى وجه الخصوص، في محيط الجماعات الزاهدة، بعين الرضا للنصاري، وإذن فليس من الغرابة أن ينقل عن محمد بن يوسف الأصبهاني أنه كان إذا رأى نصرانيا أكرمه وأضافه وأتحفه مبتغيا بذلك ميله إلى الإسلام.
يعتقد تور أن الوعي بالقرابة الفكرية مع المسيحية، أو بصورة أدق مع تلك الصيغة المسيحية التي اعتقد المرء أنها الصيغة الأولى، غير المحرفة، من خلال مكان الصدارة الذي احتله المسيح في أقوال وتصورات الزاهدين، فالأنبياء الذين يذكرون في الروايات الدينية هم المسيح وموسى وداود ويوحنا المعمدان، مرتين على هذا النحو تماما، فالمسيح يحتل من بين هؤلاء الأربعة المرتبة الأولى.
يتجاهل تور أن الكتاب المقدس للمسلمين (القرآن) ومن ثم عقيدة المسلمين تعظم من شأن الرسل والأنبياء، حتى أن القرآن أفرد مساحة كبيرة لموسى عليه السلام وقصته أكثر مما أعطى لعيسى عليه السلام، وأن ذلك احتل بلا شك حيزا ضخما في العقل الإسلامي ووجدانه، لكن الكاتب بحكم نشأته الكنسية سلط مجهر بحثه على روايات في التراث الإسلامي يستطيع من خلالها أن يثبت مدى تأثير المسيحية على الإسلام، مغفلا الروايات التراثية الأخرى التي صبت في اتجاهات عديدة تأتي من روافد إسلامية بحتة بحكم أن الإسلام جاء خاتما للرسالات السابقة لا ناقضا لها.
يسترسل تور في إثبات فكرته الأصلية قائلًا: يبدو أن الزهاد المسلمين قد أصابوا معرفة لا بأس بها عن صفات المسيح الواردة في الإنجيل، ولكن الأمر الذي يجلب الانتباه هو الدور الضئيل الذي لعبته هذه الصفات في تشكيل صورة المسيح في معتقدات المؤمنين المسلمين، فالسيد المسيح عليه السلام في معتقدات التصور الإسلامي هو بالدرجة الأولى زاهد عظيم، إنه المثل الأعلى للقديس الذي استغنى عن حاجات الحياة الدنيا وارتباطاتها جميعا، فراح يسيح في الأرض يلتحف السماء ويتوسد الأرض، وهو في جولاته ورحلاته لا يطلب النقود مثله في ذلك مثل الراهب البوذي المتسول تماما، ولكنه يختلف من حيث أن هذا الأخير كان يمتلك مصفاة وطاسة للصدقات، أما المسيح فما كان يمتلك أي شيء من المتاع، إنه لا يتسول من أجل لقمة عيشه، وإنما يقتات بما تجود به له الطبيعة: ماء من عين وحشائش مما ينبت في الأرض.
ومن مأثور ما ينقل كثيرا عنه: (… كان عيسى عليه السلام يلبس الشعر، ويأكل الشجر، ويبيت حيث آواه الليل، ولا يرفع غداء لعشاء، ولا عشاء لغداء ويقول: مع كل يوم رزقه).
وحسب ما ينقله كعب الأحبار: ( كان عيسى بن مريم … سبط الرأس، ولم يدهن رأسه قط، وكان عيسي يمشي حافيا، ولم يتخذ بيتا ولا حلية ولا متاعا ولا ثيابا ولا رزقا إلا قوت يومه، وكان حيثما غابت الشمس صف قدميه وصلى حتى يصبح) .
ومعنى هذا أنه كان عليه السلام قد حقق أعلى درجات الزهد في الحياة الدنيا ( لأنه كان في سياحته من التجرد بحيث لم يكن يملك إلا الوعاء، وعندما رآه يخلل شعره بأصابعه رمي المشط).
لكن ما لم يشر له آندريه أن الإسلام أعد عيسى عليه السلام من ذوي العزم من الرسل، حتى أن الصفات التي ذكرها عن المسيح كما يراه الإسلام لا تبتعد عن صفات الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، فقد كان زاهدا متقشفا لكنه لم يكن لديه خصومه مع الدنيا، وحث الرسول المسلمين على التزام الطرق الوسطى ( اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وأعمل لآخرتك كأنك تموت غدا..) و(إِن قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها).
يستمر تور في الاستشهاد بما جاء في كتب التراث عن عيسى عليه السلام: إذن فهو عليه السلام المثل الأعلى للزهاد والمتصوفين، فقد (سأل الحواري عيسي بن مريم هل لك شبيه في الأرض، فقال: نعم من كان حديثه ذكرا لله وصمته عبادة ومنظره تحذير للنفوس) وربما تجدر الإشارة إلى أنه كان لدى المسلمين تصورا جيدا عن هيئة عيسى عليه السلام وملامح وجهه.
يحاول المؤلف أن يصل إلى نتيجته المسبقة: يمكننا ببساطة تسمية التعبد الصوفي بأنه “اتباع طريق المسيح” ففي قول مأثور يشوبه الإبهام والغموض يحدثنا نوف الكلبي قائلا: ( رأيت عليا بن أبي طالب رضي الله عنه قد خرج فنظر إلى النجوم، فقال يا نوف، أراقد أنت أم رامق؟ قلت: بل رامق يا أمير المؤمنين! فقال: يانوف طوبى للزاهدين في الدنيا والراغبين في الآخرة أولئك قوم اتخذوا الأرض بساطا وترابها فراشا وماءها طيبا والقرآن والدعاء وثارا وشعارا فرضوا الدنيا على منهاج المسيح عليه السلام.