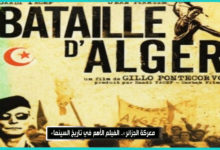«كنت أول فنان يرسم صورا للحرب».. جاءت على لسان الفنان الإنجليزي كرو نيفينسون الذي قدم العديد من اللوحات التي تعبر عن الحرب، كما أنه شارك في الحرب العالمية الثانية كسائق سيارة إسعاف.
العبارة توحي بالفخر، كما أنها شهادة في الوقت نفسه على خوض حرب أخرى بالجمال والإبداع والفن، هذا ما يجعلنا نسأل هل تعطي الحرب انطباعات مغايرة عن الجحيم والقسوة والدمار والخراب الذي يسكن بداخلها؟
نفر أحيانا من ويلات الحرب بقراءة ما تولد عنها من حياة أخرى، إلى أعلام مرفوعة بالبهجة على أرض افترشتها جماجم. من عاشوا ويعيشون تحت وطأة دوي القنابل والانفجارات هم الأكثر قدرة على وصف ما يجري، هم الأجدر بالتصدي لقراءة الحرب بعيون مفتوحة وكتابتها كشاهد عيان.
تاريخنا وموروثنا الثقافي العربي هو الأكثر احتفاء بالحرب، بطل منجزه الإبداعي الذي تبارى العديد من شعراء العربية في وصف معاركه، بل وما خاضوه بأنفسهم من حروب.
في هذا الملف توجهنا لمبدعين عاشوا أو عايشوا تلك اللحظات في ساحات شتى خضبت أرضها الدماء، ليكتبوا لنا شهاداتهم عن واقع الإبداع تحت وطأه الحرب، وأن يقدموا إجاباتهم عن السؤال: هل تتولد من الحرب حياة موازية تثير فينا أحيانا شيئًا من الإعجاب والدهشة والفرح؟
انتصار السري (اليمن): رحلتي مع الحرب

أن تنام في هدوء وتصحو على صوت يهز كيانك ويرج بيتك، صوت غريب عليك لم تسمعه من قبل، لا تشعر إلا بخوف ينهش روحك وعائلتك، كل هذا تشعر به وأكثر في لحظات فاصلة ما بين زمن راح فيه الأمان وزمن أت معه الخوف.
لحظتها تشعر أنك لن تقدر أن تغادر بيتك، فالصواريخ تتساقط على مدينتك وبلدك مثل المطر، وفي خلال أيام يتدمر كل شيء في بلدك، شعور بالموت لحظتها يشل قلمك، تفكر بالنجاة، الخلاص.
تمر أيام وأنا قابعة في بيتي اتابع نشرات الاخبار، واتتبع اصوات الصواريخ وعدد الضحايا، كل يوم يزداد اعدادهم وينتشلون جثثهم من تحت الأنقاض. سعير الحرب يزداد كل يوم، اعتدنا النوم على صوت الصواريخ ومشاهدة اشلاء الشهداء تتناثر في كل مكان، كنت اقول كل ذلك سوف يكون من الماضي، ستكون مجرد ذكرى أليمة سوف تمحى، لن يظل غير بقايا بشر فقدوا اطرافهم، قلب أم مجروح على طلفها، طفل صار يتيما.
خلال تلك الفترة لم اتمكن من القراءة بشكل جيد، لم اتمكن من مسك القلم وكتابة حتى خواطر، انقطعت الكهرباء وعملي كله الكتروني يعتمد على الكهرباء والنت، اخرج من البيت إلى المقاهي احمل كمبيوتري لشحنه وشحن هاتفي. عندها بدأت اشاهد الناس يخرجون يضحكون، وكأن لا يوجد هناك حرب. اوضاع البلاد كل يوم في تدهور، الحرب لا ترحم، وخاصة أن الصحيفة التي كنت اشتغل فيها اغلقت مع الحرب، وكذلك المجلة التي كنت احرر صفحتها الأدبية اغلقت لعجزها عن دفع الرواتب، مع ذلك لم ايأس بل كنت أحاول أبث روح الأمل على من حوالي من الزملاء وأقول سيكون ذلك من الماضي، بدأت اتواصل مع مجلات عربية ونشرت عندهم عدد من الاعمال الصحفية.
مع مرور الأيام صار الدولار يرتفع ويزيد، وكل يوم بسعر جديد، لقد تفاقمت الحرب الاقتصادية علينا تلك التي لهيبها أشد سعيرٍ من حرب الصواريخ. وها نحن ننتظر فرج من السماء وأن تقام ثورة جديدة تسمى ثورة الجياع سوف تكون هي ثورة الشعب.
عادل فورتيه (ليبيا): ضوء في آخر النفق
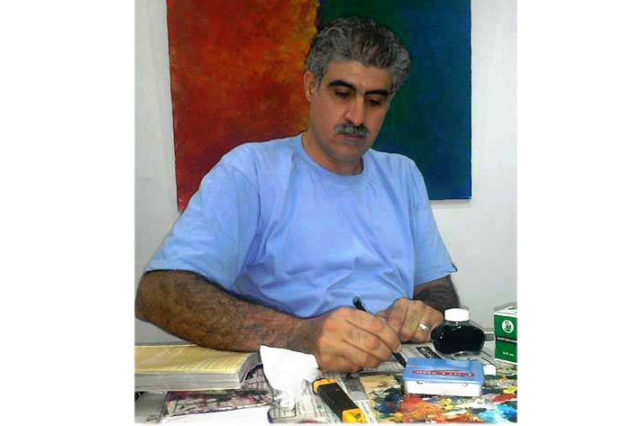
لا أدري، هل ثمة حروب تنشب مباشرة ويصبح هدفها الأساسي هو القتل لمجرد القتل؟ اعتقد أن الأيديولوجيا هي الخطر الحقيقي على الإنسان عموما، ليس لكونها فكرة مطلقة غير قابلة للنقاش أو الحوار، بل لاعتبارات مختلفة أساسها تصنيف البشرية مع أو ضد، وبذلك تصبح الحروب اداة طيّعة عند من يمتلكون قرار إشعالها.
ذلك الخطر من الممكن أن يدمر العالم كما حاولت أن تفعل الفاشية أو النازية، والآن نجد أيضا بعض الدول الكبرى تسعى بكل قوتها لإضرام نار الحروب في مناطق عديدة من العالم لا لشيء إلا لفرض أجندتها وهيمنتها وتحقيق مصالحها الضيقة أحياناً.
للأسف، شعور سيئ جدا تجاه ما يحدث في منطقتنا المتعددة الأعراق والطوائف والملل والنحل، وخاصة ليبيا حيثما أعيش، فالقتل أصبح عند البعض متعة ورغبة جامحة للسيطرة على الآخر. ليس هناك وقت محدد حتى تسيل دماء أحدهم، فقط الضغط على الزناد.
أحاول بكل الطرق أن أسجل وأوثق ما يعترى الجسد الليبي من تشظي وتفسخ جراء الحروب والقتل، كان ذلك من خلال اسكتشات (أبيض وأسود). أعرف أن المكان هنا بارد ومظلم لكن باعتقادي هناك نور في النفق، ضوء خافت يقترب رويداً.
أؤمن كثيراً بالإنسان في حد ذاته، لن تستطيع الحرب بشراستها وجبروتها أن تقضي على ذلك الإنسان، سيظل هو المحور والمركز، حامل القيم والمبادئ الخيّرة، ربما لايزال الطريق طويلا، ولكن رغم الدمار المحيط بنا من كل الجوانب، ينبغي أن نستنهض ذلك الأنسان في ذواتنا جميعاً، وهي قضية شائكة بالأساس من حيث حضورها في العالم لكن ينبغي أن يظل للفنان والمثقف والأديب صوتاً قوياً يستطيع من خلاله أن يخرج للعلن بين الفينة والأخرى، وبكل الأساليب، المباشرة منها وغير ذلك، بالرغم من فداحة الموقف أحياناً.
عند اشتعال الحرب الأهلية في إسبانيا قبض ذات مرة على الشاعر الإسباني لوركا، وجرى سؤاله: أنت مع من؟ فأجاب بكل جرأة: أنا مع الخاسر.
بسمة شيخو (سوريا): في البدء كانت الكلمة

قصيرو النَفَس، لا نستطيع أن نتكلم عن مأساة سوريا دون أن نلهث على عتبات الألم، تتناثر الكلمات من شفاهنا منهكة ومتقطّعة وكأنّ زخات الرصاص قد طالتها هي الأخرى، لا ذنب لسوريا، وبالطبع لا ذنب لنا إن لم تقو ظهورنا على حمل عبء التغريبة الجديدة، تلك التغريبة التي فرضت بقسوة بعد أن فرض السلاح نفسه في الشارع فلم يبق للبيوت الآمنة إلا الرحيل.
سوريون يغزون العالم بأسى جديد، إلى أين سيصل العدّ بنا، لم يعدّ ذاك أمراً قابلاً للتكهن، حبات السبحة تكرج بين يدي الحرب أعواماً كثيرة، عامٌ يزيح آخر من وجه نهايتنا ولا شيء يبدّل العجز الذي نشعر به، مع كلّ موجة نزوح نوضب حقائبنا من جديد وندخل لغرفةٍ أعمق في بيت الحزن الذي بنيناه في صدورنا، هذا البيت يتسع يوماً بعد يوم، لم يترك مكاناً لمساحات فرحٍ خضراء.
نحاول أن نتوازن في ظلّ هذا العالم المجنون، أن تكون عاقلاً وسط هذه الفوضى هو أقصى درجات الجنون؛ الخيبات تتكدّس في الطرق ككومة ثلج لا ترغب في الذوبان، ولكن الأمل مخاتل دوماً يجد منفذاً ليمسح الغبش عن المرآة ونبصر وجهنا من جديد بعد كلّ الخذلان الذي يطلّ مع إعلانات مؤتمرات السلام والأعداد الكبيرة للوفود المشاركة، خذلان لا يتوانى عن تقديمه أحد و لا يستثنى طرفاً من الأطراف.
الأمل وحده من يستدعي الشّعر، لا بل اليأس يفعل أحياناً، الشعر بكلّ الأحوال ليس بأفضل حالاً منا، ها هو يتمدد ما بين المجاز والواقع يتأرجح بألعابه اللغوية أمام شاشات التلفاز، يتابع الأخبار بمنتهى الملل، يمضغ القرارات الأممية وأرجل طاولة المفاوضات ويبصقها في قصيدةٍ عن طفلٍ مات بالصدفة وهو يجمع أشلاء أبيه، ينتقي الكلمات بحذرٍ شديد ويرميها حصواتٍ في بركة الركود الفكري لتؤلف بدوائرها سمفونيات ليستَ دوماً مستساغة، سمفونيات مالحة، مرة، وحلوة بطعم الذكريات.
يهرب البعض إلى الشعر ويرتاح على صدره، وأرى الشعر يهرب من البعض الآخر، هذه المأساة تكره اللون الرماديّ لذا قد لمّعت تجارب شعريّة صادقة لدرجة الشفافية، تجارب ناصعة على جبين الأدب تعكس الواقع بذكاء شهرزاد ودليلة وتراوغ فجاجة الحدث، فتؤرخ وتوّثق بسلاسة تفاصيل يومية من أيامٍ لا تكرر، لا تخدعها الأحداث الكبيرة.
الشعر كالشيطان يكمن في التفاصيل، وتجارب أخرى قاتمة تسلقت على أكتاف الضحايا حملت صراخهم وصورهم لتحجز لنفسها مكاناً في عالم الإبداع دون أن تملك أدنى مقومات للعمل الأدبي، النجاح كان حلف البعض فقط لأنه تبنّى هذه القضية، هذه النجاح شعلة شمعة سيطفئها الشعر حين يزفر مللاً.
لكن في النهاية مهما ساءت التجارب الشعريّة المرافقة للأحداث السوريّة أو تميّزت إلا أنها تبقى حالة إيجابية، فأن تواجه هذا الكم الهائل من الموت والدمار والتشرد بالكلمة فقط. هذا بحد ذاته بسمةٌ تستحقُ أن تلمع وسط كل هذه الدموع، لأن الكلمة كانت البدء وستبقى لأنها مصنوعة من أنفاس الناس وحشرجة الألم.
لارا الظراسي (اليمن): الكتابة متنفس للوجع

إذا كنا نقول إن الإنسان هو ابن بيئته، فإن المثقف والأديب هو ابن البيئة البار. المثقف هو أحد أفراد المجتمع فإذا كان المجتمع يعيش بسلام وتطور وتقدم تجد أن المثقف يعكس لنا من خلال كتاباته الأدبية و النقدية والأكاديمية هذا الجانب، والعكس صحيح.
الأديب والكاتب هو عين المجتمع، يتأثر بكل ما حوله، ويترجم أوجاعه وملاحظاته وظروفه إلى أدب إنساني. أفضل وأهم الروايات هي التي تحكي عن حزن الإنسانية ومشاعرها المتضاربة عن الشقاء والبحث عن الخلاص والحرية، فالكتابة ببساطة متنفس للوجع. وبما أن الموضوع هو الإبداع والحرب، نجدنا نتجه بالتأكيد إلى دول تحظى بالإبداع وتعاني من الحرب، مثل اليمن.
أعتقد أن حب الإنسان للحياة، للهواء الذي يدخل إلى الرئة ويغسلها من همومها وأوجاعها ويعدها بالحرية، هو طاقتها الحقيقة للاستمرار والسر الذي يجعل بلادا تعاني مرارة الحرب قادرة على إنتاج الإبداع والمبدعين.
شخصيا، في كتابي (زرقاء عدن) الفائز بجائزة دبي الثقافية كانت البطولة لليمن، همومه، أوجاعه، آثار الحرب التي تغير سلوكيات البشر وتجعلهم في صراع دائم للبقاء. التميمة كانت الإنسانية ضد القسوة، العدل ضد الظلم، الأمل في قمة المأساة.
الغربي عمران (اليمن): للحرب وجوه عدة

لطبيعة التركيبة السكانية القبلية في اليمن وتضاريسه الوعرة أثر قوي، لذلك تجد وضعها مختلفا عن محيطه العربي، إضافة إلى ضعف سيطرة السلطة المركزية على المناطق الجبلية والنائية، لذا نعيش مع العنف والصراعات الدائمة.
حمل السلاح ظاهرة متجذرة بين أوساط الشعب، نادرا ما تجد بيتا ليس به سلاح. ولا تتعجب إن عرفت أن اليمن تعيش في كل عقد صراعا مسلحا، فدوما تنشب دورات دم بين أجنحة السلطة وتياراتها، ولا تمر عشر سنوت إلا وتتخللها حرب مدمرة.
في عشية جلاء البريطانيين نشبت مواجهات مسلحة دامية بين الجبهة القومية وجبهة التحرير لعدة أشهر، كانت المواجهات على من سيخلف المستعمر. بعد الجلاء، وبالتحديد في صيف1978تم اعدام الرئيس سالم ربيع علي، وفي عام 1986 أنفجر القتال بين أجنحة الحزب الاشتراكي في عدن لتمتلئ الشوارع بالجثث، وتدمر الكثير من مباني المدينة ويتشرد الألاف.
ومثلها صنعاء، ما أن انتهت الحرب بين أنصار الملكية وأنصار الجمهورية 1967، حتى تجدد صراع بين أجنحة الحكم، وكان لليمن خمسة رؤساء خلال خمسة عشر سنة. وبعد تحقيق الوحدة في عام 1990 نشب قتال بين دعاة الانفصال والمدافعين عن الوحدة في صيف 1994. ثم بعدها حروب صعدة الستة، وها هي الحرب الدائرة التي نعيشها بداية من عام 2015.
أنا ككاتب أرى نفسي محظوظا، وإن كنت متضررا، فالقتل والتشرد والجوع والخوف طال الجميع. وجه الحظ الذي أدعيه أنني أعيش مع الحرب وضعا استثنائيا لا أتمناه لغيري، ظروف من الفقد والرعب اليومي. أعيش مشاعر كنت أتصورها سهلة وأنا أشاهدها وأسمعها عبر وسائل الإعلام حول حروب وأحداث في مجتمعات أخرى، وها أنا اليوم أعيشها للسنة الرابعة وقد تعودت على أزيز الطائرات ودوي الانفجارات والخروج في اليوم أكثر من مرة للمشاركة بحمل من يتوفون إلى مثواهم الأخير.
طوابير المحتاجين للإغاثة، خاصة الأطفال والعجزة، ما يدمي العين ويفطر القلب، طوابير الوقود والغاز المنزلي والاحتياجات البسيطة، شيوع السوق السوداء، سماع من قتل أطفاله وقتل نفسه، ومن خرج ولم يعُد. دوماً ما نهيئ أنفسنا لسماع مقتل قريب أو صديق مع غروب كل شمس، ودوما لا تأتي الأخبار السعيدة.
خلال سنوات الحرب تضرر المشهد الأدبي والفني، لم تعد خشبة مسرح، ولا تقام حفلات موسيقية أو ملتقيات للشعر والسرد أو معارض تشكيلية، ولا يوجد في عرض البلاد وطولها دار سينما تفتح أبوابها، حتى الحدائق هجرتها الأشجار والطيور. أقفلت المنظمات الإبداعية أبوابها، وفر عشرات المبدعين خارج اليمن، والبعض يرزح في السجون لمجرد رأي معارضة، ومن تبقوا يعيشون التشرد والخوف من جماعات الحرب.
لم يعد من وطن، والمبدع الحلقة الأضعف، الهشة، دون سند دون سقف يحتمي تحته. ولذلك من بقوا في دائرة النار يحاولون مداراة نبض جراحهم، يخفضون همسهم، يقللون من حركتهم حتى لا يستدل عليهم مسلحون يقتادونهم إلى المجهول.
انقطع التيار الكهربائي عن صنعاء منذ 2015. تخيل مدينة يسكنها أكثر من ثلاثة ملايين مواطن دون كهرباء لسنوات، وتوقفت مرتبات الموظفين، وانهارت العملة، وتزايدت أسراب المتسولين والمترددين على براميل المخلفات. فقدنا عددا كبيرا من الأصدقاء، من الصعب عودة من فقدناهم، حتى ابتسامات الأطفال اختفت، ولقاءات الأعياد، رقصات الأعراس.
أربع سنوات من الانكفاء، لا نجد ما نقوم به غير تكرار قراءة ما كنا قد قرأناه من كتب في سنوات خلت، فلم يعد لدينا معرض للكتب ولا بريد يصل بالجديد من الكتب. أكتشف اليوم أن سنوات الحرب لم تذهب سدى، فخلالها أنجزت ثلاث روايات. انقطعت عن المشاركات خارج اليمن، فلا سفارات تفتح أبوابها لتمنحنا تأشيرة السفر، ولا أصدقاء يخففون علينا بدعواتهم ما نعيشه. نبحث أن ثقوب لنتنفس من خلالها ونواصل الحياة.
للحرب وجوه عدة، بالنسبة لي ككاتب هي فرصة لحياة مختلفة، أن أعايش ما كنت أسمع عنه، مهما تكن سلبيتها وعنفها وكل هذا الخراب الذي نعيشه، أراها رفدتني بواقع معرفي من البشاعة والقسوة. لستُ مع الحرب أيا كانت وفي أي مكان من العالم، لكنها فرضت وعليَّ أن أعيشها.
محمد حيّاوي (العراق): تعال إلى المتعة، تعال إلى حيث الحرب

طالما تساءلت عن كم التأثير الهائل الذي تركته الحرب على وعيي وإسهامها في تكويني الكتابي. في الغرب لا يعدّون من دخل حربًا سويًا، على الأقل من الناحية النفسية، ويعاملونه معاملة خاصّة، ويخضع في الغالب لحالة طويلة من العلاج النفسي. لاحظ أنّهم يتحدثون هنا عن حروب قد تدوم أيّامًا أو أسابيع أو أشهرًا. فما بالك في من يدخل حربًا في عمر الثامنة عشرة ويخرج منها وهو في عمر الثلاثين؟
وعلى الرغم من كل ما يُسبغ على الحروب من مسميات أو مبررات، من مثل الحرب من أجل فرض السلام أو حرب الضرورة أو الحرب المقدسة أو حرب التحرير وغيرها، إلّا أن الحرب تبقى في حقيقتها التي خبرتها جيّدًا، شر مطلٌق.
يقول وليم غولدنغ في معرض حديثه عن روايته الشهيرة “ملك الذباب” وهي رواية حرب بامتياز، أنّ الإنسان ينتج الشّر كما ينتج النحل العسل، وهو توصيف استعاري طالما وقفت عنده وتأمّلته في الحقيقة، فالذي يمتص رحيق طفولته من العنف والحرمان والموبقات والكبت، لابدّ سيكون سلوكه عدوانيًا وشريرًا لاحقًا، حتّى لو غلف سلوكياته تلك بالشعارات البراقة ـ بطعم العسل ـ.
لقد تمكنت الحرب في المحصلة، من كسرنا في النهاية، وهذا أمر مؤكد، لكنّها لم تستطع تحطيمنا تمامًا لحسن الحظ، وعلى الرغم من أنّنا لسنا أسوياء نسبيًا، لكننا قادرين على الكتابة في لحظات أسطورية ومخاتلة الوحش الكامن داخلنا. نكتب عن الحبّ والجمال والإحساس، في غفلة منه، خوف أن يستيقظ ويداهمنا ويسوّد خيالنا من جديد.
وطالما هناك حروب، سيظل هناك كتّاب يحاولون فهمها واستلهام شيء مفيد من حطامها. لقد كان جيلي من الأدباء في العراق جيل محنة وتشرد وتهديد مصير، ولعله الجيل الأدبي الوحيد في العالم العربي الذي تعرض لمثل تلك المحن، فمنذ امتلاكنا لوعينا الإبداعي مطلع الثمانينيات، نشبت الحرب العراقية الإيرانية الطاحنة التي استمرت أكثر من ثماني سنوات وطبعت ذاكرتنا بمشاهد القتل والدم، ومن ثم تعرض العراق لحصار اقتصادي ظالم وشرس أدى في المحصلة لانهيار البنية الأخلاقية للمجتمع ككل، ثم اندلعت حرب الكويت وما تلاها من هزات ارتدادية عميقة مهدت في آخر المطاف للاحتلال الأمريكي للعراق وانهيار النظام السابق وتحطيم الدولة العراقية بالكامل.
إن تلك المحن والمتغيرات العميقة التي امتدت على مدى ثلاثة عقود، هي عمر جيلنا الافتراضي وفترة امتلاكه لوعيه النقدي والإبداعي، طبعت كتاباتنا بطابع المأساة وما زالت، ولا اعتقد أننا سنتخلص من ذلك التأثير الساحق قريبًا، وعلى الرغم من تشتت هذا الجيل بين الخارج والداخل، إلّا أنّه ما يزال يمتلك بعض الملامح المتقاربة، سواء على صعيد الرؤية أو التقنيات.
أتخيل الجنود الناجين من الحروب مثل الأنبياء والكهنة، هم على الرغم من امتلاكهم القوّة والقلوب الميتة من كثرة ما رأوه من القتل والدمار والرزايا، إلّا أنّهم معبؤون حكمة وتأنِ وصمت.
أن تكتب تحت وطأة تلك التفصيلات المهولة، معتمدًا على التذكر، وتحف جوانحك الألام والخشية من المستقبل، وعقلك يستحضر تلك الوجوه التي قاسمتك لحظات الرعب والجوع والتعلّق بحبل النجاة المتأرجح بين الموت والحياة، لهو عذاب موجع في الحقيقة، لكن الأكثر وجعًا منه هو محاولتك دفن ماضيك في الجزء الخلفي من رأسك المقاوم للانفجار ومحاولتك فتح نافذّة للضوء المشرق ليتسلل إلى ذاكرتك وصورها المتربة بفعل الزمان وتكتب روايات عن الحب تعلق تفصيلاتها في شغاف القلوب وتعرّش في رؤوس القرّاء الذين سيلعنونك في النهاية، لأنّك أفسدت عليهم يومهم وتركتهم معلقين في الهواء.
وكما لو أن حربًا واحدة ليست كافية، منّت علينا الأقدار في العراق بحروب ثلاثة، كل واحدة منهن أبشع من الأخرى. وعندما كنتُ في سن الثامنة عشرة، رفضني معهد الفنون الجميلة لأنّني كنتُ شيوعيًا،ولم استطع دخول قاعة الامتحان النهائية للثانوية العامّة خوفًا من مداهمة رجال الأمن، فرسبت وساقوني إلى الجيش الذي لم أتسرح منه إلّا وأنا في الثلاثين من العمر.
خضت حروبًا ثلاثة، استمرت الأولى ثماني سنوات قاتلة، قضيت نصفها جنديًا في قوة المشاة ونصفها الآخر مراسلًا حربيًا، شاهد ووثق الأهوال وتحطّمت روحه مئات المرّات في وحل الجبهات، أما في الثانية فقد كنت محررًا في الإذاعة، هرب مدرائي واختبأوا خوفًا من دخول الأمريكان عليهم إلى مكاتبهم، وبقيت وحدي أكتب الإستغاثات ومناشدة ضمير العالم كي ينجد شعبي وبلدي، قبل أن يقرر الأمريكان التوقف ويسمحوا بخروج صدام من مخبأة وأدّعاءالانتصار، وحين عاد مدرائي إلى مكاتبهم، عاقبوني لعدم هروبي وكتابة النداءات المتخاذلة! ونقلوني إلى أقصى نقطة في الجنوب لتغطية انسحاب القوات العراقية من الكويت، لأنجو مرّة اخرى من الموت الساحق على الطريق الرابط بين الكويت والبصرة حيث قتل أكثر من ربع مليون جندي عراقي.
قررت بعد ذلك الفرار من العراق وعدم انتظار الحرب الثالثة، لأنّني كنت متيقنًا من أنّني لن أنجو منها هذه المرة إن وقعت. لكن الحرب لاحقتني حتّى منفاي واٌقضت مضجعي، حين رأيت الصواريخ الأمريكية تنهمر على بغداد، وبقيت أبكي طول الليل، ولم استطع الذهاب إلى عملي في اليوم التالي ولا الذي بعده، حتى تركت ذلك العمل في النهاية وتفرغت للمراقبة والذهول والكتابة من حين لأخر، علني أجد روحي الضائعة في مكان ما في تلك القصص والروايات الخادعة.