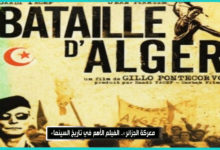لا يمثل عبد الحكيم قاسم نموذجا فريدا بين أبناء جيله فحسب؛ فهو متفرد في كل جوانب شخصيته وحياته، صهرته المحن وصبه الحنين وشكّلته التجارب ليصير استثناء لا يمكن الالتفات عنه، مشروعه الأدبي لم يكتمل لكنك لا تجد في نفسك الجرأة لتزعم أن به نقص أو فتور.
لغة قاسم المحتفى بها في كل أعماله تسير على حافة خطرة وتتوازن بين متناقضات، فلا تسقط في شراك الشعرية، ولا تضبط متلبسة بمخاصمة السرد، فهو يصنع جمله بعناية؛ ثم يصفها صفا في نسيج من الحميمة والصدق؛ فإذا بها وثيقة الصلة بكل معاناة؛ حتى إذا قيل لأحدهم: أهكذا جرحك.. قال: كأنه هو.
لم تخرج القرية من عقل ووجدان قاسم أبدا؛ صاحبته في سجنه الذي استمر لخمس سنوات، وغادرت معه إلى منفاه الذي طال لإحدى عشرة سنة، وعندما عاد-منتصف الثمانينات- لم يقو على مواجهة طوفان القبح الذي أغرق كل شيء؛ فكان اعتلال الصحة ثم محنة المرض التي انتهت برحيله.
وبالرغم من أن قاسم هو ابن ذلك الفضاء الرحب في الريف المصري؛ إلا أنه ظل يعاني تلك الجدران العالية والغرف الضيقة وذلك الشعور المرير بالأسر ؛ لكنه لا يكف عن “محاولة للخروج” من “قدر الغرف المقبضة” و” الهجرة إلى غير المألوف” بعد أن مزقته “الظنون والرؤى” فلا هو صار “المهدي” ولا هو استطاع أن يغالب “الأشواق والأسى” حتى شوطه الأخير.
صنع قاسم عالمه من كثير من التناقضات منذ أن جاء الحياة عليلا في وضع اجتماعي هو أقرب إلى التفكك؛ لكنه يبدو متماسكا في حضور طاغ لأب حاز الفضائل وملك الألباب، وهو يعاني أيضا ذلك الاختلاف الكبير بين معاملة أهل أبيه له، وهي معاملة ملؤها الحفاوة وظاهرها الحب وباطنها الرحمة، ونبذ أهل أمه له على نحو غير مفهوم؛ ربما بسبب شخصية أبيه القاهرة.
في سنوات الاعتقال في الواحات كتب حكيم رائعته “أيام الإنسان السبعة” وبعد خروجه أعاد كتابتها ثلاث مرات إلى أن أصبحت على صورتها النهائية التي صدرت بها عام 1996. شكّل الاحتفاء الذي قوبلت به الرواية والتقدير الكبير من عديد من الأدباء والنقاد تحديا لقاسم حاول مرارا التغلب عليه، وجاءت روايته التالية “محاولة للخروج” عام 1978، محاولة لكسر ذلك القيد الذي أحكم لقرابة عقد من الزمان.
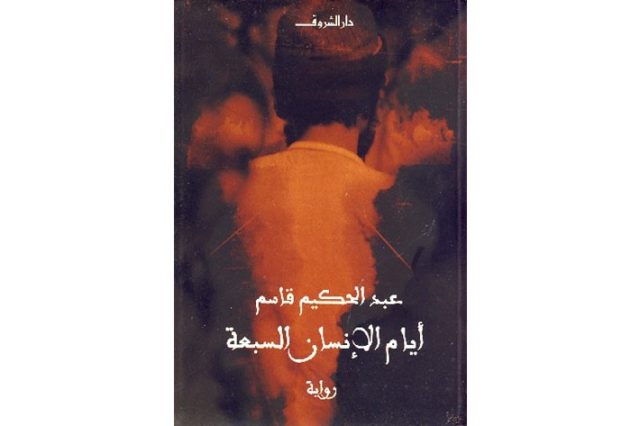
الحقيقة أن ارتباط “قاسم” بأيامه السبعة غير قابل للفصم أو الإضعاف، فتلك الأيام هي فترة الوجود الأرضي لـ”قاسم” الذي بدأ في السابع من نوفمبر عام1934، وانتهى في الثالث عشر من نوفمبر عام 1990.
أيام ” قاسم” لا تشبه أيام أحد من الذين كتبوا عن ريف مصر.. ربما لأن أيامهم ظلت أسيرة لنمط معين من الكتابة؛ أما قاسم فقد تلقى وحي التفاصيل المبهرة من وهج الطين وهدير السواقي، وقد نمت شخوصه بانسجام وتناغم على ضفاف الترع وجسور الحقول، وقد استنطقها حكيم بلسان المحب فباحت عيونها بلهفة العاشق، في تجاوز لكل آلام العوز والحرمان، وتجاور لكل تناقضات تلك الحياة التي تمور بالصراع وتهدأ في كنف الأحلام.
شكلت المدن التي عاش بها حكيم محطات للألم والمعاناة والحرمان، فكان الرفض لها ولما تمثله من قيم الحداثة الكاذبة، والتحقق الزائف. من طنطا إلى الإسكندرية إلى القاهرة إلى برلين.. تمزقت روح الفتى، وتكاثرت عليه الخيبات؛ فازداد حنينه إلى قريته البندرة مركز السنطة بمحافظة الغربية، وقد أورثته تلك الصدمات ردود فعل عنيفة ظهرت في آرائه المنشورة في مقالات بصحيفة “الشعب” القاهرية تناول فيها كثيرا من القضايا الأدبية، وانقلب فيها على جيل الستينات من الأدباء وتساءل: كيف يشعر هؤلاء بمعاناة الجماهير، وهم يسهرون حتى الصباح يحتسون “البيرة” وينامون طوال النهار.
حتى توجهه اليساري صار مرمى لسهامه الغاضبة؛ فعندما سئل عن روايته “المهدي” وأنها مثلت انحيازا واضحا ضد التيار الإسلامي أجاب قاسم نافيا: “أنا قريب جدا من الفكر الإسلامي، ولا يوجد في رأسي فكرة غير إسلامية.. وأضاف: أنا لست شيوعيا تائبا كما يرى البعض، فأنا لم أكن أبدا ماركسيا أو شيوعيا بالمعنى الحرفي للكلمة، كل ما هناك أن في الماركسية بعض الأفكار التقدمية من حق الناس أن يأخذوا بها حتى ولو لم يكونوا ماركسيين… وتلك هي حيرة الإنسان المخلص حين يكون في وسط عقائدي يزحمه بعقائديته”.
حتى الأدب نفسه لم يسلم من هجوم حكيم؛ إذ نعته بأنه السبب في ما آلت إليه أحواله من سوء، وأن لم يكسب منه ما يكفي لشراء حذاء، حتى أنه استدان ليعيش في منفاه.. وكان قد أعلن فور عودته أنه لا يقبل العبث باللغة العربية تحت دعاوى التجديد، وأن الالتزام بما يصدر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة أمر لا بد منه، حتى فيما جرى فيه الخلاف.
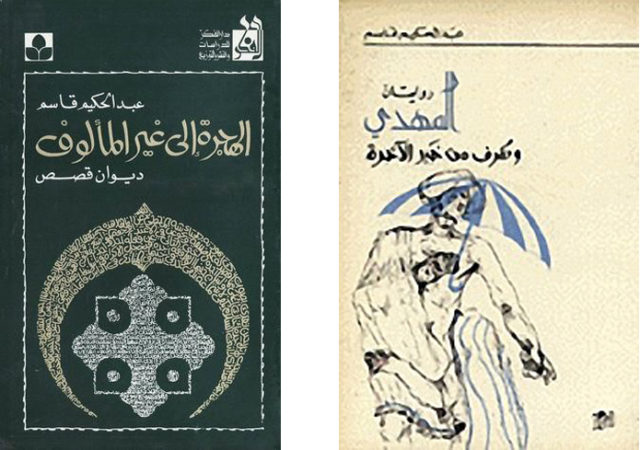
عاد ” قاسم” بعد تجربة المنفى في ألمانيا، وقد استقر في وجدانه عداء شديد للغرب الذي لم ير فيه سوى لص فاجر ينهب الأشياء الثمينة ويهدم قيمنا ليشوه روحنا؛ وكان ذلك بسبب ما قساه من برلين وهو يحاول إنجاز أطروحته للدكتوراه، واضطراره للعمل كحارس ليلي لمتحف من متاحف برلين؛ فتجلى له خلال تلك الساعات الطويلة المملة كيف صنع هذا الغرب حضارته من دماء ودموع تلك الشعوب التي استعبدها لآماد بعيدة.
مثل عبد الحكيم قاسم بكل معاناته ومآسيه، هزيمة جيل من المثقفين لم يستطع مواجهة الموجة العاتية من المتغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية التي اجتاحت الحياة العربية، ولم يستطع التواؤم كغيره. ظل صلبا حتى انكسر مع انكسار الأحلام الكبار التي حملها جيله.. وهو يعترف بذلك دون مواربة فيقول: “الآن أدرك كيف أنني عشت العمر كله أواجه في وطني قهرا حقيقيا وإذلالا حقيقيا, وأعيش مع ناسي مقاومة غير جادة وثورة مغشوشة وحماسة مدخولة.. العمر كله أمشي في تظاهرات وأحضر اجتماعات وأسمع خطابات.. تلك نهاية جيلنا، جيل فشل نهائيا، وعلي كل المستويات، وبعد الانتصار الصهيوني سيكون علي نطاق العالم وضع شاذ مؤداه إذلال أمة كاملة في كل مكان”.
صدر لـ “قاسم” في كتاب الهلال حكايات للأطفال بعنوان «الصغيران وأفراخ اليمامة» عام ١٩٩0، كما صدرت مجموعته القصصية «ديوان الملحقات» في سلسلة مختارات فصول، وصدر بعد رحيله في العام ١٩٩١ كتابه «الديوان الأخير» عن دار شرقيات الذى ضم ١٧ قصة قصيرة وعدة فصول من روايته التي لم تكتمل «كفر سيدى سليم»، والمسرحية الوحيدة التي كتبها لإذاعة البرنامج الثاني عام ١٩٨٨، “ليل وفانوس ورجال، وصدر له كتاب «كتابات نوبة الحراسة – رسائل عبدالحكيم قاسم» والذى يضم مراسلات ورسائل عبدالحكيم قاسم التي كتبها بخط يده.

لم ينتم عبد الحكيم قاسم إلى “شلة” أدبية تنافح عن تفرده الأدبي وتعمل على نيل حقه.. لقد ظل الرجل في محاولته للتصدي لكل ما هو زائف ومدعى في حالة صدام مع الكل.. رغم سنوات عمره القصير التي لم تتجاوز السادسة والخمسين؛ إلا أن قاسم هو حالة فريدة في الأدب المصري ستحظى يوما بحقها وإن طال الزمن.. رحم الله الحكيم قاسم وغفر له.