أغلب المصادر التاريخية ترجع نشأة التصوف إلى زمن النبوة، ويرجع أصل اصطلاح (الصوفية) إلى أهل الصفة، وهي تلك الجماعة من فقراء المسلمين وعوامهم الذين كانوا يتخذون من عمود الصفة بالمسجد النبوي موضعا لعباداتهم ومجاهداتهم غير عابئين بهموم الدنيا ولا رغد العيش.
العديد من كتب التفاسير اعتبرت هؤلاء المتصوفة أنهم المشار إليهم في الأية الكريمة التي خاطبت النبي صلى الله عليه وسلم (وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا)، وقد قيل أن أصل النسبة إلى ما كان يرتديه هؤلاء من لباس الصوف الخشن.
قال الطبري في تفسير الآية السالفة، إن أشراف مكة كانوا قد اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم مخالطته لبعض الفقراء في مسجد النبي الذين آذتهم رائحة بعضهم، وكانوا يرتدون الصوف ولا شيء سواه، وكان من بين هؤلاء سلمان الفارسي، وأبا ذر الغفاري وغيرهم، فنزلت الأية التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله أن جعل من بين أمته من يؤمر بمجالستهم.
كانت هذه النواة الأولى لتلك الجماعة الواسعة التي ستعرف فيما بعد بالصوفية، وعلى أيدي هؤلاء تربى الجيل الأول من المتصوفة وإن لم يكونوا قد حملوا الإسم بعد، أو كما يقول القشيري في رسالته فإن المسلمين لم يتسموا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بتسمية عًلم سوى صَحبَة رسول الله، ثم سمي من أدركهم من العهد الثاني بالتابعين، ثم لقب من بعدهم بتابعي التابعين، ثم اختلف الناس وتباينت المراتب فقيل لمن اشتهر بالزهد والورع بالزهاد والعباد، ثم حصلت البدع فاشتهر من حفظ قلبه من طوارق الغفلة بالتصوف واشتهر أصحابه بهذا الإسم قبل المائتين من الهجرة.
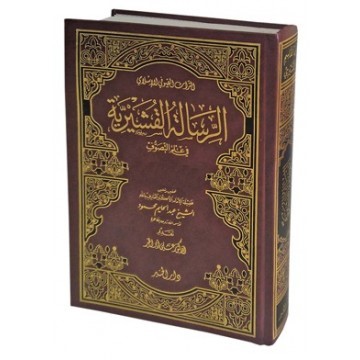
حين ظهر التصوف إذا لم تكن هناك جماعة تسمي نفسها “السلف” لتمارس ذلك النوع من القفز الزمني أو السلطوية التاريخية، بحيث يمكنها إدعاء القطيعة المعرفية مع جيل مبتدع والاتصال بجيل آخر أكثر نقاء في عبادته، فمن أين تأتي تسمية السلفية إذن ؟ ومتى تتحقق تاريخيا في المجتمع الإسلامي؟.
لم يكن الصوفية في زمن نشأتهم مضطرون لخوض صراع مع تلك الجماعة التي تسمي نفسها (السلفية)، وإنما كان نزاعهم الضروري وصراعهم الحتمي مع من عرفوا بالفقهاء، نتيجة اختلاف المنطلق ما بين المتصوفة والفقهاء في طريقة فهم النص الديني واستيعابهم لجوهر الشريعة الإسلامية.

كان على المتصوفة بإعلائهم لقيمة العاطفة والوجدان أن يتجاوزوا ثنائيات الفقهاء في النظر إلى مقاصد الشريعة، نعني ثنائيات (الجنة والنار)، (الحلال، والحرام)، فالفارق بين الصوفي والفقيه في النظر إلى الأوامر والنصوص الإلهية كالفارق في التعريف بين من يعرف الصلاة بأنها (أفعال وأقوال مفتتحة بالتكبير ومنتهية بالتسليم)، وبين من يعرفها على طريقة المتصوفة باعتبارها (مناجاة قلبية بين العبد وربه)، فالفرض عند الأول يسقط بمجرد إتيان مجموعة الحركات التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم ولو زاغ القلب، ولو لم يتمكن من الحضور مع الخالق.. بينما الحضور الكامل شرط التحقق عند الثاني.
وحين يسأل أحدهم عن الزكاة يقول للسائل: عندنا أم عندكم؟ يقول السائل: وهل هناك عندنا وعندكم؟ فيجيب نعم عندكم تخرج الزكاة على تحقق النصاب، أما عندنا فالعبد وماله لربه. لذلك يكثر عند الصوفية وصف الفقهاء بأهل الظاهر وعلماء الرسوم، وغيرها من الأوصاف التي تفيد التمايز في فهم ومقدار ونوع الامتثال للأمر الإلهي، وسرعان ما شرعن المتصوفة لهذا الفارق بالحديث عن (الحقيقة) في مقابل (الشريعة)، و(الباطن) في مقابل (الظاهر)، وعيروا الفقهاء بقولهم: أخذتم علمكم ميت عن ميت، (في إشارة إلى القوعد المتعارف عليها بين الفقهاء والمحدثين في الحفظ والنقل المتوارث)، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، (في إشارة أخرى إلى ما يتم تحصيله لهم من الكشف والمشاهدة والعرفان الذي الذي يلقى في القلب بمجرد التطهر والاستعداد لاستقبال الأنوار الإلهية).
كما توسع المتصوفة في التأويل إلى الحد الذي وصل بالصدام إلى ذروته حين لم يقدر الفقية على استيعاب تأويلاتهم في حدود الشريعة، دون أن يعني هذا وقوع انحرافات ظاهرية على الأقل من بعض المتصوفة أثارت حفيظة الفقهاء خوفا على شيوع منطق المتصوفة ما قد يتسبب في تحلل العامة من الشريعة.
بالإضافة إلى بعض الأسباب النفسية والسياسية، كان الفقهاء قريبي الصلة بالحكام لا يغادرون بلاطهم لكنهم لم يستطيعوا الوصول إلى قلوب العامة، بينما عرف الزهاد والمتصوفة الطريق إلى القلوب، فكان عبدالقادر الجيلاني (470 هـ – 561 هـ) يجلس في سبعين ألفا من المريدين في بغداد حتى قيل في زمن الخلافة العباسية أن لبغداد خليفتين.
ربما كان ذلك ما دفع الفقهاء لمحاولة الإيقاع ما بين الحكام والصوفية، فتوالت الفتن والمحن التي تعرض لها المتصوفة، كمحنة الحلاج، ومحنة الحكيم الترمذي، ومحنة غلام الخليل التي أوشك فيها سيف الجلاد أن يطيح برقاب سبعين من أئمة المتصوفة كان من بينهم الجنيد شيخ الطائفة، والنوري وغيرهم.

رغم ذلك لم تكن القطيعة كاملة ما بين المتصوفة والفقهاء، فالكثير من المتصوفة جمع ما بين علوم التصوف والحديث والفقه، كما عملوا على ربط علوم التصوف وقيدها بالالتزام بالشريعة، حتى قال بعضهم: “من تحقق ولم يتشرع فقد تزندق، ومن تشرع ولم يتحقق فقد تفسق”، وقال الجنيد: “إذا رأيت الرجل يركب الماء ويطير في الهواء ويخالف شرع الله فهو كذاب”، وحدثت الكثير من المراجعات المبكرة لممارسات المتصوفة وادعاءاتهم على نحو ما فعل القشيري في “الرسالة”، والطوسي في كتابه “اللمع”.
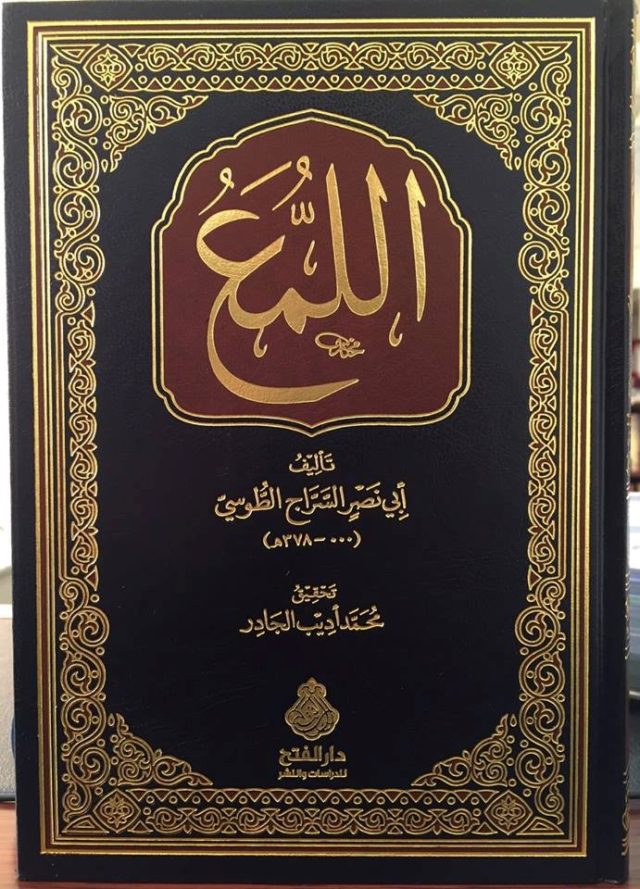
حتى ذلك الحين لم يكن قد ظهر بعد ما يسمى بالسلفية لتحمل على عاتقها مهمة العداء مع المتصوفة، فلقد كان ظهور مصطلح (السلف) للمرة الأولى في القرن الرابع الهجري على نحو ما يبين الشيخ أبو زهرة، أما كيفية النزاع مع المتصوفة ومساره التاريخي ، فهو ما يحتاج إلى مزيد من التوضيح.













