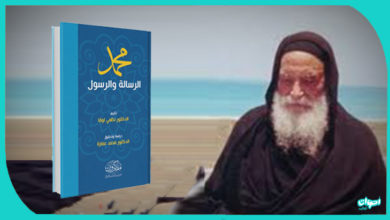نحن جيل لم يفهم حتى الآن ما حدث في تلك الأيام، كنا وما زلنا حيارى بين حبنا الجارف لشخصية الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وبين الانهيار الذى وقع في يوم وليلة. أتحدث عن حرب يونيو أو نكسة يونيو، تلك التي لم نر منها -نحن الذين لم نعاصرها- إلا بعض اللقطات التسجيلية القصيرة، أو أفلام ومسلسلات حاولت أن ترصد ما حدث، وكأنها معركة خسرناها، بينما الحقائق شيء آخر، بينما الجندي المصري البريء هو من تحمل أعباء كل شيء: دماء وشهداء وأسري وكوارث حياتية لكثير من الأسر المصرية، لتصبح تلك الأيام أياماً ثقيلة على قلوبنا، كما كانت ثقيلة على قلوب من عاصروها.
وأتذكر هنا بعض المشاهد من فيلم «العصفور» «ليوسف شاهين» وهو أحد الأفلام القليلة التي أرّخت سينمائيا لهذا الحدث..يقف «سيف عبد الرحمن» معترضا طريق «صلاح قابيل» (يوسف) في مقر الصحيفة متسائلا في حسرة: فين الحقيقة؟، فيرد عليه «يوسف» في حيرة: الحقيقةّ، روح شوفها تلقاها غرقانة فين؟ ويتركه، بينما نرى «سيف عبد الرحمن» يسير تائها وسط الشوارع مع قطع للقطات تصور جنودنا وهم ينزفون الدماء ويحترقون بنيران العدو، ثم ننتقل إلى «بهية – محسنة توفيق» وهي تقوم بتوليد إحدي جاراتها – والتي تنجب دائمًا بنات- بينما الأب جالس ينتظر أن تنجب زوجته ولداً، فتذهب «بهية» للأب وتخبره قائلة: مبروك عليك، وتنظر للأب المصدوم بخلفته للأنثي، فتكمل «بهية»: وحياة النبي وشها بينور.. تقولش هو بدر مصور، فيرد الرجل غاضبا: وحياة اللي خلفوها لمسميها برضك حنفي، ويتركها وينصرف، تقف «بهية» منهزمة وحزينة، فتأتي إحدي بنات الرجل وتقول لها: يعني لازم تقوليله؟، فترد عليها «بهية» وهي تلقي قطعة قماش من يديها: الحقيقة عمرها ما تستخبي يا بنتي».
ثم تخرج «بهية» للحارة، وتتجه للمقهي، فتجد «صلاح قابيل- يوسف» جالسا منهزما وعيونه تكاد تنفجر بالدمع، مذهولا وضائعا، تحدثه وهي شبه تائهة، وتجلس أمامه وتنظر له، بينما نظراته متحجرة للفراغ، فتقول له: قل لى، قل لى أنا يا يوسف، فيدير وجهه لها وينظر لها نظرات خيبة، وحسرة، وفشل عظيم، لا تصدق «بهية» تلك النظرات، تنهض وتستدير وتتجه لباب آخر للمقهي، فتجد جندياً عائداً في زيه العسكري، فيقول لها «عبد الوارث عسر»: أهو رجع يا بهية.. شوفيله حتة يتاوي فيها، فتقول له بهية: إيه اللي بتعمله ده فينا يا علي؟، فيقول الجندي «علي» منكسرا وهو ينظر في الأرض: أوامر بإننا ننسحب للخط التاني!، تنظر «بهية» بحيرة وحسرة وهي لا تفهم ولكنها تشعر بكارثة كبيرة: وتقول: الخط التاني، والخط التاني هنا في الحتة يا علي، فينهض زوجها «محمود المليجي» السكير ويدندن بأغنية: كنت فين يا علي وأمك بتدور عليك..
ثم نجد الجميع جالسًا منتظرًا سماع خطاب التنحي الشهير للزعيم جمال عبد الناصر، وتظل تلك العبارة هي ملخص حقيقي لما حدث في تلك الأيام، فهل فعلا الخط الدفاعي التاني هنا في الحتة؟
https://youtu.be/xb_c5MNfsXk
شهادة مستجاب.. وعظمة مصر
وبينما تزداد حيرتى، يطل وجه أبى الأديب الكبير الراحل محمد مستجاب، من خلال مقال له، وكأنه يرد ويدافع عن هذا الشعب وذلك الجندي. كان مستجاب يعمل حين قامت حرب يونيو 1967 في مشروع السد العالي بأسوان، وكتب شهادته عن ذلك اليوم فى مقال طويل تحدث فى بدايته عن السد وكيف أنه اعتبر الكتابة الروائية عن السد وأيام عمله به مشروعا روائيا مؤجلا لأسباب كثيرة أوردها وفصّلها لاحقا.

الأديب الراحل «محمد مستجاب»
غير أن الكتابة الراصدة لأيام فارقة فى تاريخ مصر هى أيام نكسة يونيو 1967، -وكيف تعاطى المصريون العاملون فى منطقة السد العالى معها، حيث كان يعمل مع آلاف العمال والمهندسين وقت حدوثها- ألحت على مستجاب، ليس كعمل إبداعى روائى، ولكن كمقال رصد فى جزء كبير منه، مشاعر وانفعالات وأحاسيس المصريين العاملين فى مشروع السد العالى وقت حدوث النكسة، نعرضها ونترك لكم الحكم. فقد كتب مستجاب مقاله بعنوان: ذلك اليوم الرهيب.. أين سيذهب به هؤلاء المؤرخون؟: ومنه نقتطف تلك السطور التى رصدت مشاعر العاملين بالسد وقت النكسة، ومن المؤكد أنها كانت اختصارا معبرا عن مشاعر عموم المصريين البسطاء العاشقين للوطن، يقول مستجاب:
«غير أن امورا تحدث للواحد منا، أمورا غير مرئية لكنها مؤثرة، تجعله غير قادر على الهروب أو التأجيل أو المراوغة، تحاصره وتضع أحاسيسه ومناطق تفكيره ورؤاه في مربع مضغوط قد يكون حلما أو ذكري أو مقالا متقن الإنشاء لكاتب مغرض، فيجد هذا الواحد. وهو أنا في هذه المرة – نفسه لا يفكر ولا يأكل ولا يشرب إلا تحت سطوة وهالة مثل هذا اليوم. يوم غريب لم يره أصحاب التدوينات التاريخية باسم التصحيح، ولم يدركه كل ذوي القدرة في الإنشاء التاريخي الحديث، ولم ينتبه إليه من شاهدوه أو لمسوه أو حُكي لهم عنه، يوم يخرج على كل وجهات النظر المطروحة لحساب التعصب لعبد الناصر أو المناوئة المعادية لعبد الناصرّ.

كان 5 يونيو 1967 الشهير، قد مضي بطائراته وقصفه وإدعاءات الإعلام المصري بتحقيق الانتصار المطلوب – أو رد الهجوم الغادر- للقوات الإسرائيلية، وأول من انتبه إلى خطورة ما يحدث، هو المهندس محمد حافظ في الساعة الحادية عشرة صباحا، والذي كان رئيسي في منطقة (عملية الطمية) وكنت مرافقه في سيارته من موقع العملية في الصحراء الغربية إلى المكاتب الإدارية بجوار مشروع السد العالي، وكان آخر بيان منفعل بالوطنية والانتصار قد جاء من الراديو محملا بإسقاط عدد مهول من الطائرات وصل إلى مائتين وستين، فأوقف السيارة جانبا ونظر إلى الأفق – حيث كان السد العالي قد وصل إلى مرحلة عالية من التنفيذ – وقال بوضوح: أنا غير مطمئن، ثم صمت قليلا وهمس: كم طائرة هاجمتنا لنسقط منها هذا العدد؟ وأضاف: ربنا يجعل العواقب سليمة.
ولم يبارحني هذا القلق الذي تسرب واضحا من المهندس حافظ، إذ أني أعرف عنه – من خبرة طويلة في العمل والتعامل والمعايشة- أنه ذكي قادر على تحليل الظواهر للوصول من غلافها المرواغ إلى البواطن غير المرئية.
ومر يوم الاثنين الشهير هذا ببياناته وانتصاراته وأناشيده.. يليه يوم الثلاثاء، فازددنا قلقا على قلق، وكانت الأنباء المروعة قد تسربت من الإذاعات الخارجية إلى الناس في بوتقة العمل في السد العالي، هذه البوتقة الواسعة التى تكاد تغطي مستطيلا أطواله «10X 40» كيلو مترا بما يساوي مساحة قدرها 400 كيلو متر مربع (لكي لا يتهمها أحد بأنها مسافة طويلة وليست مساحة مربعة) وبدا واضحاً مدي التناقض بين الذي وقع والذي يذاع ويعلن، فاضطرب العمل في المشروع اضطراباً واضحاً، ولم يستطع يوم الثلاثاء الإجابة على أي استفسار أو وضع أي نقط على أي حروف، بل زاد الأمر سوءاً أن الكثيرين تحولوا إلى أصحاب رؤي وتحليلات واستنتاجات، البعض ينتظر من الجيش الروسي أن يتدخل، والبعض استعان بالجيش الصيني، وآخرون استعانوا بالجيوش اليابانية أو الألمانية أو أية جيوش لأمم ودول ليست لها جيوش مقاتلة أصلا..

الإنذار الإسرائيلي
لكن المؤكد أن يوم الاربعاء 7 يونيو 1967 قد جاء محملا بالنذر والشرور والعذاب، ذلك أن صباحه قد أتي بخبر أذاعته محطة إسرائيل – لمن يسمع محطة إسرائيل- وتناقلته الإذاعات الأخري بسرعة معروفة: فقد طلبت إسرائيل من العاملين في مشروع السد العالي إخلاء الموقع كله تمهيداً لضرب محطة كهرباء السد العالي بالقنابل.
لم تكن محطة الكهرباء قد استكملت أركان وعناصر كونها محطة كهرباء، هي مجرد انشاءات في الصخور حول قناة التحويل وداخلها، وهي القناة التى تم شقها في نفق تحت الجبل في جانب لكي تصبح مساقط مياه داخلية تستخدم في تشغيل توربينات توليد الكهرباء. ولم يكن قد تم تركيب أي توربين أو أية أدوات وآلات وتوصيلات فنية..كانت مجرد إنشاء بنائي صخري معظمه في باطن الجبل، ولا يوجد بها إلا معدات البناء والتخريم وتحريك الصخور، وكلها سهلة الإخفاء والتحريك كما أنها لا تتعرض للضرب بأية حال لأنها ليست في منطقة مكشوفة.
وكان من المتوقع أن يلجأ العاملون في المنطقة كلها إلى الهرب بعيدا ولو بالسير على الأقدام، منذ ترديد الإنذار الإسرائيلي صباح ذلك اليوم، حتي أن بعض العاملين أصابته عصبية كاسحة فاعترض على الذين يسمعون الراديو، بل وحدثت مشاجرات أدت إلى تحطيم راديو النادي وراديو مطعم الشركة.
حين حمى العمال محطة كهرباء السد بأجسادهم
في مثل هذه الحالات تنتابني حالة من الانشقاق النفسي لا زلت أدركها وأفهمها، إذ – دائما –أفاجا بنفسي وقد انقسمتُ قسمين: واحد منفعل ويصرخ ويؤكد وينفي، وواحد ينزوي داخلي يرقب ويمعن ويرصد في يقظة جادة وحادة وبالغة الحساسية، ذلك أن الناس الذين اعتقدت أنهم تجاوبوا مع الإنذار الإسرائيلي، والذين تحركوا من المواقع البعيدة مستخدمين سيارات اللوري أو حتي على أقدامهم، وبدون واعظين من التنظيمات السياسية ولا مؤثرين من الاتحاد الاشتراكي، وبدون أي فرد يقود أية جماعة من الخمسة والثلاثين ألفا الذين يعملون في الموقع..الأميون والجهال والذين يفكون الخط والذين يعملون في مختلف الأعمال الفنية أو الترابية أو الهندسية.. المظلومون والظالمون وعمال الرمل والزلط والمتخصصون في التفجير وفي قيادة الكراكات والبلدوزرات والسيارات، الذين يعملون في أنفاق الأرض أو على سطحها، الذين في ورديات العمل والذين خارج الورديات، القادرون والعاجزون.. الكل تحرك، كل واحد بنفسه ودون دعوة تحرك.. إلى أين؟…
إلى مشروع محطة الكهرباء، تلك الواقعة في نفق التحويل، وفي عز لهيب يونيو المشتعل في منطقة أسوان، «حيث الشمس عمودية على مدار السرطان الذي تقع المنطقة فيه»، الكل يتحرك يزأر ويصرخ ويبكي ويلعن، ثم يجلس على فتحة محطة الكهرباء، حول الفتحة الواسعة وعلى شفتيها وعلى أصداغها وتحت أنفها وفوق هامتها، كل منطقة محطة كهرباء السد العالي، سواء ما كان منها داخل النفق أو خارجه أصبح محتميا بأجساد كل العاملين في السد العالي، منذ التهاب الظهيرة في الصخور والرمال والزلط والحديد المسلح، ودون أن يمر أحد بين كل هذا الحشد الذي يعلو على أي مشهد، ليبيع الشاي والمعسل والطعام والماء، أجساد فقط تتحرك في حدود أن يجد كل جسد المساحة التى تصلح مستقرا ساخنا ودون اعتبار لما قد يدور في الذهن- وقد دار بالفعل الجزء المنشق مني: ماذا يمكن أن تفعل هذه الأجساد العزلاء إزاء قنابل الفانتوم والميراج؟!

يدور هذا في العقول دون أن يتجرأ أحد ويعلنه جهرا.. يكفي هذا الشعور الجمعي الذي هيمن على الناس بمختلف قدراتهم ووعيهم وإدراكهم، أن هذا المشروع هو ملك للناس، وليس لأحد آخر حتي ولو كان عبد الناصر، لم يقولوا ذلك لكنهم فعلوه.وقد ظللنا ننظر إلى السماء طوال ذلك النهار الملتهب، ثم عندما حل الليل، حيث لم يغادر أحد مكانه، حتي آخر الليل، ودون اضطراب لظهور طائرات اقتربت أو ابتعدت، لقد ظل المشهد الرهيب رهيبا.
دعنا الآن مما حدث في اليوم التالي، أو الذي تلاه أي يوم تنحي عبد الناصر وما كتبه المحللون والقوالون والخباصون والزاعمون أنه حدث – بتأثير من قيادة التنظيم السياسي – ودعنا أيضا مما حدث بعد ذلك بثلاث سنوات في 28 سبتمر 1970 يوم رحيل عبد الناصر نفسه، إذ أن العاطفة قد لعبت دورا فيه قبل أي تنظيم سياسي بالتأكيد. أما ما حدث يوم الانذار بتدمير محطة كهرباء السد العالي فقد كان خارج قدرات العاطفة والانفعال وأيه تنظيمات معروفة في التاريخ..لقد كان يوما رهيبا وعظيما، وأعظم ما فيه أن كافة الكتّاب لم يدركوه، ولم ينتبهوا له، لأنه خارج قدراتهم المحدودة أيضا..