على الرغم من خمول ذِكره، إذ لم يكُن مشهورًا بين أئمة المعتزلة، فإن ثمامة بن أشرس النميري (توفي تقريبا في نحو 225 هجرية ) كان ذا أثر كبير في تمكين مذهب المعتزلة كمذهب رسمي للدولة الإسلامية في عهد الخليفة عبد الله المأمون المتوفى عام 218 هـ).
كان ثمامة من أصدقاء المأمون، وأحد أكبر مستشاريه المخلصين، ليس في الثقافة وشؤونها فحسب، ولا في الدين وأصوله فقط ، بل إنه كان مستشارا سياسيا للمأمون، حتى إنه كان يرشّح له بعض الوزراء، وينتقد آخرين، الأمر الذي جعله فيلسوف دولة المعتزلة دون منازع، في الوقت الذي كان يرفض فيه تولّي أي منصب رسمي أو وزاري.
اقتراب ثمامة بن أشرس من الخليفة المأمون، واختلاطه بدائرة الحُكام والوزراء وأهل الشورى في محيط دولة الخلافة، كان له تأثير سلبي للغاية عليه شخصيا ؛ فالرجل لم يكن مشهورا بين العوام ،بقدر شهرته بين الخواص، لذلك قال القاضي عبد الجبار بن أحمد الأسد أبادي في كتابه (فضل الاعتزال، ص 275): «له مذاهب لم تنتشر لقلة اختلاطه بالعامة»، أي أن أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت أفكاره وآراءه بعيدة عن العوام من الجماهير، اختلاطه الشديد بدائرة الحكم والسياسة، وابتعاده عن العامة وإنفاق وقته كله بين أروقة قصور الخلافة وأبهائها، ودخوله معترك السياسة والحُكم.

وابتعاده عن العامة هنا إنما ليس بسبب ذلك فقط، بل بسبب عدم اكتراثه لهم، فقد كان ينظر إلى العوام نظرة دونية كونهم لا يستطيعون التفكير واتخاذ القرارات، ولعل السبب في ذلك أن ثمامة كان متعاليا بعلمه وثقافته، مؤمنا بأن العامة غير المثقفين إنما هم بحاجة إلى الانقياد كما ينقاد القطيع إلى الراعي، وتلك نظرة دونية، لا شك في هذا، وأكبر دليل على ذلك ما رواه ابن طيفور في كتابه (كتاب بغداد، ص 54)، من أن الخليفة المأمون لما أن عزم اتخاذ قرار بسبّ معاوية بن أبي سفيان على المنابر، فعارَضه القاضي الشهير يحيى بن أكثم، محذرا إياه من أثر ذلك القرار على نفوس العامة، ناصحا إياه أن يدع الناس على ما هم عليه، لأن ذلك أصلح في السياسة، فإذا بثمامة بن أشرس يذهب مذهبا آخرَ في تلك القضية، فيشجع المأمون على المُضي قدما في تنفيذ وتفعيل هذا القرار، فلا يكترث للناس، ولا يضعهم في اعتباره، إذ ليس لهم رأي أو عقل، لكن هذا كله لم يمنع الناس من اللجوء إليه أحيانا، وتقديم مظالمهم ومطالبهم إليه، كونه أكبر مستشاري الخليفة وأقربهم إلى قلبه وعقله، وقد ذكر الجاحظ أخبارا من ذلك الأمر في كتابه (البخلاء).
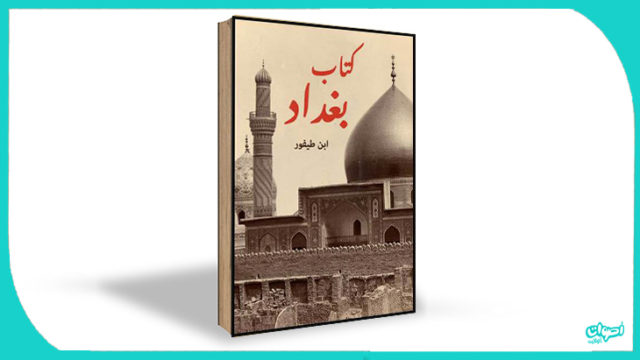
في قصور الخلفاء
بداية اتصاله بقصور الخلفاء كانت في عهد الخليفة هارون الرشيد، فقد كان من مقربيه وخلصائه على الرغم من أنه كان في السجن قبل ذلك عندما اتُّهم بالزندقة، وكانت تهمة سياسية بالأساس، لكن الرشيد عفا عنه بعد ذلك، وأُعجب بفكره وقوة حجته فاتخذه جليسا، وفى مجالس الرشيد سال عقله ولسانه بالحكمة والثقافة والمنطق وسرعة البديهة، وتقول الرواية إن الرشيد سأل يومًا جلساءه عن أسوأ الناس حالًا، فأجاب كل واحد عما يخصه، حتى جاء دور ثمامة فقال: أسوأ الناس حالًا عاقل يجرى عليه حكم جاهل، فلما لاحظ ثمامة أن وجه الرشيد يتميز غيظا، لأنه ظن أنه يعنيه عندما أمر بحبسه، فقال: يا أمير المؤمنين، ما أحسبني وقعتُ بحيث أردتَ، وإنما عنيت حادثة، وهى أن سلاما الأبرش – وكان سجانًا – وأنا في السجن كان يقرأ في المصحف«{ويل يومئذٍ للمكذبين»، بفتح الذال، فقلت له: المكذَبون هم الرسل، والمكذِّبون هم الكفار، فاقرأها: «ويل يومئذ للمكذِبين» بكسرها، فقال سلام: قيل لي من قبل إنك زنديق ولم أقبل، ثم ضيَّق عليَّ أشد الضيق، فجعل الرشيد يضحك.
كان ابن أشرس قوي الحجة، وذلك لسرعة بديهته، وموسوعية ثقافته، وقوة منطقه، وفصاحة لسانه، لذلك مدحه الجاحظ في كتابه (البيان والتبيين، 1/ 106)، قائلا: «كان أبلغ من حسن الإفهام مع قلة عدد الحروف، ولا من سهولة المخرج مع لفظه في وزن إشارته ومعناه في طبقة لفظه، ولم يكن لفظه إلى سمعك بأسرع من معناه إلى قلبك»، يُروى أنه ناظَر يحيى بن أكثم بين يدى المأمون في إشكالية خلق أفعال العباد، فقال ثمامة: ليست تخلو أفعال العباد من أمور تكون كلها لله ليس للعباد فيها صنع، أو أن يكون بعضها من العباد وبعضها من الله، فإن زعمت أن ليس للعباد فيها صنع كفرت، ونسبت إلى الله كل فعل قبيح، وإن زعمت أنها من الله ومن العباد كفرت، لأنك جعلت الخلق شركاء الله في فعل الفواحش والكفر، وإن زعمت أنها للعباد ليس لله فيها صنع صرت إلى ما أقوله.
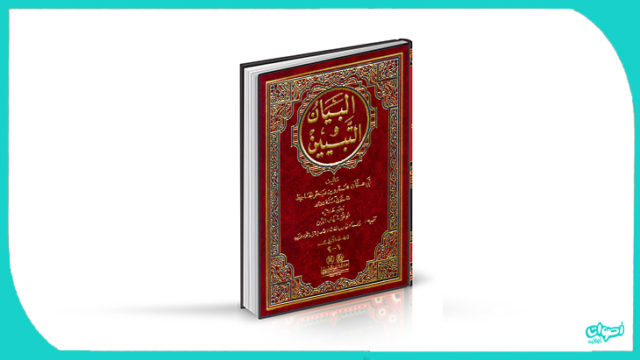
وإن يكن ثمة فضل في بلوغ مذهب المعتزلة مكانة كبيرة لدى الدولة في عهد المأمون ومن تلاه، المعتصم والواثق، فهو يرجع إلى ثمامة بن أشرس، ذلك أن الرجل لعب دورا كبيرا في سيطرة المذهب الاعتزالي على الحياة الثقافية والفكرية في الدولة آنذاك، بحيث يكون هو المذهب الرسمي، وبحيث يكون علماؤه وأئمته في طليعة المقربين للخليفة ووزرائه، ولولا وجود ثمامة بن أشرس في قصر الخلافة لما عرف كثير من أئمة المعتزلة طريقهم إلى قصر الخليفة المأمون أو المعتصم أو الواثق، فقد كان ابن أشرس يزكيهم، ويرشحهم، ويمهد لهم الطريق كي يتكلموا ويناظروا ويجادلوا ويعرضوا أفكارهم وآراءهم داخل قصر الخلافة، وهو ما مهد الطريق ليكون علماء المعتزلة في موقع الصدارة لدى دولة الخلافة.
آراء فلسفية
امتاز ابن أشرس، فوق بلاغته وعقله وقوة حجته ومنطقه، بالظُّرف والفكاهة اللذين لهما مدلول سياسي أو اجتماعي لم يكن ابن أشرس يجسر على التفوّه به بطريق مباشر، فيتخذ من الظرف والفكاهة طريقا إلى ذلك حتى لا يثير حنق الخليفة عليه؛ فيروي ابن عبد ربه، في كتابه (العقد الفريد، 6/ 148)، أن المأمون طلبه، ذات مرة، لمناظرة شخص من أذربيجان يدّعي النبوة، فما كان من ثمامة إلا أن قال بشيء من خبث وظرف: ما أكثر الأنبياء في دولتك يا أمير المؤمنين!
ولثمامة آراء معتبَرَة في الجانبين الكلامي والفلسفي، على قلة ما وصلنا عنه، واعتقاد كثيرين أن أثره الأدبي ربما كان أوضح من أثرهِ الكلاميّ، فله آراء في خلق الكون وعلاقة ذلك الخلق بالذات الإلهية؛ فهو يرى أن الأشياء مخلوقة من طبيعة الذات الإلهية، أي أن طبيعة الله هي التي جعلته يخلق هذا الكون، الذي هو قوة طبيعية كامنة في الله وليس صادرا عن مشيئته واختياره، وقد نفى بعض المعتزلة، كأبي الحسين الخياط، أن يكون هذا الرأي قد صدر عن ثمامة، كما ذهب ثمامة إلى أن المعارف كلها طباع رغم كونها أفعالا للعباد، فهي تصدر عنهم دون أن يكون لهم فيها أثر ولا اختيار اذ لا يملكون إلا الإرادة، وكالعادة؛ فقد كفّر البغدادي في كتابه (الفرق بين الفرق، ص 103) ثمامة بهذا الرأي وجعله في زمرة أهل الكفر والضلال والإلحاد!.
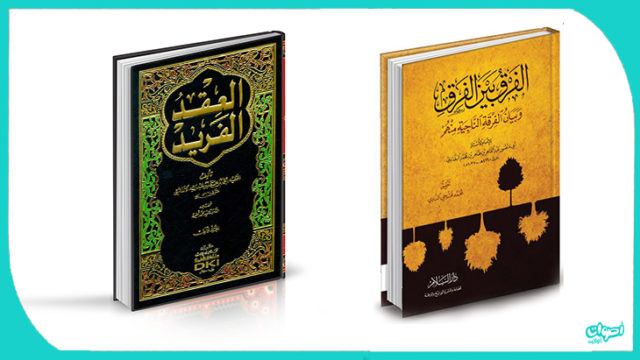
وقد اتفق ثمامة مع المعتزلة في قولهم بتحسين العقل وتقبيحه، بمعنى أن العقل قادر بمفرده على التمييز بين ما هو حسَن وما هو قبيح ولو لم يرِد بذلك نصٌّ، وإيجاب المعرفة قبل ورود السمع، لكنه زاد عليهم قوله إن من الكفار من لا يعلم خالقه وهو معذور، وقال إن المعارف كلها ضرورية، ومن لم يضطره الله إلى معرفته لم يكن مأمورا بالمعرفة ولا منهيا عن الكفر، ولعل ثمامة يقصد بذلك غير المسلمين ممن لم تصلهم الدعوة الإسلامية، أووصلتهم بطريقة مشوهة، فهم ليسوا مكلفين ولا مأمورين بالإسلام، وقد اعتمد الأزهر هذا الرأي في مناهجه الجديدة في علم التوحيد في الكتاب المقرر على طلاب الصف الأول الثانوي بالمعاهد الأزهرية دون إشارة إلى أسبقية ثمامة في اعتماد هذا الرأي، الذي يخالفه كثير من الأشاعرة.













