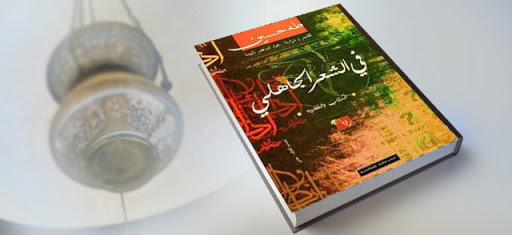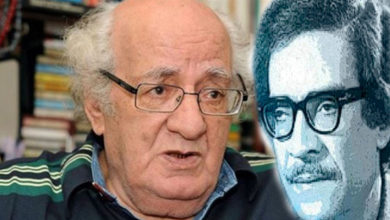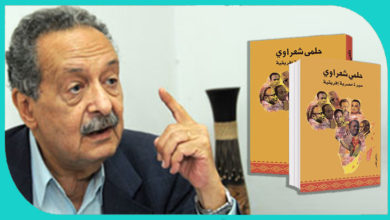كان الجامع أو المسجد في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم مكانا جامعا لنشاطات عدة تتجاوز ممارسة الشعائر الدينية إلى مناقشة وتدبير كافة شؤون جماعة المسلمين الجديدة، فلم يكن النبي الكريم وبعده الخلفاء الراشدون يسكنون القصور أو يخصصون مكانا معينا لمناقشة شؤون المجتمع المسلم، وكان هذا متصورا نظرا لقلة عدد المسلمين الأوائل، وكذلك عدد القائمين على أمرهم لاحقا، ومن ثم كان المسجد يشبه مؤسسة دينية وتربوية وتعليمية وسياسية ومقرا لشؤون الحكم.
ومع انتشار الإسلام وتوسع رقعته ونشأة أجهزة جديدة لإدارة «الدولة» كان لزاما أن تنشأ معها إدارات مستقلة، تقوم كلٌ منها على شأن معين بما يشبه الوزارات حاليا، وانسحب ذلك بالتبعية على وظيفة الجامع التعليمية أيضا، حيث بات لزاما إنشاء المدرسة التي تحولت حديثا إلى الجامعة، وهي التي غدت مسؤولة عن التأهيل العلمي للدارسين بمختلف تخصصاتهم. وقلما نجد خلطا أو لبسا في القيام بهذه المهمة في الجامعات التي تعرف بالمدنية، لأنها تهتم فقط بتدريس العلوم الحديثة من إنسانية وطبيعية، ولا تختص – إذا استثنينا كلية دار العلوم بجامعة القاهرة – بتدريس العلوم الشرعية وتخريج الوعاظ وأئمة المساجد. ولكن في المقابل تواجهنا مشكلة مع مؤسسة الأزهر القائمة على الشأن الديني في مصر في التحديد الدقيق لأدوارها، على نحو يميز بين دور الجامع والجامعة.

لا يُفرِّق الأزهر عادة في التدريس بين الجانب العقدي، وهو جانب مهم لابد من قيام الأزهر به بوصفه مؤسسة دينية، وبين الجانب التعليمي بوصفه مهمة أي مؤسسة تعليمية، ومن ثم على الأزهر إعادة التفكير في دوره الحقيقي، والتمييز بين أدواره الهامة، فكلٌ من المؤسسة الدينية والمؤسسة التعليمية لها مقوماتها وطرائقها ومناهجها وأهدافها. فالدين يقوم على الاعتقاد والتصديق، بينما العلم يقوم على الشك والتساؤل، والتوفيق بينهما يحتاج لعقول إبداعية قلما توجد، لذا نجد غالبا خلطا بين وظيفة إمام المسجد ووظيفة أستاذ الجامعة، وأرى ضرورة مراعاة التمايزات التالية بين الجامع والجامع:
-الجامع للوعظ والإرشاد ومخاطبة الروح، بينما الجامعة للنقد والشك والبحث والتساؤل.
-الجامع يتميز بثبوتية وسكونية الديني والعقدي، بينما الجامعة تتميز بالتطور والحركية الفكرية، بمعنى أن الجامع للأصالة والجامعة للابداع.
-الجامع للتدبر والتفكر في آيات الله لمزيد من اليقين الإيماني بينما الجامعة للتشكك والتفكر في العلوم ومنتجاتها والأفكار وماهياتها عبر تفكيك جزئياتها بغية تطويرها وتشكيلها بما يلائم الواقع والمستقبل.
-الجامع يجمع المؤمنين على كلمة سواء وعلى عقيدة واحدة، والجامعة تحث الدارسين على ضرورة تعدد الرؤى بناء على حرية التفكير وتنوع الاجتهادات.

-مصدر الجامع المعرفي هو مصدر غيبي عليه أن يحببك في الخير كقيمة تستفيد منها دنيويا وتثاب عليها أخرويا، بينما مصدر الجامعة المعرفي هو مصدر عقلي يقوم على التدارس والخبرة والتجربة في تحديد ماهية ذلك الخير وصوره التي تتغير باختلاف معطياتها وشروطها وزمانها ومكانها.
ومن ثم فالحقيقة في خطبة المسجد مطلقة لأنها تتعلق بالعقائد مثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، أو تتعلق بالقيم الروحية والأخلاقية من حيث جوهرها، فالخير والعدل والحب قيم مطلقة الخيرية وكذا الشر والحقد والكراهية صفات منبوذة في المطلق، أما الحقيقة في خطاب الجامعة ودرسها فهي نسبية تتعلق بمناقشة تعدد صور الخير والعدالة والحب وتنوع سبل السعي لتحقيقها.
بهذا المنهج يمكن أن تعود الأمور لنصابها ويرجع للعلم القائم على الدرس الجامعي مكانته، ومن ثم يرجع إمام الجامع في معارفه إلى أستاذ الجامعة وكتاباته، بعد أن اعتدنا العكس، حيث أصبح الشيخ السلفي أو القيادي الإخواني مرجعية دينية بغض النظر عن تخصصه وتأهيله في علوم الدين، ولكن من الممكن، بل من المفيد أيضا أن يرجع أستاذ الجامعة إلى إمام الجامع وبلاغة خطبته وجودة تلاوته في جانبه الروحي. بهذا المنهج يمكننا الحد من ظاهرة منح أعلى الدرجات العلمية الجامعية بدون معرفة حقيقية قائمة على الشك والتساؤل المؤديْيْن إلى الإبداع، وهو الأمر الذي أفقد الجامعات المصرية دورها الحقيقي في بناء وعي الشباب المصري.
بهذا المنهج يمكن للتعليم الأزهري تعزيز مبدأ التنوع وتعدد الرؤى للقضية الواحدة، وقبول الحقيقة النسبية في التعاطي مع التعددية المذهبية خارج نطاق ما يعرف بأهل السنة والجماعة وما عداها من اتجاهات ومذاهب عقدية أو فكرية حتى لا يتخذ الطالب موقفا عقديا سلبيا منها قبل معرفتها، وبذلك يتخلص الأزهري من ظاهرة الحكم على كل الأمور الدينية والدنيوية من منظور عقدي بحت، منظور ثنائيات الصواب والخطأ، الحلال والحرام، ويتمكن من رؤية الأشياء من منظور تعدد الرؤى باختلاف تعدد المنطلقات.
بهذا المنهج التعليمي يمكن تجنب الجمود في الفكر الديني الذي حذر منه الإمام محمد عبده واعتبره سببا فى ترك الدين، أي سببا في الإلحاد بلغتنا المعاصرة، حيث يقول: «إنّ الناس تحدث لهم باختلاف الزمان أمور أو وقائع لم يرد لها ذكر في كتب الفقه القديم فهل نوقف سير العالم لأجل كتبهم؟ إنّ هذا أمر لا يستطاع، إنّه جمود ومَوات يجعل العوام ينصرفون عن دينهم الذي لا يجارى واقع حياتهم» «عثمان أمين، رائد الفكر المصري: الإمام محمد عبده، الأنجلو المصرية، القاهرة، ط٢، ١٩٦٥، ص٧٩»

وختاما يمكن بهذا المنهج بناء إنسان ذي مكونين رئيسيين: مكون المؤمن المصدق ومكون المفكر المتشكك، وسمات هذا الإنسان شرحها طه حسين في مقال بعنوان «العلم والدين» نشره بجريدة السياسة الأسبوعية بالعدد 19 الصادر في 17 يوليو سنة 1926 ص5 حيث قال: «فكل امرئ منا يستطيع إذا فكر قليلا أن يجد في نفسه شخصيتين متمايزتين إحداهما عاقلة تبحث وتنقد وتحلل وتغير اليوم ما ذهبت إليه أمس وتهدم اليوم ما بنته أمس، الأخرى شاعرة تلذ وتألم وتفرح وتحزن وترضى وتغضب وترغب وترهب في غير نقد ولا بحث ولا تحليل وكلتا الشخصيتين متصلة بمزاجنا وتكويننا لا نستطيع أن نخلص من إحداهما فما الذي يمنع لأن تكون الشخصية الأولى عالمة باحثة ناقدة وأن تكون الشخصية الثانية مؤمنة مطمئنة طامحة إلى المثل الأعلى».
وبالمناسبة كانت هذه الكلمات المعبرة هي التي اقتبسها المستشار محمد نور، رئيس نيابة مصر الجديدة، الذي تولى التحقيق مع طه حسين في قضية كتابه «في الشعر الجاهلي» وبنى عليها حكمه بحفظ أوراق القضية إداريًا في 30 مارس سنة 1927م، كما جاء في كتاب «محاكمة طه حسين» لمؤلفه خيري شلبي.