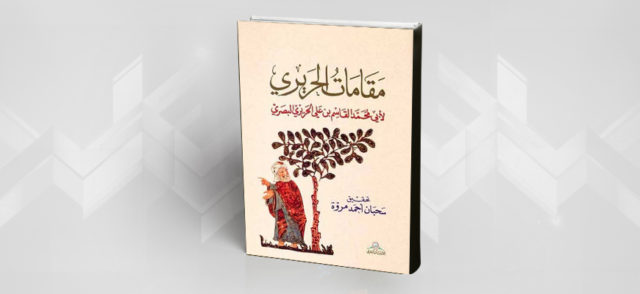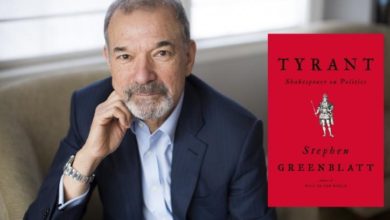الشعر خطر وتتبدى خطورته في أن المشهد الشعري الراهن يموج بأجيال جديدة تعانى من أزمة حقيقية، «أزمة الصمت النقدي»، أزمة تتوارثها أجيال الشعراء من تجاهل وتهميش يصل أحيانا إلى حد الازدراء.. ورغم كل هذا إلا أننا أمام جيل يبدو لي مختلفا في نزقه إلى كتابة مغايرة رافضا للتابوهات. هؤلاء الشباب كانت قصائدهم هى صك الاعتراف والمرور بشاعريتهم إلى ضفاف الوجود الشعري، أضف إلى ذلك تجديد وتحريك السؤال حول القضايا الكبرى. وتأتى أهمية وجدوى فتح الحوار مع جيل الشعراء الشباب، من كسر فكرة التكريس لأسماء بعينها في المشهد الشعري، وحتمية قراءة ابداعات الجيل الشاب نقديا ومعرفيا لفهم ومعرفة قضاياهم، والتي قد تبدو للوهلة الأولى قضايا وهموم وفردية، ولكن لايمكن أبدا أن ننفي أنها جزء من قضايا الهم الجمعي الذي نعيشه.
مع صاحبة «مزاج آخر للنار»- الديوان الحائز على المركز الثاني في مسابقة الهيئة العامة لقصور الثقافة فرع الشعر، الطبيبة والشاعرة ياسمين صلاح كان لنا هذا الحوار حول الشعر وجدواه في زمن التهميش والصمت النقدي…
- الإهداء بمثابة قراءة رافضة لتاريخ القبيلة، وتقويض حرية المرأة، وكأنه مدخل لمشروع شعري نسوي من الدرجة الأولى، وعلى أرضية قراءة عميقة للتاريخ والفلسفة.
الكتابة أيا كانت موالية، وخانعة في ظاهرها هي عمل ثوري، الكتابة هي رفض وتقويض للسائد، الكتابة دائما هي مشروع على أرضية من وعي الكاتب وقراءته، عميقة كانت أم سطحية للتاريخ متبنية فلسفة ما، إن فرحتى اليوم بالفوز هي لانتصار مدرسة وجدت مَن يُقدّرها، اعتمدت صدمات الصور الفنية، وموسيقى الدهشة، وهنا وأمام صياغة بليغة لسؤالك، أنا معك في شقه الأول، برفض تقويض حرية المرأة، ولكن دعني أستقل عنك في وجهتك الثانية، فأنا ضد تصنيف الأدب إلى ذكوري وأنثوي، فكما أن كرات الدم واحدة، إذ ليس هناك كرات نسائية وكرات رجالية، فالمشاعر الإنسانية واحدة، وهذا بالفعل ما أمارسه في كتابتي فتجد صوت المرأة الإنسان التي تحب الكون كله وتندمج معه وتخاطب الإله كنبية، يعلو على صوت المرأة التي تحب الذكر وتخرج من ضلعه الأعوج وتتبعه في كل شيء.
أما الإشارة إلى الاستناد لقراءة عميقة للتاريخ والفلسفة، فلن نختلف مطلقا، بل إنه بالضرورة لم يضيع الواقع سوى القراءات السطحية التي قضت على الحاضر وربما أساءت للتاريخ، وأما عن التاريخ، فجذب الأسطورة وجعلها معاصرة فاتن لي جدا، بتضمينها حياتنا اليومية ورؤيتها في ثوب جديد، فجلجامش يرتدي ربطة عنق وجلاتيا ربة منزل وأنكيدو صديقي أنا .. و جوبيتر يعزف على أوتار الكون.. و ليليث تربي أبنها كامرأة عادية.. وآدم يتعذب في عشق حواء في إعادة بناء قصة الخلق.. إحياء لهذا العالم الساحر والخيال الذي يستهويني.

إهداء ديوان ” مزاج آخر للنار “
- تضفير اليومي، بوصفك طبيبة تواجه كل يوم أحداثا غالبا ما تقلب وجه الشعر ليصبح الحزن هو الغالب على قصائدك..هل هذا يقوض الإحساس بالفرح لنجد القصيدة تبدو سجينة للحزن العام؟ وهل ثمة وقت للشعر في وسط كل هذه القتامة وما جدواه؟
قد تكون الإجابة التقليدية على سؤلك أن لا تأثير، وهذا مجافٍ للواقع، فالإنسان يتأثر بمحيطه، أقول «جسدي طست نحاس كلما سقط فيه شيء أصدر صوتا و فضحني» بل اُنتقدت في بداية تجربتي الشعرية، من إدخال مصطلحات طبية وتجارب خاصة بالمهنة في نصوصي.. لكنها كانت تجربتي أن أجعل المرأة الطبيبة داخلي تتكلم كما هي بكل ما يعتمل داخلها بلا زيف ولا تمثيل، وأن أجعل الطب كما هو جزء من حياتي جزءاً من حياة قارئي دون الوقوع في مصطلحات علمية بحتة.
الأصيل في الأمر أن الحزن لا يقوض الفرح مطلقا، ولنا في ثقافات الأفارقة أسوة حسنة، فهم في الفرح يرقصون وفي الحزن يرقصون وفي الحرب يرقصون، ولكن يختلف تعبير الجسد في كل حالة، فرقصة الحرب غير رقصة الحب غير رقصة الانكسار والهزائم، وعليه فالانحياز للقصيدة، يقتضي تفهّم أن انعكاسات الفرح والحزن، الإحباط والانتصار ما هي سوى فسيفساء الحياة، الحياة التي لا تعرف حزنا أبديا، ولا تعرف أفراحا دائمة، أما عن (هل هناك وقت للشعر؟؟؟) دائما هناك وقت، هو الزاد الذي يغمس فيه الكئيب خبزه ليطعم، والفقير ليشبع، والفنان ليصقل ويرتوي، والعاجز ليصبح قويا، والإنسان ليدرك ذاته، فللشعر دائما وقت، كما الحب.
- «للنار مزاج آخر»، هو أول دواوينك الشعرية ودخلت المسابقة وأنت محملة بتاريخ قديم من الاقصاء. كيف كان وقع تحصلك على الجائزة؟
الحقيقة كتابة الشعر لم تكن مهنة بالنسبة لي، ولا أعتقد أني سأنظر لها هكذا يوما، بل إنها تنمو بروحي في علاقتها بتطوري المهني وعلاقتي بالمحيطين، وكانت قصائد الديوان مبعثرة يوم علمت بالمسابقة، فجمعتها، وقررت أن أكسب قراءا جدد، هذه المرة من لجنة التحكيم، فما أكتبه غالبا أعرضه على صفحتي في مواقع التواصل الاجتماعي.. أنا ممتنة للجنة التحكيم في الجائزة، أشكر عبركم كل من ساهم في وضع أو تعزيز لبنات شعر المستقبل.
- القناع في الشعر يبدو أنه تيمة أساسية ويبدو أنه اقتراب للمعادل الإليوتي؟
الحقيقة لست أتوافق مع فكرة الهروب بالأقنعة، ولكن يبدو أني نأيت عن الوقوع في إشكالية الغرض، باختيار مبكر، لأسئلة طفولتي الأولى، أسئلة وجودية وجدانية، أنقذتني من نفسي، فأنا أكثر الداعين لتوسيع أغراض القصيدة.
- يكتب الشاعر قصائده طامحا أن تتفاعل مع الناس، و في العموم ما نجد قصائد غير مفهومة… فكيف يمكن للشاعر تحقيق التوازن بين فنية القصيدة ووعي متلقيها؟
للأسف.. تعالوا نحاكم الأعمال الأدبية لعظماء الأدب، من زاوية الانتشار والشعبية، نجد أن عددا هائلا من الأسماء طُبعت لهم مئات من النسخ من أعظم أعمالهم، فقط مئات، أعداد هزيلة ومحزنة، ربما هذا يتوافق مع أننا شعوب لا تقرأ، أو لا يتم التوجه إليها بصور مناسبة، وأعتقد جازمة أن مسألة الغموض والمصطلحات والأسماء يمكن التغلب عليها بسهولة وباستخدام آليات متعددة، فالبعض يمكن أن ينشر أعماله عبر وسائط صوتية مثلا، وأما المصطلحات فلقد عرفت الكتابة الهوامش لهذا الغرض، فمن الممكن اعتماد ذلك، لكن فكرة هبوط الشاعر لوعي ما.. أو «ما يطلبه المستمعون» لاكتساب جمهور!! هي فكرة خائبة ولحظية، فلا بقاء للنص ولا لصاحبه. وأيضا اعتماد الإيهام أكثر من سحر الرمز كأنك تكتب نصا هيروغليفيا لا يفهمه غيرك.. ليس بالفكر الصائب.. هذه المعادلة الصعبة اختبار حقيقي لأي كاتب.
- غالبا ما نجد أن أغلب الأجيال الجديدة من الشعراء يعلنون أن ثمة فجوة كبيرة بين تجربتهم وبين النقد، بمعنى أدق أنهم يلوحون بأن ثمة صمت نقدي تجاه منجزهم؟
هذا شيء حقيقي قولا واحدا، وأزيدك، إن مدارسنا النقدية هزيلة إلى حد كبير، فوجود مدارس نقدية يعني وجود روافد أدبية محفوفة برعاية ومهذبة وتتطور بوتيرة جيدة، بما يضمن انسيابها، وغياب تلك المدارس النقدية، أشبه بمياهٍ تم عرقلة مسارها فتجمعت وانتثرت دون ضابط، فضاعت الجهود وتشرذمت السبل، وفي أحسن الأحوال أنتجت أجيالا شائهة، لم يعد باستطاعتها أن تشكل ملامح محددة لما يمكن أن يعبر عنها، مهما واكبها من موهبة وعبقرية وإبداع، فالأمر لا يخص الصمت النقدي، بل غياب النقد، ففي أحسن الأحوال ودون علم أو دراسة، ينبري غير المتخصص، لينصّب من نفسه ناقدا، فيفعل فعلا عكسيا، كمدلك غير مهني يمكن أن يسبب للمريض تمزقا في الأنسجة، ودعني أنحاز إلى الجانب المشرق في السؤال، وهو نظري إلى ذلك كتبشير بتلك المدرسة النقدية، نعم هو قدر هذا الجيل أن يعاني من غياب النقد، لكن عليّ الاعتراف بأنه ليس غيابا كاملا، بل إن هناك حركة نقدية ناهضة، وإحساس نقدي عظيم، أجده مصاحبا لقدر هذا الجيل.
- في ديوانك مزاج النار جاءت قصيدتك الأولى تحت عنوان «كليمة الله» ومن بعدها «المعراج»، اختيار عناوين القصائد يشير بوضوح إلى أنها امتداد لوعي ثقافي يربط مابين قراءة واعية للموروث الديني «النص المقدس» وبين ماهو آني ولحظي و فلسفي… ترى كيف للشاعر أن يطرح تساؤلاته شعريا ويمرر رؤيته للعالم، دون أن يجرح أو يصطدم مع روح موروثنا سواء الديني أو الشعبي؟
لقد كان الاختيار الأول لاسم الديوان «كليمة الله» لأني اعتقدت أنها حالتي، حالة إيقاظ أسئلة طفولتي (من أخبر الأطفال أني لست طفلة……) فوعي الموروث الثقافي أعتقد أنه قسم أساس موردي للفلسفة، أما أن نربط هذا بالآني، ففي الحقيقة أنا ممتنة لذلك أن استطاعت أعمالي أن تمثل الواقع الآني، أنا على ثقة أن أمر التصادم المزعوم مع الموروث هو ثمرة عدم وعي، فقط على طريقة المقولة الشعبية (حبيبك يبلع لك الزلط… وعدوك يتمنى لك الغلط) فعدم الوعي هو الذي يدفع البعض للبدأ بالتصنيف قبل أن يفهم ويدرك دلالات ما يتعامل معه من نصوص. الكل يطمح في تمرير رؤيته عن العالم، وأنا من الكل، لكني لست مهمومة كثيرا بذلك فرسائلي أعمق من أن تكون أحادية الغرض، فإذا احتوت قصيدة عشر أغراض مثلا فأكون هانئة إذا استطعت مشاركة القاريء والاتفاق حول غرض أو اثنين منها فقط. أنا على يقين أن مجرد فعل الكتابة بالنسبة لأنثى هو عمل معارض للبعض من باب التطرف، وأن استجلاء منابت طفولتنا ونقاء التعامل مع موروثاتنا هو تصادم، بينما هناك تيار عظيم عميق، يمثل الذاكرة الجمعية يرى في ذلك استحقاق واجب لما يمليه علينا وعينا، وما يمكن تسميته ضريبة التفكير.
https://www.facebook.com/yasmin.salah.73157/videos/551811075594107/?t=4
الشاعرة ياسمين صلاح تلقي قصيدة «كليمة الله»
- «على الأرض مالا يستحق الحياة، لكنها مهنة مقاومة الموت ولا مكان للعاطلين عن العمل»… ثمة حزن دفين في نصك الشعري وعلى عكس درويش نفيت استحقاق الحياة؟
أستاذنا محمود درويش أورد المسألة بصيغة: «على هذه الأرض ما يستحق الحياة» وذلك في سياق محدد، سياق وجودي في مواجهة آخر معاقل الاستيطان العنصري الصهيوني، وأما أنا فطرحت وجها آخر للحياة، ان للحياة شروطها، وعلى الرأس منها مقاومة الموت ببساطة، راقب نفسك في يوم واحد، تجد فرحا وحزنا، أرى دوما أنهما وجهان لعملة واحدة كالجمال والقبح، الخير والشر.. ثنائيات تكتسب جمالها من تناقضها و حلولها بذات الشيء.
- لاحظت أنه لا وجود لهامش تعريف القارئ ببعض الأسماء («أنكيدو» مثلا).. هل يعني هذا أن قصائدك موجهة لشريحة معينة من قراء الشعر؟
دعني بداية أشير إلى إجابتي في سؤال سابق، بضرورة الهامش وأشكر لك الاهتمام بذلك، لكن ثمة شئ دفين عميق في روحي، أن العمل بالكامل وما يقدمه من مفاهيم وأسئلة وجودية موجه لشريحة، ربما لا يعوزها كون أنكيدو هو هذا الصنو، الصديق الصدوق، شريك الانتصارات والهزائم، بقدر انصهار اسم أنكيدو مع فكرة الصداقة التي يوضحها ما حول الكلمة من أفكار و كلمات، على العموم أنا منحازة جدا لفكرة توسيع الهوامش لدرجة التماهي مع نصوص «مقامات الحريري» التي وصلت بعض القراءات لها إلى وجود هامش يعادل المتن، وفي الواقع أنا مع هامش رقيق، لن يهم سوى القارئ المصطفى، بينما أتفق معك أنه يدعم النص كثيرا، وفي الختام، علي الاعتراف أنني استفدت كثيرا من تجربة الحوار النقدي حول ديواني الأول، و دائما وأبدا أشكر كل من ساهم في بناء تجربتي، بداية بأمي التي كانت تجعلني أقرأ يافطات الشوارع وكل ورقة تقع عليها عيني حتى قراطيس الطعام، و أبي الرجل الممتزج بالطبيعة المتأمل بطبعه لكل لفتة وفن، وجدتي وحكاياتها وحفظها لتراث الصعيد الذي أنعش روحي مبكرا، وفي كل مناسبة.. مرورا بالناس في الشارع الذين ننتمي لهم وهم أصحاب التجربة الحقيقية، والمريض المتأوه الذي لا أملّ سماع حكاياته.. انتهاء بكل من أنعم الله عليّ بمعرفتهم من إناس حقيقين من هذا الوسط.. لم يتوانوا أبدا عن دعم أو تشجيع صادق.