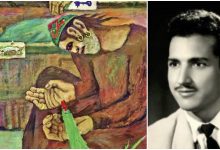في عام 1941 زار الفنان العالمي بابلو بيكاسو كهوف «لاسكو» في جنوب فرنسا؛ ثم وقف يتأمل جمال تلك اللوحات التي رسمت على جدران تلك الكهوف والتي يعود بعضها إلى أكثر من أربعين ألف عام؛ قال وهو يطلق زفرة من صدره: «نحن لم نتعلم شيئاً» وقد كان يقصد بذلك أن سكان تلك الكهوف قد سبقوا الفنانين المعاصرين في إبداعاتهم ورؤاهم. كما أن بيكاسو نفسه، وكما قال، قد حاول كذلك أن يحاكي بعض هذه الأعمال في إبداعاته الخاصة. لقد خرج الانسان القديم من الكهف منذ آلاف السنين، لكنه عاد إليه الآن من جديد في ظل هذا الاجتياح الغريب لوباء الكورونا العجيب، وقد تنوعت الرمزيات الخاصة بالكهوف وتعددت بدلالات ومعايير شتى حتى يومنا هذا. هذه مجرد محاولة لاستكشاف بعض الدلالات مع محاولة ربطها أيضًا بذلك الموضوع الأكثر حسما وتأثيرا على حياة البشر في العالم الآن ألا وهو وباء الكورونا، فما علاقة الكورونا بعالم الكهف والكهوف؟.
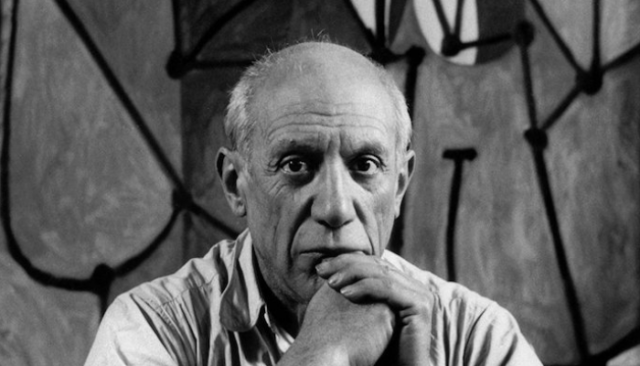
بابلو بيكاسو
رمزية الكهف
ترتبط رمزية الكهف برمزيات البيوت والأواني والرحم والمبدأ الخاص بالاحتواء والتضمين والاشتمال وبرمزية القواقع وإيقاعية الطبيعة واستمرارية الدوائر المغلقة وبمعاني الموت واليأس والعودة إلى المركز وإلى الأصل والأرض الثابتة والخوف من مواجهة الشمس أو النور أو المجهول أو العدو الغامض ورمزيات الاحتواء والصناديق والمتاهات.
وقد نشأ مفهوم المتاهة (كما أشار بول ليفي) في مصر القديمة، حيث ظهر تصور خاص حول جهنم أشبه بالمتاهة، ويكون على الموتى معرفة منافذها، وكذلك طرق العودة المبسوطة من قبل الغيلان التي تسكنها، بهدف العودة مع الشمس إلى الحياة. وقد ذهب أورفيوس بحثا عن محبوبته أو زوجته إلى العالم السفلي عبر متاهات، ووصولاً إلى تقطيع أوصاله وأوتار قيثارته، ودخوله في متاهة الضياع. ورحلات أبطال الأساطير هي غالبًا رحلات عبر متاهات.
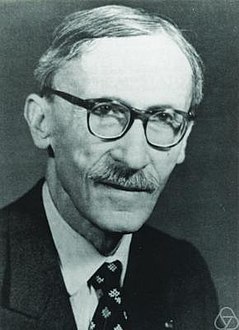
بول ليفي
والكهف «كالحلم» موضع لعملية الجمع والتكثيف لكل ما هو خفي أو غامض، مكان البداية والميلاد، ومكان النهاية والموت، والكهف مبدأ أنثوي حِمائي، يرتبط برحم الأم، وبالأرض، والقبر أيضًا. إنه مكان الدفن والميلاد من جديد، وبقلب الإنسان الذي هو أشبه بكهف يمتلئ بالأسرار، الجرم الصغير الذي ينطوي فيه العالم الأكبر، الإنسان وقلبه (وفقًا لابن عربي)، إنه مكان الأحلام الغامضة التي قد نتمنى الدخول إليها، والكوابيس التي نتمنى الخروج منها. وقد يعني الدخول إلى الكهف التجسيد لرغبة ما في العودة إلى رحم الأم، في الرقود هناك بلا مسئولية أو ألم، وفى الاستلقاء أو الاتكاء على شكل يماثل الرقود في القبر، هكذا قد يكون الكهف رمزًا للعالم في غموضه وخداعه وأوهامه التي لا تنتهي، ورمزًا كذلك للولادة من جديد، للخروج من حالة الغموض التي قد تصل إلى مرحلة التيه (الغياب وفقدان اليقين واللاتحدد)، إلى حالة من الاكتشاف للذات وللطريق والنور.
كذلك تحدث الفيلسوف الإنجليزي فرنسيس بيكون (1561-1626) عن أوهام الكهف ضمن حديثه عن الأوهام الأربعة (النوع والكهف والمسرح والسوق) وكان يقصد بأوهام الكهف، تلك الأوهام الناتجة عن الأخطاء والأهواء والميول والتحيزات الخاصة بكل فرد إنساني وقد كان يقول إن لكل إنسان منا أخطائه، وإن لكل منا كهفه الخاص به الذي يعمل في ضوء طبيعته وسماته وتربيته وبيئته وخصائصه الجسمية والعقلية ومستواه الثقافي، إنه الإطار الذي يفرض على الفرد نوعًا من التفكير والعزلة الخاصة كما لو كان يعيش بمفرده في كهفه الخاص، وقد أشار أفلاطون نفسه إلى مثل هذا النوع من التفكير الكهفي عندما تحدث عن أسطورة الكهف، حيث نظر إلى أن كل إنسان، بل كل فيلسوف أيضًا على أنه سجين كهفه، وإنه لا يفكر إلا في ضوء مزاجه الخاص وأوهامه الخاصة وطبيعته الخاصة والتي قد تتناقض مع الواقع وأيضًا مع أفكار الآخرين.

فرنسيس بيكون
في كهف أفلاطون
باختصار فإن سقراط يحكي في «محاورة الجمهورية» لأفلاطون قصة عن كهف ما كان موجودًا تحت الأرض، وقد وضعت فيه مجموعة من البشر منذ ولادتهم وتم تقييدهم من أعناقهم وأرجلهم وإجبارهم كذلك على النظر، على نحو ثابت، نحو حائط تنعكس عليه ظلال متحركة. وهذه الظلال التي تأخذ شكل الحيوانات هي مجرد صور ظلية لعرائس يتحكم في تحريكها لاعب ماريونيت موجود خلفهم. ويواصل سقراط حكايته فيقول إنه لو قدِّر أن أحد هؤلاء المساجين قد تم تحريره وذهب إلى خارج الكهف فإنه سيشعر بضيق شديد لكنه تدريجيا سيعرف بوجود عالم حقيقي غير ذلك العالم الوهمي الذي كان يعيش فيه.
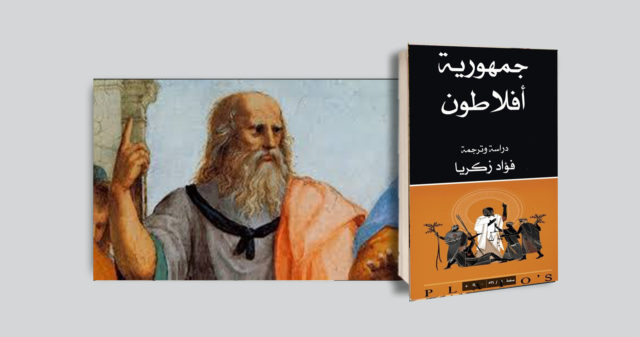
إن هذه الظلال هي النواتج الخاصة بعالم الإبصار (أو الرؤية البصرية). هكذا يقول سقراط في هذه المحاورة: هكذا يمكنك أن تدرك، عزيزي جلوكون، إن البيت/السجن هذا هو عالم الإبصار، وإن ضوء النار هو الشمس، وإن رحلة الخروج من الكهف هي عملية صعود خاصة بالروح إلى العالم العقلي، عالم الأفكار، هكذا يكون واجب المفكرين والفلاسفة أن يعودوا إلى الكهف وأن يحرِّروا سكانه، وأن يساعدوهم على تحريك رؤوسهم، وإدارتها هنا وهناك، وعلى الخروج من الكهف. وإنه من خلال ذلك كله قد ينجح هؤلاء السجناء في إدراك أن الواقع الذي كانوا يعيشون فيه، واقع الظلال، ليس هو الواقع الحقيقي، فالواقع الحقيقي يوجد خارج تلك الظلال. يوجد حيث توجد الشمس وحيث يشع النور، ذلك النور الذي هو نور الوعي والتفكير، وإنه مثلما كانت النار تلقي بضوئها وظلالها على حائط الكهف، فكذلك العقل الإنساني مقيَّد، وعلى نحو كبير، بعالم الانطباعات التي ترد إليه عبر الحواس.
إن السجين المُحرَّر ربما اعتقد أن العالم الموجود خارج الكهف عالم أكثر تفوقًا من ذلك العالم الذي كان يعيش في ظله في الكهف، ومن ثم فإنه قد يحاول جعل السجناء الآخرين يشاركونه هذه الخبرات الجديدة بأن يجعلهم يخرجون من الكهف ويبدأون مرحلة جديدة نحو الشمس لكن هذا السجين العائد، والذي اعتادت عيناه على ضوء الشمس في الخارج، قد يصيبه ما يشبه العمى عندما يعود إلى الكهف مرة أخرى.
ألا يمكن أن يكون ما يحدث الآن في عالم الصور الخاصة بالتليفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرهما أمرًا مماثلاً؟ وهل حلت الصور المنعكسة على الشاشات الآن محل صور الكهف القديمة؟ وألا يعد ما نتلقاه بحواسنا عبر تلك الشاشات الآن مجرد ظلال للحقائق، أو أشباه للحقائق، أشياء ندركها «كما لو كانت» حقائق، لكنها ليست كذلك؟
في كهوف الصور والتليفزيون
لقد قام بعض المنظرين ما بعد الحداثيين، وتحديدًا الفرنسي جان بودريار بمراجعة خاصة لأفكار أفلاطون هذه؛ فبينما كان أفلاطون يرى أن الصور ظلال للواقع؛ رأى بودريار أن «الصور هي الواقع ذاته»، وأن صور التليفزيون هي المُجسِّدة لذلك أكثر من غيرها، وكذلك أن الصور بوصفها مظاهر خادعة لا تكشف عن شيء ولا تنتج عنها أية معرفة حقيقية، وذلك لأن «الصور قد أصبحت هي وسيلتنا في معرفة العالم».
هكذا اتسم فكر بودريار بنزعة أفلاطونية معكوسة، فهو قد رفض تمييز أفلاطون بين المظهر والجوهر، بين الصورة أو الظل والحقيقة، بل إنه رفض أيضًا مجرد فكرة وجود واقع حقيقي فعلا، وذلك لأن ما هو موجود فعلا بالنسبة إليه، وكما قال، مجرد مستويات من الصور الخاصة بالواقع، ومجرد مظاهر فقط لأشكال شتى من الواقع، فلا يوجد واقع مُحدَّد هنا أو هناك، بل مظاهر للواقع تتجلى على أنحاء شتى، هنا أو هناك. هكذا حاول بودريار أن يحل أو يذيب تلك التمييزات الموجودة بين الواقع والمظهر؛ مؤكدًا أن الواقع المسموح لنا أن نعرفه مجرد مظهر أو صورة للواقع الحقيقي، وذلك لأننا مغمورون، كما قال، في واقع ما بعد حداثي فائق أو أعلى، فيه تكون الحقيقة متعلقة فقط بآخر ما تم الإجماع عليه عن طريق الوسائط والوسائل الخاصة بالإعلام. هكذا تعد الصور الفوتوغرافية والتليفزيونية والرقمية وغيرها من المكونات الكبرى لهذا الواقع الفائق، إنها وسائل لا للإخبار بالمعلومات أو الكشف عن الحقيقة، بل للمشاركة في تكوين حالة من الإجماع المُخلّق أو المُصنّع الذي يتم تمريره كحقيقة أو معرفة، هكذا أصبح عالم الواقع يحاكي عالم الصور، وصارت الحياة تحاكي الفن، وعالم الظل أكثر حقيقة من عالم الواقع الفعلي الذي لا ندرك عنه شيئًا سوى ما تتيحه لنا الوسائط عنه أو حوله.

وهكذا قيل أيضًا إن كل ما يقدمه لنا الساسة والمفكرون والإعلاميون وغيرهم من خلال وسائل الإعلام ما هو إلا نسخة غير مطابقة من الواقع، مجرد عينة صغيرة منه قد تكون ممثلة بصدق أو على نحو زائف له، نسخة أقرب إلى الصور المحاكية أو غير ذات الأصل المحدد، أي ذلك الأصل الذي تم تحريفه على أنحاء شتى وعن عمد أو عن غير عمد. إنها النسخة الخاصة بهم، النسخة التي يراد تمريرها وترويجها من شيء ما، أو عن شيء ما، النسخة التي يريدون منا أن ندركها هكذا خلال تلاعبهم بعقولنا، النسخة المُحرّفة، النسخة المُعوْلبة، النسخة المريضة، النسخة المُغيِّبة، النسخة غير ذات الأصل المُحدَّد إلا في سراديب أجهزتهم ومؤسساتهم.
وهكذا فإن ما نحصل عليه حول موضوع معين يكون غالبًا مجرد النسخة التي أتيحت لنا من خلال حواسنا وبخاصة حالات الإبصار أو السمع والتي نستخدمها بينما نحدِّق في التليفزيون أو غيره من وسائل الإعلام. إنها ليست الشكل الأعلى أو الأصلي أو الفعلي من ذلك الواقع المرتبط بعالم القيم أو المثل العليا والتي كان أفلاطون يتحدث عنها، أي تلك القيم المُحيطة العليا والتي لا يصل إليها سوى الفلاسفة وأصحاب الفكر الراقي.
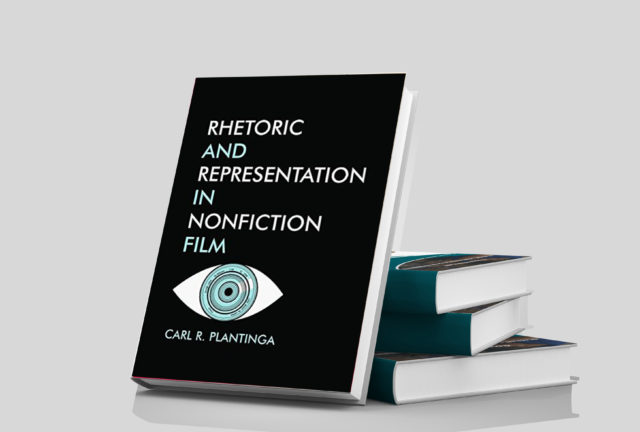
في كهوف القرن الحادي والعشرين
هكذا أصبحنا نجلس في بيوتنا في الظل أو شبه العتمة، وكالسجناء في كهف أفلاطون القديم، نشاهد أضواء شاشات التليفزيون وغيرها من الأجهزة، تأتي إلينا بالأخبار والمعلومات التي يقال لنا إنها حقيقية عن وباء الكورونا الذي اجتاح العالم، وفي ظني بل ويقيني أنه ربما لم يسبق في تاريخ البشرية أن كانت هناك ظاهرة محاطة بالأكاذيب والخداع والمعلومات الناقصة والمتناقضة والمغلوطة كما حدث بالنسبة لهذا الوباء، فهناك معلومات ناقصة ومتناقضة عن أسبابه، وأخرى مماثلة عن أعراضه وعن عدد الإصابات والوفيات وعن كيفية انتقاله ووسائل الشفاء منه، ومعلومات سطحية عن تماثلات بينه وبين أوبئة أخرى مرت على البشرية، وفيضان كذلك من الكتابات عن الأبعاد والتأثيرات السياسية والاقتصادية والنفسية والجسدية والاجتماعية والتعليمية الخاصة بهذا الوباء، وليست هناك من معلومة واحدة يقينية أو مؤكدة خاصة بأي شيء حوله. لقد سقطنا في براثن التزييف والخداع وصار غير المتخصصين يدلون بدلوهم، وصار الأطباء في كل فرع عارفين بخبايا هذا الفيروس ونواياه، يقولون الشيء اليوم ونقيضه غدًا، وصار التعليم موجودًا عن بعد، والثقافة عن بعد، والعروض الفنية والمؤتمرات والاجتماعات والندوات.. إلخ تتم عن بعد، صار كل شيء افتراضيًا، صورة مُحاكية للأصل أو صورة مُحرَّفة منه، هكذا أصبح التعليم محاكاة للتعليم، وأصبحت الثقافة محاكاة للثقافة، والفنون محاكاة للفنون، والأعمال محاكاة للأعمال، وأصبح العالم كله يُدار من خلال كهوف افتراضية، تقدم نسخًا غير ذات أصل مُحدَّد من الحقيقة؛ نسخة «كما لو كانت» هي الأصل ولكنها ليست كذلك، وذلك لأننا لم نزل نعيش في عالم يعتمد على كثير من الأفكار الوهمية أو المتخيلة والتي نشكل من خلالها عالمًا يبدو «وكأنه العالم» وكما أشار هانز فايهينجر (1911-1952)، وبعده أدلر إلى ذلك خلال ثلاثينات القرن الماضي تقريبًا.

هانز فايهينجر
في كهفنا الكورونيالي
لقد دخلنا إلى كهف القرن الحادي والعشرين. وصار العالم يُدار من خلال أجهزة التليفزيون أو برامج الزوم zoom وغيرها. وصرنا نحن أنفسنا صورًا مُحاكية غير ذات أصل مُحدَّد، كائنات تعيش كالأشباح في عوالم الحجر المنزلي التي شبَّهها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالسجن. صرنا أشباحًا حاضرة غائبة؛ فقدنا أرواحنا، أصبحنا كائنات غير كاملة، تستخدم أجهزة حديثة وتقنيات متقدمة في حياتنا، لكنها وفيما يبدو، لم تغادر كهوفها القديمة بعد.

بوريس جونسون يتواصل مع حكومته من داخل الحجر الصحي
لقد قام ذلك الفيروس، أو الكائن الصغير بتحويل هذا المجتمع الإنساني إلى كهف كبير، وقد استخدمت بعض السلطات آليات السيطرة على المرض من أجل السيطرة على البشر، وكثر الكلام في بعض المجتمعات حول وعي الناس وغيابه بينما لم تطرح أسئلة مناسبة حول وعي المسؤولين ودورهم ودور ممارساتهم الخاطئة في تفاقم هذا البلاء، وأصبحت الكمامة وسيلة قمع وسيطرة وجباية بدلًا من أن تكون وسيلة وقاية وحماية، صارت مصدرًا للخوف بدلاً من أن تكون وسيلة للأمان.
أين الحقيقة؟ لا توجد، في الحقيقة، أية حقيقة! لا يوجد سوى أيقونة الخوف المتمثلة في القناع (أو الكمامة) وسوى الغبار، وسوى الأمل. لقد انفتح صندوق باندورا وأطلق من داخله كل الشرور، ولم يبق لنا سوى أن نبحث عن بقايا أمل موجودة في أعماقه، وما هذا الصندوق أيضًا سوى كهف آخر قديم يعاد فتحه من جديد.
هل سنعود كما كنا قبل حدوث هذا الاجتياح الغاضب للكورونا؟ هل سنخرج من كهوفنا كما دخلنا إليها؟ الإجابة يقينًا هي بالنفي، فلسوف يتعلم الناس عادات جديدة في النظافة والتباعد الاجتماعي والمحافظة على الصحة وسوف تظهر تقنيات وإبداعات جديدة في التعليم والعمل والإدارة والصناعة والثقافة والفنون وغيرها. لكنني أعتقد أيضًا أن ذكريات هذه الأيام الغريبة سوف تبقى مع الناس الذين عاصروها مختزنة طويلاً في قلب ذاكرتهم إلى نهاية حياتهم، إنهم سوف يخرجون ويعودون إلى أعمالهم وأنشطتهم ومناسباتهم الاجتماعية والدينية والثقافية والتعليمية وغيرها، لكنهم سوف يتذكرون دائمًا أيضًا مخاوفهم التي لن تغادرهم عندما يغادرون منازلهم أو كهوفهم، ولسوف يتحينون دائمًا أيضًا الفرصة للانتهاء من المهام التي خرجوا من أجلها كي يعودوا سريعًا إلى بيوتهم، أو بالأحرى إلى كهوفهم الحديثة التي تتلألأ الأضواء والأكاذيب على شاشات أجهزتها الحديثة، وقد يشعر كثيرون منهم بحرج مماثل لذلك الحرج الذي كان يشعر به، شويتشي يوكوي، فمن هو شويتشي يوكوي؟ ولماذا كان يشعر بالحرج الشديد؟

إنني أشعر بالحرج الشديد
في 24 يناير عام 1972 اقترب صيادان من صيادي الأسماك من رجل كان يجلس بجوار نهر قريب من شلالات «تالوفوفو» في جزيرة «جوام» في المحيط الهادي (وهي تحت سيطرة الولايات المتحدة منذ عام 1944)، وقد عرف بعد ذلك أن هذا الرجل كان اسمه شويتشي يوكوي، وقد كان جنديًا يابانيًا ظل يعيش في عزلة في كهف صنعه بيديه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945 بعد أن هرب واختبأ هناك عندما قامت القوات الأمريكية بغزو تلك الجزيرة عام 1944، مفضلاً ذلك على أن يستسلم ويؤخذ كجندي أسير، وقد كان عمره ستًا وعشرين عامًا عندما تم تجنيده في الجيش الياباني عام 1941، وفي ذلك الوقت كان يتم تعليم الجنود اليابانيين أن الاستسلام أسوأ مصير يمكن أن يلقاه الجندي، وأن الموت أفضل كثيرًا من الاستسلام للأعداء، ومع ذلك فقد أخذ يوكوي طريقًا وسطًا، فلم يستسلم ولم يمت، بل هرب ومعه عشرة من زملائه إلى غابة قريبة، بعدها افترق هؤلاء الرجال وظل اثنان منهما فقط بالقرب من يوكوي يتزاوران معه، بعد أن حفر كهفًا بالقرب من شلال للمياه، ثم قام بتغطيته بخشب الخيزران وأعواد القصب. وعندما اكتشفه هذان الصيادان عام 1972 بجوار النهر لم تكن لديه فكرة عن أن الحرب قد انتهت منذ أكثر من سبع وعشرين عامًا بعد هروبه. ثم أنه بعد مقاومة شديدة منه للصيادين استطاعا التغلب عليه ثم تسليمه لسلطات الجزيرة التي قامت بعلاجه في إحدى المستشفيات ثم حكى بعد ذلك قصته الغريبة هذه وأرسل بعد ذلك إلى اليابان، التي لم يرها منذ حوالي ثلاثين عامًا، وخلال تلك السنوات السبع والعشرين التي عاشها يوكوي في الجزيرة كان يقتات على أكل الضفادع والفئران والأسماك وكذلك الفاكهة والبندق والفستق.

شويتشي يوكوي
عندما وصل يوكوي إلى طوكيو عام 1972 كان هناك حشد يقترب من خمسة آلاف من الناس في استقباله يرحبون بعودته ويحتفلون به، لكنه كان يشعر بالحرج لشعوره بالتقصير في أداء واجبه فقال «إنني أشعر بالحرج الشديد» وصارت تلك مقولة شائعة في اليابان وذلك بالنسبة لمن يوضع في مثل موقفه ويضطر للهروب من مسؤوليته. بعد ذلك لم يكف يوكوي عن العودة إلى تلك الجزيرة أو الهرب إليها مرات عديدة حتى بعد أن أصبح حرًا وتزوج، بل إنه قد عاد إليها ليقضي فيها بضعة أيام من شهر العسل بعد زواجه. ووفقًا لما ورد في نعيه بعد ذلك (توفي عام 1997 بعد خمسة وعشرين عامًا من اكتشافه)، فإن يوكوي قد مر بأوقات صعبة حاول أن يتكيف خلالها مع حياته الجديدة في اليابان، وكانت زياراته المتكررة لتلك الجزيرة، إلى كهفه وعزلته، وسيلته المفضلة في الهروب من الضغوط ومشقات الحياة التالية التي عانى منها.

شويتشي يوكوي يصل اليابان بعد 27 عام من غيابه
على الرغم من أن ذلك الكهف الذي عاش فيه يوكوي قد انهار ودُمِّر بعد ذلك وأصبح أثرًا بعد عين؛ إلا أن قصته تظل باقية حية مُفْعَمة بالدروس والدلالات، خاصة ما يتعلق منها بالعزلة والتقشف وصعوبات إعادة التكيف التي يعاني منها الإنسان بعدها، وكذلك رغبة الإنسان في العودة إلى ذلك الكهف أو البيت الذي عاش فيه فترة آمنة من حياته هربًا من الموت وتحاشيًا للهلاك. فهل سيقوم بعضنا بذلك أيضًا بعد أن تنقضي جائحة الكورونا هذه أو تنقشع مخاوفها وتتراجع أو تزول؟ في الأحوال كافة سوف تبقى معنا تلك الروح الشبحية الكورونيالية المُهوّمة تطاردنا في يقظتنا، وفي نومنا أيضًا.

الكهف الذي عاش فيه شويتشي يوكوي
إننا نجلس الآن في بيوتنا، غالبًا في أضواء خافتة نسبيًا، نشاهد أخبار العالم وأحداثه تأتي إلينا من خلال شاشات التليفزيون وأجهزة اللابتوب وغيرها. نحن نجلس نتابع الأخبار فإننا، وعلى نحو ما، نشبه هؤلاء السجناء الذين كانوا في كهف أفلاطون، إننا نجلس الآن في كهف حديث قد تم تزويده بالأجهزة الحديثة والكهرباء والمياه النقية، لكن جوهر خبراتنا يكاد يكون واحدًا، نحن نرى ظلال الأشياء لا نرى حقيقتها، لقد قرأنا وسمعنا ولا بد عددًا كبيرًا من تلك الإشاعات التي تواترت حول الكورونا والتي قيل في بعض المواقع الإخبارية إنها قد بلغت مليون شائعة، وقد سمعنا الشيء ونقيضه وبقلب بارد من الشخص نفسه. وقد كانت الكورونا بالنسبة لنا صدفة عنيفة تشبه الحرب التي أعلنها عدو خفي شرس مع العالم كله، وكانت تلك ولم تزل صدفة مخيفة وقاتلة، ربما على نحو أشد من حرب عالمية.

لقد أصبح وجودنا أسيرًا في قبضة عالم افتراضي تداخلت فيه الحقائق مع الأكاذيب والظلال مع الأشياء الفعلية، وقد أصبح هذا الواقع الافتراضي بالنسبة إلينا «عاملاً ثانيًا» كما كان بودريار يسميه، ليس هو عالم الواقع ولا عالم الوهم أو الخيال، بل عالم يقع في منزلة بين منزلتين لا تدري عندها ما الواقعي وما الوهمي وما الخيالي!! هكذا صرنا أسرى أو سجناء في سراديب مواقع التواصل/الانفصال الاجتماعي.
وفي كهف أفلاطون كانت تعرض الأشياء خلف هؤلاء الجالسين في كهفهم/سجنهم ويرون ظلالها أمامهم، أما نحن في كهفنا الحداثي أو حتى ما بعد الحداثي هذا، في بيوتنا، فتأتي إلينا المعلومات التي هي أشبه بظلال للحقائق من الفضاء الخارجي، ليس من الخلف بل من الأعلى، من خلال أجهزة البث والأقمار الصناعية، وعلى الرغم من هذه الفروق الواضحة فإن الجوهر واحد، أنت في الحالتين مستلب، وأنت في الحالتين سجين ترى الظلال، ولا ترى الحقيقة أو النور، أنت في الحالتين قد تم تضليلك، ولو حاول أحد أن ينبهك إلى ما تحتوي عليه هذه المشاهد والأحداث والأخبار من أكاذيب، فلربما تحول إلى عدو لك، عدو للوطن والإنجازات، وربما طالب البعض بإلقاء القبض عليه. إنك لم تزل تعيش في الكهف، كهفك الخاص، كهفنا جميعا، وقد أصبحنا كائنات مُخلَّقة مُصنَّعة أنتجها البث التليفزيوني وآليات التعليم القديمة والحديثة، صرنا فاقدين للروح، صرنا أشباحًا موجودين ما بين الحياة والموت، الحضور والغياب، أصبحنا في حالة خوف دائم، خوف من المجهول والمستقبل والموت ومن عالم الكورونا، هذا الغامض الغريب المُخيف اللامُحدَّد الذي لا يصاحبه أي يقين.
إن أسوأ ما قد يحدث بعد انتهاء هذه الجائحة أو خفوتها، أو كمونها النسبي، هو أن نصاب أيضًا بفقدان الاهتمام، أن تضعف دوافع الحياة لدينا، وأن يفقد الناس اهتماماتهم السابقة، أن تتراجع رغباتهم في الذهاب إلى أماكن العبادة أو الدراسة أو الفاعليات الثقافية أو المناسبات الاجتماعية، أن يقنعوا بالبقاء في الكهف أو الكوخ، أن تصبح حياتهم متجهة إلى الداخل، داخل بيوتهم وداخل نفوسهم وداخل علاقاتهم وأن يضيق المجال الحيوي والإنساني بالنسبة لكثيرين منهم إلى حد كبير؛ أو أن نكون صورًا مُحاكِية أخرى لتلك الصورة التي كان عليها السجين الياباني شويتشي يوكوي.

مراجع
1- Plantinga, C (1996). “Moving Pictures and the Rhetoric of Non-Fiction: Two Approaches”. In: Bordwell, D & Carrol, N – Post Theory: Reconstructing Film Studies. NY: UNIV. of Wisconsin Press.
2- أفلاطون (1985) جمهورية أفلاطون (دراسة وترجمة فؤاد زكريا) القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.
3- أشرف منصور (2003) صنمية الصورة: نظرية بودريار في الواقع الفائق. مجلة فصول، 30، 62، 226.
4- شاكر عبدالحميد (2005) عصر الصورة، الإيجابيات والسلبيات. الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، سلسلة عالم المعرفة.
5- عن قصة الجندي الياباني شويتشي يوكوي أنظر: