عرض وترجمة: أحمد بركات
ثقافة الإلغاء هي أحدث مصطلح يتم تداوله الآن في مجال الحرب على حرية التعبير. تعني هذه الكلمة بالنسبة لمستخدميها فصل الأشخاص من وظائفهم بسبب ما يقولونه أو يعتقدونه (عادة بسبب شيء يعد غير صحيح سياسيا). وبحسب هؤلاء، فإن حشود اليساريين على تويتر الآن تكمم حرية التعبير لشخصيات عامة تنتمي إلى اليمين، وبالنسبة لدوائرهم الانتخابية المفضلة للأفراد العاديين، الذين يقصدون بهم مؤيديهم وأنفسهم.
من المغري أن نتجاهل ثقافة الإلغاء باعتبارها حيلة يمارسها اليمينيون للعب دور الضحية. فقد سخر هؤلاء على مدى سنوات مما يطلقون عليه ’أولمبياد الاضطهاد‘ (المنافسة الافتراضية بين الفئات المضطهدة لتحديد الأكثر مظلومية). وومن خلال التظاهر بأنهم ضحايا للرقابة اليسارية، يعتقد هؤلاء أن بإمكانهم أخيرا الفوز بالميدالية الذهبية.
لكن، يجب علينا مقاومة هذا الإغراء لأن ثقافة الإلغاء الحقيقية موجودة بالفعل. لقد استمرت هذه الثقافة طويلا، وتم بالفعل فصل كثيرين من وظائفهم وحرمانهم من العمل بسبب تعبيرهم عن آرائهم. ليس ذلك فحسب، بل استهدفت ثقافة الإلغاء أفرادا عاديين يحملون وجهات نظر يسارية ويتحدثون في أماكن العمل عن أرباب عملهم، أو ينضمون إلى نقابات عمالية، أو يشاركون في تنظيمها.
تحمل ثقافة الإلغاء الحقيقية تحمل اسما أقدم، وهو ’القائمة السوداء‘ التي أدى تفعيلها إلى الحد من حرية التعبير حيثما كانت الاتحادات والأفكار اليسارية معنية على مدى المائتي عام الماضية. وإذا كنا نرغب في الدفاع عن حرية التعبير لجميع الأفراد ومنع فصلهم من وظائفهم بسبب آرائهم، فيجب علينا أن نفكر بشكل أكبر في الفضاء الوحيد الذي لم تكن حرية التعبير موجودة فيه حقيقة، وهو مكان العمل.

من أين تأتي ثقافة الإلغاء
يعود الحرمان من حرية التعبير في العمل إلى السنوات الأولى من الثورة الصناعية في الوقت الذي وقف فيه القانون دائما إلى جانب رؤساء العمل البريطانيين والأمريكيين، وظلت النقابات محظورة قانونا، كليا أو جزئيا، طوال القرن التاسع عشر. ومع انتهاء هذه المحاذير، طور أصحاب العمل طرقا أخرى لإبقاء روح “التعديل الأول” بعيدة عن أجواء المصانع.
وقد واصلت الولايات المتحدة على مدى القرن التاسع عشر تطوير هذه الأساليب. فقد نشر أصحاب العمل أسماء مثيري الشغب ومحرضي النقابات فيما بينهم حتى لا يلتقط أي من عمالهم عدوى الخطاب النقابي، وتحولت ’مسودات‘ هذه الأسماء إلى قوائم سوداء. وذهب البعض إلى أبعد من ذلك حيث حصلوا على توقيعات من جميع الموظفين على ما أطلق عليه ’القسم الحاسم‘ (عُرفت فيما بعد باسم ’العقود الصفراء‘، وهي عقود بين أصحاب العمل والعمال، يوافق من خلالها الطرف الثاني على عدم الانضمام إلى أي نقابة، أو البقاء فيها). ويستدعي تيرينس بودرلي، أحد الزعماء العماليين في وقت لاحق المناخ الذي شكلته هذه الأساليب في سبعينيات القرن التاسع عشر عندما ضرب الكساد الاقتصاد الأمريكي:
“لم يجرؤ أحد ممن ارتبطت أسماؤهم بالتنظيمات العمالية على السماح بظهور اسمه علنا؛ فالقائمة السوداء سيتم استخدامها، وسيكون جزاء العامل على انضمامه إلى النقابات العمالية في تلك الفترة هو البطالة والفقر والعوز وربما الموت”.
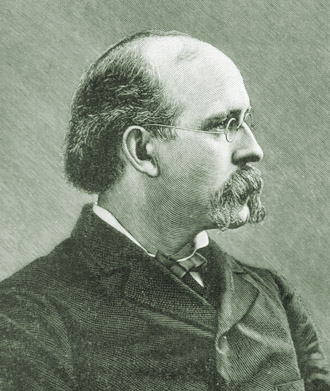
وشكل المحققون الخاصون الحليف الأهم لأصحاب العمل في حربهم على حرية التعبير وإنشاء الاتحادات. وعرضت شركات من قبيل “بينكرتون للتحقيقات” استخدام عدد من موظفيها، مثل مفسدي الإضرابات والجواسيس والوكلاء المحرضين، داخل أماكن العمل للكشف عن النقابيين، وتفعيل ’القائمة السوداء‘ و’القسم الحاسم‘، وتشويه النقابات في عيون الجماهير. وبناء على توجيهات الشركات، أطلقت جيوش المحققين الخاصين العنان لاستخدام العنف ضد النقابات على نطاق لم تشهده أي دولة صناعية أخرى. وكممت أفواه العمال وحرموا من حقهم في حرية التعبير ليس بالتغريد على موقع تويتر، وإنما بالرصاص والجواسيس.
وفي القرن العشرين، استبدل أصحاب العمل البريطانيون المحقق بـ ’الشرطي المكتبي‘ (Desk Jockey). ففي عام 1919، تعاون أصحاب المصانع الأثرياء مع رئيس سابق للمخابرات البحرية لإنشاء “الرابطة الاقتصادية” (Economic League) للدفاع عن المشاريع الحرة ومعارضة الحُمر. وطورت هذه الرابطة أسلوبا جديدا وبسيطا، حيث قام باحثوها بقراءة جميع المنشورات اليسارية التي استطاعوا الحصول عليها لتحديد الأشخاص اليساريين، ووضع كافة التفاصيل الخاصة بهم في ملف. وأُدرج التروتسكيون وأعضاء الحزب الشيوعي والمخربون الآخرون في القوائم السوداء. وبمرور الوقت، أضيف إلى هذه القوائم نشطاء من حملات مختلفة، وكان أغرب ضحايا هذا الأسلوب هو سيد سكروجي، أحد قدامى المحاربين الذي كان كفيفا ومعاقا، وكانت جريمته خطابا نشرته الصحيفة المحلية في مدينة دوندي بولاية أوريغون في ثمانينيات القرن الماضي يمتدح فيه دعم المجلس لنيلسون مانديلا.

وبعد الحرب العالمية الثانية أصبحت الرابطة أكثر من مجرد شرطة فكرية خاصة، وبدأت شراكة مربحة مع شركات بريطانية لإدراج مثيري الشغب النقابيين في القوائم السوداء، خاصة في مجال صناعة البناء, وقامت الشركات بتمرير التفاصيل الخاصة بأعضاء النقابات والعمال الناشطين الذين أثاروا مخاوف تتعلق بالسلامة أثناء العمل إلى الرابطة، ثم إلى القائمة. ولم يتمكن كثير من هؤلاء من العثور على عمل في نفس المجال مرة ثانية. وأسهم ضباط الشرطة والمخابرات في إنشاء وإضافة معلومات إلى هذه الملفات، كما فعل – لعارهم الأبدي- بعض المسئولين النقابيين المارقين.
انهارت الرابطة في عام 1992، وتشوهت صورتها من خلال ما كشفته الصحف بصورة متكررة عن طبيعة عملها. وذهبت ملفاتها إلى “الاتحاد الاستشاري” (Consulting Association)، الذي احتفظ بها وقام بتحديثها.
لكن الاتحاد تعرض لمداهمة في عام 2009 من قبل “مفوض المعلومات” (Information Commissioner) لخرقه قوانين حماية البيانات. وبعد عدد من الدعاوى القضائية، قامت شركات البناء بدفع تعويضات زادت على 55 مليون جنيه استرليني لضحايا قوائمها السوداء.

امتد العفن إلى القطاع العام، بما في ذلك ما يعتبره اليمينيون معقلا رئيسيا لليسار المتيقظ، وهي هيئة الإذاعة البريطانية (BBC). ففي ثمانينيات القرن الماضي تخلص مديرو BBC ممن وصفوهم بـ “المخربين”، وعلى رأسهم التروتسكيين والشيوعيين، إضافة إلى بعض أعضاء الجبهة الوطنية للحفاظ على التوازن داخل الهيئة.
واتبعت الخدمة المدنية نظاما مشابها، واستخلصت المخابرات البريطانية معلومات من مفتشي المدارس لقياس التوجه التخريبي في أوساط المعلمين. وبهذه الوسائل، تمكنت الشرطة السرية من إنقاذ الجماهير من قارئي صحيفة “ميليتانت“.
ماذا تعني ’ثقافة الإلغاء‘ اليوم
تبدأ هذه النماذج فقط في تتبع الحرب الأكبر التي شنها أصحاب العمل ضد حرية التعبير في العمل. لا نعلم على وجه التحديد أعداد من دمرت القوائم السوداء حيواتهم. ولا توجد طريقة لقياس الضرر الذي لحق بالنقابات بمرور الوقت بإلغاء حقوق اعضائها. كل ما نستطيع قوله في هذا الصدد هو أن الأعداد بلغت عدة آلاف، وأن الضرر كان بالغا. وبمقارنة هذه الحركة الممتدة والمتشعبة ليس فقط للحد من حرية التعبير، وإنما لتجميدها تماما، تبدو الشكاوى التي تتردد اليوم بشأن ثقافة الإلغاء هينة حد السذاجة.
تتسم هذه الشكاوى أيضا بسوء التوجيه، لأن الحرب على حرية التعبير في العمل لا تزال مستمرة. علينا فقط أن نعود إلى أبريل 2020، عندما طردت “امازون” كريستيان سمولز، أحد عمالها في مستودع جزيرة ستاتن، لإثارته مخاوف تتعلق بالسلامة في ذروة الموجة الأولى لتفشي وباء كوفيد – 19، أو الطريقة التي روج بها “فيسبوك” لتطبيقه الجديد “Workplace”، الخاص بتواصل الموظفين، باقتراحه للعملاء المحتملين بأنه يمكنهم منع كلمات معينة من الظهور في موجز التطبيق. وكانت الكلمة التي تم اختيارها كمثال هي “نقابة“.

وفي الوقت الحالي، يقوم أصحاب العمل بتسليح تكتيكات القرن التاسع عشر بتكنولوجيا القرن الحادي والعشرين. فالعقود الصفراء التي تم حظرها في عام 1932 تلقى اليوم رواجا واسعا على يد بعض رؤساء العمل الأمريكيين. وفي الوقت الذي لا يملك فيه هؤلاء تفويضا قانونيا، يرسلون إشارات واضحة إلى العمال الذين قد يفكرون في الانضمام إلى نقابات. ربما لم تعد جيوش “بينكرتون” تجوب الأرض بحثا عن نقابات لإفشالها، لكن صناعة الاستشارات المناهضة للنقابات تستخدم علم النفس الصناعي والبيانات الضخمة لمساعدة الشركات على التنبؤ بالكيانات التي قد يشكلها العمال. وقد أعلن أحد هؤلاء المستشارين عن خدماته على النحو التالي:
“من خلال منصتنا، يمكنهم حرفيا تسجيل الدخول إلى المنصة، والحصول على إجابة لهذا السؤال، والقول: ’نرى أن 20%من هذه المجموعة معرضة لخطر الانضمام إلى نقابات‘”.
قد يكون هذا الكلام من قبيل المبالغة، لكن توجد دلالات على أن أصحاب الأعمال سوف يستغلون أي فرصة لوقف النقابات. ففي عام 2018، قام أحدهم بتسريب فيديو تدريب موجه إلى مديري “أمازون” بهدف مساعدتهم في معرفة ما إذا كان عمالهم ينضمون إلى نقابات، وما يمكنهم عمله وقوله لمنع ذلك. وقد حث الفيديو المشرفين على تحري عبارات مشبوهة من قبيل “الأجر المعيشي”، التي تمثل علامة على التحريض على الانضمام للنقابات. والأسوأ من ذلك، طالب هذا الفيديو أصحاب العمل بتوخي الحذر في حال أخذ العمال الخطوة الحاسمة التي تتمثل في قضاء وقت معا بعد الانتهاء من العمل.
وتمنح وسائل التواصل الاجتماعي الشركات طرقا جديدة للحد من حرية التعبير في العمل، حيث يمكن تأديب الموظفين، أو تحذيرهم، أو حتى فصلهم بسبب ’الإضرار بسمعة الشركة‘ بنشر تعليقات انتقادية عبر الإنترنت، وهي تهمة يسهل توجيهها بقدر ما يصعب دحضها، فضلا عن أنها تمثل “مصيدة” لمنع العمال من التعبير عن المعارضة العامة فيما يتعلق بالعمل.
ويجب على المدافعين عن حرية التعبير الانتباه إلى ذلك. فعندما يتأوهون بسبب حرب يشنها اليسار على اليمين من أجل إتاحة حرية التعبير عن الرأي، يجب عليهم أن يتذكروا أن الرجال والنساء الذين تم فصلهم من أعمالهم بسبب آرائهم كانوا جميعهم تقريبا أعضاء في أحزاب يسارية، أو عمال أرادوا الانضمام إلى نقابة أو الاحتجاج على تصرفات رؤسائهم.
هذا ما كانت تعنيه ثقافة الإلغاء في الماضي، وهذا ما لا تزال تعنيه حتى الآن. وإلى أن يرغب المحاربون ضد حرية التعبير (الشركات والهيئات العامة التي تحاول القضاء على حرية التعبير في العمل) في التخلص من ازدرائهم لمن يمارسونها أكثر من غيرهم، فإنهم يدينون أنفسهم بالرغبة في أخذ الحقوق لأنفسهم وإنكارها على الآخرين.
لا يمكن لبقيتنا أن تظل محايدة. فالأقوياء دائما سيجعلون أصواتهم مسموعة، ومن ثم فإن أي تحرك لتكميم أفواه الناس أو عقولهم، بدرجة أو أخرى، سوف يصيب أولئك الذين يعملون لدى شخص آخر. وإذا كنا نريد الاحتفاء بآلاف الأرواح التي دمرتها القوائم السوداء، فعلينا أن نقول لأي شخص في اليسار يريد تكميم الأفواه: “لا تلغ، فقط نظم”.
ستيفن بارفيت – أستاذ بجامعة لوبورو، وباحث متخصص في التاريخ الاجتماعي في بريطانيا والولايات المتحدة. أحدث مؤلفاته Knights Across the Atlantic: The Knights of Labor in Britain and Ireland
*هذه المادة مترجمة. يمكن مطالعة النص الأصلي باللغة الإنجليزية من هنا








