إن السياق التاريخي لإنتاج نص ابن تيمية يكشف لنا وبعمق عن دور البعد التاريخي والسياسي والاجتماعي في إنتاج هذا النص ،ويكشف عن أسباب عنفه، وحدة موقفه تجاه رفض الفلسفة في كتبه ،ونقد التصوف والتشيع .
ونتيجة لهذه الظروف التاريخية كان من الطبيعي أن يتجه ابن تيمية لحماية الأصول التاريخية والحضارية والدينية للمسلمين، فإن هذا الوضع التاريخي لم يهدد الواقع التاريخي الإسلامي فحسب، وإنما هدد تراثاً استمر ثمانية قرون، وكان فيه من التأسيس والفتوحات المعرفية والسياسية النصيب الأوفر، إن هذا الوضع اختزل ماضي المسلمين وحاضرهم ومستقبلهم في هجوم التتار، وحملة الصليبيين، فكان من الطبيعي أن يحتمى ابن تيمية بالأصول، وأن يحصن الهوية الإسلامية بالإلحاح على الرجوع إلى منابعها، ونقصد الكتاب والسنة، وكأن الخلاص لا يمكن أن يكون إلا من خلالهما ، ناهيك عن أن القرآن مشحون بعبارات الأمل، وبعث الرجاء، التي كانت مطلوبة وبإلحاح في هذا المناخ المشحون.

وبسبب محاربة ابن تيمية للمغول، ومشاهد مطامع الصليبيين في العالم الإسلامي صارت نظرته إلى الآخر الأجنبي على أنه مُهدد للوجود الإسلامي في كل أبعاده، وتم تعميم هذه النظرة النظرة السلبية حيث كان ينظر إلى كل ما هو وافد وأجنبي باعتباره مهدداً للحصون والثوابت الإسلامية بما في ذلك ما قد يكون مفيدا في شؤون الحياة الدنيا. وشعر ابن تيمية آنذاك أن عليه أن يوظف سلطته كعالم له حق توجيه العوام في الفكر والمعتقد ، لأن دور العلماء على جانب كبير من الأهمية ، فقد كانوا يستفتون في كل الأمور ، وفى كل الأوساط ليس في المسائل النظرية فقط، وإنما أيضاً في كل القضايا الحيوية، وكانت حكمتهم مسموعة، وكانوا يتمتعون بمهابة عظيمة، وكان الحكام يعهدون إليهم بالكثير من المهام السياسية، لا سيما المهام الدقيقة الصلبة ،وكان من النادر أن يرسل وفد إلى الفرنج أو إلى المغول، وليس معه فقيه أو أكثر، كما كانوا عنصراً من عناصر الاستقرار الاجتماعي، وكان يعول على وساطتهم أحياناً للحيلولة دون وقوع الاضطرابات “.
وفى ظل هذا الواقع المتردي بدا ابن تيمية وكأنه الفقيه الحالم الذى يسعى إلى العودة بالإسلام إلى بساطته الأولى بعيداً عن تعقيدات الفلسفة وعلم الكلام التي أسهمت في تحلل العقيدة من وجهة نظره ، وابتعادها عن الشحن الوجداني والعاطفي الذى يسهم في تغيير النفس الإنسانية إلى الأفضل ، ولا يمكن أن يحدث هذا إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة ، ومن ثم ” فإذا نَظر المنصف إلى ابن تيمية بعين العدل يراه واقفاً مع الكتاب والسنة لا يميل عنها قول أحد كائناً من كان ، ولا يخاف في ذلك أميراً ولا سلطاناً ولا سوطاً ولا سيفاً ، ولا يرجع عنها لقول أحد وهو متمسك بالعروة الوثقى، واليد الطولي ، وعامل بقوله: ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول ) سورة النساء “3 “.
وفى إطار هذه الظروف التاريخية الضاغطة عكف الشيخ تقى الدين في خطبه وكتاباته على مراجعة الإسلام التاريخي ، وما طرأ على الإسلام من البدع ، وهب لمناهضة البدع التي عملت على تحوير المعالم الأصلية للإسلام ، وتعديلها سواء كان ذلك في العقائد أم في الأحكام والعبادات، كما أبدى هذه الغيرة في مقاومة الآثار التي أحدثتها الفلسفة في الإسلام متجاهلا دورها المهم في تحرير العقل كما أمر القرآن ، وحتى الصيغ الكلامية الأشعرية على الرغم من أن السنة قد أقرتها منذ زمن طويل ، وكافح ابن تيمية الصوفية ومبادئها الحلولية ، كما استنكر تقديس النبي والأولياء ، و نهض ابن تيمية دون أن يوقفه شيء إلى مقاومة السلطات الدينية التي أضفت على المراسم الطفيلية الزائدة في العبادات صفة شرعية هي ثمرة الإجماع ، فقد كان يرجع في تحقيقها إلى السنة ، وإلى السنة وحدها.

وارتبط موقف ابن تيمية من الفلسفة بسياق موقفه العام المناهض لكل ما يخل بصورة الإسلام الأولى البسيطة كما تصورها هو ، وكل ما اعتقد أنه يُفقد الإسلام قوته الروحية ، فقد ” رأى ابن تيمية أهل البدع ، والضلالات ، والأهواء كالمتفلسفة ، والباطنية ، والملاحدة، والقائلين بوحدة الوجود، والدهرية ، والقدرية ، والنصيرية ، والجهمية والحلولية ، والمعطلة ، والمجسمة ، والمشبهة ، والراوندية ، والكلامية ، وغيرهم من أهل البدع قد تجاوزوا الضلال ، وبان له أن كثيراً منهم إنما قصد إبطال الشريعة المقدسة المحمدية الظاهرة العلية على كل دين ، وأن جمهورهم أوقع الناس في التشكيك في أصول دينهم ، ولهذا رأى ضرورة رفع شبههم وأباطيلهم ، وقطع حجتهم وأضاليلهم ، وأن يبذل جهده ليكشف رذائلهم ، ويزيف دلائلهم ذباً عن الملة الحنفية والسنة الصحيحة الجلية ” ويمكن أن نفهم رد ابن تيمية على الفلاسفة وعلماء الكلام والمتصوفة وغيرهم من أهل الفرق باعتبارهم تصرفوا في النص بحسب ما يمليه العقل والذوق ، وهنا تطرح إشكالية فعل التاريخي في النص المقدس ، وهو فعل يقلصه ابن تيمية لا رغبة في غلق أبواب الاجتهاد وحسب، وإنما رغبة في إعادة الاعتبار للمقدس.. هكذا تصور ابن تيمية الأمر في زمه وفي ظروفه.
لقد رأى ابن تيمية أن العقيدة والشريعة الإسلامية قد تحلل بعض عراها بسبب الفلسفة والتصوف والفرق ، وكان من نتائج ذلك أنه شعر بأن الشريعة في خطر أمام فلسفة وحدة الوجود لابن عربي التي رأى أنها تحالفت مع “الغلو في الزهد” كما تحالفت الباطنية مع التشيع المبالغ فيه لآل على. وبناء على هذه الطريقة في النظر استنتج ابن تيمية أن النتيجة في الحالتين واحدة ، إذ على حساب النبوة يتم تمجيد الولاية في الحالة الأولى ، وتمجيد الإمامة في الحالة الثانية ، ويترتب على تفوق الولي على النبي تلاشى الفرق بين طبيعة إلهام الحكيم وطبيعة الوحى المنزل على النبي، و أسست الفلسفة لذلك حين ساوت أيضاً بين الحكيم والفيلسوف ، وهو ما يصب في تمييع قضية المقدس ، ومسيرته في حركة التاريخ .
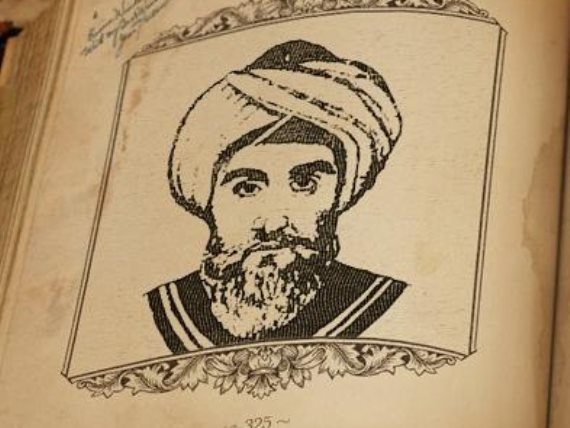
وكان ابن تيمية يهاجم أي نشاط للفلسفة ويواجه تلامذة نصير الدين الطوسي الذين يروجون للفلسفة والتشيع ، ويهاجم الفلسفة لأنها أثرت في تطور التصوف وعلم الكلام ، وكان في الشرق في تلك الفترة ” بعض علماء الكلام الذين وفدوا من الشرق يولون الأفكار الفلسفية عناية كبيرة أثناء مررهم بالقاهرة والشام، ومن أكبر علماء الإلهيات الضالعين في المذهب الأشعري في الفلسفة صفى الدين الهند الآرموى المولد بالهند (644هـ) وقد أقام بدمشق (695 هـ) حيث أخذ يلقن العلوم المختلفة ، وامتد أثر المنطق على القزوينى المتوفى (695 هـ) والذى ترك كتابه في المنطق ” .
و تصدى ابن تيمية بقلمه وسيفه لبعض الفرق والمذاهب الإسلامية ، وتيارات التصوف الحلولى ، وخاصة بعض الشيعة ، والنصيرية الذين ساندوا التتار في تلك الفترة التاريخية فضلاً عن مساندتهم التاريخية للمغول في احتلال بغداد، حيث ساعد الشيعة والنصيرية في الشام التتار ، “وكتب ابن تيمية إلى أطراف الشام في الحث على قتال المذكورين ، وجهز لغزوهم في جبل كسروان ، وكان توجه الشيخ ابن تيمية إلى الكسروانيين فى مستهل ذي الحجة من سنة (704 هـ) وصحبة الأمير قراقوش ومعهم نائب السلطان الأمير جمال الأفرم بمن تأخر من عسكر دمشق إليهم لغزوهم، واستئصالهم في ثاني شهر محرم من سنة (705 هـ)، وكان قد توجه قبله العسكر طائفة بعد طائفة، وفى يوم الخميس السابع عشر من صفر وصل النائب والعسكر إلى دمشق بعد أن نصرهم الله على حزب الضلال من الروافض والنصيرية ، وأصحاب العقائد الفاسدة، وأبادهم من تلك الأرض ” وكان ابن تيمية ينظر إلى الروافض على أنهم كفار مرتدون أكفر من اليهود والنصارى ، وأنهم ساندوا التتار على أهل القرآن والإيمان ، وكان يرى ” أن في هؤلاء خلقاً كثيراً لا يقرون بصلاة ، ولا صيام ، ولا حج ، ولا عمرة ، ولا يحرمون الميتة والدم ، ولحم الخنزير ، ولا يؤمنون بالجنة ، والنار من جنس الإسماعيلية ، والنصيرية ، والباطنية ، وهم لنا أكفر من اليهود والنصارى بإجماع المسلمين “ولا شك أن موقف ابن تيمية من وضعية الأقليات الشيعية والنصيرية في الشام جاء نتيجة وعيه بدور هذه الأقليات السلبى في ثلم عرى الإسلام ، وتحريف العقائد، كما أنهم يروجون إلى دعوات دينية وسياسية مقتبسة من القرامطة، وأتهمهم بأنهن انحازوا للتتار، وكانوا عوناً على التدخل الأجنبي في العالم الإسلامي ، ولذا لم يتوان ابن تيمية على محاربتهم بالسيف أولاً ، ثم دحض عقائدهم في معظم كتبه ، وبصفة خاصة كتابه : منهاج السنة. وعادة ما يحدث خلط لدى الكثير من المسلمين اليوم .. هل حارب ابن تيمية أصحاب هذه الفرق والمذاهب بسبب الاختلاف الفكري أم بسبب تباين مواقفهم من التدخل الأجنبي من التتار ؟
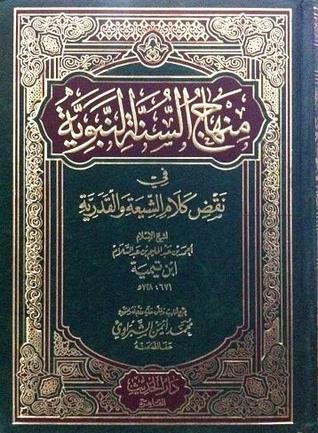
ورغم تغير الظروف التاريخية الآن إلا أن نصوص ابن تيمية في مهاجمة الشيعة ، وتكفيرهم مازالت فاعلة في حياتنا حتى الآن ، وأن موقف ابن تيمية الحاد من الشيعة مازال هو المُشكل لوعى التيار السلفي تجاه مذهب إسلامي كبير يدين له قطاع كبير من المسلمين في أرجاء العالم فقطاع كبير من التيار السلفي مازال ينظر إلى الشيعة اليوم أنهم أشد كفراً من اليهود والنصارى .
وفى عصر ابن تيمية انتشر التصوف الحلولى ، انتشرت الطرق الصوفية أمثال الطريقة الشاذلية نسبة إلى أبو الحسن الشاذلي (ت 686 هـ ) والأحمدية نسبة إلى البدوي (ت 676 هـ ) وغيرها من الطرق الصوفية ، وعاش في عصره ابن عطاء الله السكندري ( ت 709 ) وكان من أبرز خصوم ابن تيمية، وقد حمل ابن تيمية على الطرق الصوفية، والتصوف الاتحادي حيث” مارست الصوفية على اختلاف أشكال تطرفها نشاطاً هو بمثابة معول هدم للمذهب السنى ، وتسللت إلى الإسلام عن طريقها مؤثرات مسيحية ، وتحول الدين عن حقيقته الاجتماعية ، وأصبح المثل الأعلى في نظر المؤمن هو الانقطاع عن الدنيا لعبادة الله عبادة وتأمل ، وبالتدريج تحولت الحركة السنية المجاهدة إلى سنية هادئة متمسكة بالطقوس ، وبعد أن كان الجهاد في الأصل أعظم الأعمال الشرعية أصبحت أفضل الأعمال هي هروب الفرد من المجتمع، وممارسته للتوبة والندم عن طريق الصلاة والصوم والخلوة “وقد تبع انتشار الطرق الصوفية في تلك الفترة التاريخية تقديس الأولياء .
ومما سبق نلاحظ أن موقف ابن تيمية الحاد من الفلسفة وغيرها من أنماط التفكير المغايرة للنمط السلفي الذى كان يبغيه كان موقفاً حاداً ، لأنه كان يسعى أن يعود بالعقيدة إلى بساطتها الأولى حتى يستطيع أن يجمع شمل المسلمين ، ويُعيد إحياء السنة – من جديد- التي تم تغييرها وتحريفها على يد المتصوفة والمتكلمين ، وأصبح هذا الحلم الخاص بابن تيمية مستحيل التحقيق بسبب تنوع مسارات الوحى في التاريخ ، وبسبب اختلاف المسلمين فرقاً ومذاهب في نظرتهم للكتاب والسنة .
وإذا كان ابن تيمية يتسم بالحدة والقطعية في موقفه من الفلسفة اليونانية وأتباعها في العالم الإسلامي في نصوصه وكتاباته فإن وضع نص ابن تيمية وسلوكه ضد هذه المذاهب الفلسفية والكلامية في سياق الواقع التاريخي ، نجد أن التاريخ بأحداثه ووقائعه يعطى مبرراً كافياً لحدة ابن تيمية ، وأن حالة تحلل العقيدة ، وتحلل واقع المسلمين ، وتفرقهم تاريخياً يعطى مبرراً تاريخياً لموقف ابن تيمية ، ومن ثم فإن محاكمة ابن تيمية للفلسفة والتصوف تظل منقوصة إن لم نرها في بعدها التاريخي الذى يفسر لنا الاسباب التاريخية والاجتماعية لتلك المحاكمة.










