مقدمة:
مما لاشك فيه أن مصطلح القداسة بوجه عام و في الإسلام بوجه خاص من المصطلحات المهمة والخطيرة في نفس الوقت. لأنه مصطلح أثار الكثير من الجدل، وألقى بظلاله في جميع العصور، وأثارالعديد من المشكلات و خاصة ما يتعلق بالحكم. ولعل السؤال المحوري في تلك القضية الشائكة هو هل القداسة في الإسلام أي العصمة من الخطأ يمكن أن ننسبها إلى شخص معين أو أماكن معينة أو أزمنة محددة؟ والإجابة بكل وضوح لا يحتمل الشك أن القداسة في الإسلام لله وحده الملك القدوس،الله وحده هو الذي ينفرد بتلك الصفة و تلك العصمة من الخطأ.
وما عدا ذلك هو إضفاء للأهواء الذاتية والأحكام الشخصية المتسرعة على القضايا و الأمور. وبنظرة فاحصة وثاقبة إلى الإسلام نجده يرفض التجسيد في الأشياء و الأشخاص، كما أنه بالمثل يرفض التحديد في الأزمنة و الأمكنة. ما نفهمه و نعرفه عن الإسلام كدين أنه يرسخ مجموعة من المبادئ و القيم ،عندما توجد وتطبق على أرض الواقع فإن الإسلام يوجد معها،وإذا ما غابت غاب معها الإسلام. ما نعرفه عن الإسلام أنه يرفض بشكل قاطع و حاسم أن يكون هناك جنس أوسلالة أو قبيلة أو فرد ينفرد بالإسلام وحده، ويدعي القداسة وحده. وإذا ما تأملنا بتروي القرآن الكريم نجد أن القداسة و العصمة لله وحده لا شريك له،ومحاولة إضفاء تلك الصفة على أحد من البشر فأنه سيكون فيه شبهة شرك بالله. أما إضفاءها على مكان بعينه فهو الوثنية بذاتها.
لأننا نعرف ونعلم تمام العلم أن الإسلام جاء من أجل القضاء على كل أنواع الوثنيات و الشرك. ولعلنا نشير هنا في هذا السياق أن التجريد لقيم الإسلام و مبادئه هو من السمات الجوهرية و الأصيلة في الإسلام. وأي محاولة للإخلال بهذا التجريد و إضفاء التجسيد هو ابتداع في الدين و مبادئه. ولنا في شخصية النبي صل الله عليه و سلم الأسوة والقدوة الصالحة، فالنبي بشر، هو بشر رسول، وصفه القرآن بأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي. فالعصمة هنا ليست مطلقة تمام الإطلاق بل مرتبطة بالوحي الإلهي و محاطة بحدود الرسالة. وفي سياق الحرص على التجريد و ليس التشخيص و التجسيد يسوق لنا القصص القرآني حوارًا بين نبي الله إبراهيم و بين الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة(الآية 134) (إني جاعلك للناس إماما) فيعقب إبراهيم ومن ذريتي الإجابة بحزم من الله لا ينال عهدي الظالمين .هنا يتم وضع القضية في سياق آخر هو العدل أي تجريد وليس تشخيص.

القداسة في مسيرة التاريخ الإسلامي:
لعلنا هنا نؤكد على حقيقة مهمة و هي أن فكرة ربط الأشخاص بالدين في اللقب وغيره ،لم تظهر إلا في عصور الضعف و الانحطاط. أما في عصور القوة و الازدهار للأمة فلم يكن هذا موجودا على الإطلاق. ونستقرئ التاريخ الإسلامي هنا لنرى تلك الحقيقة ناصعة ساطعة بلا غيوم، يرفض أبو بكرالصديق لقب (خليفة الله) وأصر أن يكون لقبه خليفة رسول الله، وجاء من بعده عمر الذي في عهده تم وضع التقويم الإسلامي، وربط التقويم بحادثة الهجرة ، وليس بتاريخ ميلاد رسول الله صل الله عليه و سلم رغم أهميته في نفوس المسلمين ومكانته. وهنا نرى عظمة فهم و إدراك عمر في عدم ربط التقويم بميلاد الرسول، وربطه بالهجرة فهو تأكيد لقيمة الاعتزاز بالهجرة كحركة لكل المسلمين وللإسلام، وليس بشخص حتى لو كان رسول الله.
هنا التزام بمنطق التجريد و ليس التشخيص. فالتجسيد و التشخيص فكرة غربية بعيدة تماما عن الإسلام و منهجه في التجريد و الارتقاء بالمبادئ والقيم بعيدا عن الأشخاص و الأزمان و الأماكن. في الغرب المسيحي يتدرج التجسيد حتى يصل إلى تنصيب شخص له قداسته مثل البابا أو البطريرك، ومكان له قداسته مثل الفاتيكان والكنيسة. ولعلنا نعود قليلا إلى الوراء و نرى أن ربط كلمة الدين في التاريخ الإسلامي بأشخاص حدث في أواخر العصر العباسي الأول، وهوالعصر الذي تقلص فيه النفوذ العربي و تزايد تأثير الأعاجم المسلمين، فضلا عن التدهور السياسي والفكري الذي شهدته تلك المرحلة و الذي وصل إلى ذروة الانحطاط و الضعف في العصر العباسي الثاني.
ويذكر محمد كردي علي في كتابه (الإسلام والحضارة الغربية) أن أول من لقب بالدين في الإسلام هو بهاء الدين بن بويه ركن الدين. وبعد ذلك سرت وانتشرت تلك الألقاب إلى العامة والخاصة من الناس. ومن هنا فإنه منذ تلك العصور، تسرب التجسيد في شكل جديد إلى الواقع الإسلامي، وبتأثيرات العجم الذين لم يكونوا قد تخلصوا تماما من أثار الوثنية والكسروية القديمة.
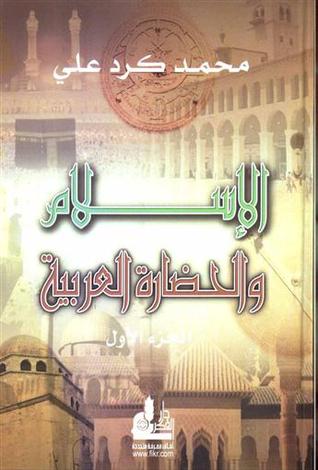
وظهرت في قاموس أوصاف الزعماء والقادة خصوصا في مناطق خراسان و الهند وماوراء النهر، ألقاب مثل تاج الملة، وفخر الدولة ،وضياء الملك، وبهاء الدولة. وبعد ذلك عرفت في المناطق الفارسية، وعند العثمانيين ألقاب أخرى مثل بادشاه الإسلام، وشيخ الإسلام و مفتي الإسلام إلى آخر الألقاب التي لم يعرفها الإسلام ولا العرب. وفي العصر العثماني انتشرت تلك الألقاب في المؤسسات الدينية، وأصبح العلماء والفقهاء موظفين عند السلطان، يتقاضون رواتب شهرية من أجل الإفتاء لصالح السلطة وتزيين أعمال الحكام. و بهذه الخطوة قطعت رحلة تجسيد الإسلام شوطا في عكس الاتجاه الذي يمليه الدين و تعاليمه الأساسية. من هنا فإن إسقاط القداسة و العصمة عن الأشخاص أولى به في منطق الإسلام .
القداسة والقرآن:
عندما نتأمل منطق القرآن في حديثه عن القداسة نجد أنه رفض رفضا تاما أن ترتبط القداسة بالأشخاص أو الأماكن أو الأزمان. فالقداسة لم تطلق على الأماكن بصورة مطلقة بل مقيدة . عندما أشار القرآن إلى حديث موسى لربه و كلامه معه في الوادي المقدس . و أشار إلى صفة القداسة وارتباطها بالوادي .
وأيضا قرن القداسة والمقدس بالأرض المقدسة، عندما دعا موسى قومه إلى دخول الأرض المقدسة أي الشام في التفسير.
نرى أن القداسة في الموضعين لم تكن مطلقة، ولكنها ارتبطت بعلة معينة موقوتة بظروف معينة، فقداسة الوادي استمرت لأنه المكان الذي جرى عليه كلام الله إلى موسى. وقداسة الأرض في الحالة الثانية استمرت حل كونها تطهرت من الوثنية لما بعث الله فيها الأنبياء. في غيرهذين الموضعين، وخارج السياق التاريخي فإن القرآن لم يذكر القداسة مرتبطة بمكان على الإطلاق. وكل إشاراته بعد ذلك إلى خصوصية وتميز أماكن أو أشياء بذاتها استخدمت مشتقات لفظ الحرمة، مثل الشهر الحرام و البيت الحرام والمسجد الحرام .

صفوة القول القداسة في الإسلام غير مرتبطة بأشخاص أو أزمنة معينة أو أمكنة معينة بصورة الإطلاق بل القداسة نسبية و بشروط معينة. والقداسة في الإسلام مرتبطة بالله فقط فهوالقدوس، هو الذي يملك العصمة من الزلل والخطأ، وغيره لا يملك تلك العصمة. وإذا كان الله كرم الإنسان على سائر المخلوقات بالعقل وسخرله كل ما في الكون، فليس له أن يدعي القداسة لأن تلك القداسة نسبية ومعلقة على شرط هو الإيمان بالله و العمل الصالح.













