عرض وترجمة: أحمد بركات
في 6 أكتوبر 1981، تم اغنيال الرئيس السادات أثناء متابعته عرضا عسكريا في ذكرى عبور قناة السويس في المرحلة الافتتاحية من حرب أكتوبر 1973، فيما يمثل أعظم إنجاز عسكري حققته مصر في العصر الحديث. وطالما كان ثم اعتقاد بأن خالد الإسلامبولي، الضابط بالجيش المصري برتبة ملازم آنذاك، هو من نفذ عملية الاغتيال، لكن الرصاصة القاتلة صدرت على الأرجح من بندقية الرقيب حسين عباس محمد، إلى عنق الرئيس المصري من فوق شاحنة مسطحة.
دفعني انتشار 25 ألف جندي من الحرس الوطني الأميركي في شوارع واشنطن لتأمين حفل تنصيب الرئيس جو بايدن إلى التفكير فيما حدث في مصر قبل ما يقرب من 40 عاما. وانتابني شعور بالقلق من أن واشنطن على الأرجح لم تستوعب درس التاريخ، شأنها في ذلك شأن أغلب بلدان الشرق الأوسط.
على الجانب الآخر، أثبت المتمردون في أحداث الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير أنهم استفادوا من خبرات نظرائهم في الشرق الأوسط، والتي تتلخص في أنه إذا أراد المرء الإطاحة بحكومة، فإن جزءا مهما من استراتيجيته يجب أن يتمثل في اختراق الأجهزة الأمنية والجيش.
فهؤلاء في نهاية المطاف هم من يملكون السلاح ويستطيعون استخدامه. ومن ثم، كان الإسلامبولي ومحمد، ومعهما عطا حميدة رحيم، ضابط مهندس احتياط، هم الفريق ’المثالي‘ لتنفيذ عملية الاغتيال ضد الرئيس السادات. وبرغم أن بعض العناصر المهمة في الجهادية العابرة للحدود ما زالوا غير معروفين لمحللي الإرهاب، إلا أن بعضهم يمتلك خلفيات عسكرية. هؤلاء الضباط السابقون في الجيش والشرطة جعلوا أسامة بن لادن وأبوبكر البغدادي، وأيمن الظواهري وغيرهم من القادة المتطرفين الذين لا يمتلكون أي خبرات سابقة في القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أكثر دموية.
إن قدرة أفراد الأمن على تفعيل الفتنة هي السبب الذي يجعل التقارير التي تشير إلى مشاركة قدامى المحاربين وضباط الشرطة وحتى بعض ألعسكريين الحاليين في أحداث مبنى الكابيتول في 6 يناير أمرا مثيرا للقلق.

توجد الآن حركة سياسية في الولايات المتحدة تنخرط في محاولة للإطاحة بالنظام الدستوري. ومن بين مئات الآلاف من هؤلاء المستعدين للانقضاض واستخدام القوة ضد الحكومة أعضاء في قوة إنفاذ القانون والقوات المسلحة.
ليس من قبيل التهويل أن نشير إلى أن الولايات المتحدة تواجه اليوم تهديدا يفوق ما واجهته إبان أحداث 11 سبتمبر أو ميناء اللؤلؤ، عندما كان الأمر يتعلق بهجمات من الخارج. فالأمريكيون اليوم يجدون أنفسهم أمام واقع جديد ومخيف يضع شرعيتهم السياسية على المحك من خلال وسائل عنيفة ومنسقة من الداخل.
غالبا ما يشير المحللون الغربيون إلى ما يفعله القادة في الشرق الأوسط ومناطق أخرى من العالم لضمان تأمين أنظمتهم السياسية على أنه “أمن النظام”. على المستوى التجريدي، كانت الولايات المتحدة مهملة في هذا المجال – برغم التحذيرات الكثيرة – مقارنة بشركائها في الشرق الأوسط.
على سبيل المثال، نشر الصحافي التركي، محمد علي بيراند كتابا في عام 1991 بعنوان Shirts of Steel: Anatomy of the Turkish Officer Corps (قمصان من حديد: تشريح فيلق الضباط التركي)، قدم من خلاله رؤية غير مسبوقة لكيفية تدقيق القوات المسلحة التركية المرشحين للتدريبات العسكرية، ثم تلقينهم الطرق العلمانية الكمالية.
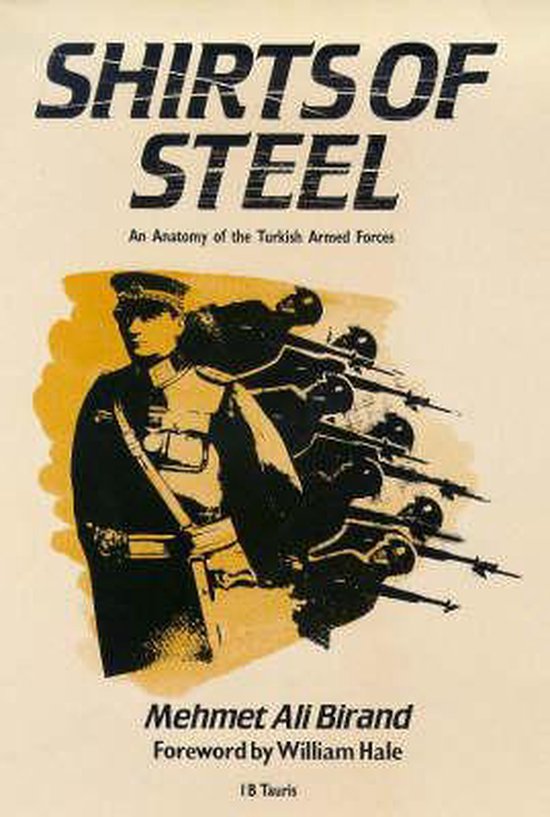
وأفاد بيراند بأنه قبل التحاق المرشحين بأكاديميات الخدمة والمدارس الثانوية، يشرع الجيش في فحص عائلاتهم، بحثا عن أي دلائل على “الرجعية” – أي “الإسلاموية”، أو الانفصالية، أو، بعبارة أخرى، القومية الكردية. ثم – بحسب بيراند – هناك أيضا المراقبة المستمرة للضباط والجنود لضمان دعم الجيش للكمالية كمصدر للسلطة والهيبة والشرعية في النظام السياسي التركي.
لا يعني هذا أن الولايات المتحدة بحاجة إلى اقتفاء أثر تركيا في هذا الصدد، وإنما التفكير فقط في أن الولايات المتحدة ليست حالة مختلفة عن سائر دول العالم كما يعتقد الأمريكيون.
لم يكن أحد يفكر مجرد تفكير في أن الفتنة والتمرد قابلتان للحدوثفي الولايات المتحدة، فهي، في نهاية المطاف، مدينة مشرقة فوق قمة تل، واستثناء لا يمكن أن يطاله هذا النوع من المشكلات. حسنا، لكن هذا هو ما وصلنا إليه بعد سنوات من ظهور نذر التحذير في الأفق الأمريكي. وكما أشار تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالية “لقد أظهر قادة وجماعات العنصرية البيضاء اهتماما باختراق قوات إنفاذ القانون، أو تجنيد عناصرهم”. كان ذلك في عام 2006.
واليوم، أجبرت أحداث الكابيتول في 6 يناير الأمريكيين على الاعتراف بضرورة توافر ما يمكن تسميته بـ ’الجودة المزدوجة‘ في عناصر قوات الشرطة والجيش في بلدهم. فهؤلاء الذين يسيطرون على وسائل العنف يجب أن يكونوا أقوياء وآمنين من الاختراق، حتى يتمكنوا من حماية النظام الدستوري، لكن ليس أقوياء إلى درجة تجعلهم وراء حدود السيطرة المدنية.
إن المشكلة في الولايات المتحدة بسيطة وبديهية: مثيرو الفتنة والمحرضون موجودون داخل الصف، وعندما يتعلق الأمر بقوات إنفاذ القانون يصبحون بعيدا عن قبضة السيطرة المدنية الفعالة.

السؤال الذي يطرح نفسه بقوة الآن يدور حول ما يجب عمله حيال ذلك. وغني عن البيان أن الولايات المتحدة لا يمكنها أبدا، ولا ينبغي لها على الإطلاق، أن تقوم بهذا النوع من التلقين والمراقبة التي تنتهجها السلطات في بعض الدول الشرق أوسطية لدرء الفتنة.
رغم ذلك، ليس من الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة يمكن أن تتحمل عبء التحقيق في اختراق النازيين الجدد والعنصريين البيض والمؤمنين بنظرية كيو أنون لقوات الأمن، بالنظر إلى الكيفية التي جعلت بها حقبة ترمب هذه المجموعات ذات أهمية وتأثير سياسي.
على أقل تقدير، يعد قرار وزارة الدفاع الأمريكية بفحص أفراد الحرس الوطني الذين ذهبوا إلى واشنطن أثناء التنصيب أعترافا بوجود هذه المشكلة داخل القوات المسلحة. ومن ثم، فإن اتباع سياسات وكتابة قواعد جديدة تمنح الجيش وقوة إنفاذ القانون وسائل تفيد في تحديد المتمردين واستئصالهم من الصف يجب أن يمثل الأولوية الأولى لوزير الدفاع الجديد وللنائب العام.
صحيح أن الحفاظ على الروح الكمالية داخل الصفوف في تركيا كان يعني الحفاظ على نظام سياسي غير ديمقراطي، إلا أن هذه الحقيقة يجب ألا تصرف الأمريكيين عما يفهمه المتمردون أفضل من غيرهم، وهو أن النظام السياسي يظل ضعيفا ما دامت قوات الأمن عرضة للتأثر بالأفكار والأفعال المثيرة للفتنة.
وأخيرا، فإن مصير النظام الديمقراطي في الولايات المتحدة وأمن وسلامة الشعب الأمريكي يعتمدان، في نهاية المطاف، على الوعي بحقيقة أن الولايات المتحدة ليست استثناء بحال من الأحوال.
_______________
ستيفن كوك – كبير زملاء معهد “إيني إنريكو ماتي لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا”، التابع لـ “مجلس العلاقات الخارجية”.
*هذه المادة مترجمة (باختصار). يمكن مطالعة النص الأصلي باللغة الإنجليزية من هنا













