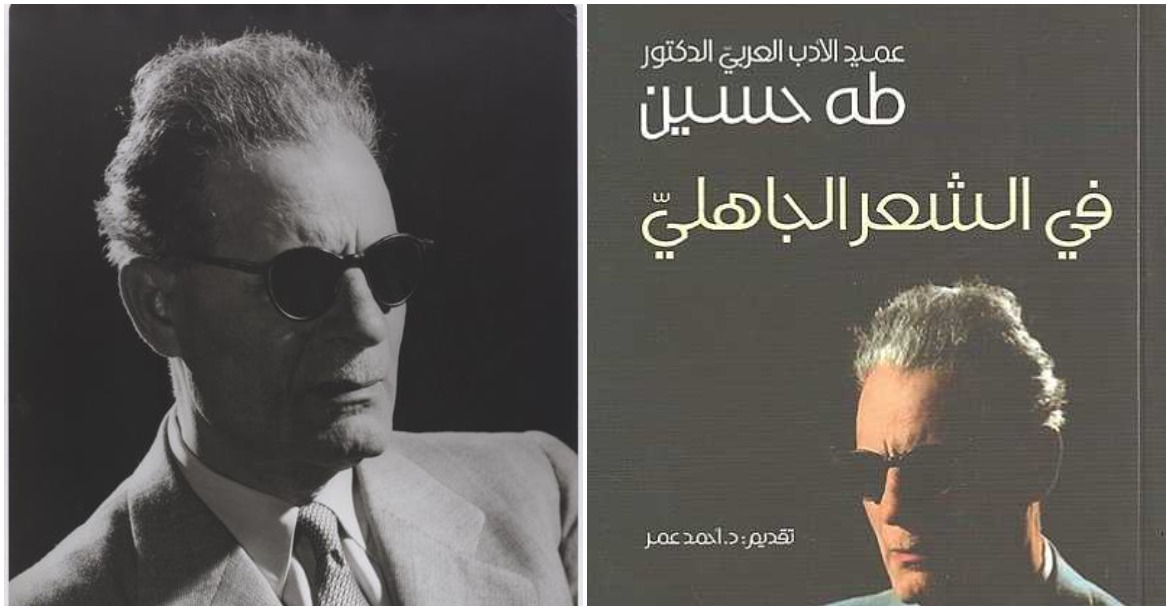إذا كنت ستبحث في هذه الوثيقة عن دليل “إدانة” للدكتور طه حسين، أو عن دليل”براءة” له، فأنت ـ والحال كذلك ـ تكون قد انعطفت بعيدا عن المغزى الذي حملنا على أن نعرض نص هذه التحقيقات التي أجراها محمد بك نور في 19 /10/ 1926رئيس نيابة مصر الجديدة مع طه حسين بشأن كتابه في “الشعر الجاهلي”، وأغلقت النيابة ملفها في 30/3/ 1927.
الوثيقة في فحواها ومعناها الحقيقي، تحفة فكرية وجمالية من المفترض أن تدرس لطلاب النقد الأدبي في كليات الآداب وكذلك لطلاب كليات الحقوق، إذ جميع رئيس نيابة مصر الجديدة ـ آنذاك ـ محمد بك نور، بين الحسنيين: الناقد الأدبي والباحث العلمي المدقق من جهة، والتجرد من الهوى والحياد المحض تنقيبا عن العدالة.. العدالة وحسب من جهة أخرى. إنها درة من درر القضاء المصري، دست أدراج النسيان بمضي الوقت وخفوت وهج أزمة “الشعر الجاهلي” بالتدرج، ولا أدري كيف أصاب هذه الوثيقة ما أصابها من الإحالة إلى أرفف الأرشيف، ولم يلتفت إلى قيمتها وقامتها الباحثون الجادون، ولعل حالها يفتح بابا عساه لا يغلق في وجه التفتيش عن “درر” أخرى، قد لا نعرف عنها شيئا، في ظل انشغالنا بما لا طائل من ورائه.. والآن إلى الوثيقة:
[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]
نحن محمد نور رئيس نيابة مصر
” من حيث إنه بتاريخ 30 مايو سنة 1926 تقدم بلاغ من الشيخ خليل حسنين الطالب بالقسم العالي بالأزهر لسعادة النائب العمومي يتهم فيه الدكتور طه حسين الأستاذ بالجامعة المصرية بأنه ألف كتابا أسماه “في الشعر الجاهلي” ، ونشره علي الجمهور وفي هذا الكتاب طعن صريح في القرآن العظيم حيث نسب الخرافة والكذب لهذا الكتاب السماوي الكريم إلي آخر ما ذكره في بلاغه.
وبتاريخ 5 يونيو سنة 1926 أرسل فضيلة شيخ الأزهر لسعادة النائب العمومي خطابا يبلغ به تقريرا رفعه علماء الجامع الأزهر عن كتاب ألفه طه حسين المدرس بالجامعة المصرية أسماه “في الشعر الجاهلي” كذب فيه القرآن صراحة ، وطعن فيه علي النبي صلي الله عليه وسلم وعلي نسبه الشريف وأهاج بذلك ثائرة المتدينين وأتي فيه بما يخل بالنظم العامة ويدعو الناس للفوضي ، وطلب اتخاذ الوسائل القانونية الفعالة الناجعة ضد هذا الطعن علي دين الدولة الرسمي وتقديمه للمحاكمة وقد أرفق بهذا البلاغ صورة من تقرير أصحاب الفضيلة العلماء الذي أشار إليه في كتابه . وبتاريخ 14 سبتمبر سنة 1926 تقدم إلينا بلاغ آخر من حضرة “عبد الحميد البنان” أفندي عضو مجلس النواب ذكر فيه أن الأستاذ طه حسين المدرس بالجامعة المصرية نشر ووزع وعرض للبيع في المحافل والمحلات العمومية كتابا أسماه ” في الشعر الجاهلي” طعن وتعدي فيه علي الدين الإسلامي – وهو دين الدولة – بعبارات صريحة واردة في كتابه سنبينه في التحقيقات.

وحيث إنه نظرا لتغيب الدكتور طه حسين خارج القطر المصري قد أرجأنا التحقيق إلي ما بعد عودته فلما عاد بدأنا التحقيق بتاريخ 19 أكتوبر سنة 1926 فأخذنا أقوال المبلغين جملة بالكيفية المذكورة بمحضر التحقيق ثم استجوبنا المؤلف وبعد ذلك أخذنا في دراسة الموضوع بقدر ما سمحت لنا الحالة.
وحيث إنه اتضح من أقوال المبلغين أنهم ينسبون للمؤلف أنه طعن علي الدين الإسلامي في مواضع أربعة من كتابه:
الأول : أن المؤلف أهان الدين الإسلامي بتكذيب القرآن في إخباره عن إبراهيم وإسماعيل حيث ذكر في ص 26 من كتابه “للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل ، وللقرآن أن يحدثنا عنهما أيضا ، ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي فضلا عن إثبات هذه القصة التي تحدثنا بهجرة إسماعيل بن إبراهيم إلي مكة ونشأة العرب المستعربة فيها ونحن مضطرون إلي أن نري في هذه القصة نوعا من الحيلة في إثبات الصلة بين اليهود والعرب من جهة وبين الإسلام واليهود والقرآن والتوراة من جهة أخري إلي آخر ما جاء في هذا الصدد.
الثاني: ما تعرض له المؤلف في شأن القراءات السبع المجمع عليها والثابتة لدي المسلمين جميعا وأنه في كلامه عنها يزعم عدم إنزالها من عند الله ، وأن هذه القراءات إنما قرأتها العرب حسب ما استطاعت لا كما أوحي الله بها إلي نبيه مع أن معاشر المسلمين يعتقدون أن كل هذه القراءات مروية عن الله تعالي علي لسان النبي صلي الله عليه وسلم .
الثالث : ينسبون للمؤلف أنه طعن في كتابه علي النبي صلي الله عليه وسلم طعنا فاحشا من حيث نسبه فقال في ص72 من كتابه :” ونوع آخر من تأثير الدين في انتحال الشعر وإضافته إلي الجاهليين وهو ما يتصل بتعظيم شأن النبي من ناحية أسرته ونسبه إلي قريش ، فلأمر ما اقتنع الناس بأن النبي يجب أن يكون صفوة بني هاشم وأن يكون بنو هاشم صفوة بني عبد مناف وأن يكون بنو عبد مناف صفوة بني قصى وأن تكون قصي صفوة قريش وقريش صفوة مضر ومضر صفوة عدنان وعدنان صفوة العرب والعرب صفوة الإنسانية كلها”. وقالوا إن تعدي المؤلف بالتعريض بنسب النبي صلي الله عليه وسلم والتحقير من قدره تعدّ علي الدين وجرم عظيم يسيء إلي المسلمين والإسلام فهو قد اجترأ علي أمر لم يسبقه إليه كافر ولا مشرك.
الرابع : أن الأستاذ المؤلف أنكر أن للإسلام أولية في بلاد العرب وأنه دين إبراهيم إذ يقول في ص80 :” أما المسلمون فقد أرادوا أن يثبتوا أن للإسلام أولية في بلاد العرب كانت قبل أن يبعث النبي وأن خلاصة الدين الإسلامي وصفوته هي خلاصة الدين الحق الذي أوحاه الله إلي الأنبياء من قبل” إلي أن قال في ص 81 “وشاعت في العرب أثناء ظهور الإسلام وبعده فكرة أن الإسلام يجدد دين إبراهيم ومن هنا أخذوا يعتقدون أن دين إبراهيم هذا قد كان دين العرب في عصر من العصور ثم أعرضت عنه لما أضلها به المضلون وانصرفت إلي عبادة الأوثان”… إلي آخر ما ذكره في هذا الموضوع.
ومن حيث إن العبارات التي يقول المبلغون إن فيها طعنا علي الدين الإسلامي إنما جاءت في كتاب في سياق الكلام علي موضوعات كلها متعلقة بالغرض الذي ألف من أجله ، فلأجل الفصل في هذه الشكوى لا يجوز انتزاع تلك العبارات من موضعها والنظر إليها منفصلة ، وإنما الواجب توصلا إلي تقديرها تقديرا صحيحا بحثها حيث هي في موضوعها من الكتاب ومناقشتها في السياق الذي وردت فيه وبذلك يمكن الوقوف علي قصد المؤلف منها وتقدير مسئوليته تقديرا صحيحا.
عن الأمر الأول
من حيث إنه ما يلفت النظر ويستحق البحث في كتاب “في الشعر الجاهلي” من حيث علاقته بموضوع هذه الشكوى ، إنما هو ما تناوله المؤلف بالبحث في الفصل الرابع تحت عنوان “الشعر الجاهلي واللغة” من ص24 إلي ص30.
ومن حيث إن المؤلف بعد أن تكلم في الفصل الثالث من كتابه علي أن الشعر المقال بأنه جاهلي لا يمثل الحياة الدينية والعقلية للعرب الجاهليين وأراد في الفصل الرابع أن يقدم أبلغ ما لديه من الأدلة علي عدم التسليم بصحة الكثرة المطلقة من الشعر فقال إن هذا الشعر بعيد كل البعد عن أن يمثل اللغة العربية في العصر الذي يزعم الرواة أنه قيل فيه.
وحيث إن المؤلف أراد أن يدلل علي صحة هذه النظرية فرأى بحق من الواجب عليه أن يبدأ بتعرف اللغة الجاهلية فقال: “ولنجتهد في تعرف اللغة الجاهلية هذه, ما هي أو ماذا كانت في العصر الذي يزعم الرواة أن شعرهم الجاهلي هذا قد قيل فيه ” قد أخذ في بحث هذا الأمر فقال إن الرأي الذي اتفق عليه الرواة أو كادوا يتفقون عليه، هو أن العرب ينقسمون إلي قسمين؛ قحطانية منازلهم الأولي في اليمن ، وعدنانية منازلهم الأولي في الحجاز ، وهم متفقون علي أن القحطانية عرب منذ خلقهم الله فطروا علي العربية فهم العاربة ، وعلي أن العدنانية قد اكتسبوا العربية اكتسابا، كانوا يتكلمون لغة أخرى هي العبرانية أو الكلدانية ، ثم تعلموا لغة العرب العاربة فمحت لغتهم الأولي من صدورهم وثبتت فيها هذه اللغة الثانية المستعارة وهم متفقون علي أن هذه العدنانية المستعربة إنما يتصل نسبها بإسماعيل ابن إبراهيم ، وهم يرون حديثا يتخذونه أساسا لكل هذه النظرية خلاصته أن أول من تكلم العربية ونسي لغة أبيه هو إسماعيل ابن إبراهيم وبعد أن فرغ من تقرير ما اتفق عليه الرواة في هذه النقطة قال : إن الرواة يتفقون أيضا علي شيء آخر ، وهو أن هناك خلافا قويا بين لغة حمير وبين لغة عدنان مستندا إلي ما روي عن أبي عمرو بن العلاء من أنه كان يقول :” ما لسان حمير بلساننا ولا لغتهم بلغتنا، ” وعلي أن البحث الحديث قد أثبت خلافا جوهريا بين اللغة التي كان يصطنعها الناس في جنوب البلاد العربية واللغة التي كانوا يصطنعوها في شمال هذه البلاد وأشار إلي وجود نقوش ونصوص تثبت هذا الخلاف في اللفظ وفي قواعد النحو والتصريف بعد ذلك حاول المؤلف حل هذه المسألة بسؤال إنكاري فقال:”إذا كان أبناء إسماعيل قد تعلموا العربية من العرب العاربة فكيف بعد ما بين اللغتين لغة العرب العاربة ولغة العرب المستعربة، ثم قال إنه واضح جدا لمن له إلمام بالبحث التاريخي عامة ويدرس الأقاصيص والأساطير خاصة أن هذه النظرية متكلفة مصطنعة في عصور متأخرة دعت إليها حاجة دينية أو اقتصادية أو سياسية.
ثم قال بعد ذلك :” للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل وللقرآن أن يحدثنا أيضا عنهما ، ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي فضلا عن إثبات هذه القصة التي تحدث بهجرة إسماعيل ابن إبراهيم إلي مكة ونشأة العرب المستعربة فيها ، وظاهر من إيراد المؤلف هذه العبارة أن يعطي دليله شيئا من القوة بطريقة التشكك في وجود إبراهيم وإسماعيل التاريخي وهو يرمي بهذا القول إنه مادام إسماعيل وهو الأصل في نظرية العرب العاربة والعرب المستعربة مشكوكا في وجوده التاريخي فمن باب أولى ما ترتب علي وجوده مما يرونه الرواة . أراد المؤلف أن يوهم بأن لرأيه أساسا فقال :”ونحن مضطرون إلي أن نرى في هذه القصة نوعا من الحيلة في إثبات الصلة بين اليهود والعرب من جهة أخرى “. ثم أخذ يبسط الأسباب التي يظن أنها تبرر هذه الحيلة إلي أن قال :”أمر هذه القصة إذن واضح فهي حديثة العهد ظهرت قبيل الإسلام واستغلها الإسلام بسبب ديني وسياسي أيضا ، وإذن فيستطيع التاريخ الأدبي واللغوي ألا يحفل بها عندما يريد أن يتعرف أصل اللغة الفصحى ، وإذن فنستطيع أن نقول إن الصلة بين اللغة العربية الفصحى التي كانت تتكلمها العدنانية واللغة التي كانت تتكلمها القحطانية في اليمن إنما هي كالصلة بين اللغة العربية وأي لغة أخرى من اللغات السامية المعروفة ، وأن قصة العاربة والمستعربة وتعلم إسماعيل العربية من جرهم كل ذلك أحاديث أساطير لا خطر له ولا غناء فيه… وهنا يجب أن نلاحظ علي الدكتور المؤلف الكتاب”1” أنه خرج من بحثه هذا عاجزا كل العجز عن أن يصل إلي غرضه الذي عقد هذا الفصل من أجله ، وبيان ذلك أنه وضع في أول الفصل سؤالا وحاول الإجابة عليه ، وجواب هذا السؤال في الواقع هو الأساس الذي يجب أن يرتكز عليه في التدليل علي صحة رأيه هو يريد أن يدلل علي أن الشعر الجاهلي بعيد كل البعد عن أن يمثل اللغة العربية في العصر الذي يزعم الرواة أنه قيل فيه ، و بديهي أنه للوصول إلي هذا الغرض يتعين علي الباحث تحضير ثلاثة أمور:
- الشعر الذي يريد أن يبرهن علي أنه منسوب بغير حق للجاهلية.
- الوقت الذي يزعم الرواة أنه قيل فيه
- اللغة التي كانت موجودة فعلا في الوقت المذكور.
وبعد أن تتهيأ له هذه المواد يجري عملية المقارنة فيوضح الاختلافات الجوهرية بين لغة الشعر وبين لغة الزمن الذي روي أنه قيل فيه . ويستخرج بهذه الطريقة الدليل علي صحة ما يدعيه . لذا تتضح أهمية السؤال الذي وضعه بقوله:
“لنجتهد في تعرف اللغة الجاهلية هذه, ما هي أو ما إذا كانت في العصر الذي يزعم الرواة أن شعرهم الجاهلي هذا قد قيل فيه”… وتتضح أهمية الإجابة عنه.
ولكن الأستاذ المؤلف وضع السؤال وحاول الإجابة عنه وتطرق في بحثه إلي الكلام علي مسائل في غاية الخطورة صدم بها الأمة الإسلامية في أعز ما لديها من الشعور ولوث نفسه بما تناوله من البحث في هذا السبيل بغير فائدة ولم يوفق إلي الإجابة ، بل قد خرج من البحث بغير جواب اللهم إلا قوله :”إن الصلة بين اللغة العدنانية وبين اللغة القحطانية ، إنما هي كالصلة بين اللغة العربية وأي لغة أخري من اللغات السامية المعروفة”. وبديهي أن ما وصل إليه ليس جوابا عن السؤال الذي وضعه، وقد نوقش في التحقيق في هذه المسألة فلم يستطع رد هذا الاعتراض ولا يمكن الاقتناع بما ذكره في التحقيق من أنه كتب الكتاب للأخصائيين من المستشرقين بنوع خاص وان تعريف هاتين اللغتين عند الإخصائيين واضح لا يحتاج إلي أن يذكر لأن قوله هذا عجز عن الجواب ، كما أن قوله إن اللغة الجاهلية في رأيه ورأي القدماء والمستشرقين لغتان متباينتان لا يمكن أن يكون جوابا عن السؤال الذي وضعه لأن غرضه من السؤال واضح في كتابه إذ قال :”ولنجتهد في تعرف اللغة الجاهلية هذه ما هي”. وقد كان قرر قبل ذلك :” فنحن إذا ذكرنا اللغة العربية نريد بها معناها الدقيق المحدود الذي نجده في المعاجم حيث نبحث فيها عن لفظ اللغة ما معناه نريد بها الألفاظ من حيث هي ألفاظ تدل علي معانيها تستعمل حقيقة مرة ومجازا مرة أخرى وتتطلب تطورا ملائما لمقتضيات الحياة التي يحياها أصحاب هذه اللغة ، فبعد أن حدد هو بنفسه معني اللغة الذي يريده فلا يمكن أن يقبل منه ما أجاب به من أن مراده أن اللغة لغتان بدون أن يتعرف عل واحدة منهما.
فالمؤلف إذن في واحدة من اثنتين: إما أن يكون عاجزا وإما أن يكون سيئ النية بحيث قد جعل هذا البحث ستارا ليصل بواسطته إلي الكلام في تلك المسائل الخطيرة التي تكلم عنها في هذا الفصل وسنتكلم فيما بعد عن هذه النقطة عند الكلام علي القصد الجنائي.
2- أنه استدل علي عدم صحة النظرية التي رواها الرواة وهي تقسيم العرب إلي عاربة ومستعربة وتعلم إسماعيل العربية من جرهم، بافتراض وضعه في صيغة سؤال إنكاري . إذا كان أبناء إسماعيل قد تعلموا العربية من أولئك العرب الذين نسميهم العاربة فكيف بعد ما بين اللغة التي كان يصطنعها العرب العاربة واللغة التي كان يصطنعها العرب المستعربة . يريد المؤلف بهذا أن يقول، لو كانت نظرية تعلم إسماعيل وأولاده العربية من جرهم صحيحة لوجب أن تكون لغة المتعلم كلغة المعلم.
وهذا الاعتراض وجيه في ذاته ولكنه لا يفيد المؤلف في التدليل علي صحة رأيه ، لأنه نسي أمرا مهما لا يجوز غض النظر عنه هو يشير إلي الاختلافات التي بين لغة حمير ولغة عدنان ، وهو يقصد بلغة عدنان التي كانت موجودة وقت نزول القرآن لأنه يري من الاحتياط العلمي أن يقرر أن أقدم نص عربي للغة العدنانية هو القرآن ، وهو يعلم أن حمير آخر دول العرب القحطانية ، وقد مضي من وقت وجود إسماعيل إلي وقت وجود حمير زمن طويل جدا أي أنه قد انقضي من الوقت الذي يروي أن إسماعيل تعلم فيه اللغة العربية من جرهم إلي الوقت الذي اختاره المؤلف للمقارنة بين اللغتين زمن يتعذر تحديده ، ولكنه علي كل حال زمن طويل جدا لا يقل عن عشرين قرنا ، فهل يريد المؤلف مع هذا أن يتخذ الاختلافات التي بين اللغتين دليلا علي عدم صحة نظرية الرواة غير حاسب حسابا للتطور الواجب حصوله في اللغة بسبب مضي هذا الزمن الطويل وما يستدعيه توالي العصور من تتابع الحوادث والاختلاف الظروف . إن الأستاذ قد أخطأ في استنتاجه بغير شك.

ونستطيع إذن أن نقول إن استنتاجه لا يصلح دليلا علي فساد نظرية الرواة التي يريد أن يهدمها وأنه ما ثبت وجود اختلاف مهما كان مداه بين اللغتين فإن هذا لا ينفي صحة الرواية التي يرويها الرواة من حيث تعلم إسماعيل العربية من جرهم , ولا يضيرها أن الأستاذ المؤلف ينكرها بغير دليل لأن طريقة الإنكار والتشكك بغير دليل طريقة سهلة جدا في متناول كل إنسان عالما كان أو جاهلا.
علي أننا نلاحظ أيضا علي المؤلف أنه لم يكن دقيقا في بحثه , وهو ذلك الرجل الذي يتشدد كل التشدد في التمسك بطرق البحث عن أمرين ، الأول ما روي عن أبى عمرو بن العلاء من أنه كان يقول “ما لسان حمير بلساننا ولا لغتهم بلغتنا”. والثاني قوله :” ولدينا الآن نقوش ونصوص تمكننا من إثبات هذا الخلاف في اللفظ وفي قواعد النحو والتصريف أيضا”.
أما عن الدليل الأول فإن ما رواه أبو عبد الله بن سلام الجمحي مؤلف طبقات الشعراء عن أبي عمرو بن العلاء “ما لسان حمير وأقاصي اليمن بلساننا ولا عربيتهم بعربيتنا” وقد يكون للمؤلف مأرب من وراء تغيير هذا النص ، علي أن الذي نريد أن نلاحظه هو أن ابن سلام ذكر قبيل هذه الرواية في الصفحة نفسها ما يأتي:
وأخبرني يونس عن أبي عمر قال:” العرب كلها ولد إسماعيل إلا حمير وبقايا جرهم” – راجع ص8 من كتاب طبقات الشعراء طبعه مطبعة السعادة – فواجب علي المؤلف إذن وقد اعتمد صحة العبارة الأولي أن يسلم أيضا بصحة العبارة الثانية ، لأن الراوي واحد والمروي عنه واحد, وتكون نتيجة ذلك أنه فسر ما اعتمد عليه من أقوال أبي عمرو بن العلاء بغير ما أراه بل فسره بعكس ما أراده ويتعين إسقاط هذا الدليل.
وأما عن الدليل الثاني فإن المؤلف لم يتكلم عنه بأكثر من قوله:” ولدينا الآن نقوش ونصوص تمكننا من إثبات هذا الخلاف” فأردنا عند استجوابه أن نستوضحه ما أجمل فعجز” وليس أدل علي هذا العجز من أن نذكر هنا ما دار في التحقيق من المناقشة بشأن هذه المسألة:
س- هل يمكن لحضرتكم الآن تعريف اللغة الجاهلية الفصحي وعلي لغة حمير وبيان الفرق بين لغة حمير ولغة عدنان ومدي هذا الفرق وذكر بعض أمثلة تساعدنا علي فهم ذلك؟
جـ – قلت إن اللغة الجاهلية في رأيي ورأى القدماء والمستشرقين لغتان متباينتان علي الأقل ، أولهما لغة حمير وهذه اللغة قد درست ووضعت لها قواعد النحو والصرف والمعاجم ، ولم يكن شيء من هذا معروف قبل الاكتشافات الحديثة ، وهي كما قلت مخالفة للغة العربية الفصحي التي سألتم عنها مخالفة جوهرية في اللفظ والنحو وقواعد الصرف، وهما إلي اللغة الحبشية القديمة أقرب منها إلي اللغة العربية الفصحي، وليس من شك في أن الصلة بينها وبين لغة القرآن والشعر كالصلة بين السريانية وبين هذه اللغة القرآنية . فأما إيراد النصوص والأمثلة فيحتاج إلي ذاكرة لم يهبها الله لي ، ولابد من الرجوع إلي الكتب المدونة في هذه اللغة.
س- هل يمكن لحضرتكم أن تبينوا لنا هذه المراجع أو تقدموها لنا؟
جـ – أنا لا أقدم شيئا.
س- هل يمكن لحضرتكم أن تبينوا إلي أي وقت كانت موجودة اللغة الحميرية ومبدأ وجودها إن أمكن؟
جـ – مبدأ وجودها ليس من السهل تحديده ولكن لا شك في أنها كانت معروفة تكتب قبل القرن الأول للمسيح وظلت تتكلم إلي ما بعد الإسلام ، ولكن ظهور الإسلام وسيادة اللغة القرشية قد محيا “محوا” هذه اللغة شيئا فشيئا كما محيا”محوا” غيرها من اللغات المختلفة في البلاد العربية وغير العربية وأقرا مكانها لغة القرآن.
س- هل يمكن لحضرتكم أيضا أن تذكروا لنا مبدأ اللغة العدنانية ولو بوجه التقريب؟
جـ – ليس من السهل معرفة مبدأ اللغة العدنانية وكل ما يمكن أن يقال بطريقة عملية هو ان لدينا نقوشا قليلة جدا يرجع عهدها إلي القرن الرابع للميلاد ، وهذه النقوش قريبة من اللغة العدنانية ولكن المستشرقين يرون أنها لهجة قبطية وإذن فقد يكون من احتياط العلم أن نرى أقدم نص عربي يمكن الاعتماد عليه من الوجهة العلمية إلي الآن إنما هو القرآن حتى نستكشف نقوشا اظهر وأكثر مما لدينا.
س- هل تعتقدون حضرتكم أن اللغة سواء كانت اللغة الحميرية أو اللغة العدنانية كانت باقية علي حالها من وقت نشأتها أو حصل فيها تغيير بسبب تمادي الزمن والاختلاط.
جـ – ما أظن أن لغة من اللغات تستطيع أن تبقي قرونا دون أن تتطور ويحصل فيها التغيير الكثير.
ونحن مع هذا لا نريد أن ننفي وجود اختلاف بين اللغتين ولا نقصد أن نعيب علي المؤلف جهله بهذه الأمور فإنها في الحقيقة مازالت من المجاهل وما وصل إليه المستشرقون من الاستكشافات لا ينير الطريق ، وإنما الذي نريد أن نسجله عليه هو أنه بني أحكامه علي أساس مازال مجهولا ، إذ إنه يقرر بجرأة في آخر الفصل الذي نتكلم بشأنه ،”والنتيجة لهذا البحث كله تردنا إلي الموضوع الذي ابتدأنا به منذ حين وهو أن هذا الشعر الذي يسمونه الجاهلي لا يمثل اللغة الجاهلية ولا يمكن أن يكون صحيحا ، ذلك لأننا نجد بين هؤلاء الشعراء الذين يضيفون إليهم شيئا كثيرا من الشعر الجاهلي قوما ينتسبون إلي عرب اليمن إلي هذه القحطانية العاربة التي كانت تتكلم لغة غير لغة القرآن والتي كان يقول عنها أبو عمرو بن العلاء إن لغتنا مخالفة للغة العرب والتي أثبت البحث الحديث أنها لغة أخرى غير اللغة العربية .
 فمتي قال أبو عمرو بن العلاء إنها لغة مخالفة للغة العرب, لقد أشرنا إلي التغيير الذي أحدثه المؤلف فيما روي عن أبي عمرو حيث حذف من روايته .” وقلنا قد يكون للمؤلف مآرب من وراء هذا التغيير ، فهذا هو مآربه ، إن الأستاذ حرف في الرواية عمدا ليصل إلي تقرير هذه النتيجة.
فمتي قال أبو عمرو بن العلاء إنها لغة مخالفة للغة العرب, لقد أشرنا إلي التغيير الذي أحدثه المؤلف فيما روي عن أبي عمرو حيث حذف من روايته .” وقلنا قد يكون للمؤلف مآرب من وراء هذا التغيير ، فهذا هو مآربه ، إن الأستاذ حرف في الرواية عمدا ليصل إلي تقرير هذه النتيجة.
وبقول المؤلف أيضا والتي أثبت البحث الحديث أن لها لغة أخرى غير اللغة العربية – وقد أبنّا فيما سلف أنه عجز في إثبات هذه المسألة عن إثبات ما يدعيه – ومن الغريب أنه عندما بدأ البحث اكتفي بأن قال ، ولدينا الآن نقوش ونصوص تمكننا من إثبات هذا الخلاف في اللفظ وفي قواعد النحو والتصريف أيضا, ولكنه انتهي بأن قرر بأن البحث الحديث أثبت أن لها لغة أخرى غير اللغة العربية!!
قرر الأستاذ في التحقيق أنه لاشك في أن اللغة الحميرية ظلت تتكلم إلي ما بعد الإسلام ، فإن كانت هذه اللغة هي لغة أخرى غير اللغة العربية كما يوهم أنه انتهي به بحثه فهل له أن يفهمنا كيف استطاع عرب اليمن فهم القرآن وحفظه وتلاوته؟
نحن نسلم بأنه لابد من وجود اختلافات بين لغة حمير وبين لغة عدنان ، بل ونقول إنه لابد من وجود شيء من الاختلافات بين بعض القبائل وبين البعض الآخر ممن يتكلمون لغة واحدة من اللغتين المذكورتين لا تخرجها عن العربية وهذه الاختلافات هي التي قصدها أبو عمرو بن العلاء بقوله :” ما لسان حمير بلساننا” والمؤلف لا يستطيع أن ينكر الاختلاط الذي لابد منه بين القبائل المختلفة خصوصا في أمة متنقلة بطبيعتها كالأمة العربية ، ولابد لها جميعا من لغة عامة تتفاهم بها هي اللغة الأدبية ، وقد أشار هو بنفسه إليها في ص 17 من كتابه حيث قال عن القرآن:
ولكنه كان كتابا عربيا لغته هي اللغة العربية الأدبية التي كان يصطنعها الناس في عصره أي في العصر الجاهلي”. وهذه اللغة الأدبية هي لغة الكتابة ولغة الشعر ، والمؤلف نفسه عندما تكلم في الفصل الخامس عشر عن الشعر الجاهلي واللهجات بحث في ص35 و36و37 بحثا يؤيد هذا المعني وإن كان يدعي بغير دليل أن الإسلام قد فرض علي العرب جميعا لغة عامة واحدة هي لغة قريش مع أنه سبق أن ذكر في ص17 أن لغة القرآن هي اللغة العربية الأدبية التي كان يصطنعها الناس في عصره أي في العصر الجاهلي فلم لا تكون لهذه اللهجة الأدبية السيادة العامة من قبل نزول القرآن بزمن طويل وكيف يستطيع هو هذا التحديد وعلام يستند؟.
يتضح مما تقدم أن عدم ظهور خلاف في اللغة لا يدل في ذاته حتما علي عدم صحة الشعر . ونحن لا نريد بما قدمنا أن نتولي الدفاع عن صحة الشعر الجاهلي إذ إن هذه المسألة ليست حديثة العهد ابتدعها المؤلف وإنما هي مسالة قديمة قررها أهل الفن والشعر كما قال “ابن سلام” صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم كسائر أصناف العلم والصناعات وهو يحتاج في تمييزه إلي خبير كاللؤلؤ والياقوت لا يعرف بصنعة ولا وزن دون المعاينة ممن يبصره – ولكن الذي نريد أن نشير إليه إنما هو الخطأ الذي اعتاد أن يرتكبه المؤلف في أبحاثه حيث بدأ يرتب عليه قواعد كأنها حقائق ثابتة كما فعل في أمر الاختلافات بين لغة حمير وبين لغة عدنان ثم في مسألة إبراهيم وإسماعيل وهجرتهما إلي مكة وبناء الكعبة إذ بدأ فيها بإظهار الشك ثم انتهى باليقين بدأ بقوله :” للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم و إسماعيل و للقرآن أن يحدثنا عنهما أيضا ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي فضلا عن إثبات هذه القصة التي تحدثنا بهجرة إسماعيل ابن إبراهيم إلي مكة ونشأة العرب المستعربة فيها”.
إلي هنا أظهر الشك لعدم قيام الدليل التاريخي في نظره ، كما تتطلبه الطرق الحديثة ثم انتهي بأن قرر في كثير من الصراحة: إن ضعف هذه القصة إذن واضح فهي حديثة العهد ظهرت قبل الإسلام واستغلها الإسلام لسبب ديني … إلخ .. فما هو الدليل الذي انتقل به من الشك إلي اليقين؟
هل دليله هو قوله “نحن مضطرون إلي أن نري في هذه القصة نوعا من الحيلة في إثبات الصلة بين اليهود والعرب من جهة وبين الإسلام واليهودية والقرآن والتوراة من جهة أخرى؟ وأن أقدم عصر يمكن أن تكن قد نشأت فيه هذه الفكرة إنما هو ذلك العصر الذي أخذ اليهود يستوطنون فيه شمال البلاد العربية ويبنون فيه المستعمرات .. إلخ – وأن ظهور الإسلام وما كان من الخصومة بينه وبين وثنية العرب من غير أهل الكتاب قد اقتضي أن نثبت الصلة بين المدن الجديدة وبين ديانتي النصارى واليهود وأنه مع ثبوت الصلة الدينية يحسن أن تؤيدها صلة مادية….إلخ.
إذا كان الأستاذ المؤلف يرى أن ظهور الإسلام قد اقتضي أن تثبت الصلة بينه وبين اليهود والنصارى ، وأن القرابة المادية الملفقة بين العرب وبين اليهود لازمة لإثبات الصلة بين الإسلام وبين اليهودية فاستغلها لهذا الغرض ، فهل له أن يبين السبب في عدم اهتمامه أيضا بمثل هذه الحيلة لتوثيق الصلة بين الإسلام وبين النصرانية؟ و هل عدم اهتمامه هذا معناه عجزه أو استهانته بأمر النصرانية ؟ وهل من يريد توثيق الصلة مع اليهود بأي ثمن , حتى باستغلال التلفيق هو الذي يقول عنهم في القرآن :”لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا” إن الأستاذ ليعجز حقا عن تقديم هذا البيان إذ إن كل ما ذكره في هذه المسألة إنما هو خيال في خيال وكل ما استند إليه من الأدلة هو:
- فليس ببعيد أن يكون ..
- فما الذي يمنع ..
- ونحن نعتقد …
- وإذن فليس ما يمنع قريشا من أن تقبل هذه الأسطورة.
- وإذن فنستطيع أن نقول !!!
فالأستاذ المؤلف في بحثه إذا رأى إنكار شيء يقول لا دليل عن الأدلة التي تتطلبها الطرق الحديثة للبحث حسب الخطة التي رسمها في منهج البحث وإذا رأي تقرير أمر لا يدلل عليه بغير الأدلة التي أحصيناها له وكفي بقوله حجة.
سئل الأستاذ في التحقيق عن أصل هذه المسألة “أي تلفيق القصة” وهل هي من استنتاجه أو نقلها . فقال :” فرض فرضته أنا دون أن أطلع عليه في كتاب آخر وقد أخبرت بعد أن ظهر الكتاب أن شيئا مثل هذا الفرض يوجد في بعض كتب المبشرين ، ولكن لم أفكر فيه حتى بعد ظهور كتابي”. علي أنه سواء كان هذا الفرض من تخيله كما يقول أو من نقله عن ذلك المبشر الذي يستتر تحت اسم “هاشم العربي” فإنه كلام لا يستند إلي دليل ولا قيمة له ، علي أننا نلاحظ أن ذلك المبشر مع ما هو ظاهر من مقاله من غرض الطعن علي الإسلام كان في عباراته أظرف من مؤلف كتاب الشعر الجاهلي لأنه لم يتعرض للشك في وجود إبراهيم وإسماعيل بالذات وإنما اكتفي بأن أنكر أن إسماعيل أبو العرب العدنانيين وقال إن حقيقة الأمر في قصة إسماعيل أنها دسيسة لفقهاء قدماء اليهود للعرب تزلفا إليهم .. إلخ . كما نلاحظ أيضا أن ذلك المبشر قد يكون له عذره في سلوك هذا السبيل لأن وظيفته التبشير لدينه وهذا غرضه الذي يتكلم فيه ولكن ما عذر الأستاذ المؤلف في طرق هذا الباب وما هي الضرورة التي ألجأته إلي أن يري في هذه القصة نوعا من الحيلة …إلخ….
 وإن كان المتسامح يري له بعض العذر في التشكك الذي أظهره أولا اعتمادا علي عدم وجود الدليل التاريخي كما يقول فما الذي دعاه إلي أن يقول في النهاية بعبارة تفيد الجزم : إن غرض هذه القصة إذن واضح فهي حديثة العهد ظهرت قبيل الإسلام واستغلها الإسلام لسبب ديني واضح ..إلخ مع اعترافه في التحقيق بأن المسألة فرض افترضه؟
وإن كان المتسامح يري له بعض العذر في التشكك الذي أظهره أولا اعتمادا علي عدم وجود الدليل التاريخي كما يقول فما الذي دعاه إلي أن يقول في النهاية بعبارة تفيد الجزم : إن غرض هذه القصة إذن واضح فهي حديثة العهد ظهرت قبيل الإسلام واستغلها الإسلام لسبب ديني واضح ..إلخ مع اعترافه في التحقيق بأن المسألة فرض افترضه؟
يقول الأستاذ إنه إن صح افتراضه فإن القصة كانت شائعة بين العرب قبل الإسلام فلما جاء الإسلام استغلها وليس ما يمنع أن يتخذها الله في القرآن وسيلة لإقامة الحجة علي الخصوم المسلمين كما اتخذ غيرها من القصص التي كانت معروفة وسيلة إلي الاحتجاج أو إلي الهداية – وهاشم العربي يقول في مثل هذه : ولما ظهر محمد رأي المصلحة في إقرارها فأقرها وقال للعرب إنه إنما يدعوهم إلي ملة جدهم هذا الذي يعظمونه من غير أن يعرفوه فسبحان من أوجد هذا التوافق بين الخواطر…
إن الأستاذ المؤلف أخطأ فيما كتب وأخطأ أيضا في تفسير ما كتب وهو في هذه النقطة قد تعرض بغير شك لنصوص القرآن وليس في وسعه الهرب بادعائه البحث العلمي منفصلا عن الدين , فيلفسر لنا إذن قوله تعالي في سورة النساء:” إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلي نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسي وأيوب ويونس وهارون وسليمان ..الخ..” وقوله في سورة مريم :”واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا” و”اذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا” وفي سورة آل عمران :” قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل علي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون” وغير ذلك من الآيات القرآنية الكثيرة التي ورد فيها ذكر إبراهيم وإسماعيل ،لا علي سبيل المثال كما يدعي حضرته ، وهل عقل الأستاذ سليم بأن الله سبحانه وتعالي يذكر في كتابه أن إبراهيم نبي وأن إسماعيل رسول نبي مع أن القصة ملفقة، وماذا يقول حضرته في موسى وعيسى و قد ذكرهما الله سبحانه و تعالى في الأية الأخيرة مع إبراهيم و إسماعيل و قال في حقهم جميعا لا نفرق بين أحد منهم ، و هل يرى حضرته أن قصة موسى و عيسى من الأساطير أيضا قد ذكرها الله وسيلة للاحتجاج أو للهداية كما فعل في قصة إبراهيم وإسماعيل مادامت الآية تقضي بألا نفرق بين أحد منهم ، الحق أن المؤلف في هذه المسألة يتخبط تخبط الطائش ويكاد يعترف بخطئه لأن جوابه يشعر بهذا عندما سألناه في التحقيق عن السبب الذي دعاه أخيرا لأن يقرر بطريقة تفيد الجزم بأن القصة حديثة العهد ظهرت قبيل الإسلام فقال في ص37 من محضر التحقيق :”هذه العبارة إذا كانت تفيد الجزم فهي إنما تفيده إن صح الفرض الذي قامت عليه وربما كان فيها شيء من الغلو ولكنى أعتقد أن العلماء جميعا عندما يفترضون فروضا علمية يبيحون لأنفسهم مثل هذا النحو من التعبير فالواقع أنهم مقتنعون فيما بينهم وبين أنفسهم بأن فروضهم راجحة”.
والذي نراه أن موقف الأستاذ المؤلف هنا لا يختلف عن موقف الأستاذ “هوار” حين يتكلم عن شعر أمية بن أبي الصلت وقد وصف المؤلف نفسه هذا الموقف ص82و83 من كتابه بقوله:”مع أنى من أشد الناس إعجابا بالأستاذ “هوار” وبطائفة من أصحابه المستشرقين وبما ينتهون إليه في كثير من الأحيان من النتائج العلمية القيمة في تاريخ الأدب العربي التي يتخذونها للبحث فإني لا أستطيع أن أقرأ مثل هذا الفصل دون أن أعجب كيف يتورط العلماء أحيانا في مواقف لا صلة بينها وبين العلم”.

حقا إن الأستاذ المؤلف قد تورط في هذا الموقف الذي لا صلة بينه وبين العلم بغير ضرورة يقتضيها بحثه ولا فائدة يرجوها لأن النتيجة التي وصل إليها من بحثه وهى “إن الصلة بين اللغة العدنانية وبين اللغة القحطانية كالصلة بين اللغة العربية وأي لغة أخرى من اللغات السامية المعروفة وأن قصة العاربة والمستعربة وتعلم إسماعيل العربية من جرهم كل ذلك حديث أساطير لا خطر له ولا غناء فيه” ما كانت تستدعي التشكك في صحة إخبار القرآن عن إبراهيم وإسماعيل وبنائهما الكعبة ثم الحكم بعدم صحة القصة وباستغلال الإسلام لها لسبب ديني.
ونحن لا نفهم كيف أباح المؤلف لنفسه أن يخلط بين الدين وبين العلم وهو القائل بأن الدين يجب أن يكون بمعزل عن هذا النوع من البحث الذي هو بطبيعته قابل للتغيير والنقض والشك والإنكار”ص 22 من محضر التحقيق”.
وإننا حين نفصل بين العلم والدين نضع الكتب السماوية موضع التقديس ونعصمها من إنكار المنكرين وطعن الطاعنين “ص24 من محضر التحقيق” ولا ندرى لم يفعل غير ما يقول في هذا الموضوع.
لقد سئل في التحقيق عن هذا فقال :” إن الداعي أني أناقش طائفة من العلماء والآباء والقدماء والمحدثين وكلهم يقرون أن العرب المستعربة قد أخذوا لغتهم عن العرب العاربة بواسطة أبيهم إسماعيل بعد أن هاجر ، وهم جميعا يستدلون علي آرائهم بنصوص من القرآن ومن الحديث فليس لي بد من أن أقول لهم إن هذه النصوص لا تلزمني من الوجهة العلمية؟.
أما الثابت من نصوص القرآن فقصة الهجرة وقصة بناء الكعبة وليس في القرآن نصوص يستدل بها علي تقسيم العرب إلي عاربة ومستعربة ، علي أن إسماعيل أبو العرب العدنانيين , ولا علي تعلم إسماعيل العربية من جرهم ، ونص الآية التي ثبتت الهجرة “ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون” ، لا يفيد غير إسكان ذرية إبراهيم في وادي مكة أي أن إسماعيل هو جرهم صغير “كنص الحديث” إلي هذا الوادي فنشأ فيه بين أهله وهم من العرب وتعلم هو وأبناؤه لغة من نشئوا بينهم وهي العربية لأن اللغة لا تولد مع الإنسان وإنما تكتسب اكتسابا وقد اندمجوا في العرب فصاروا منهم وهذا الاندماج لا يترتب عليه أن يكون جميع العرب العدنانيين من ذريته ، إذ الحكم بهذا يقتضي ألا يكون مع إسماعيل أحد منهم حتى لا يوجد غير ذريته وهو ما لم يقل به أحد – ويا ليت الأستاذ المؤلف حذا حذو ذلك المبشر “هاشم العربي” في هذه المسألة حيث قال:” ولا إسماعيل نفسه بأب للعرب المستعربة ولا تملك أحد من بنيه علي أمة من الأمم وإنما قصارى أمرهم أنهم دخلوا وهم عدد قليل من قبائل العرب العديدة المجاورة لمنازلهم فاختلطوا بها وما كانوا منها إلا كعصاه في قلاة”- راجع ص356 من كتاب مقالة في الإسلام – ولو أن المؤلف فعل هذا لنجا من التورط في هذا الموضوع .
أما مسألة بناء الكعبة فلم يفهم الحكمة في نفيها و اعتبارها أسطورة من الأساطير اللهم إلا إذا كان مراده إزالة كل أثر لإبراهيم وإسماعيل ولكن ما مصلحة المؤلف من هذا؟ الله أعلم بمراده”. انتهى
ونكمل في الجزء الثاني إن شاء الله