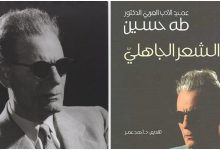“رافق شقيقته العروس إلى الكوافير، استقلا سيارة من قريتهما إلى الزقازيق، الطريق الزراعي ضيّق وغير ممهد، تعرّضا لحادثٍ، توفيت العروس ولحق بها شقيقها طالب الجامعة، بعدها بسويعات قليلة”.
الدم ـ على الإسفلت ـ يلمع مثل وردة حمراء تفتحت لتوها، ترتوي من شفق الغروب نورًا شجيًا، يلقي أحزانه الثقيلة على نوافذ السيارات التي تقطع الطريق ذهابًا وإيابًا، تغالب العيون الدموع.. والدموع تغالبها، وعندما يخطو الليل أولى خطواته الرمادية، تبدو البيوت مسكونةً بالصمت، كأنها أذعنت لقسوة الحياة، ولكن الحزن يعبق برائحة الموت، ويظل مثل ضباب الساعات الأولى من الصباح، يسدل قطرات الندى على العيون الناعسة، في انتظار أن تمد الشمس يدها الدافئة، ولكن الشمس هنا، في قريتنا، عجوز متثاقلة، فيبقى الحزن يمضغ قلوب المكلومين ولا يفتر حماسه.
الموت على الطرق، في قريتنا، لا تنتهي عنده الحكايات.. بل تبدأ حاملة في قبضة يدها المتبلدة، حفار الحزن تغمده بلا رحمة، في قلوب كاد يلامس قاربها المشطور، الماء الضحل على الشاطئ.
القتلى على الطرق، لا يموتون في قريتنا، يموتون فقط عند ذويهم، وأحياء عند الناس، تحل أرواحهم في أجساد الجن والعفاريت وأشباح هلامية، تباغت من يقفل راجعًا إلى بيته ليلًا، تارة في صورة قطيع من الضأن، ومرة في هيئة عجوز يركض منحنيًا مثل المنجل على الجسر، يرتدي جلبابًا واسعًا، يربط جزءه السفلي حول وسطه، ولا يرد السلام على أحد، أو طفل ملفوف في كفن أبيض، مسجى وسط مصلاة من القش، تحت شجرة توت عتيقة.
روى لي صديقي ـ طالب الجامعة ـ أنه عاد ذات ليلة شاتية، من الزقازيق يشق الطريق وحده، لا شيء إلا الصمت والظلام وحفيف الشجر وارتطام الورق اليابس المتساقط مع الإسفلت، مخلفًا همسًا غامضًا، كأنه وشوشة بين أشياء.. ولا أشياء!، لا يرى أبعد من طرف حذائه. وفجأة ظهر له شقيق العروس المتوفى، يحمل قنديلًا بيدِ ونبوتًا باليد الأخرى، يسبقه بخطوات، وكلما جاوزه خوفًا وهلعًا، لحق به وتجاوزه، اختفى مع لمح أول لمبة جاز، معلقة على جدار مقهى نصف مغلق، تعبق رائحة الحشيش، في غلالة الهواء المسترخية على بابه الموارب، وكأن يدًا خفية حلّت قيدًا، طوق قدمه اليمنى وربطها باليسرى، وأطلقهما بعدها للريح، عاد القيد المتخفي يشد وثاقه مجددًا، عندما شاهد مباراة كرة قدم، بين فريقين على ملعب القرية، والمشجعون رؤوسهم رأس إنسان، وأيديهم تشبه حوافر الماعز. وكأن ريحًا عاصفًا، انتزعته من المكان، وألقت به قبالة المسجد، قبل الفجر بساعة، لمح فتاة جميلة تخطو مُسرعة، تحمل في يدٍ فستان زفاف أبيض طويلاً مرصّعًا بالأحجار الكريمة، وفي الأخرى بوكيه من ورد البنفسج، استوقفها وقصّ عليها ما رآه: مشجعون رؤوسهم رأس إنسان، وأيديهم تشبه حوافر الماعز. ألقت الفستان وبوكيه الورد، ومدّت له يديها، وقالت: مثل هاتين؟!
صمت برهة ثم أردف: “لا أدري كيف عثر علي أبي، أفقت على صوته، غاضبًا يتوعدني بالعقاب، على سهري إلى تلك الساعة خارج البيت”.
لم يشغلني في هذه اللحظة التدقيق في روايته، مثيلاتها باتت من حكايات آخر الليل قبل النوم في كل بيت، لا طعم بدونها لبراد الشاي وإبريق الماء وطبق الكحك، يلوكونها ولا يلقون لها بالًا وهم على فروة الصلاة. أعرف يقينًا أن اقتفاء أثرها عبث. لم يشغلني إذ ذاك إلا مشاعر أمهما المفجوعة.